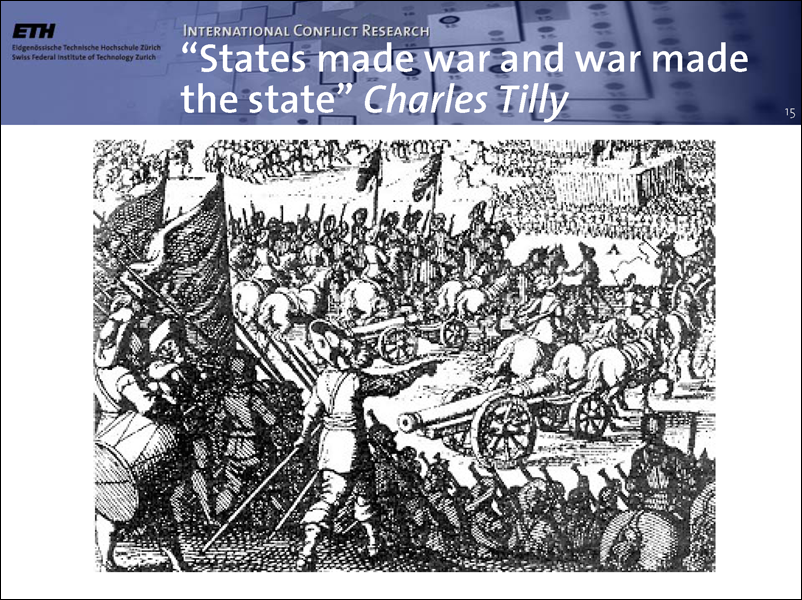التطرف صنيعة العولمة والاستبداد/ مضر رياض الدبس
تطرفٌ كَليلِ امرئ القيس أرخى سدولَهُ. ولا يتفاءل الذين أرادوا صباح الحرية بصبحٍ أفضل. يستشهدون بواقع ثورتهم لتبرير تشاؤمهم، وبالاستبداد الذي أردف أعجازًا وناءَ بكلكلِ، ولم تكن داعش منه بأمثلِ… هذا لسانُ حالِ سوري يُسرِّج للتأمل فكرَتَهُ، وللفلسفة صوفيتَها، ويسأل: من سقى “الداعشي” كأس الجنون؟ ومن سقى “جنود الولي الفقيه” كأس الجنون؟…”إلهي إن كان، في سابق علمك، أن يوجَد الجحيم فعظّم خلقي فيه، حتّى لا يسع معي غيري”، هذه عبارة تُنسب للصوفي صاحب الشطحات، أبو يزيد البسطامي، قالها بإيثارٍ كثير، ويرد عليه “الداعشي”، وسلفه في المكان أتباع الولي الفقيه، بعد إثني عشر قرنًا، فيض أنانية: إلهي، إن الدنيا لا تساوي عندك جناح بعوضة، فعظّم خلقي فيها، حتّى لا تسع معي غيري… وإن كان أبو يزيد البسطامي قد قال: “سبحاني ما أعظم شأني”، قالها تعظيمًا لخلق الله، وإن شطح، فإن الداعشي ومجاهد الولي الفقيه قالاها بطشًا وشططا.
من سقى جبابرةَ البطش كأس الجنون؟ نقف للإجابة عن هذا التساؤل التأملي. ولهذا، نترك التأمل، وننتقل إلى علم الاجتماع، وتحديدًا إلى الحقل الذي يدرس في طبيعة المقدسات وانعكاساتها على سلوك الإنسان، وتأثُّرها وتأثيرها في ثقافتنا، وفي نوعية مداركنا. نجد أن المقدَّس لم يكن مُعطى ناجزًا عبر التاريخ، بل ظلَّ يتقلَّب في دلالاته عبر الأزمان، ويتغيرُ بتغيرِ الثقافة والمكان. تأخذنا اللغة، في معناه، إلى الطاهر غير المدنس، واستخدم عرب الحجاز لفظ “القَدَس” للدلالة على الإناء الذي يغتسلون به، أي الذي يتطهرون ويتقدّسون بواسطته. والتقديس في الإسلام هو تنزيه الله عز وجل، وهذه عبارةٌ واسعةُ الدلالات ومتعددةُ الفهم، وتستطيعُ أن تُبَرِر طُرق التنزيه الصوفية كطُرق البسطامي، كما يمكن تأويلها لتبرير طرق التنزيه “الداعشية”، وأساليب البطش بالعباد، ويمكن أن تستخدم لتبرير كثير من طُرق الفهم الخاصة والغريبة بينهما، ولا مجال للخوض فيها هنا. ولكن، يأخذنا تَعدُد الدلالات إلى تعريفٍ علمي للمقدس، يضبط دلالته؛ فنقول: “المقدس هو ما يُعلِّق الإنسانُ عليه سلوكَه بالكامل، سواء كان شيئًا أم فكرة. إنه ما لا يقبل أن يطرحه على طاولة البحث، وما لا يقبل رؤيته مُهانًا، أو محتقرًا، وما لا ينكره، ولا يخونه، مهما كان الثمن”، هو الحبيبة بالنسبة للعاشق، والرسم بالنسبة للفنان، والثورة بالنسبة للثائر… إلخ.
ويتطلَّبُ المقدّس أفعالًا اجتماعيةً معينةً تُناسبه. وكأي فعلٍ اجتماعي، لا يمكن أن يأخذ دلالاته إلا من خلال الثقافة، فإذا انفكّت، أو تعطلت العلاقة بين المقدس والثقافة، أو بين الثقافة والمجتمع، سيؤدي ذلك إلى ارتباك في الفعل الاجتماعي الذي يُنتِجُهُ المقدَّس، وسيشوبه عدم الاتزان. هذه النتيجة مهمةٌ جدًا في سياق الإجابة عن تساؤلِنا، فإن الذي سقى “داعش” ومجرمي دولة الفقيه كأس الجنون هو الذي هَيَأَ لهما المسببات والدوافع لتكوين دينٍ صافٍ منزوع الثقافة، وبالتالي مَنَحَهُما الأهليَّة للخوض في الجهل المقدس، وبمشاركة ومباركة ممن هيأ لهما الوسط المناسب للنمو والتكاثر. وليس من الصعوبة استنتاج أن الاستبداد الذي كشَّرَ عن أنيابه في مواجهة شعبٍ ثائر طلب حرية، وجعل من بلاده مكاناً للفوضى ومركز جذبٍ لها، هو الذي منح التطرف وسط الحياة والتكاثر والممارسة. ويبقى البحث عن الذي مَنح الأهليَّةَ لتكوين الجهل المقدس، وذلك عَبرَ فكّ ارتباط الدين بمرجعيته الثقافية والمجتمعية والأخلاقية، وبالتالي، تأهيلُه لعبور الحدود والقارات، بالشكل الذي لا يقيم وزنًا لأي انتماءٍ وطني. وإذا أهملنا الأسباب الأقل تأثيرًا، وركّزنا على السبب الأساسي، فإننا سنصل إلى العولمة التي على الرغم من إنجازاتها الكبرى التي تصب في مصلحة الإنسان، فإن لها أعراضها الجانبيَّة التي بدأت تظهر، الآن، بشكل يهدد إنسانيَّة الإنسان، وأصبحنا نحتاج إلى علاج لمرضٍ سبَّبه العالم مُجتمعًا. يبدو عزل الدين عن الثقافة شرطاً أولياً ليصبح قابلًا للتعولم، أي قابلًا للتصدير وعبور الحدود، فتقوم الأديان، تحت تأثير العولمة، وتحت تأثير الضغط الأصولي باتجاه التوسع والانتشار، ضمن هذه “القرية الصغيرة”؛ بإنجاز فصل الدين عن ثقافته، من أجل تحضيره للتصدير، ويؤدي هذا الديني المعزول إلى تقديس كلماتٍ مجهولة الدلالات، وعديمة المضمون المعرفي، كنتيجةٍ لانعدام اتصاله مع أي ثقافة، وإن هذا الدين المحض، بما يمتلك من نزعة إنتاج ثقافة اللاثقافة وثقافة المُتخيَّل، يتحول إلى “جهلٍ مقدّس”، فدور تحفيظ القرآن الكريم، مثلًا، في الهند وباكستان وبنغلادش وإندونيسيا، تخرّج آلاف الطلاب الذين يحفظون القرآن، من دون فهم معنى ودلالات القسم الأعظم مما يحفظون. فلم تعد المعرفة شرطًا للخلاص، ولا شرطًا للتقديس. هذا الخواء المعرفي المجرد الذي يعود فيصطدم بواقع ملموس، لا يجد إلا البطش والإرهاب منهجًا. هو جنون العالم بعد جرعة زائدة من العولمة، و”داعش” و”حزب الله” وأمثالهما هم آليات تنفيذ هذا الجنون، وأعراضه ومؤشراته، وهم وجهنا القبيح، ووجه كلّ العالم القبيح!
نعود الآن، بعد هذا الكلام السوسيولوجي، إلى التأمل الفلسفي؛ وقول الشاعر الصوفي عز الدين المقدسي: “سقوني وقالوا لا تُغني ولو سقوا/ جبالَ حنين ما سقوني لغنتِ”. فإن الصوفي، هنا، إذ يتحدث عن الخمر الذي لم يقاوم إغراءَ شُربِه، فغنّى، بعد الشرب، كنتيجةٍ منطقيه له، فإن “الداعشي”، أو إرهابي ولاية الفقيه، لو امتلك حكمة الصوفي، وهذا خيال، لتحدث عن إغراء خمر العولمة الذي لا يقاوم، والذي لا تَكمُن نشوته في الغناء، لكنها تكمن في الذبحِ، والرجمِ، والسبي، والجنونِ المجرَّدِ الذي يَصطدمُ بالواقعِ الملموس، أي جنون الإرهاب. وما سبق تفسيرٌ، وليس تبريراً.
العربي الجديد