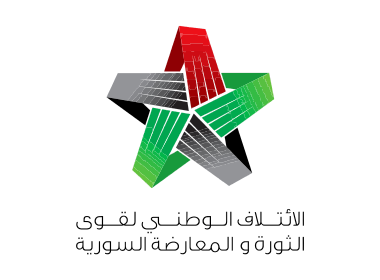الثورة السورية والوطنية: علا شيب الدين

علا شيب الدين
أكثر من ثلاثة آلاف تمثال لحافظ الأسد، حُطِّمت أو أُسقِطت، وثّقتها “لجان التنسيق المحلية” أخيراً، كان أولها تمثاله في مدينة القامشلي 2004، وأضخمها ذاك الذي أُسقط في 4/3/2013 بمحافظة الرقة. مشهد هذا الأخير في أثناء تهاويه، ربما يذكّر بمشهد تهاوي تمثال الطاغية صدام حسين في بغداد، مع فارق جوهري يكمن في أن الأول أسقطته أياد سوريّة، بينما الثاني أُسقط بأياد أميركية إبان غزو العراق عام 2003. كل التماثيل في المدن والبلدات السورية المختلفة، شأنها شأن تمثال الرقة، حُطِّمت أو أُسقِطت بأياد وطنية، في الوضح، وتحت قرص الشمس الناري. لم يوثّق لحظة تحطّم أي تمثال أو سقوطه سيّاحٌ في أعناقهم كاميرات مدلاة، بل ناشطون سوريون حملوا أرواحهم على الأكفّ، وآثروا توثيق أحداث الثورة لحظة بلحظة، بواسطة كاميرات هواتف جوالة بسيطة، وكان الدم المراق كياقوتة لا تقدَّر بثمن، ثمناً لإسقاط كل تمثال، وفداء لوطنية هي الحلم والثراء وفانوس خلاص وحرية.
التظاهرات الشعبية الحاشدة، المدنية السلمية، حتماً لم تكن في بلاد السند والهند، ولا كان أهلوها كائنات فضائية، بل هم أبناء درعا وبناتها مثلاً (مهد ثورة الحرية والكرامة)، وحمص (عاصمة الثورة)، وكفرنبل (ضمير الثورة). ليسوا عصابات مسلحة، ولا إرهابيين وتكفيريين، ولم يثوروا على المبايعة الأبدية لآل الأسد، من أجل مبايعة “القاعدة”، وقد لاقت مبايعة ما يُسمّى “جبهة النصرة” المثيرة للشكوك، تنظيم “القاعدة” لحكم سوريا، رفضاَ قاطعاً، ورُفعت في التظاهرات لافتات تؤكد أن “الشعب السوري لا يبايع إلا الشعب السوري”. وهناك تحليلات ترجّح اختراق النظام وحلفائه للجبهة المذكورة لتشويه سمعة الثورة!
منذ أكثر من عامين، لا يزال السوريون الثائرون يهتفون: “خاين، خاين، خاين/ الجيش العربي السوري خاين”. لماذا يا ترى؟ لأنه جيش وطني، حماهم وحمى ديارهم وأرضهم وعرضهم، فكافأوه بهذا الهتاف؟! أم لأن هجمة النار الآتية من المالكي وإيران و”حزب الله” لتشارك في حرق السوريين وقتلهم في مدينة القصير بمحافظة حمص وغيرها من المناطق السورية، ليست ارتزاقاً، بل “وطنية” مضاعَفة مضافة إلى “وطنية” القوات “الباسلة”؟!
استراتيجيا الغزاة، التسلل. يطنبون في الحديث عن الأخلاق والوطنية، لكن غالباً ما تثبت صحة استنتاج مؤسس التحليل النفسي، فرويد: “أكثر الناس حديثاً عن الأخلاق، هم أبعد الناس عنها”. فمَن يفرط في إلقاء الضوء على موضوع أخلاقي، جيِّد ومقبول لدى الناس، ويسخِّر الطاقات لتثبيته في الوعي، معناه أن ثمة أمراً مناقِضاً للمعلَن، يُراد إخفاؤه والتستُّر عليه. هكذا، كان النظام السوري دوماً يسلّط كل “أضوائه” على “فكرة” المقاومة. طويلاً جُنِّد السوريون، وزُجَّ بهم في سجن الطوارئ تحت ذريعة الحرب مع العدو الإسرائيلي الذي “احتُفِظ دوماً بحق الرد على اعتداءاته!”، وطويلاً حُرِموا حتى من أبسط الحقوق تحت اسم “الممانعة” التي منعت كل جميل ونبيل. بيد أن الممانعة “العظيمة” في الضوء، لم تكن في العتمة إلا خيانة “عظمى”. استناداً إلى استنتاج فرويد نفسه، فإن قول بشار الأسد في خطابه الأول في بدايات الثورة: “وإننا نؤكد في سوريا أن السلام الشامل، لن يتحقق إلا بعودة الجولان كاملاً”، إنْ هو إلا رسالة غزَل للإسرائيليين، مفادها: “وإننا نؤكد في سوريا إخلاصنا لكم، الجولان لا نريد استرجاعه كما تعلمون، لكن قفوا إلى جانبنا ضد احتجاج الشعب، وساندونا من أجل البقاء في السلطة”. في المقابل، ما رفْض الزعماء في أميركا وإسرائيل للأسد ونظامه في العلن، إلا قبول مطلق به في الباطن، وقد أثبتت التجربة أنه كان كلما علت أصوات تدعو الأسد إلى التنحي، وتزعم أن أيامه باتت معدودة، ازداد التمسك في بقائه، على الأقل حتى ينتهي من تدمير البلد. يتخاصمون على المنابر، وخلف الستائر يتفاوضون ويخططون. وعليه، لم يكن مصادفة، ارتفاع منسوب التخوين للسوريين الثائرين، كلما ادعى زعماء غربيون دعم ثورتهم – مع أنهم لم يدعموا-، إذ كانوا بذلك يساندون النظام في تأكيد نفسه عبر تصنّع طهارة الوطنية في الضوء، في مقابل ضمان بقائه حارس إسرائيل في العتمة.
كان هتاف الثائرين السوريين: “إبن الحرام باع الجولان”، من أشد الهتافات تعريةً للطهارة المصطنعة، والوطنية الباذخة في ماخور عهر، هكذا يمكن فهم قلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في تصريحه: “انتهى الهدوء الذي ساد الجولان لمدة أربعين عاماً”. أما بالنسبة إلى الثوار في سوريا، فقد قرعوا طبول الحرية والكرامة، بعدما انتهى السكوت عن “وطنية” مختصة بعقد المجاملات، وإبرام العقود والاتفاقات على حساب الوطن والشعب.
وطنية أطفال الحرية
تجمع الأطفال والفلاسفة صفة الدهشة؟ طبعاً. فأطفال درعا، هم أول مَن التمع في عقولهم بريق سؤال الوطنية المتمخّض عن نظرة جديدة للوطن، قبل أن يغدو السؤال نفسه هاجس الملايين وإشكاليتهم. أطفال الحرية، كانوا مناضلين، كالثائرين البالغين، مثلهم اضطهِدوا، بعضهم قُتِل، بعضهم اعتُقِل، بعضهم اغتُصِب، بعضهم أمسى يتيم الأب والأم، بعضهم تشرّد، وبعضهم حُرِم اللعب والعلم. إلا أن سؤال الوطنية ظلّ هاجساً، يعتور النفوس والعقول، يتنقّل بين طفلة ضاجة نعومةً وأنوثة في مخيمات اللجوء، ما انفكت إحدى القنوات الفضائية تعيد كلامها وكلام غيرها: “هون ما في شي حلو، هونيك عنّا أحلى”، وأخرى في أحد الأحياء المدمَّرة تقول: “بشار عبيبعتلنا طيارات لتقصف مدارسنا، بس نحنا جَكَر ببشار رح نتعلم بالشوارع، ورح نكبَر ونبني هالوطن”، ومراهق بعدما أصبح عاجزاً بدنياً يقول: “أنا صرت مقعد، بس مقعد بحريتي وكرامتي، الحرية والكرامة عندي ياها هلّق أغلى شي، وما رَح إندم على الشي إلي ساويتيو لأن سوريا بتستحق إدفع ثمن أغلى”. لقد سحب سؤال الوطنية أولئك الأطفال من حياتهم الخاوية المعنى، ليضعهم أمام أحاجي الأنا والآخر والوطن الكبرى، ربما كاستجابة إلى صوت في عمق أعماقهم يقول إن في الوطن لغزاً كبيراً.
“الطفل أقوى، أوسع، أضمن قاسم مشترك بين كل الأغلبيات”، هكذا يعرّف ميلان كونديرا بالطفل في روايته “الهوية”. أطفال سوريا أقوى، أوسع، أضمن قاسم مشترك بين كل أغلبيات السوريين إذا ما أرادوا الإبحار بحثاً عن وطنية مفقودة.
إن قتلة الأطفال الذين يعادون ضروب اللعب واللهو، ويوجّهون جلّ مخزوناتهم من الحقد في اتجاه نسف الطفولة، هم الفارّون من كل أشكال الإنسانية والوطنية والكفاح، أولئك ينبغي سحقهم، كيف؟ بملاحقتهم ومحاسبتهم حتى لو لم يتبقّ في العمر سوى لحظة، بالثورة عليهم حتى النصر! فـ”من تحت الركام سيولد طفل ينشد حلماً… يبني وطناً… ليزهر ربيع الثائرين”، هذا ما قاله مَن ظل حياً من أطفال بلدة حاس بريف محافظة إدلب، في لافتة تاريخها 22/3/2013 رفعوها عالياً بعد تسلقهم ركام بيوتٍ قصفها قاتل الأطفال.
التمثل الأسطوري للوطنية
ذات يوم، بثّ التلفزيون السوري خبر خروج الناس في حي الميدان بالعاصمة دمشق إلى الشوارع بهدف “الاستسقاء”! بدا العقل المؤطَّر بالسلطة حينها، عاجزاً عن إيجاد تفسير علمي، واقعي لظاهرة التظاهر التي عمّت سوريا، فعمد إلى تفسيرها على أنها صلوات استسقاء، واستجداء إله المطر (حاكم البلاد)، لكي يبعث الأمطار (الإصلاحات!).
يُسمّى الموالون لبشار الأسد، “منحبكجية”. اشتُقّ المصطلح من مفردة “مِنْحبَّك” التي طُبخت بمهارة في مطابخ الاستخبارات بعدما أُخرِج جيش الطاغية من لبنان عام 2005. اللافت، أن عقل “المنحبكجي” المستسلم لـ”الحب” المذكور، أثبت أنه غير قادر على فهم الوطن عبر فصله عن الرئيس “إله المطر”. كل ما يحبه رئيس الوطن هو الخصب والوطنية في ذاتها، وكل ما يمقته هو العقم والخيانة، وكل خارج على نص “الرئيس الوطن، والوطن الرئيس” عميل وخائن!
في إحدى أساطير شمال النروج، يُحكى أن إلهاً يُدعى تور كان يعبر السماء في عربة يجرّها تيْسان، وكان كلما طرق بمطرقته، أثار العاصفة والصاعقة، وأرسل المطر. وكان سكان الشمال “الفايكنز” يعتقدون أن العالم المأهول أشبه بجزيرة تهددها باستمرار أخطار خارجية، ويسمّون الجزء المأهول “ميدغارد”، أي أمبراطورية الوسط. تضم ميدغارد “اسغارد”، أي مقر الآلهة، على أطراف ميدغارد تأتي أمبراطورية “أوتغارد” التي تقع في الخارج، ويسكنها “الجبابرة” الخرافيون الذين يحاولون تدمير العالم. يُطلق على هذه الشياطين اسم “قوى الفوضى”، وهي التي يتولى الإله تور مهمة القضاء عليها.
بلغة سورية معاصِرة، مستمَدة من واقع الثورة الشعبية، يمكن القول إن “الشبيحة” الذين طالما اعتبروا الرئيس بمثابة “إله المطر”، جنّدهم “الرئيس الإله” نفسه ليكونوا “مطرقته”. المطرقة هنا حتماً ليست لاستدعاء المطر، بل تشكّل سلاحاً ممتازاً في الصراع ضد الثوار الذين يسمّونهم “عصابات مسلحة، إرهابيين”، أو “قوى الفوضى والجبابرة” بلغة الأسطورة.
يتضح أكثر التمثل الأسطوري لـ”سوريا الأسد” (ميدغارد التي تضم اسغارد) في نعت الثوار بـ”المندسّين والمتآمرين” أي “شياطين الخارج (أوتغارد)”، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير أمبراطورية الوسط (سوريا الأسد)، ولكي يتمكن “الرئيس الإله” من الانتصار على الثوار “قوى الفوضى أو الجبابرة”، يجب أن يُضحَّى بكبش يُقدَّم إليه، بحيث يصبح الإله أقوى. هكذا، عمد الشبّيحة إلى تقديم الأضحية تلو الأخرى من الأطفال والنساء والشباب والمسنّين إلى “الرئيس الإله”، حتى أن الأضحيات باتت ألوفاً مؤلفة! كان تقديم الأضحيات يتخذ أحياناً شكل المجزرة، وقد تعددت المجازر التي تعتمد طريقة الذبح بالسكاكين، ممهورة بطابع طائفي، مثل مجزرة قرية البيضا بريف بانياس التابعة لمحافظة طرطوس 2/5/2013، حيث اقتُحمت القرية المسالمة، وتمت تصفية المئات من أهلها. مجزرة مروعة، تأتي، بحسب محللين وناشطين، ضمن حملة “تطهير عرقي أو مذهبي” من شأنها إفراغ المنطقة من سكانها السنّة، حتى يتسنى للأسد وحلفائه تنفيذ مخطط هو بمثابة خيار أخير لهم، أي إقامة “دويلة علوية”. أما هتاف الشبّيحة بعد كل مجزرة فهو: “لبيكَ يا أسد/حرقنا البلد”.
إن التصور المركزي لمقر الآلهة في الأسطورة، هو التصور ذاته المهيمن على رؤية الشبّيحة لـ”سوريا الأسد”، كمركز يصارع “هامشاً- خرافة”، أي الشعب الثائر. تصوُّر الشبّيحة هو جزء من تصوّر أعمّ يطبع النظام العالمي “الحديث”، ويقسِّم العالم بين مركز وهامش، حقيقة وخرافة، آلهة وشياطين. هكذا، فإن مركزية النظام العالمي، لم تعترف بـ”الهامش، الخرافة، الشيطان” في سوريا، ولم تتعاطف معه، أي الشعب الثائر من أجل الحرية، الذي عاش ويلات المذابح والمجازر، لا بل كان في قمة المركزية تلك، مجلس أمن يطرق مراراً بمطرقة “فيتو” ذي وجهين، أحدهما معلَن (روسيا والصين)، والآخر مضمَر (الغرب والولايات المتحدة على رأسه)، يتعاضد مع مقر الآلهة (اسغارد) في سوريا، أي النظام ورئيسه.
التمثل الحميمي للوطنية
“في سوريا المستقبل: لن يكون هناك حكم أشخاص أو عائلات، سيكون حكم القانون فقط”. تلك كانت لافتة أهالي بلدة داعل بمحافظة درعا خلال إحدى التظاهرات. في اللافتة، إشارة إلى جوهر الثورة السورية وغايتها في آن واحد، أي القطع مع التمثل الأسطوري للوطن والرئيس، وبناء دولة الحق والقانون.
لقد ساهمت الثورة في تبديد الحتمية، وفتّت الثوابت، وأفرزت مفاهيم وطنية غزيرة تمهرها الحركة، وتطرح من الأسئلة أكثر مما تجيب. كل مفهوم ارتبط بثائر، بعدما أثبتت التجربة أن شراع الوطنية الذي يعالَج بجسد الثائر الحقيقي وروحه ودمه وكلمته، وحده الذي يؤمّن حسن اتجاه البلد، فالوطن يحتاج لإدارة ملاّح وطني.
أسئلة ليست عارضة، أثارتها الثورة، من مثل: من نحن؟ لماذا نعيش؟ فالسوري الثائر ما عاد ذاك الذي يعاني تلف “الوطنية” التي كانت تجعل كل الموضوعات الأخرى تافهة، وكانت تعتورها البلادة والكذب، وتبعث على السأم والاكتئاب من حيث هي تقريظ للحياة. فكأن السوري الثائر انتقل من الوطن ليس لي، لا أبالي، إلى “أشعر” بالوطن، وكل ما فيه يمثل بالنسبة إليَّ قيمة كبرى. إن أحداً لا يستطيع إخضاع المشاعر للتجربة أو منعها، فالشعور لا سلطة عليه، وهو بلا ترجمة واقعية خارج الشعور يمكن تلمسها والإحساس فيها كـ”شيء”. شعور السوري الثائر في وطنيته جعلها تنتقل من كونها خارجية، لتصبح داخلية، حميمة، وكما الإغواء الماكر تلتصق بالجسد والروح، بالعقل والعاطفة، وتساهم في تشكيل هوية خصبة خاصة بكل “شاعر” فيها.
* كاتبة سورية
النهار