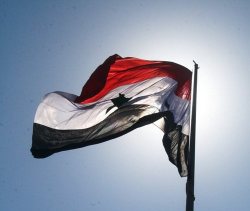الجريمة مباحة في ظل الاستبداد

دلال البزري
في شريط يوتيوب للفنانة السورية فدوى سليمان الذي تعلن فيه عن انضمامها الى اهالي مدينة حمص الثائرة المنكوبة، جملة تقولها بعفوية وهدوء، تلخّص فيها واحدة من ملامح سوريا الأسدَين، الأب والابن:”إما ان تموتوا وإما ان تحرّروا سوريا”. هي تعني على الأرجح بان سوريا في ظل الأسدَين ليست حرة لأن النظام يملك عمليا كامل الحق بأن يقتل مواطنيها. معنويا، ضميريا، انسانيا، سياسيا… ليس له حق، لكن في الواقع هو قادر على ممارسة هذا الحق. منذ متى؟ منذ نشأته: بدأ بتصفية الرفاق المنافسين، ثم داوم على اعتقال المخالفين له بالرأي وخطفهم وتعذيبهم وتصفيتهم واخفائهم وانتحارهم. وفي هذه الاثناء، تجاوب مع نفسه في مقْتلة حماه بذريعة تسلح خصومه الاخوانيين، أوقعت بين 20 و40 الف قتيل، وربما أكثر.
هذا الوجه للنظام السوري السابق على الثورة، لم يكن مكشوفا ولا مفضوحا الا ضمن دائرة ضيقة من العرب. بالنسبة للبنانيين كان وجها مألوفا: بالتجربة وبعد ذلك بالغريزة يلتقطون تعبيراته ويتعاملون معها تبعا لولاءاتهم. نطاق المعرفة بهذا الوجه والاعلان عنه كان ضيقا، فوق ان الغرب، العالِم بكل شيء تقريباً، كان غاضا الطرف عنه…. مصالح واسراتيجيات. كانت حالة موت عادية روتينية؛ شبه معلنة بثّأً للخوف من جهة، ومطبقاً عليها تماما من جهة اخرى، خطفا للقرائن والاثباتات على القتل.
ما الذي تغير الآن حتى صار القتل الأسدي على هذه السعة من الانكشاف؟ الاعلام والشبكة وكل وسائل التكنولوجيا التي عرف الثوار السوريين كيف يستخدمونها من اجل توثيق تلك الشهوة السياسية بالقتل… طبعا لها دور كبير.
ولكن أيضا، الذي له دور أكبر هو اتساع رقعة القتل مع اتساع عدد المعارضين صراحة للنظام. بعبارات اخرى، انكسار حاجز الخوف من القتل وبالتالي اتساع دائرة الموضوعين على لائحة القتل. الذي تغير بعد الثورة السورية ان قاعدة القتل المعتمدة لدى النظام انتُزعت منها ورقة التوت. ومع ذلك، لا تبخل مخيلته الفقيرة اصلا في اختراع جرائم ينسبها الى الثوار، او في التلاعب بالحقائق وخداع الباحثين عن الوقائع الصحيحة، وربما قتلهم.
من أين يستمد النظام حقه بالقتل؟ بأي حجة يدعمه حلفاؤه؟
من انه “يقاوم” أميركا واسرائيل.هذا الثنائي الخالد، الامبريالية والصهيونية، لا يختلف عن النظام السوري، من حيث انه يمنح نفسه، هو أيضا، الحق بالقتل. مع فارق ان الاولى، الامبريالية، غلّفت هذا الحق، على امتداد تاريخها، بتفسيرات حضارية، فيما الثانية، الصهيونية، كانت حيثيتها الهية.
اذن النظام السوري الذي يقاوم هاتين الكتلتين مقاومة افتراضية او حقيقية او حتى بالتوكيل، لم يستطع الارتقاء بمستوى قتاله لهما الى اكثر من تقليد أسهل أوجهه، أبشع أوجهه. وما ساعده على ذلك انه لم يكن بحاجة الى المسّ بالتقاليد السياسية العربية، العريقة بدورها في استباحة ارواح البشر، الاعداء والأهل والاصدقاء…
كل خطب الأسد منذ بداية الثورة، وكل المكْلمة التي يغوص في انشائياتها محللوه واصدقاؤه وشخصياته العامة، كلها تدور حول لازمة واحدة: ان الذي يقود هذه الثورة هم ارهابيون، وانهم ادوات لمؤامرة ضد سوريا يحيكها كل من الامبريالية والصهيونية. ولذلك، فنحن سنخوض، بكل شجاعة…. حربا ضارية، من دون رحمة، ضد هذه المؤامرة وارهابييها. حقه المطلق بالقتل قائم على انه يصدّ مؤامرة ضد البلاد نظّمها الخونة الذين باعوها للأجنبي. فيحلل لنفسه تشغيل ماكينة القتل على اعلى درجاتها، كما تفعل الامبريالية والصهيونية، التي “يقاتلها” عبر قتل شعبه.
انه ذلك التشابه بين آلة القتل الرسمية السورية والآلتين الامبريالية والصهيونية. انها آلة جيش الاحتلال واساليبه في ذروة غزوته: الدخول الى المدن بالدبابات، اطلاق النار والصواريخ على البشر والحجر، العقوبات الجماعية، الاعتقالات الجماعية، التعذيب حتى الموت، وبمختلف اشكاله، التمثيل بالجثث، الخطف والتجويع والترويع….
حتى خروج مسيرات التشييع تشبه تلك التي ألفها الفلسطينيون، خصوصا في غزة. كأن السوريين لاجئون في ديارهم، من يقتلهم غريب عنهم. ومن لا يستطيع ان يقتلهم، من لا يستطيع تنفيذ اوامر القتل، يخرج من صفوف القتلة وينضم الى الجهة المقابلة، حيث الموت أمر يومي، شبه حتمي… إما قاتلا أو مقتولا.
من المؤكد ان بشار الاسد ومن لفّ لفّه في قمة النظام مدرك لهذا التقارب في الاساليب بينه وبين خصومه المفترضين، من امبريالية وصهيوينة. او على الاقل سمع من يعلق على التشابه بين الاسلوبين. ومع ذلك تراه ماضيا في القتل، لا شيء يثنيه. هي قوة السلطة، عندما تصل الى درجة خارقة من التمكن، لا تعود تهبط الى الاسفل الا بعدما تستنفد قدرتها العملية على القتل. لكن ما يعطي لهذه العملية زخمها المحلي، شرعيتها المحلية، هي الفكرة النائمة، التي يصيغها النظام بأنصاف العبارات: فهو غاضب ليس لأن دائرة المرشحين للقتل توسّعت وانكشفت، هو الذي يحتاج الى جرعات غضب تبرر طاقته الخارقة على القتل. بل ايضا لأنه يؤمن في دهاليز نفسه ان هذا الشعب “شعبه وهو حرّ فيه…”. كما يفعل كل ذي هيمنة تامة على أهله: او على ما يدعي انهم اهله. “هذا شعبي وانا حرّ فيه…”، حرّ في قتله خصوصا، في هذه الآونة بوجه أخصّ، إرث الاستبداد المديد، المتلطّي خلف الاهلية والمحلية، والواقف بعناد ضد اية اغاثة من هذا الاجرام: هي تلك الجوهرة الفكرية التي تحرس ضمير النظام، عصبها الذهني القوي الذي يطمئن رجاله وأنصاره ومتكلّميه. طبعا لو كان يشعر فعلا بأن هذا الشعب “شعبه”، لما كان يقتله. فهو عندما يقول “هذا شعبي”، يقصد “هؤلاء عبيدي وانا حرّ بهم”. لا يجب اخذ هذا الادعاء الا بالمعنى الاخير. والا عدنا الى الاخوين قايين وهابيل …
عندما تقول فدوى سليمان “إما ان تموتوا وإما ان تحرّروا سوريا”، وترفقها بجملة اخرى: “ليس عندكم اصلا ما تخسرونه”، هي تعني بأن الموت المؤجل، الموت غير المعلن كان من حظوظ ابناء سوريا قبل ثورتهم. وان توسيعه وتكثيفه الآن بعد الثورة، حوّل القتل الى عملية جذرية، لا يرد عليها الا بموقف اكثر جذرية، يُستغنى بموجبه عن الحياة طلباً لتوقيف آلة القتل.
سوريا الجديدة، الديموقراطية، سوف تضع القتل على لائحة بنودها. لا ديموقراطية مع القتل، مهما سبب هذا القتل، مهما كانت هوية القاتل أو المقتول. اذ تكون سوريا قد عرفت الموت باسم أسمى الاشياء، أغلاها. لن يعوزها الجهد النظري الكثير، بعد جحيم الأسدَين، الأب والابن، لتربط ربطا وثيقا بين الديموقراطية وبين الحق المطلق بالحياة.
المستقبل