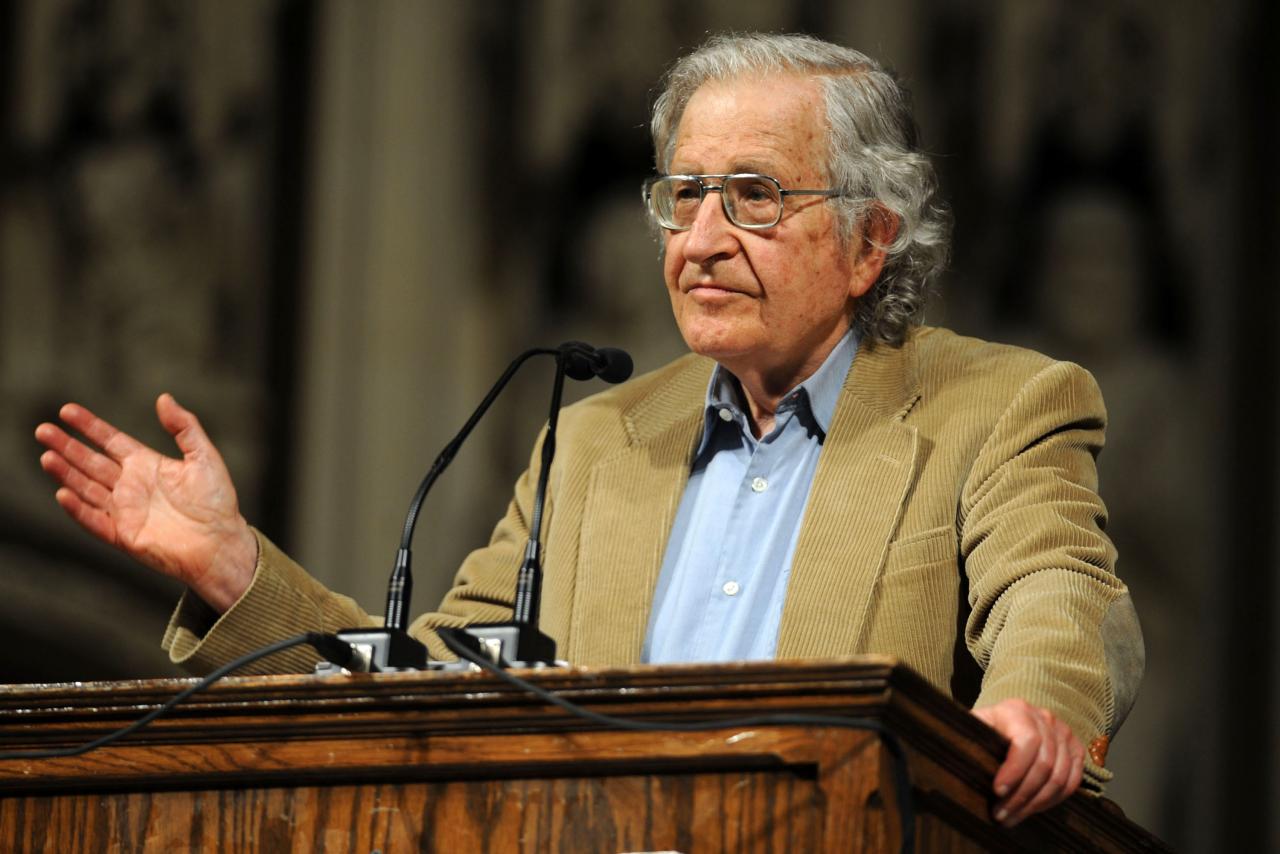الحوار المعلّق بين محمد عبده وفرح أنطون/ محمود الزيباوي

منذ أكثر من مئة وعشر سنين، دخل الشيخ محمد عبده في سجال طويل مع المفكر فرح أنطون، طاول أحوال الدين والدنيا والفكر والسياسة، متخطياً الكثير من القيود التي تفرضها هذه الشؤون. تعيد دار “بيسان” نشر هذه “المناظرة الدينية” في زمن لم يعد التطرق الى مثل هذا الموضوع من المحرّمات والمحظورات. نعود إلى هذه المناظرة اليوم، ونكتشف أن هذا الحوار الطويل لا يزال “معلّقا”. يرى الشيخ محمد عبده أن السلطة المدنية في الإسلام تبقى “مقرونة بالسلطة الدينية بحكم الشرع لأن الحاكم العام هو حاكم وخليفة معاً”. في المقابل يدعو فرح أنطون إلى الفصل بين الدين والدنيا، لأن الجمع بين السلطتين يؤدي إلى ضعف الأمة.
في حزيران 1902، نشر فرح أنطون في مجلته “الجامعة” بحثاً حول “تاريخ ابن رشد وفلسفته” تعرّض فيه لاضطهاد المفكرين والعلماء على يد السلطات الدينية. رأى الشيخ محمد رشيد رضا أن “رفيقه” فرح أنطون ينال في هذه الدراسة من الإسلام، فدفع الشيخ محمد عبده إلى الرد عليه. تطوّر هذا السجال وتشعّب، وتحوّل إلى سلسلة من ست مناظرات تداخلت فيها مراحل الأخذ والرد بين طرفي الحوار. بدأ هذا السجال فلسفياً، غير أنه تحوّل إلى مناظرة في قضايا الدين والدنيا. اتجه الشيخ محمد عبده إلى الدفاع عن الإسلام والمفاضلة بينه وبين المسيحية. وردّ فرح أنطون عليه بخطاب “علماني” دعا فيه إلى تجاوز هذه المفاضلة العبثية بتبني مبدأ الفصل بين السلطتين الدينية والمدنية.
في هذه المناظرة، يرسم الشيخ محمد عبده صورة وردية للإسلام ويبرّئه من كل الفتن التي عرفها في تاريخه الطويل، غير أنه يرصد في المقابل أشهر الفتن التي عرفتها المسيحية، ويرى أنها جزء لا يتجزأ من تاريخها. يقول في هذا الصدد: “لم يُسمع في تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين والأشاعرة والمعتزلة مع شدة التباين بين عقائدهم. نعم سُمع بحروب تُعرف بحروب الخوارج كما وقع من القرامطة وغيرهم، وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد وإنما أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الأمة، وقد وقعت حروب في الأزمنة الأخيرة تشبه أن تكون لأجل العقيدة وهي ما وقع بين دولة إيران والحكومة العثمانية والوهابيين. ولكن يتسنى لباحث بأدنى نظر أن يعرف أنها كانت حروباً سياسية، أما الحروب الداخلية التي حدثت بعد استقرار الخلافة في بني العباس وأضعفت الأمة وفرَّقت الكلمة فهي حروب منشأها طمع الحكّام وفساد أهوائهم”.
في الجهة المعاكسة، ينتقل الشيخ محمد عبده إلى رصد أشهر الإجراءات الكنسية التي قيّدت الفكر وأشعلت الفتن بين المسيحيين وما تبعها من “الوقائع التي اسودَّ لها لباس الإنسانية”، فينطلق من الحرب “بين الأرثوذكس والكاثوليك على عهد القياصرة الرومانيين”، ثم ينتقل إلى “حادثة برتلمي التي سفك فيها الكاثوليك دماءَ إخوانهم البروتستانت”. بعدها، يستعيد الشيخ تاريخ محاكم التفتيش التي أنشئت “بطلب الراهب توركمادا، وقامت بأعمالها حق القيام في مدة ثماني عشرة سنة”، فـ”حكمت على عشرة آلاف ومئتين وعشرين شخصاً بأن يُحرقوا وهم أحياء فأحرقوا، وعلى ستة آلاف وثمانمئة وستين بالشنق بعد التشهير فشُهّروا وشُنقوا”. في فترة لاحقة، “قرر مجمع لاتران أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد”، ودعا “أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار الناس الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة، أي الاعتراف بالذنوب طلباً لغفرانها”. و”حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة 1481 إلى سنة 1808 على ثلاثمئة وأربعين ألف نسمة، منهم نحو مئتي ألف أحرقوا بالنار أحياء”. في الختام، يساوي الشيخ محمد عبده بين الكاثوليك والبروتستانت، ويرى “أن الإصلاح البروتستانتي لم يكن أكثر تساهلاً من الكنيسة الرومانية، فإن كَلْفين أمر بإحراق سيزفيت في جنيف، وأحرق فايتي في تولوز سنة 1629. وكان لوثير أشد الناس إنكاراً على من ينظر في فلسفة أرسطو، وكان يلقّب هذا الفيلسوف بالخنزير الدنس الكذّاب”.
في ردّه على هذه المقولة، يتساءل فرح أنطون عن السبب الذي دفع بمحمد عبده إلى رصد هذه الوقائع، ويضيف: “هل غرضه أن يثبت أن الاكليروس المسيحي قد أخطأ في ما مضى من الزمن في فهم الكتب المسيحية وتأويلها ولذلك صبغ تاريخه بالدم وحشاه بالصغائر؟ إذا كان هذا هو غرض الأستاذ فنحن معه لأن هذا الأمر حقيقة لا شك فيها”. يعود فرح أنطون إلى كلام الشيخ عبده حول تقاتل المسلمين، و”قوله عن نفي القتال من أجل الاعتقاد”، وتأكيده أن الحروب والفتن لم يكن سببها إلا “الآراء السياسية في طريقة حكم الأمة”، ثم يعلّق ويقول: “نحن نستحسن قول الأستاذ هذا كل الاستحسان. وهو رأينا أيضاً. ولكنا لا نرى هذا الرأي في أمة دون أمة، بل نطلقه على جميع الأمم. وعلى ذلك فجميع ما حدث في العالم المسيحي باسم الدين من القتل والتمثيل كديوان التفتيش ومذبحة سان برتلماي وغيرها، يكون مصدره السياسة أيضاً والاختلاف على طريقة حكم الأمة. والإنصاف يقتضي أن يُحكم على جميع الناس حكم واحد”.
مبدأ التساهل
يساوي فرح أنطون بين الأديان، ويدعو إلى “التساهل”، وهو المبدأ الذي يُعرف اليوم بـ”التسامح”، ويؤكد أن “الفصل بين السلطتين” آلة هذا المبدأ ووسيلته. يقول في التعريف بهذا المبدأ: “لا نقدر أن نعرّف التساهل تعريفاً لغوياً لأن هذه الكلمة دخيلة في اللغة العصرية الجديدة. وإنما نعرف معناه باصطلاح الفلاسفة. فمعنى التساهل عندهم وهو المعنى الذي استعملناه له أن الإنسان لا يجب أن يدين أخاه الإنسان، لأن الدين علاقة خصوصية بين الخالق والمخلوق. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يُشرق شمسه في هذه الأرض على الصالحين وعلى الأشرار معاً فيجب على الإنسان أن يتشبه به ولا يضيّق على غيره لكون اعتقاده مخالفاً لمعتقده. فليس إذاً على الإنسان أن يهتم بدين أخيه الإنسان أياً كان لأن هذا لا يعنيه. والإنسان من حيث هو إنسان فقط أي بقطع النظر عن دينه ومذهبه، صاحب حق في كل خيرات الأمة ومصالحها ووظائفها الكبرى والصغرى حتى رئاسة الأمة نفسها. وهذا الحق لا يكون له من يوم يدين بهذا الدين أو بذاك بل من يوم يولد. فالإنسانية هي الإخاء العام الذي يجب أن يشمل جميع البشر ويقصر دونه كل إخاءٍ. وبناءً على ذلك إذا كان زيد مسلماً وخالد مسيحياً ويوسف اسرائيلياً وكونوا بوذياً وسينو وثنياً وديدرو كافراً معطلاً يجحد كل الأديان لا يعتقد بشيءٍ قطعياً، فهذه مسألة بينهم وبين خالقهم عزَّ وجل لا تعني البشر، ولا يجوز لهؤلاء أن يتداخلوا فيها”.
يقود هذا الحديث إلى الكلام عن حرية الإنسان وحقه “في أن يعتقد ما يشاء”، أو “أن لا يعتقد بشيءٍ” إذا أراد. يستطرد فرح أنطون مضيفاً: “وهنا نصل إلى جحود الأديان. فهل تطيق الأديان أن تصبر على أحد يجحدها. نحن نعلم أن كل الأديان لا تطيق ذلك على وجه الاطلاق. وإذا أطاقته اليوم فما ذلك إلا لأنها أصبحت تقدم الشرع المدني على الشرع الديني. فالمسلمون يسمّون جاحدي الأديان “زنادقة” وهم يوجبون قتلهم. والمسيحيون يسمّون هؤلاء الجاحدين “كفرة” وهم يوجبون استئصالهم من بين الناس كما يُستأصل الزوان من الحنطة. ولذلك قتل الأكليروس المسيحي منكري الأديان في زمن ديوان التفتيش في إسبانيا وقتل المنصور الزنادقة”. يعود فرح أنطون إلى كلام “الأستاذ” محمد عبده، ويردّ عليه من جديد، فيقول: “ولكن من التناقض الغريب أن الأستاذ حلل هذا القتل والتمثيل في الإسلام، وحرّمه في المسيحية على يد ديوان التفتيش. فهل الفضيلة أو الرذيلة تتغير وتتبدل بتغيّر الزمان والمكان أم تكون فضيلة أو رذيلة في كل زمان ومكان؟ أما العلم فإنه يحرّم الأمرين معاً. فهو يقول لقاتلي الزنادقة في الإسلام وقاتليهم في المسيحية إنكم كلكم مخطئون في قتل من تسمّونهم زنادقة وإن كان هؤلاء قد أخطأوا خطأ ما بعده خطأ. ذلك أن الحياة التي منحها الله للبشر لا يجوز لإنسان أن يسلبهم إياها بأية حجة كانت وبأيّ سبب كان. وهنا يحدث أيضاً الانفصال بين العلم والدين لأن العلم يدافع عن حق الإنسان المجرد كل دفاع، والدين لا يطيق التساهل إلى ذلك الحد خوفاً على نفسه”.
يتواصل السجال متخطياً كل الحساسيات. يجعل محمد عبده من الإسلام دين العقل والعلم، ويجعل من المسيحية ديناً يقوم على الخوارق والمعجزات والعجائب والإيمان بغير المعقول. من جهته، يسأل فرح أنطون: “ما هو الدين؟ هو الإيمان بخالق غير منظور وآخرة غير منظورة ووحي ونبوءة ومعجزات وبعث وحشر وثواب وعقاب، وكلها غير محسوسة وغير معقولة ولا دليل عليها غير ما جاء في الكتب المقدسة. فمن يريد فهم هذه الأمور بعقله ليقول إن دينه عقلي ينتهي إلى رفع ذلك كله لا محالة”. في هذا السياق، يرى فرح أنطون أن الشيخ محمد عبده، “سامحه الله، يدافع ويناضل عن مذهب واحد بالحطّ من شأن مذهب آخر”، وعليه أن يخلع رداء الأحزاب كلها وليلبس رداء البشر، “فهو حينئذٍ يكتب كإنسان لا كمسلم أو كمسيحي، وكل ما يُكتب باسم الإنسانية فقط، لا باسم حزب واحدٍ من أحزابها، فإنه لا يكون فيه إلا النفع المحض لكل أجزاء الإنسانية”. ثم يختم ردّه بالقول: “كلامنا إذاً في هذا الموضوع كلامُ مَن يحكم على الإسلام والمسيحية حكماً مجرداً عن كل شهوةٍ وغرضٍ غير غرض الفضيلة المقدسة. وقد قلنا الفضيلة ولم نقل الحقيقة، لأن الحقيقة هي الله وحده، والأديان كلها مستمدة منه سبحانه وتعالى”.
يمضي فرح أنطون في هذا السجال، ويتوقف أمام بعض المقولات الشائعة التي تبناها الشيخ محمد عبده في ردّه عليه. يستعيد مفتي مصر الرأي القائل بأن “الإسلام استعجم وانقلب عجمياً” بسبب دخول الفرس والترك إليه. يرفض فرح أنطون هذه المقولة، ويذكّر بأن “جراثيم الفتن والانحلال كانت في تاريخ المسلمين قبل اتصالهم بالترك والفرس”، ويضيف: “ونحن نعتقد بلا مداجاة ولا مصانعة، أنه ما انقذ الإسلام وحفظه إلى اليوم إلا الترك والفرس، وحسب الفرس فضلاً على التمدن أنهم كانوا من أعظم العناصر الإنسانية اشتغالاً بالعلم والفلسفة وابتداعاً فيهما وأقومهم في السياسة وحسن التدبير، حتى أن عدد مَن نبغ فيهم باللغة العربية من فطاحل العلماء يساوي عدد علماء العرب”. من جهة أخرى، يتوقف محمد عبده أمام الدور الذي لعبه بعض الخلفاء العباسيين في نشر العلم، ويسرد أسماءهم وأسماء “العلماء النصارى واليهود والصابئة الذين حظوا عندهم”. يتوقّف فرح أنطون أمام هذا الكلام، ويعلّق عليه بقوله: “نحن نستحسن كل ما ذكره الأستاذ في هذا الموضوع ولا نخالفه فيه. وإنما نجاري في هذا الموضوع ثقاة المؤرخين، فنقسم الخلفاء في تاريخ العرب إلى قسمين، فقسمٌ هذا الذي أشار إليه الأستاذ، وكان هذا القسم يعتمد على النساطرة والسريان والفرس واليهود والهنود لنشر العلم والفلسفة في الأمة. وقسم آخر كان لا يميل إلى هذه العناصر الغريبة ولا إلى فلسفتهم وعلومهم التي هي غريبة أيضاً لأنها من أصل يوناني. ولو كانت قد اخترعت كلمة الدخلاء يومئذٍ لأطلقها هذا القسم عليهم. وعلى ذلك فحسنات القسم الأول لا تمحوها سيئات القسم الثاني، ولا سيئات القسم الثاني تمحوها حسنات القسم الأول”.
الحاكم والأمة
في الخلاصة، يخال القارئ عند قراءته هذه المناظرة الطويلة، أن الشيخ محمد عبده يسعى إلى تدوير الزوايا للتوفيق بين الدين والدنيا، فـ”الملك الحاكم لا يمكنه أن يتجرّد من دينه مع وجود الفصل بين السلطتين”. على العكس، يقول فرح أنطون إن الملك “خلق ليكون خادماً للأمة”، و”هو مقيد بالمجالس النيابية التي تسن القوانين والشرائع وتضع الدساتير التي يجب أن يعتقد بها الملك”. بقي هذا السجال معلّقاً، ولم يحفل أي من الطرفين في إعلان الغلبة.
في مقالة بالفرنسية تعود إلى عام 1934، تكلم طه حسين عن الإمام محمد عبده بإجلال كبير، غير أن هذا التقدير لم يمنعه من الإشارة إلى “ضعف” المنهجية التي اعتمدها المصلح الكبير في مطلع القرن الماضي، فقال: “لا شك أن الشيخ محمد عبده قد هزّ العالم الإسلامي بأسره وأيقظ العقل الشرقي وعلّم الشرقيين أن يحبّوا حرية الفكر. ولا ريب أيضاً أنه أتاح لكثير من المسلمين أن يتطلعوا بأمل راسخ إلى يوم يتحقق فيه التوفيق بين العلم والدين، بين التقاليد الشرقية والحضارة الغربية. ولكن العالم الإسلامي أصابه التغير منذ ذلك العهد. لقد تغير كثيراً في فترة لا تتجاوز ربع قرن إلا بقليل. ففي الثلاثين سنة الأخيرة تزايدت الصلات بين مصر وأوروبا، ووقعت الثورة التركية التي أطاحت بالاستبداد والملوك، ونشبت الحروب التي قضت تماماً على هيمنة تركيا وألغت الخلافة ومنحت شعوب الشرق نظماً ديموقراطية لم يكن لهم بها عهد على الإطلاق. ولم يعد محمد عبده مواكباً للعصر وإذا بلباقته في إحداث التجديد تبدو مستخذية تعوزها الجسارة. ولم يعد يكفي التفكير والكلام، فهناك محاولة للعمل. وصارت كل أفكار محمد عبده بشأن العلم والدين بالية. فهي ليست بالأفكار التي مضى عليها زمن طويل، ولكنها لم تعد تتواءم مع انطلاق الشرقيين نحو الحرية الكبرى”. على مثال فرح أنطون، يختم طه حسين هذه المقالة بسؤال يختصر مشروعه الأكبر: “أفلا يجب بالأحرى أن نتقبل العلم والوحي كما هما وأن نعترف لكل منهما بمجاله الخاص في حياة الإنسان؟ ذلك على الأقل ما تراه الأجيال الجديدة من المثقفين الذين لم يستمعوا إلى الشيخ محمد عبده وإن كانوا قد استمعوا إلى أساتذة الغرب”.
كان ذلك في منتصف الثلاثينات. تبدّلت الأحوال بعدها، وها اليوم نحنّ إلى زمن محمد عبده وإلى الفتاوى الجريئة التي أطلقها في محاولة لإقصاء شيوخ الأزهر التقليديين. ننسى مواقفه التقليدية الثابتة و”طريقته التبسيطية” في التوفيق بين الدين والعلم، ونكتفي بترداد قوله قبل رحيله:
ولستُ أبالي أن يُقالَ محمدٌ/ أُبِلّ أو اكتظّت عليه المآتمُ
ولكنه دينٌ أردتُ صلاحه/ أحاذر أن تقضي عليه العمائم
النهار