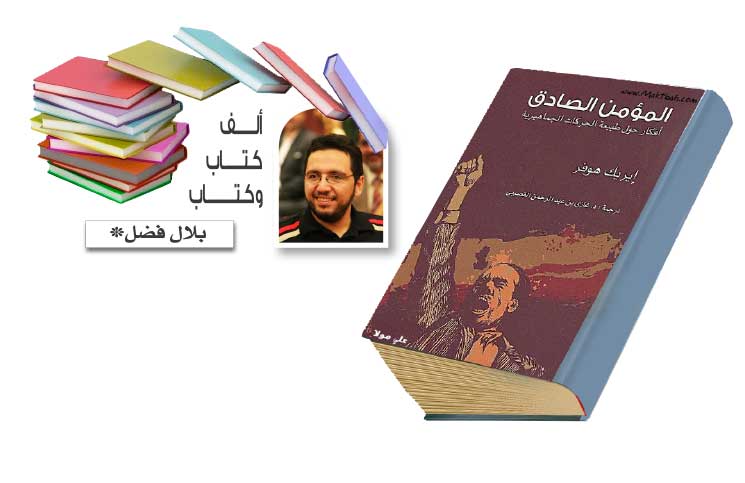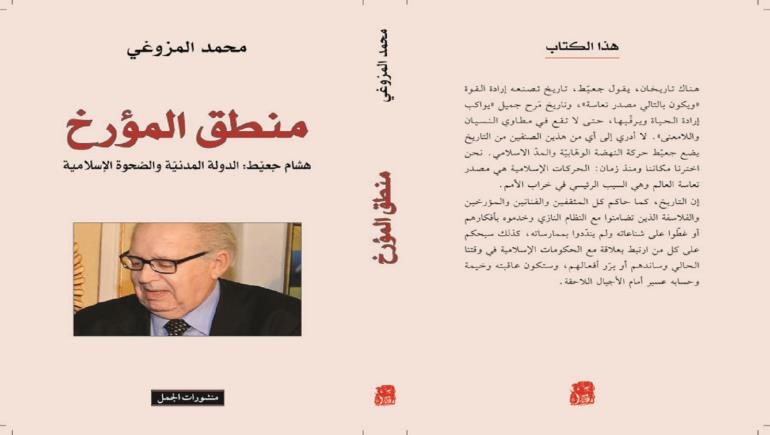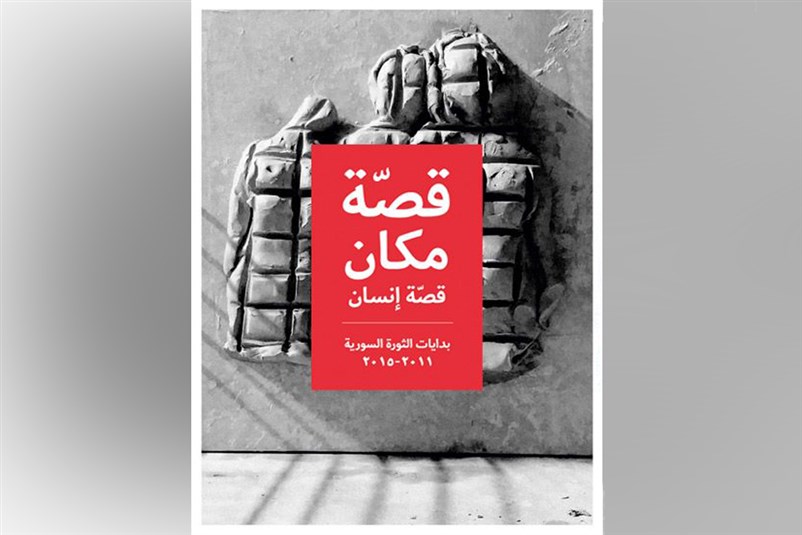الدين في سياق الديموقراطية الليبرالية

[ الكتاب: قوة الدين في المجال العام
[ الكاتب: يورغن هابرماس (بتلر ومجموعة من الباحثين)
[ المترجم: فلاح رحيم
[ الناشر: دار التنوير، بيروت، بغداد مركز دراسات فلسفة الدين 2013
هي مساهمات أربعة مفكرين كبار تحاوروا في ندوة عقدت العام 2009 في نيويورك حول «قوة الدين في المجال العام»، ويسوغ ناشرو الترجمة التي أنجزها الباحث العراقي، فلاح رحيم، المقيم في كندا، راهنية الكتاب في كونه يفتح باباً جديداً «الى فهم مُنتج للعلاقة بين العلمانية والدين»، اذ تسود في المجال العربي أفكار تُضاد بينهما، منقولة من الفكر الغربي الذي ساد منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين المنصرم، وأيضاً تبني «الفهم الأنتروبولوجي» للدين: نظريات روبرت تايلور في «الثقافة البدائية»، وجيمس فرايزر في «الغصن الذهبي»، والفهم العلمي (ماركس وأتباعه)، والنفساني (فرويد ومناصريه)، والاجتماعي (إميل دوركهايم). وبدلاً من ضمور الدين الذي تنبأت به أو توقعته هذه الرؤى المختلفة، فإنه عاد بقوة ليكون فاعلاً وحاضراً في المشهد السياسي والاجتماعي، ما حدا بالمفكرين الى إعادة النظر في قدرة «الخطاب الديني» على الجذب وممارسة التأثير، ومن ثم إعادة التفكير في دور الدين في المجال العام، واستحداث دراسات تهتم بما يسمى «ما بعد العلمانية»، بإشراك الدين في إنتاج المعنى والقيّم.
تُشدد المقدمة التي وضعها محررا الكتاب إدواردو منديتا وجوناثان فانانتويربن (الصادر عام 2011) على سوء فهم الدين وإطلاق أحكام عليه بعيدة من الواقع تماماً، فهو «ليس مجرد شأن خاص، ولا هو موسوم باللاعقلانية البحتة»، ولا يسود في المجال العام التفكير العقلاني فحسب وفي كونه ميدان «التوافق الطوعي» حصراً.
يُقارن فيلسوف مدرسة فرانكفورت، هابرماس، في ورقته «السياسي: المعنى العقلاني لميراث اللاهوت السياسي المريب» بين السياسة في ظل دولة الرفاهية، من حيث القدرة على إنتاج الروابط وبينها في ظروف الرأسمالية المعولمة، حيث القدرة الضعيفة عليها، والخطر أن تتحول الديموقراطية الى مجرد واجهة، ما يفرض في رأي الفيلسوف الألماني ضرورة العودة الى «السياسي» (Le Politique) المتمايز عن «السياسة» (La Politique) (علاقات قوة) ومنحه معنى عقلانياً، وهو في تفحصه للمفهوم يراه من وجهة النظر التجريبية «ذلك الحقل الرمزي الذي شكلت فيه الحضارات الأولى صورة نفسها»، ولهذا الغرض يعود الى الماضي ليرى «السياسي» في أصول المجتمعات التي تنظمها الدولة، ولا سيّما المجتمعات القديمة التي نجحت في الربط بين القانون والقوة السياسية، من جهة، وبين المعتقدات والممارسات الدينية، من جهة أخرى، ونجحت في إقامة القانون على أصل مقدس يملك استقلاليته الخاصة وتجذره في أفكار عن «الخلاص»، وتبع ذلك عقد صلة بين سلالات الحكام والإلهي. ويعني «السياسي»: «التمثيل الرمزي والفهم الذاتي الجمعي… من خلال التفات الى شكل واع وليس تلقائياً من أشكال الاندماج الاجتماعي»، وفي «العصر المحوري» (بمصطلح كارل ياسبرز) الممتد من 800 الى 200 قبل الميلاد ومع سيّادة التفكير الناموسي، أمكن النظر الى أفعال الحكام كبشر. وفي الحقبة الحديثة فقد «السياسي» حضوره، وما كان لسلطته الموحِدة والدمجية أن تستمر إلا في السلطة المطلقة للملوك المسيحيين في الدول الاستبدادية في بواكير الحداثة، كما يقول كارل شميث، الذي يناقشه هابرماس في نظريته عن «حقبة الدولة» التي اقتربت من نهايتها، حيث يتهم الأول الليبرالية بأنها دمرت «السياسي» من خلال تحييده (تحرر المجتمع المنقسم وظيفياً، وانفصال الدين عن الدولة)، ويميل الى ديموقراطية الجماهير التسلطية التي يقودها قائد كاريزمي. والحال، يرى جون رولز إن علمنة الدولة نفسها لا تعني علمنة المجتمع، وبالتالي لم تُحل مسألة الأثر السياسي للدين في المجتمع المدني، ما دفعه الى اقتراح دور محدود للدين في المجال العام. ويُقِر هابرماس إن الدولة في الديموقراطية الليبرالية قد فقدت هالتها الدينية، وينحو الى الاعتراف بدور للمجموعات الدينية في العملية الديموقراطية، ففيها ينخرط الطرفان الديني والعلماني في تفاعل، وتُضفي مساهمة المتدينين شرعية على «السياسي» داخل المجتمع العلماني. ويعتبر صاحب «الفعل التواصلي» إن العملية الديموقراطية «عملية تعلم في الوقت نفسه»، وكل مؤسسة ديموقراطية هي «مشروع وستبقى هكذا».
يُبرِر تشارلس تيلر، البروفسور الكندي في العلوم السياسية والفلسفة في جامعة ميكجيل، سؤال «لماذا نحتاج الى تعريف جذري للعلمانية؟»، وفي ظنه أنه رغم تعدد النماذج العلمانية، فهي تتفق في فصل الكنيسة عن الدولة، بمعنى حيادية هذه الأخيرة، ما يخدم شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة ولا سيّما الحرية، حيث حرية المعتقد وعدمه والمساواة (من دون تمييز) والأخوة التي تتيح للرؤى المختلفة أن تتصارع. ويرى تيلر إن العقل وحده لا يستطيع أن يؤمن أساس هذه المطالب وتحقيقها، ما يتطلب إدخال المجموعات الدينية في مجال الحوار بوصفها شريكة فيه، وهي قد عدلت في كثير من مواقفها وفاقاً للسيّاق الديموقراطي الليبرالي، الأمر الذي حدث مع الكاثوليكية العالمية ولا يُستبعد أن يخضع الإسلام نفسه لهذا الاختبار. ويُعيد الباحث رسم صورة العلمانية على أنها معنيّة «بالاستجابة الصحيحة التي تصدر من الدولة الديموقراطية تجاه التنوع»، والدين، في هذه الحال، جزء من المشهد، وتكون الدولة «حيادية» بإزاء كل الآراء.
يستعيد تيلر نشوء العلمانية الأميركية وبدايتها غير المعنيّة باستبعاد الدين، والفرنسية التي قامت في غمرة النضال ضد الدين. ففي واشنطن يستحضر الناس العلمانية مثابة «حائط الفصل»، والجمهوريون المتشددون في فرنسا بوصفها «الكلمة الأخيرة». وانطلاقاً من منع الحجاب في بلاد الغال، يرى تيلر الى التنوع في الممارسات، وهو يعزوه الى عاملين: الحفاظ على حيّادية المؤسسات العامة والمساواة بين العقائد الأساسية. ومن هذه الإجابات المتضاربة يُدرك الفيلسوف الكندي ضرورة وجود «شعب» يملك هوية «سياسية» جمعية قوية في الدولة الديموقراطية الحديثة. فعنده لا يمكن الدولة أن توسم بأي صفة، وعلى القوانين أن تعكس اقتناعات المواطنين المختلفة، فالدولة العلمانية لا تقيم «متاريس ضد الدين» ولكنها تسعى لضمان أهداف الحرية والمساواة والأخوة.
تتساءل جوديث بتلر، استاذة البلاغة والأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا (بركلي) «هل اليهودية هي نفسها الصهيونية؟»، فتبدأ من موقع «الدين» الخاص في الحياة العامة أو «المجال العام»، ويتحدد إطار النقاش آن تحديد نمط الديانة المعنية، اذ يمكن العلمانية أن تكون شكلاً آخر من أشكال استمرار الحياة الدينية. ومن ثم تنتقل كاتبة «مشكلة الجنوسة» لتفسر كيف أن النقد العام لعنف دولة إسرائيل يجب أن يكون «مطلباً أخلاقياً إلزامياً من داخل الأطر اليهودية، الدينية منها وغير الدينية»، وتستند الى أعمال حنة أرندت لترسم حداً بين اليهودية والدين اليهودي، اللذين لا يقودان بالضرورة الى اعتناق الصهيونية. وترى أن على اليهود نقد دولة إسرائيل والاحتلال في ادعائها التصرف باسم الشعب اليهودي، ففي الدين تصور للعلاقة مع الآخر يقوم على «التعايش»، وعلى هذا الأساس «يمكن ويجب أن يتم نقد عنف الدولة القومية غير الشرعي»، وتشير الباحثة بالضبط الى نقد مشروع الكولونيالية الاستيطانية المستمر والعنيف الذي يُشكل الصهيونية السياسية.
نظر كورنيل ويست، الأستاذ في جامعة برنستون، في «دين النبوءة ومستقبل الحضارة الرأسمالية»، معرفاً نفسه «رجل بلوز في حياة الفكر، ورجل جاز في عالم الأفكار»، ويقصد مصاحبة الشعر (التقمص والتخييل) للفلسفة، وأبعد من ذلك ضرورة سماع العلمانيين للنغمة الدينية، والعكس صحيح أيضاً. فالدين عنده يُقدم لنا «العون» في هذه الحياة المحدودة التي يترصدنا فيها الموت والرهبة وخيبة الأمل. ولهذه الغاية استمع المفكر الأميركي واستجاب «انعطافة النبوءة» المُبشِرة بالحب والعدالة نقيضاً من الأشكال المهيمنة للدين، المتوافقة مع الجشع والخوف والتعصب، وتسمح صحوة الدين النبوي للمعاناة أن ترفض وتتكلم. وفي عصر الرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، يصبح السؤال على لسان ويست:»هل يستطيع الدين النبوي، بكل أشكاله المتنوعة، أن يعبئ الناس، ويوّلد مستويات من النقمة الخيّرة ضد الظلم؟»، ويتيح التفكير النقدي والتنظيم والتعبئة.
كلمة الختام بعد نقاشات المتحاورين الأربعة، أتت من كريغ كالهون، مدير مجلس بحوث العلوم الاجتماعية في جامعة نيويورك عن «قوة الدين المتعددة» وارتباطه في الولايات المتحدة بالنشاط السياسي. والكتاب، أخيراً، يستحق القراءة المتأنية في زمن الحراك العربي ونزاع الدين والعلمانية.
مراجعة: د. عفيف عثمان