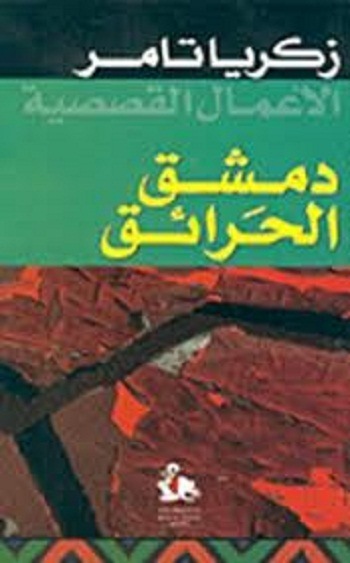الدين وموانع الديمقرطية
د. السيد ولد أباه
في كتابه الجديد المعنون بـ”الإسلام إمام الديمقراطية”، يذهب عالم الاجتماع الفرنسي “فيليب ديريبارن” إلى أن العائق أمام استنبات الديمقراطية التعددية في المجتمعات المسلمة عائق ديني يتعلق بالرؤية العقدية للإسلام، التي تقوم على فكرة اليقين المنزل الذي لا شك فيه ولا جدل، مما يعني علمياً أن الاستسلام هو الموقف الوحيد المنسجم مع هذه الرؤية، سواء تعلق الأمر بالأمور الدينية، أو بالقضايا الاجتماعية والمدنية.
يستعيد المؤلف أطروحة “ماكس فيبر” التي طورها “مارسل غوشيه” حول خصوصيات الديانة المسيحية من حيث هي “ديانة الخروج من الدين”، باعتبار أنها ديانة تقوم على عقيدة التجسد التي تؤسس لتعويض “الإلهي” بالإنساني، كما أنها تكرس ثنائية الدين والدولة وتنظر لمسار الحقيقة في منظور احتمالي قلق.
ومن ثم، فإن العلمانية هي النتيجة المنطقية لمقولة “نزع القداسة عن العالم”، التي بلورتها المسيحية والديمقراطية إفراز طبيعي لهذا النزوع الإنساني، وذلك التصور الاحتمالي للحقيقة، تجذرت هذه الأطروحة حول “الاستثناء المسيحي” في الدراسات الاجتماعية، وكادت أن تصبح من البديهيات على الرغم من نقاط ضعفها الكثيرة في المستويين النظري والتاريخي.
ومن أبرز مظاهر قصورها الفصل بين الرؤية العقدية المسيحية والتقليد التوحيدي إجمالاً الذي يتقاسم معها المنظور الجوهري الذي هو بالفعل فكرة التعالي الإلهي ونزع الطابع السحري عن العالم (أو التبصير مقابل التسحير بلغة طه عبدالرحمن). ولا شك أن هذا التصور أقوى في الإسلام الذي مد مفهوم التعالي إلى حده الأقصى في مقابل فكرة الاصطفاء في بعديها اليهودي (الشعب المختار) وبعدها المسيحي (التثليث). ولقد اعتبر الفيلسوف الألماني “هيجل” أن هذا التصور يلغي أي إمكانية للتواصل مع الإلهي في تجريدته المطلقة، رغم أن هذه الملاحظة غير دقيقة أنها تقف عند لاهوت الغيب دون الانتباه إلى لاهوت الشهادة والتجلي الخصب في التقليد الكلامي والصوفي.
أما فكرة “التجسد” ففضلاً عن كونها ليست عقيدة إجماعية في التقليد المسيحي، بل تبين الدراسات التاريخية (مثلما بين فردريك لنوار في كتابه كيف أصبح المسيح إلهاً) أنها تحول لاحق في الديانة المسيحية، فإنها لا يمكن أن تقرأ بمنظور النزوع الإنساني بدلالته الحديثة، كما تبين النقاشات اللاهوتية الوسيطة حول الصلة بين الإلهي والبشري في شخص المسيح (رصدها آلان دي لبيرا في عمله الموسوعي الضخم حول حفريات الذات).
ومع التأكيد على حدود الأطروحة الثقافية القوية، التي تلغي الدور التأويلي للسياق المجتمعي في ضبط الأفكار وإعادة فهمها، فإن تأثير التقليد المسيحي في تشكل الحداثة الغربية في أبعادها السياسية والمجتمعية قابل للقراءة في اتجاهات شتى متباينة.
وبالرجوع للأعمال الفكرية المؤسسة للحداثة السياسية الغربية (أبرزها أعمال جان بودين وسبينوزا وهوبز وروسو ولوك)، نجد اتجاهين متباينين حاضرين بقوة هما الوعي بالقطيعة الجذرية بين فكرة الدولة المدنية التعاقدية والثيوقراطية المسيحية ومحاولة ترجمة المقولات الجديدة في الشرعية السياسية في القاموس اللاهوتي (الدولة بصفتها مطلقاً أو إلهاً فانياً والديانة المدنية…).
هذا الطابع الإشكالي المزدوج، الذي يبدو حتى في مقولة “الحداثة” ذاتها (في مفهومها الذي يقربها من مفهوم المعجزة الديني)، يدفعنا إلى تجاوز النظرة التحديدية المبسطة لتأثير المرجعية الدينية في الوقائع المجتمعية، الحديثة، باعتبار أن الدين ليس نسقاً دلالياً مغلقاً وأحادياً، بل هو “رأسمال رمزي” بلغة “بورديو” قابل لأنماط شتى من التوظيف والاستثمار.
لقد بينت أبحاث “جورجيو أغامبن” الرائدة حول مسارات المسألة الدينية-السياسية في الغرب الحديث أن التأثير الحقيقي للتقليد المسيحي في السياق المجتمعي الأوروبي يبرز في مفهوم السياسة كتسيير وتدبير مع اضفاء هالة التمجيد والاحتفاء علی هذا النموذج التسييري. يرى أجامبن بهذا الخصوص أن عقيدة “التثليث” هي تحرير لاهوتي اقتضاه الجمع بين فكرة التدبير الإلهي كسيادة مطلقة وفكرة “القدر” اليونانية، مما ينتج عنه تصور السياسة كتدبير مادي وتسيير اقتصادي منزلي يحتاج إلى غطاء رمزي وتصور الدولة على شكل الإله المطلق الذي لا يمارس سلطته إلا بالتفويض دون أن يفقد سمته المفارقة المطلقة.
إنما نريد أن نبين أن هذا التصور للسياسة والشرعية ليس بالضرورة متماهياً مع الفكرة الديمقراطية التعددية، مما يدل عليه كونها جاءت متأخرة في الظهور عن المقاربة الجديدة للدولة السيادية المطلقة، بل يمكن القول إن فكرة السيادة في بعدها الاطلاقي نقيض للأطروحة الديمقراطية (مما انتبه إليه تقليد فلسفي من كانط إلى دريدا) ولقد تعايشا في شكل توفيقي هش تعبر عنه الأزمات الراهنة المتفاقمة للنموذج الديمقراطي التمثيلي. والواقع أن التقليد الحداثي نفسه لم يكن اتجاهاً وحيداً متجانسا، بل يمكن التمييز داخله بين تيارين ذهب أحدهما في اتجاه فكرة المجال العمومي المشترك أفقاً أوحد للسياسة، وذهب الآخر في اتجاه اختزال المجال المدني في آليات التنظيم الإجرائي للتناقضات الاجتماعية الناتجة عن نظام قسمة العمل وخريطته الطبقية.
ليس الإسلام عقيدة وتقليد طرفاً في هذا المسار بطبيعة الحال، لكن ليس ثمة حواجز أو عوائق فكرية أو ثقافية تحول دون تبنيه لقيم التحرر الفردي والمجتمعي، التي من السهل استظهارها من مدونته العقدية والمعيارية.
وإذا كان أمكن في بعض المقاربات استخراج مقولات العلمنة والذاتية والحرية الفردية من المنظومة اللاهوتية المسيحية الوسيطة، فإن مقولة “الاستخلاف” أبلغ مدى، وأثرى معنى في أطروحة “ديانة الخروج من الدين” من فكرة “التجسد”، إذ عنينا هنا بالدين مفهوم السلطة المقننة للاعتقاد والمهيمنة على الشأن العمومي، (حاول عبدالنور بيدار قراءة مفهوم الاستخلاف من هذا المنظور باعتباره تعويضاً كاملاً).
إن الإشكال يتلخص في ما عبر عنه “طلال أسد” من قدرة الإسلام الفعلية على استيعاب كل القيم الليبرالية الحديثة مع التساؤل حول إمكانية تطابقه مع فكرة الدولة السيادية المطلقة التي هي في عمقها تحويل للدولة إلى دين.
الاتحاد