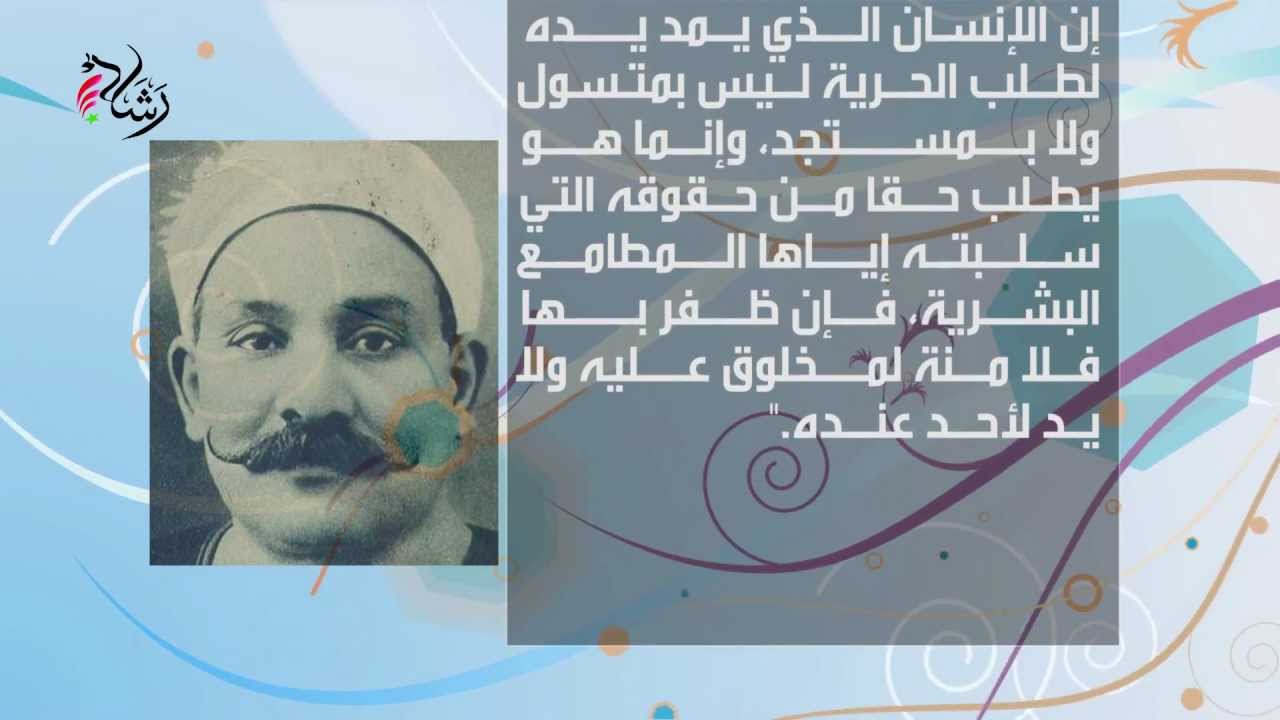الرواية السورية في مرآة الحرب: وثائق قيد التخييل/ مناهل السهوي

أفرزت الحرب الدائرة في سورية منذ سنوات نصّاً روائياً هجيناً، هو مزيج من التوثيق والتخييل، إذ اتجه معظم الروائيين السوريين في هذه الفترة- مرغمين ربما- نحو رواية الحرب، كما لو أنهم يكتبون سيرة الدمار والخوف والقتل، أو ما يسميها الروائي والناقد نبيل سليمان “روايات الزلزال السوري”. تتقاطع هذه الأعمال وتفترق، حسب الخندق الذي اختاره هذا الروائي أو ذاك. ولكن كيف وجد الروائيون أنفسهم حيال سردية الحرب، وكيف رصدوا وقائعها؟
تخرج “نارنج” إحدى بطلات رواية “اختبار الندم” 2017 لخليل صويلح من المعتقل بأذن واحدة بعدما فقدت الأخرى داخله، ليقدم لنا الراوي ثلاث نساء تفصلهن أبعاد مختلفة عن الحرب ليتماهى الراوي مع حكايات بطلاته، أما “جمان” بطلة رواية شهلا العجيلي “سماء قريبة من بيتنا” (القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية)، فهي تعيش مكابدات الحرب والسرطان، وهي بذلك تقودنا إلى سؤال جوهري: هل يختلف تنظيم الدولة في احتلاله مدينة “الرقة” عن السرطان الذي يلتهم رئة جمان؟ في حين انخرط “ملهم” بطل رواية “حقول الذرة”(جائزة الطيب الصالح/2016) لسومر شحادة، نحو مواجهات أكثر حميمية حين اعتكف وحيداً هارباً من داخله تنتابه انفعالات متناقضة، وجد في كتابتها علاجاً لأزماته. من جهته رصد نبيل سليمان في روايته “جداريات الشام: نمنوما” حياة عائلة سورية مزقتها الحرب كما مزّقت الجغرافيا. شخصيات مغلقة على يقينيات راسخة وإيمان مطلق بوجهات نظرها، فها هما “نمنوما” التي تعمل قاضية، وابنتها تدعمان الثورة، في حين بقي زوجها العقيد على الضفة الأخرى لتبقى الأسئلة الكبرى حول مستغلي الأزمات والمهربين والرماديين والكثير من النماذج التي أفرزتها الحرب، من ناحية أخرى يذهب الروائي هيثم حسين في روايته (إبرة الرعب\2013) ليسلط الضوء على أشكال الفساد وصولاً إلى الاتجار بالأعضاء البشرية، ليتحول رضوان الذي لم يكمل تعليمه لممرض تثق به كل القرية وهو حقيقة يمارس نشوته في لمس المؤخرات قبل غرس الإبر فيها. روايات تطرح وتغوص في أسئلة مرحلية ووجودية، هل كان اغتصاب ملهم لحبيبته في النهاية وخسارة الطفل الذي لم يعلم بوجوده تشويه لإنسانية ندعيها، هل السرطان هو عجزنا عن فهم الأشياء التي تقتل دون سبب، وكيف نكمل حياتنا بأذن واحدة وبنصف قلب ونصف عائلة، هل الحروب تمضي إذاً، بعد حين إن لم تجد من يلتقط وقائعها، ومن يحاكي واقعها الاجتماعي والسياسي والإنساني؟ “ضفة ثالثة” توجهت إلى الروائيين نبيل سليمان وخليل صويلح وشهلا العجيلي وهيثم حسين وسومر شحادة، بسؤالهم عن رواية الحرب: تجربتك معها، وكيف تنظر اليوم إلى واقع المدوّنة الروائية السورية، ما الذي طرأ على نصك، وإلى أي حد هيمن موقفك السياسي على ضرورات التخييل الروائي، وما الذي سيبقى من هذه الموجة بزوال أسبابها المباشرة؟ فكانت الشهادات التالية:
نبيل سليمان:
في 2014 صدرت روايتي (جداريات الشام – نمنوما)، وهي عن السنة الأولى من الزلزال السوري، والتي تتوجت بهزيمة (السلمية) وانتصار (العسكرة) التي كان قد بدأها النظام منذ الأيام الأولى.
من القليل الذي عشته في تلك السنة، ومن الكثير الذي تقريته شهقةً وقطرة دم ولهفة عشق، جبلت تلك الرواية، مغامراً في الكتابة عن تاريخ يتشكل، تاريخٍ جارٍ وساخن وعامر بفخاخ اللهاث خلف الراهن، والتوثيق، والشعاراتية.
وكنت قد خضت مثل هذه المغامرة في روايتين عن حرب تشرين الأول 1973، هما (جرماتي -1977) و(المسلة -1980). ولعلك تعلمين أن لي كتاباً عن التجربة العربية في كتابة رواية الحرب هو كتاب (الرواية والحرب -1999).
في العام الماضي صدرت روايتي (ليل العالم). وبفضلها فُكّتْ واحدة من عقدي المكينة، ذلك أني منذ غادرت مدينة الرقة عام 1972، وبعد خمس سنوات فيها من أخصب ما عشت، حاولت مرة بعد مرة أن أكتب رواية عن الرقة، فأخفقت، حتى كانت للرقة شهورها السلمية، قبل أن تدهمها العسكرة، وتسيطر عليها جبهة النصرة ثم داعش وإذا بالرواية التي انتظرتها أكثر من أربعين سنة تنكتب، وبها تتجدد مغامرة مثل هذه الكتابة التي يتحاشاها كثيرون، بدعوى الانتظار حتى (تختمر) التجربة وتنتهي المرحلة، تماماً مثلما يسقط كثيرون في مهاوي المباشرة والثأرية ومنافسة الصحافي أو المؤرخ أو الناشط أو السياسي.
بفضل هاتين الروايتين اللتين منع توزيعهما في سورية، أظن أن تلمّس نبض التاريخ في جريانه، جاء أشبه بالسرّ في لحن موسيقي. وفي مثل هذا يقوم الفارق بين الرواية وبين الريبورتاج أو الشهادة أو الكاميرا وسوى ذلك مما يدّعى أنه رواية، وسواء أصحّ ما في اعتقادي من أنه ما من كتابة بريئة، أم لم يصح، فإنني أحسب أن الموقف السياسي لم يهيمن على ضرورات التخييل، فيما حاولت من كتابة الرواية، وبخاصة في الروايتين الأخيرتين والفرق كبير بين ما قد يكون للسياسي في نبض التاريخ، وبين هيمنته وتحويله الرواية إلى منشور أو خطاب أو بيان، وهذا ما نتأ في الكثير مما سمي بروايات الحرب، ومنها ما صدر في سنوات الزلزال السوري لأصوات مخضرمة ولأصوات جديدة.
من الأسماء المكرسة بحق وبغير حق، من لم يكتفِ بإيثار الانتظار حتى تنجلي (الغمّة)، بل حكم على كل ما كتب أثناء (الغمة) بأنه ليس رواية، وهكذا عدنا إلى موّال الاختمار واكتمال المرحلة، بالأحرى: الهرب من المسؤولية ولكن بالمقابل، جاءت روايات شتّى لأصوات مخضرمة أو لأصوات جديدة، تتقفى السياسي، وتغلّبه على الفنّي، ويشوّهها ما يعلق بها من سوءات السياسة، حتى بلغ الأمر أحياناً أن تلوثت الرواية بالطائفية.
مثل هذا الزبد سوف يذهب جفاءً وهباءً. كم من الروايات التي كتبت في العراق عن الحرب العراقية الإيرانية، ذهبت بدداً؟ كم من الروايات التي كتبت عن حرب تشرين 1973 في سورية أو في مصر، أو عن الحرب الأهلية اللبنانية، أو عن العشرية الجزائرية السوداء، وذهبت جفاءً وهباءً وبدداً؟
ليس بالشعارات ولا بالهجاء ولا بالثأر تنهض رواية الحرب أو رواية الثورة أو أية رواية وليس بحشد الأحداث والوقائع التي يشيب لشعرها الولدان فالرواية فن، وليست تأرخة ولا شهادة، وحتى لو عُنيتْ بالشأن العام، فإنها تفعل بصفتها خطاباً رمزياً.
وإذا كان شر البلية ما يضحك، فمن المضحك أن من روايات الحرب أو الثورة أو الزلزال السوري ما ابتلي بنرجسية الكاتب، فتحولت الرواية إلى سيرة ذاتية ركيكة. وثمة أيضاً البلوى بعقدة الترجمة إلى اللغات الأخرى وبشهوة العالمية، ولذلك يجري حقن الرواية، مثلاً، بحقنة عن اليهود و/ أو حقنة عن المثلية، و/ أو حقنة من الإكزوتيكا، و(تعا تفرج يا سلام / على فلان وعلّان من كتّاب هالأيام) أو على هذه أو تلك من (روايات هالأيام) والويل لك إن تجرأت ولمحت مجرد إلماح إلى مثل هذه العلة أو تلك في رواية أحدهم، والويل لك أيضاً إن ترفّعت عن مثل هذا (السِّقط)، فالكاتب المعني وأنصاره الميامين بالمرصاد، وخصوصاً بالمرصاد الفيسبوكي الثورجي ولكن، على الرغم من كل هذا الهباء والزبد والجفاء، فإن عدداً غير قليل من الروايات المعنية بالزلزال السوري قد نجا من هذه الفخاخ والمزالق، بنسبة أو أخرى، فبات لنا مدوّنة روائية مبدعة، ولو كره من يحكم على كل ما يكتب الآن، وإلى أن تنجلي (الغمة) بأنه ليس رواية.
خليل صويلح:
لم أكن مهيأً لكتابة رواية عن الحرب، إلى أن سمعت هدير أول حوّامة بالقرب من نافذة غرفتي على سطح بناية في وسط دمشق. بدأ مخاض الكتابة على هيئة يوميات كنوع من العلاج المؤقت لمرضٍ مباغت. كانت أخبار التظاهرات والقتل والقنص تملأ الشاشات. بسقوط أول قذيفة على سطح البيت المقابل لبيتي، أدركت أن الأمر لم يعد مزاحاً. هكذا انخرطتُ في كتابة “جنّة البرابرة” بقصد تشريح فكرة الخوف. أن تباغتك قذيفة، وأنت ذاهب إلى موعد، أو وأنت عالق في زحام سيارات أمام حاجز أمني. كنت أرسم سيناريو متخيّلاً لكيفية طيران الأجساد لحظة انفجار القذيفة. سيتطور النص على مراحل باستخدام مفردات لم أستعملها قبلاً، مثل الحاجز، القنّاص، الاختفاء القسري. وسأبتعد عن “عنتريات” البطل الروائي لمصلحة حكايات كانت تتناسل من كل الجهات بأقسى أنواع الهلاك، ثم تحوّلت مناماتي إلى كوابيس. الحيرة بين عمل المؤرخ، وعمل عالم الاجتماع، قادتني إلى يوميات حلّاق دمشقي، عاش في القرن الثامن عشر، بظروف مشابهة لما نعيشه اليوم، كتبها بعنوان “حوادث دمشق اليومية”، ثم سأستنجد بابن خلدون لترميم طبائع البشر في لحظة بدويّة متوحشة. بين هذين الخطين، كنت أدوّن يومياتي طوال سنتين من عمر الحرب، ببسالة راوٍ يعيش في ظل حرب مدمّرة، من دون ادعاءات فرديّة، أو اختراع بطولات كتلك التي تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي على بعد آلاف الأميال، فقد كان الموت أليفاً كقطة تتناول حساءها على الأريكة المجاورة، وكان عليّ أن أدين العنف لدى الطرفين بجرعات عالية، من دون ثأرية، ولمصلحة كتابة سردية محمولة على رافعة وثائقية، فأن تكتب عن منطقة روائية غير مسبوقة، تحتاج إلى تقنيات موازية، وهذا ما سعيت إليه بابتكار سرديات متجاورة. كنت أظن أنني دفعت فاتورة الحرب تماماً، لكنني بعد نقاهة طويلة إلى حدّ ما، دهمني نصّ آخر هو “اختبار الندم”، ففيما كانت “جنة البرابرة” مشغولة بالمشهد الخارجي للحرب، ذهبت روايتي الثانية إلى فحص الطعنات الداخلية للشخوص، وتلك الندوب العميقة في الأرواح المهزومة، كمحاولة لترميم العطب أو فضح أحوال الجسد، ومعنى العار، جنباً إلى جنب مع فحص اللغة نفسها وضرورة تقشيرها من فائض البلاغة الجوفاء والانتهاك الإنشائي، وتالياً مقاومة لغة العنف بلغة محسوسة وبصرية لا تقبل المراوغة أو عمليات الفوتوشوب الإيديولوجية. سنحتاج وقتاً طويلاً للنجاة من أعباء النص الطارئ للحرب، قبل الغوص في بئر آثامه العميقة، وتنظيف هذه البئر من شوائب الاعتداء على مفاهيم السرد، بقوة الموقف من الحرب وحسب. شخصياً، أخشى نصوص الكراهية والبطولات الخرقاء لروائيين طارئين، أتوا وليمة لم يشاركوا في طهوها، وادعوا أن الآخرين مجرد ضيوف عليها. لكن نصّ الحرب، بالنسبة للروائي السوري اليوم، سيبقى وشماً في الجبين لحقبة طويلة، نظراً للمخزون الثقيل الذي خلفته هذه الحرب على الأجساد والأرواح معاً. على منوال مخلفات الحرب سنقع على نصوص مشابهة، بعكاز، أو ذراع مبتورة، أو حالة عمى مؤقت.
شهلا العجيلي
تبدو الحرب المرآة الأكثر وضوحاً، التي تعكس التحوّلات التاريخيّة الكبرى ومعها دراميّة البشر، أي صراعاتهم وتناقضاتهم، فهي لحظة تتساقط فيها الأقنعة، وتظهر الرغبات البشريّة في أبشع صورها، وأكثرها عنفاً، وتتراجع الثقافة الرفيعة لصالح الطبيعة والثقافة غير العالمة، فتكون الحرب هنا محكّاً للقيم والأخلاق العرفيّة، ويتجلّى خلالها ما يسمّيه كانط بالعقل العمليّ غير الممنهج، فضلاً عن الدراميّة الناشئة من المشاعر في حالتها القصوى الخوف، الشعور بالضعف والازدراء، والتهديد ضدّ رغبات البشر في الحياة، في الأمن والكرامة والاستقرار… هذا كلّه يشكّل أصلاً نظريّاً لفنّ الرواية، وعلى الروائيّ أن يوجّه كشّافه ليضيء على هذه التحوّلات الدراميّة، ويرسم بوعيه الفرديّ خريطته الخاصّة للتحوّلات الراهنة والمتوقّعة، أمّا الحرب بوصفها حدثاً، فهي سرديّة قائمة، بمعزل عن مشاركة الروائيّ فيها، لها يوميّاتها ووثائقها وأبطالها، وهؤلاء جميعاً ليسوا أدواتي ولا في مرمى كتابتي، عادة ما أهمّش المظاهر الكبيرة والواضحة، أو أجعلها تعمل لحساب أقلّ الأشياء، لعلّ تناول الموضوعات الكبرى ليست طريقتي في الكتابة، ولا أعتقد أنّها ستكون في المستقبل.
ثمّة من الروائيّين من سيكتب عن الحرب، وثمّة من سيكتب في ظلّها، وهناك من سيكتب عن ظلالها وعقابيلها، لقد صارت منعطفاً تاريخيّاً لا يخصّ السوريين وحدهم، وسيدخل فيما يسمّيه (زولا) الحسّ التاريخيّ، الذي لا يمكن إنكاره. ما زالت تداعيات الحربين العالميّتين حاضرة في الأدب الأوروبيّ والأدب الأميركيّ، والعربيّ وغيرها من آداب الشعوب. وما زالت حرب فيتنام محرّكاً عالميّاً للكتابة، وكذلك الحال مع حروب تفكيك المستعمرات بما أنتجته من هجرات، واحتلال فلسطين، والحرب الأهليّة اللبنانية، وحرب السنوات العشر في الجزائر، وحرب البوسنة والهرسك، ونزاعات تفكّك الاتحاد السوفييتيّ… وإذا قلنا مع نظريّة ما بعد الاستعمار إنّ التاريخ يكتبه الضحايا اليوم، هذا يشير إلى أنّ كلّ ضحيّة تريد صياغة الحدث برؤيتها، وهي لن تتمكّن من ذلك بلا عودة إلى نقطة الانعطاف، سواء تغيّت الكلام على ما قبلها (التاريخ) أو على ما بعدها (المستقبل). لا يقتصر وسم الضحيّة على الفرقة المهزومة في الحرب، إذ تغيّر شكل الحروب من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الوجه الآخر لكلّ من يعدّ نفسه منتصراً في الحرب السوريّة هو وجه لضحيّة: فقد المكان، والأهل، والأحبّة، والثقة، والهويّة… هذه الثيمات هي ما يهمّني في الكتابة، وأقول دائماً إنّها المآسي الفرديّة التي لا يُلتفت إليها في خضمّ قعقعة الهزيمة أو ضجيج الانتصار، هذه المأساة لا تلغى بقرار سياسيّ أو وقف إطلاق نار، أو مصالحة وطنيّة… لقد دخلت في التاريخ وأنتجت حياة جديدة وعلاقات جديدة، وهنا تكمن خطورتها، ولا أعتقد أنّ تصحيح المسارات مهمّة الروائي، لكن أعرف أنّه لا شيء ينجو من الكتابة. لم تكن الحرب بعيدة في روايتي (سجّاد عجمي) 2012، التي كان فضاؤها التاريخ، القرن الثالث الهجريّ، حيث القلق والخوف والترقّب ما قبل لحظة خراب الرقّة، وكذلك في (سماء قريبة من بيتنا) 2014، حيث لحظة بدء الشتات، الحرب في كتابتي ذريعة للسرد وللنقد، نقد الذات ونقد البنى الاجتماعيّة، وليست هدفاً.
ستشكّل النصوص التي بدأت تتكاثر مدوّنة الحرب طبعاً، بغضّ النظر عن القيمة الفنيّة، والتي لا يمكن أن تكون جماعيّة، ففي النهاية القيمة الفنيّة للنصّ الأدبيّ وليس لمجموع النصوص، ويمكن للدارسين أن يبدأوا بوضع هذه المدوّنة تحت مجهر النقد، وقد شاركت في ندوات وملتقيات حول رواية الحرب وما أنتجته من كتابات في المنفى وفي الوطن، وأجبت على أسئلة لبعض الدارسين عن نصوصي التي خضعت أيضاً للبحث ضمن رسائل أكاديميّة، المجال خاضع للحقل النقديّ الآن.
ليس النصّ الروائيّ إعلان بيانات أيديولوجيّة من وجهة نظري، وليس وثيقة أخلاقيّة أيضاً، فالوثائق لا تنجو من التزوير، والرواية مقاربة صادقة للحياة، وإدانة للقبح والقسوة وقسريّة التحوّلات، وبالمناسبة هي ليست دعوة للتضحية أيضاً، وأجد رواية (الأم) لمكسيم غوركي أقلّ قيمة ممّا قرأت في الأدب الروسي! الرواية أيضاً أعمق بكثير من التنظيرات السياسيّة، وأكثر تعقيداً، في كتابي (الرواية السوريّة-التجربة والمقولات النظريّة) 2010 أدنت الأيديولوجيا، ووجدتها مقتلاً لأي نصّ روائيّ، ولا يعني ذلك ألا يكون الكاتب شخصيّاً منتمياً أيديولوجيا، لكن سيبذل جهدا كبيراً لتحييد أيديولوجيته، ويعود لمساءلة المسلّمات. ولا شكّ في أنّ لديه آراء سياسيّة، لكنّه سيمنعها من أن تقسره على صناعة عالم ببعد واحد، وأبطال أحاديين كلّ من يخالفهم المعتقد يصير نموذجاً جماليّاً سلبيّاً! العالم الروائي ينبني على الدراما، وإذا قام صانعها بمحاباة أحد العناصر الدراميّة أو تغييب آخر سيسبّب إخفاقاً معرفيّاً وجماليّاً على حدّ سواء.
هيثم حسين:
أعتقد أنّ الرواية السوريّة دخلت مرحلة جديدة من تاريخها بعد الثورة السوريّة، لأنّ الثورة بحدّ ذاتها بداية تاريخ سوريّ مختلف، وبعد أنّ تمّ تحويلها إلى حرب على يد النظام الإرهابيّ الذي دمّر البلد وشرّد الملايين من أبناء الشعب السوريّ في الداخل والخارج، ووضع البلد تحت الاحتلالين الإيرانيّ والروسيّ، فإنّ هذه الرواية خرجت من دائرة الجغرافيا السوريّة لتشمل جغرافيا العالم، لأنّ السوريّ أصبح شريد العصر الجديد.. هناك مَن يتهرّب من تسميتها بـ”ثورة”، ويستعمل مصطلحات كزلزال، أو مقتلة، أو مجزرة، أو كارثة، أو غيرها من مصطلحات تشير إلى فاعلين مجهولين أو قوى طبيعيّة غيبيّة مجهولة، وهي تتملّص من تحديد المجرم الرئيسيّ قبل تحديد شركائه اللاحقين المتقنّعين بأردية دينيّة وطائفيّة بائسة.
ملايين الحكايات للاجئين ونازحين ومعتقلين وشهداء، ملايين الحكايات لمفقودين وراحلين، تنتظر مَن يعيد نسجها وسردها، لذلك فرواية الحرب ورواية الآثار العميقة التي تخلّفها على الجيل الحالي والأجيال اللاحقة، لن تكون موجة، ولن تنتهي أبداً لأنّ أسبابها لن تنتهي ولن تزول، فالنظام ما يزال يمارس إجرامه، والسوريّون أصبحوا مشرّدي الأرض ومعذّبيها في القرن الحادي والعشرين، وحتّى إن انتهى النظام – ولاشكّ سينتهي عاجلاً أو آجلاً – فإنّ آثاره الإجرامية على التاريخ والمستقبل لن تزول بسهولة، لأنّه أمعن في تدمير البلاد والنفوس، وسيكون من الصعوبة التقاط هذه الآثار الخطيرة في أعمال محدودة.. وهناك نقطة رئيسة تتمثّل في أنّ خارطة البلاد الديمغرافيّة تغيّرت كثيراً، والتغيير سيطاول مختلف الخرائط الأخرى أيضاً بما فيها الحدود، لذا فأنا أوقن أنّ حقبة جديدة قد بدأت ولن تشبه إلّا نفسها، ومن الاستحالة الإيهام بالعودة إلى ما كان وكأنّ الأمر موجة عابرة أو سحابة طارئة.. المأساة السوريّة تنفتح على أعمال متميّزة لأنّ الأسى السوريّ عميق ومرير وغير محدود.
لا شكّ أنّ الموقف السياسيّ للكاتب يحدّد موقعه وضفّته، وعلى الكاتب أن يكون صاحب موقف، وإلّا فإنّه يتخلّى عن أخلاقيّاته وإنسانيّته ويتهرّب من مواجهة ذاته والمبادئ والقيم التي يزعم الدفاع عنها في أعماله.. الروائيّ يحيا في عالم الأدب، وهذا عالم يضمّ الحياة كلّها بمختلف ألوانها.. وروائيّو المقاهي البائسة لن يضيفوا أيّ إبداع إلى خارطة الرواية السوريّة لأنّهم يعتبرون أنفسهم مركز العالم في حين أنّهم غارقون في الوهم الذي يعمي الأبصار والبصائر.. هناك روائيّون لاذوا بالصمت، تخاذلوا عن الوقوف إلى جانب الحقّ ضدّ الطغيان والاستبداد والإجرام، وهنا المعارضة لنظام الإجرام موقف أخلاقيّ وليس موقفاً ثوريّاً، وهنا لا أنادي بضرورة انضواء الروائيّ في صفوف معارضة، بل أقصد أن يتمّ اتّخاذ الموقف الأخلاقيّ ضدّ سلطة القتل والتدمير، أن تتمّ الإشارة إلى الفاعل مع الإشارة إلى ردود الفعل وتداعياته الكارثية أيضاً، لكن أن يكون التركيز على حوادث منقطعة عن جذورها، فهذه خيانة للأدب والتاريخ والذات معاً.
سومر شحادة
ما حدث في سورية منذ اللحظات الأولى بدا أنّه يحدث كي يمحو ما قبلهُ. في الكتابة حصل أمرٌ مشابه إذ جعل الكثيرون من كتاباتهم نوعًا من التشفي من ماضيهم خصوصًا، من كان مرتبطًا مع السلطة، صارت الكتابة لديهم نوعًا من التبرُّؤ مما قد شكّل خطابهم. وفي غمرة ذلك التبرُّؤ تنحّى ما هو فني أمام حشدٍ من الأدوات السياسية والطائفية، وليّ عنق الفن لصالح الأيديولوجيا. لقد بنت هذه العقلية مشهدًا غير متوازن، وتمت إعادة إنتاج ما كان يعتقد الآخرون أنّهم يقومون بإزالتهِ من ماضيهم. عوضًا عن العبور إلى ما هو إنساني وراء المتاريس؛ لقد بات مجرد البقاء في سورية تهمة ترمى في وجه من بقي، وصار كلّ خروج من البلد نكرانًا لأهلها. لماذا نفعل هذا؟ ألا توجد طريقة لإيقاف سيل التشوهات الآخذ بالتشكل؟
عندما تخفت أصوات القتلى عن الترداد في نفوس الأحياء سيحين وقت تشييد الفن، بالمعنى الخالص للكلمة، أو إعادة تجميعه فوق ركام هادر من المواقف والنقاشات. ما الذي يبقى ممّا نكتبه اليوم؟ هذا مرهون بالشكل الذي يُعالج فيه الحدث، كلما كان الشكل متجاوزًا الزمن، بشروطهِ، يحيا النص. في الحقيقة، من يكتب في خضم القتل وفي أوج أزمنتهِ يستدعي أن يكون مادة الكتابة في زمن ما، وربما لن تبقى سوى صورتنا ونحن نكتب وسط برك الدماء مثل عجول عاجزة، ممثلين عبثيين لا نعرف دورًا آخر كي نؤديه.
هذا السؤال للغد.
كانت الرواية وعيًا يتشكل أثناء الكتابة لا تجليًا لوعي مسبق. بالتالي، ما طرأ على النص كان ينعكس على مواقفي في الحياة. في الأدب، الجميع متشابهون، مهزومون وانتحاريون وأشقياء. في السياسة، أحدهم جهّز البارود والآخر أطلق. هذا موجود في “حقول الذرة”، لكن من فرض على الآخر رأيه، الواقع هو ما فرض على كلينا هذا الرأي.
ضفة ثالثة