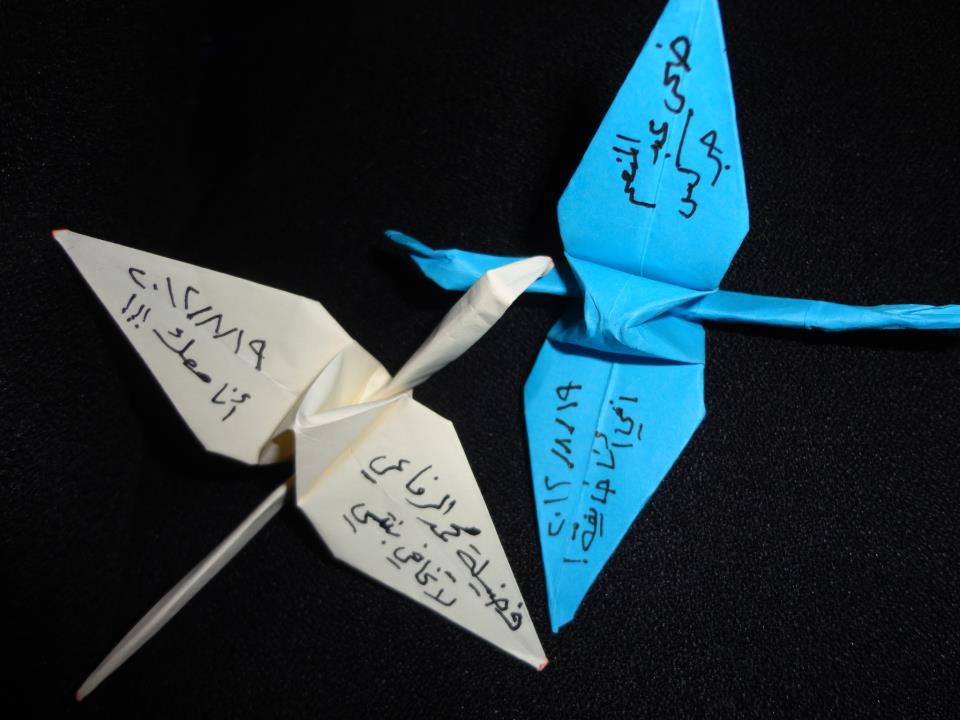السوريون بوصفهم عوالم منفصلة/ أكرم البني

أفضى استمرار العنف المنفلت إلى انزياحات واسعة في المجتمع السوري، وأكره الناس على الاصطفاف فيما يشبه العوالم المنفصلة، بحيث يبدو أن لكل عالم طريقة عيشه وهمومه ومخاوفه.
هناك السواد الأعظم من السوريين المتضررين مما خلفته الحرب ولغة السلاح وباتوا منشغلين بلملمة جراحهم وتسكين آلامهم وبجهادهم المرير من اجل الاستمرار في الحياة، سواء كانوا مهجرين خارج الحدود او نازحين داخل الوطن أو آثروا البقاء في بيوتهم ويحاولون التكيف مع دوامة العنف وتدبر لقمة العيش في ظل ظروف امنية واقتصادية قاسية.
وإذ يتعرض اللاجئون السوريون إلى أخطار وانتهاكات جسيمة منذ بداية رحلة الهروب من نار المعارك المستعرة حتى تجاوز الحدود، فهم يجبرون على العيش في معازل ومخيمات بشروط سيئة لا تليق بالبشر تتفاوت شدتها تبعاً لبلد اللجوء، أهمها معاناتهم من الإقصاء والاستبعاد ومن هشاشة حياتهم بلا مؤسسات ولا عمل، وخضوعهم تالياً للمعونة المقدمة من منظمات الإغاثة الدولية، التي تعجز عن تلبية احتياجاتهم، بدءاً بالغذاء والملبس، إلى الاستقرار والتعليم والحماية من جنون الطبيعة كالبرد والصقيع، ومن الاستغلال الجسدي وبخاصة للأطفال والفتيات، إلى الواقع الصحي الضنين، وهم الأكثر عرضة للأمراض السارية والأوبئة، وتكتظ صفوفهم بالجرحى والمصابين بإعاقات موقتة أو دائمة.
يشارك النازحون داخل الوطن اللاجئين المعاناة ذاتها بحثاً عن ملاذ يقيهم جحيم الحرب وقد باتوا اليوم بلا مأوى أو في حالة عوز شديد بعد ان فقدوا كل ما يملكون ويدخرون، ومرغمين أحياناً على التسول وغالباً على قبول أعمال وضيعة ومذلة لتأمين قوت يومهم، والأنكى أن عقدة الخوف من الملاحقة والاعتقال والتعذيب تتضاعف عندهم بسبب انتماء غالبيتهم إلى المناطق المتمردة، حتى صار بعضهم يجد الموت أرحم مما يكابده من خوف وقهر وجوع.
ثمة ما يصح تسميته عالم السلطة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وفيها تبدو الحياة كأنها تسير بشكل طبيعي، وإذا استثنينا سقوط القذائف القاتلة على بعض الأحياء، وكثرة الحواجز الأمنية المنتشرة في الشوارع والساحات، ثمة ما يشي بأن البشر قد أدمنوا ظروف عيشهم القلقة، فلم تعد تشغل بالهم حدة المعارك وأصوات الانفجارات وقصف الطائرات وأعداد الضحايا، بينما لا يوفر النظام جهداً لتكريس هذا الإدمان، مستقوياً، مرة بالنتائج التي حققها عسكرياً في الريف الدمشقي وحمص لبعث الثقة بسياساته وبجدوى خياره الحربي، ومتوسلاً، مرة ثانية الانتخابات المزمع إجراؤها لتجديد حيوية السلطة برغم تأثيرها في فرص المعالجة السياسية، ومرة إثارة المخاوف مما قد يحل بالبلاد في حال انتصار الإسلامويين المتشددين، ربطاً بتسخير الدولة وتفعيل مؤسساتها لتوفير أهم مستلزمات الحياة في مناطق نفوذه، كالالتزام بخدمات الماء والكهرباء والاتصالات، والمساهمة في تأمين المواد الغذائية والأدوية، مراهناً على مقايضة رضا الناس بما يلقونه من اهتمام بغض نظرهم عن حالات الحصار والتدهور المريع في الأوضاع المعيشية والإنسانية لأخوة لهم في الوطن.
وفي المقابل هناك عالم يحتفي بنفسه بصفته حامل لواء الإسلام والمسلمين، ويفيض بكتائب متنوعة من محاربين اسلامويين جاءوا من مختلف البقاع، ويتنافسون على فرض ما يعتقدونه شرع الله على الأرض، من دون اعتبار لتعددية المجتمع السوري وتنوع مكوناته ولشعارات ثورته عن الحرية والكرامة والدولة المدنية، ولا يخفف من خطورة هذا «العالم» القول إنه ولد كرد فعل على عنف النظام واستفزازاته الطائفية، أو الادعاء بأنه طارئ وغريب ويرتبط بأجندة خارجية سيزول بزوالها.
والمشهد يثير العجب والأسى في آن، فإلى جانب الصراعات الدموية المفتوحة بين هذه الكتائب في سعي كل منها للسيطرة على مناطق الآخرى، بين داعش والنصرة، وبينهما وبين بعض فصائل «الجيش الحر» تحضر المعاناة المركبة التي يكابدها أبناء تلك المناطق، وكأن الحصار والجوع وغياب الحد الأدنى من الحاجات الإنسانية، ثم القصف اليومي والعشوائي وما يخلفه من ضحايا ودمار، لا يكفيان ولا بد أن يستكملا باستبداد إسلاموي لا يقف عند إرهاب البشر وإرغامهم على اتباع نمطه في الحياة وإنزال أشنع العقوبات بحق من يخالف ذلك، بل وصل إلى حد النيل من رموز وأماكن العبادة، وفرض مناهج دينية تلقن للأطفال لا تمت بصلة لمنطق العلوم والمعارف، والأهم اعتقال بعض المعارضين واغتيال آخرين والتنكيل بالناشطين المدنيين والإعلاميين.
وأخيراً يصح اعتبار الكيان السياسي للمعارضة والمؤلف بغالبيته من سوريين معارضين في الخارج، عالماً قائماً بذاته، فهو لا يزال بتشكيلاته المتعددة في وادٍ بينما المعاناة الشعبية في وادٍ والأنشطة المسلحة في وادٍ آخر، وأهم مثالب هذا الكيان، أنه وضع كل بيضه في سلة الدول الغربية وراهن على دورها في إحداث التغيير المنشود، إن لجهة الامتثال للتوافقات التي تجريها حول الشأن السوري، والمثال «جنيف 2» أو لجهة حضّها على التدخل العسكري المباشر لتعديل مجرى الصراع، أو لمد المعارضة بالسلاح، مع أن ذلك يبقى عنواناً لحرب مديدة تغذي منطق العنف وجحيم الحرب، حتى لو سوغ الأمر بأنه رد طبيعي على عنف مفرط لم يتخلّ عنه النظام لحظة واحدة، أو الادعاء بأن استجرار السلاح غرضه تكتيكي لتعديل توازنات القوى من أجل إجبار النظام وحلفائه على التسليم بالمعالجة السياسية وفتح الباب لقيام الحكومة الانتقالية العتيدة.
لن تعود سورية إلى ما كانت عليه قبل آذار (مارس) 2011، فثمة جديد رسخ في الأرض وهناك متغيرات نوعية حصلت وتركت علامات عميقة في وجدان الناس وطرائق تفكيرها وخياراتها في الدفاع عن حقوقها، ويبقى الأمل قائماً، على رغم بشاعة ما يحصل، بأن تصمد أسباب اللحمة أمام نوازع التفرقة والتمييز، وبأن تحث التضحيات التي قدمتها مختلف المكونات السورية، لبناء دولتها وتعايشها، على الاستمرار في تغليب انتمائها الوطني على أي انتماء!.
الحياة