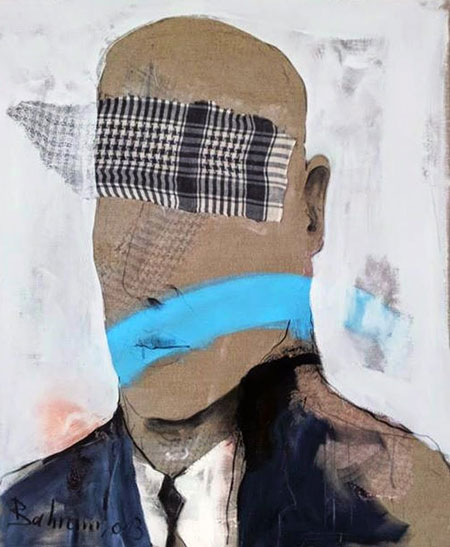السينمائي السوري جود سعيد يصور حمص على ظهر دبابة/ راشد عيسى

باريس ـ “القدس العربي”: منذ فيلمه «مرة أخرى» (2008) كنا نعرف أن السينمائي السوري الشاب جود سعيد لم يكن سوى ناطق باسم السلطة، وهو لو يخفِ مرةً استماتته في الدفاع عنها. ذلك الفيلم بالذات استُلهم من سيرته الشخصية كابن ضابط كبير خدم في جيش النظام السوري في لبنان، وإذ يروي الفيلم وقائع بين حربين؛ اجتياح العام 1982، وحرب تموز 2006، فإنما ليؤكد أن اليد السورية الممدودة للبنان حين الغزو الإسرائيلي، كانت «مرة أخرى» ممدودة في حرب العام 2006.
الفيلم يدور حول قصة حب سوريّ للبنانية أبرز ما فيها أنها تساوي بين الضحية والجلاد، فمثلما للشاب، بطل الفيلم، ثأر لدى لبناً حيث خسر والدته هناك، فإن للشابة اللبنانية قصة خسارة مماثلة حيث تلمح إلى أنها فقدت والدها على يد السوريين. عموماً جاء الفيلم ليشكل خرقاً لتاريخ السينما السورية الحافل بمواجهة السلطة والتحايل على قوانين الرقابة. فيلم «مرة أخرى» بدا كأنما أنتج على يد الرقابة، ناطقاً باسمها وباسم السلطة من دون مواربة، بل يكاد يكون ناطقاً باسم الجيش بالذات، حتى لو قدم نفسه بمشاغل بصرية معقولة.
في السنوات الأخيرة أنجز سعيد فيلم «صديقي الأخير» و»بانتظار الخريف» الذي صورت مشاهد منه في حي بابا عمرو الحمصي، أحد أهم معاقل التظاهرات السورية، وقد استولى عليه النظام بعد تدميره. وحسب ما تداولته الصحافة عن الفيلم الذي لم يأخذ طريقه للعرض بعد، فمن الواضح أن انتظار الخريف عند جود سعيد ما هو إلا طريقة للتهكم من الربيع العربي.
سعيد يصور اليوم فيلمه الجديد «مطر حمص» في قلب مدينة حمص، على أنقاضها للدقة، بعد أن خرج منها مقاتلو المعارضة السورية إثر اتفاق بين النظام والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة. لم يتضح حتى الساعة من حكاية الفيلم سوى «أنه حكاية خيالية تستند لواقع الحرب، وتنطلق عبر الزمان والجغرافيا لرواية الأحداث السوريّة وفق مستويات متعدّدة، تحتفي بالأمل والحياة والحب، وتحيل على ثيمة الهويّة»، وأنه عن «يوسف وهدى اللذين يحاولان النجاة وخلق الحياة وسط الموت والدمار، برفقة طفلين وعدّة شخصيات». غير أن بالإمكان، نظراً لموقع المخرج وموقفه، أن يتوقع المرء أين يمكن له أن يصب، خصوصاً أن سعيد يشير إلى «رمزية حمص ودلالاتها في الحدث السوري، قِدم المكان وعلاقته بتجذّر الإنسان وارتباطه بالعمارة وطبقات الهويّة السوريّة، خصوصية الشخصيّات وانتمائها لمكوّن أساسي من مكوّنات هذه الهويّة». وهو بالتأكيد لن يتناول موضوعات الهوية ورمزية المدينة ورمزية ساعة حمص القديمة والمكونات الأهلية إلا من وجهة نظر السلطة، هو القادم بحماية دباباتها وحواجزها الأمنية.
المسلحون والإنتاج السينمائي!
يريد جود سعيد أن يحتكر الرواية، حين يقول «أصنع أفلامي لأني حرّ ولا أموت، أنا صورة من يبكون ولا شاشات أخبار تعدُّ دموعهم، أفلامي هويّة أرضنا بتوقيع أهلها كي لا يكتب قاتلنا حكاياتنا». لا بأس أن يعتقد مخرج المؤسسة الرسمية بحريته، وبخلوده إن شاء، أما أن يستأثر بـ «صورة من يبكون ولا شاشات أخبار تعد دموعهم» فهنا يمكن القول إنه لم يكتف بالوقوف إلى جانب القاتل، بل ويريد أيضاً أن يلبس ثوب القتيل وأن يبكيه. ثم ما هذا الادعاء: «أفلامي هوية أرضنا»؟! عبارة لم يجرؤ على قولها عتاة السينما الذين أثبتوا التصاقاً بالأرض وهموم الناس. إنه مرة أخرى احتكار للهوية، وفوق ذلك احتكار للسينما السورية التي يريد المخرج اختصارها بأفلامه. في هذا السياق لا يتردد المخرج في الطعن بأفلام زملاء له صوّروا أفلاماً في حمص أثناء الحصار ملاحظاً أنها صُورت «تحت سلطة مسلحي المعارضة، ومنهم إسلاميون متشددون، وهذا حقهما. من هنا، لا يأخذنّ أحد علينا أنّنا نعمل تحت مظلة وزارة الثقافة». كما لا يتردد في أن يسميهم: «أسامة محمد (مخرج فيلم «ماء الفضة») مقيم في باريس ولم يأت إلى حمص. شاهد من خلال عيني شريكته في العمل، وهذا حقه، التي غادرت يوم خروج المسلحين. فيلم طلال ديركي (يقصد فيلم «العودة إلى حمص») لم أشاهده، ولكن علمتُ أنّ شخصيته الرئيسيّة التي يروّج لها الفيلم بايعت داعش أو النصرة». من الواضح أن المخرج أراد أن يخفف من فظاعة الأمر، لم يرد أن يقول إن مشروعه السينمائي مستمر بحماية دبابات جيش النظام وصواريخ السكود والبراميل المتفجرة والحواجز الأمنية، لم يقل إنه لولاها لما تجرأ على الوصول إلى قلب مدينة حمص المدمرة والمنهكة والخالية من سكانها. إنه يعمل «تحت مظلة وزارة الثقافة» فيما الآخرون ينجزون أفلامهم تحت سلطة «المسلحين»!. المقاتلون والمدنيون في حمص المحاصرة لم يكونوا يلوون حتى على لقمة الخبز، فكيف بإمكانهم أن يؤسسوا سلطة ورقابة وإنتاجاً سينمائياً. الشبان يا جود، السينمائيون الجدد صوّروا أفلامهم ببطولة نادرة، وجهاً لوجه مع سبطانة القناص، بل وسبطانة الدبابة، وهناك صور للتاريخ توثق ذلك.
لا يريد جود سعيد، كما نقلت عنه تقارير تلفزيونية مصورة، للغرباء أن يحكوا حكاية بلده. الآن أصبح كل ما عدا سينمائيي المؤسسة الرسمية غريباً لا يستحق أن يروي أو يقول. شيء ما في هذه اللغة يذكّرني بـ «قانون مصادرة أملاك الغائبين»، أراضيهم وبيوتهم والصور المعلقة على حيطان البيوت ومكتباتهم وأثاث بيوتهم وشوارعهم، وصولاً إلى سينماهم، وحكاياتهم، وأحلامهم.
لو أنك يا جود استمعت إلى الشهادات المؤثرة لأهالي حمص يعدوننا بالرجوع إلى الخالدية وكرم الزيتون والبياضة وبابا عمرو وسواها من أحياء حمص، لعرفت أن هناك رواية عميقة لن تقدر عليها البراميل المتفجرة حتى لو لبست لبوس السينما. هي رواية أهالي تلك الأحياء التي لن تقدر سينما الطغاة على احتكارها وتزويرها. لك الآن السينما كلها، والحارات الفارغة من سكانها، والأثاث، نعلم أخيراً أنه لن يبقى في الوادي غير حجاره.
القدس العربي