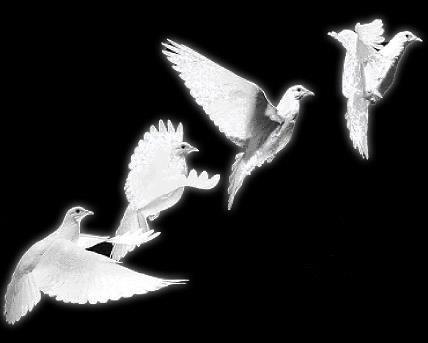الطريق إلى حلب
يسار قدور
قبل أكثر من عامين كان السفر من دمشق إلى حلب بالنسبة للمواطن السوري. عبارة عن أربع ساعات، يقضيها الشباب الصغار عادة في متابعة فيلم سخيف على الشاشة المعلقة في السيارة، ثم يغطون في النوم بعد دقائق من بداية الفيلم. أما الركاب الآخرون فتبقى أنظارهم معلقة في النوافذ، لمراقبة الطريق، وتعداد المناطق التي حفظوها عن ظهر قلب؛ اجتياز مدينة النبك يعني للسوريين الخروج الكامل من العاصمة. وتبدأ عملية عد الكيلومترات، واللهفة تُقرأ على الوجوه في انتظار الوصول إلى استراحة حمص، وتناول حلاوة الجبن التي تشتهر بها المدينة. وهذا يعني اجتياز منتصف المسافة باتجاه مدينة حلب، ويبقى فقط المرور بكل من مدينتي حماة وادلب، وصولاً لعاصمة الاقتصاد والطرب في البلاد.
بعد أكثر من عامين على قيام الثورة السورية، تغير شكل الطريق كثيراً، حتى على السوريين أنفسهم. وكأن زمن الوصول وكلفته تناسبا طرداً مع ارتفاع الدولار بالنسبة للعملة السورية. يتذكر السوريون جيداً أن قيمة الدولار كانت تقارب الخمسين ليرة سورية قبل الثورة، أما الآن فإن كل دولار يعادل قرابة المئة وخمسون ليرة سورية. قد يكون من الطبيعي أن يتم إسقاط هذا الارتفاع على قيمة تذكرة الركوب لترتفع من مئتي ليرة سورية إلى أكثر من سبعمئة ليرة سوريا، وقد تصل أحياناً إلى ألف ليرة سورية تبعاً لوضع الطرقات؛ لكن الذي لا يعلمه من هو خارج سوريا وقد لا يخطر له على بال، أن زمن الوصول من دمشق إلى حلب أصبح قرابة الاثني عشرة ساعة عوضاً عن الأربع ساعات.
حين يقرر الشخص السفر من دمشق إلى حلب لأي سبب كان، فإن المغامرة تبدأ من لحظة خروجه من مكان إقامته قاصداً تجمع السيارات المتجهة إلى العديد من المدن السورية، لأن “كاراجات البولمان” متوقفة عن العمل في العاصمة، حيث يبدأ الخطر عندما يوقفه أي حاجز أمني ويطلب بطاقته الشخصية، وقد يعتقله لأبسط الأسباب. فإن كان موفقاً ولم يعترضه أي حاجز، فإن الخوف يتركز عند المرور الاضطراري في منطقة العباسيين، التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ متى تكون هادئة أم مشتعلة، وإن أسعفه الحظ، يبقى ما يشغل البال هو وجود سيارة قيد الاقلاع خوفاً من أي طلقة قناص قد تصيبه، وهو في انتظار السيارة. فأمر الحجوزات للسفر والذهاب على الموعد أصبح من الماضي البعيد بالنسبة للسوريين.
تنطلق بنا السيارة المتجهة إلى حلب في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق صباحاً، وتبدأ حواجز قوات الأسد أو ما يُسمى (الجيش النظامي) بإيقافنا تباعاً. يعترضنا الحاجز الأول على مسافة كيلومترين تقريباً بعد الإقلاع ليصعد أحد الجنود حاملاً بندقيته وهو يطالبنا بإبراز بطاقاتنا الشخصية. أكثر ما يلفت الانتباه أنّ طريقة حمل الجندي لبندقيته تؤكد عدم خبرته بأي نوع من أنواع القتال وآليات الرمي. أما الشيء الآخر فهو طريقة تعامله مع البطاقات الشخصية، حيث أنّ التدقيق لا يكون على الاسم وإنما على الجهة الخلفية من البطاقة الشخصية، للتحقق من الانتماء المناطقي لكل مسافر، فإن كان الشخص ينتمي إلى منطقة غير معروفة بمعارضتها الشديدة للنظام، أو غير مغضوب عليها، فهذا يعفيه من أي سؤال أو تدقيق، أما الشخص الذي تشير بطاقته إلى انتمائه لإحدى المناطق الثائرةعلى الأسد، فهذا وحده يكفي لتبدأ عملية الاستجواب عن سبب السفر أولاً، ثمّ تتحول الأسئلة عن المنطقة التي ينتمي إليها المستجوَب والعصابات الإرهابية (كما يسميها الجندي) التي تعيث فساداً في الأرض، منتهياً بإجبار هذا المواطن على تحية القائد المفدى والجيش الباسل. فإذا لمس الجندي أي استياء من هذا المواطن المسكين، يتم اقتياده إلى المجهول، كما هو حال عشرات آلاف المواطنين السوريين. ويتكرر السيناريو ذاته مع الحواجز اللاحقة، مع اختلاف بسيط وهو الرائحة الكريهة الناتجة عن هؤلاء الجنود نتيجة إقامتهم في الجرود، وعدم توفر حتى مياه للاستحمام.
بعد الوصول إلى حمص تتغير الصورة كلياً، حيث تحوّل الحافلة مسارها انصياعاً لتعليمات الجنود والشبيحة، المتواجدين على مداخل المدينة، لتسلك خط سير آخر عبر قرىً وطرقات ترابية لا يعرفها سوى أبناء هذه القرى الذين لم يستطيعوا الخروج من قراهم والهرب إلى مكان آخر.
تسير بنا الحافلة عبر الطرقات الترابية ببطءٍ شديد بسبب وعورة الأرض وتعرجاتها، فيما أصوات القصف بمختلف أنواعه تُسمع بوضوح من كل الجهات، في هذه البقعة المجهولة بالنسبة لنا، حتى نحن السوريين.
تدخل بنا الحافلة إلى بساتين الفستق الحلبي، فيكسر صوت أحد الركاب صمتنا معلناً “وصلنا حماة”. ألقي نظرة على البساتين. لأجد العديد من الشباب المسلحين الذين ينتشرون في هذه البساتين، أدقق النظر فأرى علم الثورة مرفوعاً على أحد الحواجز، التي تومئ للسائق بمواصلة المسير من دون إيقاف الحافلة. يعود الصوت نفسه قائلاً “هاد الجيش الحر ما ضل حواجز للنظام عالطريق”. تتداخل أصوات الركاب ليعلو صوت أحدهم مخاطباً السائق: “سمّعنا صباح فخري خلينا نتنفّس يازلمى”. يصدح صوت صباح فخري ليغطي على كل الأصوات إلى أن يبقى صوته منفرداً “درب حلب ومشيتو”. تتابع السيارة طريقها، وكأن هواءً آخر بدأ يتسلل إلى صدورنا.
ندخل قرى مدينة ادلب برفقة القدود الحلبية وكأنها اشارة العبور لنا من دون التوقف على أي حاجز. تبدأ السيارة بالتمهل والوقوف أنظر إلى ساعتي. الساعة تشير إلى السابعة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت حلب.
المستقبل