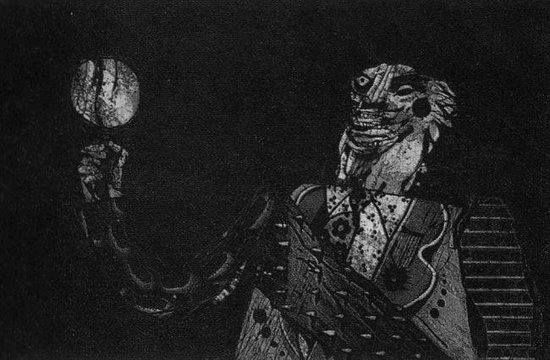العيش في الماضي والبعيد/ رستم محمود

ليلةَ رأسِ السنة الجديدة، وبينما كُنتُ أُهنِّئُ والدَيَّ عبر الواتسآب، وأسألُ عن الأحوال، أخبرني والدِي بأسىً أن نصف الشتاء قد مرَّ ولم تُمطر السماء بعد، وهو ما قد يُشكّلُ خطراً على وارد القمح، الذي قد لا ينبت قط! القمح الذي يكاد أن يكون كُلَّ شيءٍ بالنسبة للناس في الجزيرة السورية، حيث ما زال والدَيَّ يعيشان مع كثيرٍ من الأبناء والأحفاد. بعد قليلٍ سألتُ والدتي عن بعض التفاصيل، فأخبرتني أنَّ والدِي قد تكفَّلَ هذا العام بزرع باقي حصص أعمامي من أراضي جدي الزراعية، التي تقع بالضبط على الحدود السورية التُركية، وأنَّ تأخُّرَ الأمطار يؤثّرُ عليه –وعلينا- بأكثر من شكل.
مُنذ ذلك اليوم، رأيتُني أتابع النشرة الجوية على موقع Yahoo يومياً، لأرى إن كانت الأمطار ستهطل في الأيام القادمة في الجزيرة السورية أم لا، ومن ثُم أُخبِرُ والدِي بتفاصيل تلك النشرات في أحاديثنا اليومية، مثلما كُنتُ أفعلُ قبل سنوات، أيام اليفاعة حينما كان الإنترنت في أوائل عهده في البلاد، ومن قبل حينما كُنتُ أتابعُ النشرة الجوية بينما يكون والدي في المقهى.
مُنذ ذلك الوقت، وهكتاراتُ جدي الزراعية القليلة في أقصى شمال البلاد لا تغادر ذاكرتي قط، أتذكرها باعتبارها شيئاً عضوياً من يومياتي. أرضُ جدي في قرية دودان الحدودية، وكانت على شكل قطعتين، واحدةٌ سهليةٌ بالقُرب من الحدود تماماً، وأخرى تليّة، تفصلها عن الحدود تلّة دودان. كان العُرف الذي أقرته جدتي مع جدي أن تكون القطعة السهلية من حصة الأخوة الثلاث الأصغر عُمراً، ومنهم أبي، بينما تكون القطعة الأخرى لأعمامي الأكبر.
كُنتُ في السادسة من عُمري عندما سمح جدي لأول مرة لأولاده بأن يتولوا زراعة تلك الأرض. في ذلك الربيع الحزين من العام 1988، أتذكّرُ كيف كان أبي يأخذنا معه يومياً إلى الأرض الزراعية هُناك. كان أبي يهربُ من ولائمِ الندبِ الحُسينية، التي كانت تعقدها الزوجات والأخوات والأمهات والجارات في ذلك الربيع. كان الحُزن الكُردي على ناس حلبجة يفيض من كل حدبٍ في ذلك الربيع، ولم يكن من شيءٍ مثلَ سنابل القمح يواسي «الخِزي» الذي كان يحمله الرجال الكُرد الذين مثل أبي في ذلك الوقت.
كُنا نجلس، أنا وأخي الأصغر، مع كثيرٍ من أولاد العمومة، إلى جانب أبي وأعمامي وباقي رجال القرية، كُنا نتمعَّنُ في التخوم التي على الطرف الآخر من السلك الحدودي الشائك، ونتذكّرُ جدي الذي كان يُعدِّدُ لنا القُرى في شمال الخط هُناك، التي صار اسمها تُركيا فيما بعد: قصروك ومندرةِ وديرجِم ودارةِ وقورديسى… إلخ، ثُم كان يلتفتُ إلينا مُردداً بحُزنٍ مُستبطنٍ ليس من مثله شيء: «لقد أتينا من هُناك، أعرف كُل شيء عن تلك التخوم، في أية تلّة دُفن والدَيّ، وفي أي سهبٍ ما زال لنا كرومٌ من العنب». كان جدي يقول ذلك دوماً وهو يُعاين محارس الجنود الأتراك على بُعد أمتارٍ قليلة من مكان جلوسنا، لكن دلالتيّ الزمان والمكان كانتا تتراكبان دوماً في أحاديثه عن البِلاد التي قدِم منها هو وأهله قبل ثلاثة أرباع قرن. ففي أحيانٍ كثيرة، كان يقول جُمَلَهُ بصيغة الحاضر عندما يتحدثُ عن ذلك الماضي، وحينما كان يتحدث عن «هُناك»، فإنه كان يستعمل دلالات «هُنا» اللغوية. كان جدي مثل غيره من أبناء جيله الذي هُجِّروا من تلك التخوم، كان أسيرَ طفولته التي لم تغادره قط.
كان الجيل الأصغر من جدي سناً، أعمامي الأكبر والمجايلون لهم، وبينما كُنّا نرجع من القرية إلى المدينة التي لم تكن بعيدة سيراً على الأقدام، كانوا يروون لنا ذكرياتهم عن تلك القُرى، دودان وسادان وخراب كورت وهرمي شيخو، القُرى التي غدت مُجرد أطلال بالتقادم. يدلّوننا على الينابيع والسواقي التي جفّت، الملاعب والبيادر والأشجار والبيوت التي لم تعد موجودة، الأماكن التي نصبوا فيها الفخاخ للحجل، والتلال التي انتظروا عليها قدوم الحُجّاج ومُعلمي المدارس وسيارات الجمارك التي كانت «تغزو» القرى الحدودية بحثاً عن المُهرِّبين. كان أعمامي وباقي الرِجال يتجادلون فيما بينهم حول كُل تفصيل، ولساعات لا تُحصى، ثُم يتنهدون وهم يُعاينون «اللاشيء» في تلك السهوب.
فاضت الأمطار في ذلك العام، وصارَ موسماً لا يُنسى في الذاكرة الجمعية لأهل الجزيرة. كان جدي يروي لنا عن سنوات أخرى ماضية، كانت الغِلالُ فيها وفيرةً مثلما ستكون ذاك العام؛ لكنه غادر إلى السماء في شهر نيسان من العام نفسه، ولم يرَ غِلال القمح الوفيرة.
*****
في الشهور الأولى لاستقراري في مدينة أربيل، اكتشفتُ تسجيلاً قديماً لجدي، إذ كان جدي حسب تسمية الثقافة الشعبية الكُردية Dengbej، ما يُمكن ترجمته إلى العربية بـ «المُغني-الراوي». في ذلك التسجيل يروي-يُغني جدي لقُرابة ساعة حكاية «سيامند وخجة» التُراثية الكُردية التقليدية، التي تسرد حكاية الشاب الكُردي المُتمرد الشُجاع سيامند، الذي عاشَ كصعلوكٍ وقاطع طريق، إلى أن وقعَ في حُبّ ابنة أحد الآغاوات، «خجة». وقتها تتغيرُ حياته، ويغدو شخصاً آخر تماماً، إلى أن يلقى حتفه وهو يحاول تحقيق وحدة من أماني خجة الكثيرة.
في هذا التسجيل الروائي الغنائي، «الحكاية الكُردية التقليدية»، حيث تتراكب في شخصية واحدة صورة البطل والعاشق والمُتمرد، التي تنتهي عادة بأن يلقى البطل حتفه إِثرَ عددٍ من المؤامرات التي تُحاك ضده.
طوال عامين من استقراري في أربيل، أسمعُ ذلك التسجيل يومياً تقريباً، خصوصاً أثناء قيادة السيارة، حين تأخذني ألفة الشرود. أراني في أغلب الأحيان أُدندنُ مع جدي، فأنا تقريباً أحفظُ كامل التسجيل الذي يطول لأكثر من ساعة غنائية.
ليست حبكة الحكاية أو مستوى «جمالها» الغنائي ما يُثيرُني في هذا التسجيل، وهي موضوعياً عاديةٌ للغاية، بل ما يتدفق عبرها من عالمي الاجتماعي الذي كان. فطوال الثمانينات، حيث أتذكر، كان كثيرٌ من الأقارب والجيران والمعارف يجتمعون ليلاً في بيت جدي، خصوصاً في ليالي الشتاء، وفي زمنٍ لم تكن فيه وسائل الإعلام والتواصل متوفرة، لذا كان جدي يبدأ بسرد وغناء تلك الحكايات الكُردية التي تطول لساعات، وفي مرات نادرة كان يقوم أحدهم بتسجيلها عبر أجهزة التسجيل التقليدية.
من ذلك التسجيل يتدفقُ العالمُ الذي كان، شتائم عمّي حبيب التي لا تنتهي للأشرار الذين يحيكون المؤامرات ضدّ سيامند، مُطالباتُ عمّي سليم للنساء بأن يوقفنَ أطفالهنَّ عن الشغب، تنهداتُ جدتي الجالسة قُرب جدي، وآهات خالي الكبير، الذي كان يستبق المقاطع التي يعرفها بعبارات وجدانية لا إرادية. كذلك أحاولُ تخمين بعض الأصوات التي لستُ متأكداً من أصحابها، شكل الباب الخشبي الذي تُسمَعُ زقزقته بين حينٍ وآخر، بُكاءُ بعض الصِغار ولهوُ بعضهم الآخر، وطبعاً صوتي أنا بالذات حينما أطلب من عمتي أن تُضيف لي المزيد من السُكر إلى كأس الشاي، عمتي التي بقيت تُطعِمُني وتَغسلُني وتُلبِسُني بيدها طوال سنوات طفولتي.
أسمعُ ذلك الشريط مرة أو مرتين في اليوم، أغرقُ في تلك العوالم التي كانت، تفاصيل بيت جدي التُرابي الفسيح الذي كان قريباً من بيتنا، المطبخ الغريب الذي كان بداخله بئر، دالية العنب التي كانت تُغطّي كامل الفُسحة التي بين الغُرف المُتقابلة، غُرفة الضيوف الكبيرة المُطلّة على الشارع، الشبابيك الكبيرة التي كانت تطلّ على أرض الديار وعلى بيوت الجيران، السلّمُ الخشبي الوحيد الذي كانت الجارات تتداولنه صيفاً، كي يحملنَ الشراشف والأغطية والمخدات إلى أَسطُحِ البيوت، حيث كان أهل الحارة كُلهم ينامون صيفاً. بالإضافة إلى ذلك، أتذكّرُ القطط والِكلاب الشهيرة في حارتنا القديمة، أشجارها وحكاياتها، وأولاً مجانين الحارة الذين لم تكن سهرات بيت جدي تخلو منهم قط.
كان جدي يُغني-يسردُ حكاياته حسب طبيعة ضيوفِ كُلِّ ليلة، الضيوف الدائمون الذين كانوا يأتون في كُل وقت من القُرى والسهوب المُحيطة بالمدينة ويبقون لأيام حتى يقضوا حاجاتهم، فجدي كان الوحيد المُستقرّ في المدينة، لكنه كان قريباً لعشرات العشرات من ذويه القرويين. إذا كان الضيوف من المرضى مراجعي الأطباء، فإن جدي كان يُغني/يسرد حكاية Siwarê Çetelê الأليمة، إما إذا كان الضيوف من العرائس اللواتي كُنَّ يأتينَ لأيام ليشترينَ حاجاتهنَّ وزينتهنَّ قبل عُرسهنّ، تحضرُ مطولة Ferhad û Şêrîn الرومانسية، وهكذا.
في سهرات بيت جدي، كما في أكثر بيوت الجيران، كانت اللمّات المسائية هي كامل العالم الاجتماعي والثقافي والسياسي والتواصلي للبشر، لم يكن من مسافة بين الكِبار والصِغار، بين الإناث والذكور، الفقراء وميسوري الحال. ذلك العالمُ البسيطُ للغاية، كان خالياً إلا من الحدّ الأدنى من المعارف عن أحوال العالم الأبعد قليلاً من مدينتنا الصغيرة، لكنه كان مُتخماً بكُلّ أشكال الخبرة والحكمة المُجتمعية.
بالنسبة لي، ولأبناء جيلي كما أعتقد، كانت ذلك العالم الصغير والبسيط وشبه المُغلق، والحميم أولاً، كان حياتنا التأسيسية، تَشرَّبنا منه القيم والمُثُلَ والحكايات المُجتمعية، أَسَّسنا عبره ووفقاً له رؤيتنا لأنفسنا وللآخرين. ذلك العالم الذي أنهار بالتقادم طوال عقدي الثمانينات والتسعينات، حينما توسعت المدينة وتغيرت العلاقات بين ناسها، وغادرنا إلى المُدن الكُبرى، لكن أولاً حينما اُقتلِعنا من بِلادنا، ولم يعد من حقنا أن نعيش ولو بعض التفاصيل التي بقيت منه.
*****
ثمة حياةٌ كاملة على هذا المنوال، تبدأ الأشياء والأحداث اليومية، كُلّ الأشياء والأحداث، بشكلٍ طبيعي في الحاضر، ثم ما يلبثُ أن يُطبِقَ عليها الماضي، يطغى عليها ويأخذُ مكانها، طاقتها الحسّية وسلطة الشرود فيها. يتقادمُ ذلك الماضي ويتوسَّع، حتى يبدو أكبرَ وأوسعَ من الحاضر وأشدَّ حيويةً منه، يطغى حتى يكاد الحاضرُ يختفي أمامه، أو يبدو شيئاً ساذجاً ومُسطّحاً وغير ذي معنى.
صحيحٌ أن العيش في الماضي والذاكرة جزءٌ أصيل ورديفٌ للحياة الموضوعية لجميع البشر، وهذا العيش المُركَّبَ في الماضي والحاضر والمُستقبل في الآن عينه هو ما يميّزُ الآدميين عن غيرهم من الكائنات، لكن حالتي/حالتنا تبدو أكثر خصوصيةً في هذا السياق، وأكثر وحشيةً وعُنفاً على المستوى القيَميّ، وذلك لثلاثة أسبابٍ مُركبة…
فالماضي أساساً يفقد سُلطته وقوته بالتقادم البطيء، وهذا البُطء بالضبط هو ما يُقلّلُ وطأة أدواره وحضوره الدائم في الحياة اليومية. كذلك لأن الأشياء والعوالم والحوادث التي جرت إنما تختفي بشكل جزئي فحسب، يموت الجد لكن الجدة تبقى، تموت الجدة لكن العمة الكُبرى تبقى، ينهدم بيتٌ قديمٌ لكن بيوتاً أخرى قديمة تبقى، وهكذا. لكن «ماضينا» لم يَسِر في ذلك الدرب الطبيعي، لم يتلاشَ ببطء، بل انقطعَ وانتهى دفعةً واحدة، ذُبِحَ ولم يُمت بسبب التقدم بالعُمر.
كذلك لأنه من طبائع البشر القبول والتواطؤ مع الأحداث والمُجريات، ما أن يموت أحد الأحبة أو الأقارب، حتى يبدأ الآخرون باستبطان وقبول هذا الحدث بكُل ما فيه من ألم ومأساة، لكنه في المُحصلة قد حصل. لكن عوالمنا وناسنا وأشيائنا لا ينطبقُ عليها هذا المنطق، فهي ما تزال موجودة وحاضرة وحيوية، وإن في مكانٍ لا نستطيع أن نصله ونتفاعل معه. فنحنُ لا نستطيع أن نَحيك ذلك التواطؤ التقليدي والطبيعي الذي يفعله الآخرون مع ماضيهم الموضوعي، لأنه ببساطة لم يغدُ ماضياً وبعيداً بعد، ما زال وعينا مُصرّاً على حقيقةٍ موضوعيةٍ تقول إن هذا الذي نحنُ مقطوعون عنه ليس ماضياً، لأنه ببساطة لم يستوفِ شرطه الموضوعي بالانتهاء.
أخيراً، يبدو الماضي والبعيدُ خفيفَ الوطأة، لأننا نتمكن من صناعة حواضر وحيواتٍ بديلة، نحقّقُ فيه ذواتنا ونمارس أدوارنا ورغباتنا، نحسّه عالمنا وشرطنا الذي يعوِّضُ ما فقدناه من عوالم ماضية وبعيدة كانت. هذا بالضبط ما لا نستطيع توفيره، فالماضي والبعيدُ شديد القسوة علينا، بالضبط لأنه الشيء الوحيد الذي كان، لأنه لا حاضرَ حقيقياً ومعوِّضاً ومكافئاً لما صار ماضياً وبعيداً.
*****
قبل كِتابة هذه المادة بأيام قليلة، كُنتُ قد لاحظتُ بعض البُقع البُنيّة الغامقة على أماكن مُختلفة من يَدَيّ. راجعتُ طبيب الجلدية المُختصّ وأنا خائفٌ من الأمر. هدَّأَ الطبيبُ مخاوفي، وابتسمَ قائلاً: «هذهِ البُقع ليست شيئاً خطيراً، إنها علامات ونتائج الشيخوخة المبكرة فحسب!!».
بالضبط، هي شيخوخة مُبكرة، فحسب.
موقع الجمهورية