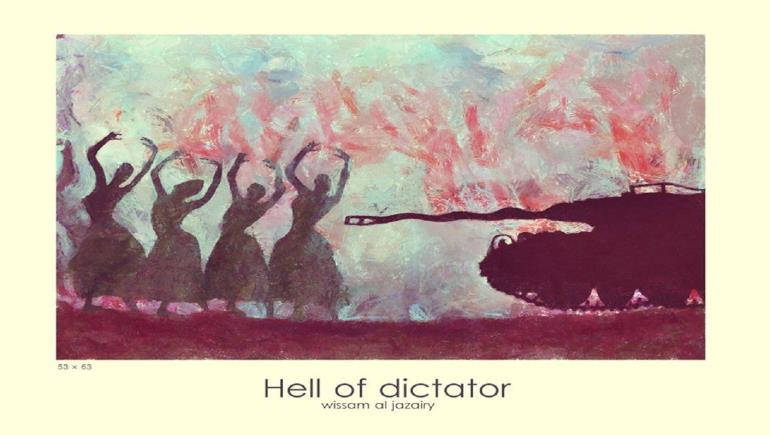الفوتوغرافي السوري نَصوح زغلولة: الاحتفاء بالصمت

مناهل السهوي
في إحدى حارات “الدويلعة” الواقعة في ضواحي دمشق يستقبلنا الفوتوغرافي نصوح زغلولة بيدين ملوثتين بالطين، فقد حوّل إحدى زوايا سطح منزله إلى حديقة صغيرة بالإضافة إلى وجود طيور يعمل على تربيتها تاركاً مساحة أخرى لنِجَارة الخشب صانعاً طاولات وكراسي بذاكرةٍ تخصّ يديه، ليحول الحياة إلى مادة بسيطة كما صوره مستخلصاً السعادة والسلام منها، سنتجول على هذا السطح لندرك لاحقاً أن للسطوح حكاياتها في هذه المدينة.
درس الفوتوغرافيّ السوريّ دبلوم اتصالات فوتوغرافية من المدرسة الوطنية العليا للفنون الزخرفية في باريس، وعمل مصوّراً فوتوغرافياً لأكثر من عشرين فيلماً وثائقياً في فرنسا، كما درس التصوير الضوئي في المعهد العالمي للصوت والصورة – باريس، ويشغل حالياً منصب عميد كلية الفنون في الجامعة العربية الدولية، كان لضفة ثالثة اللقاء التالي معه:
صوّرها وسماها دمشق:
كما البدايات الساحرة، حين نتتبع الضوء في صغرنا لنصل إلى عالمنا الخاص، هكذا تبع نصوح زغلولة الظلال والضوء في أزقة دمشق القديمة. ابن الخامسة الذي كان يمشي ممسكاً أيدي خالاته تأمل بعمق خطواته المتجهة نحو الضوء، فظلّت الظلال تحفر عميقاً داخله إلى أن حان وقتها بعد أكثر من أربعين عاماً، فصورها وسماها دمشق.
ليست دمشق فقط البيوت القديمة والأزقة الضيقة بل أكثر من ذلك ورغم تتبعه ذلك الضوء طوال حياته إلّا أنه لم يتجرأ على تصويره إلا متأخراً، يقول: “كنتُ أرى الضوء جيداً لكني كنتُ خائفاً من تصويره، يجب أن نكون حذرين للغاية عند تصوير دمشق، إنّها طفولتي”.
قبل الحرب كان لهذا الفوتوغرافي المتفرّد موعدٌ أسبوعيّ كل يوم جمعة، من السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ففي هذا التوقيت تكون دمشق فارغة، ما يتيح له وقتاً نموذجياً للتصوير إلى أن تبدأ صلاة الظهر، يقول: “في ذلك الوقت كنت أشعر أن دمشق لي وحدي، أستطيع ان أتجول فيها كما أريد دون أن يزعجني أحد”، ورغم أن تصويره دمشق بدأ منذ أكثر من ثلاثين عاماً إلا أنّه لم يشعر أن هذه هي المدينة التي يبحث عنها، يتابع: “دمشق أبسط وأعمق بكثير، هي العودة للماضي، لطفولتي، للرائحة، هنالك صور نشمّ فيها الرائحة، عندما نمرّ تحت قوس في الشام القديمة نشعر أن الهواء المحبوس داخله له رائحة مختلفة تماماً عمّا حوله، رائحة دمشق ليست فقط الياسمين، لا أعتبر الياسمين رمزاً لها، بالنسبة لي الوردة الشامية أي الورد الجوري أهم بكثير، الياسمين دخيل بطريقةٍ ما”.
تنطوي أعمال نصوح زغلولة بالأبيض والأسود على بعد غرافيكي، وتكوينات نمرُّ أمامها غالباً، دون أن ننتبه لحضورها، فقط نحتاج أن نفتح عيوننا لنلاحظها، يتابع: “لستُ مستعجلاً على شيء، أصور دمشق منذ خمسين عاماً ولا أعلم كم بقي لي، ما أحتاجه فقط أن يسمحوا لي بالتصوير، فأنا أصور حالياً فقط بكاميرا الموبايل”.
تقدم أعماله الضوء كروح ولغة تخصّ المدن القديمة، وملموسات نستغني عنها بتكوينات الضوء على ما يحيط بنا، ظلُّ الضوء الذي ينساب على أجسادنا ومنازلنا له لغة من الارتجاف، ومن هنا يؤثث مصورنا لقطاته المتتابعة، من ذات النقطة، لكن في أوقات وفصول مختلفة، يقول في ذلك: “لدي الكثير من الصور المكرّرة، لأنني أعبر ذات الشارع، ولكن ليس في ذات الظروف الضوئية”. يظهر فهم نصوح للمكان كحيز متغير فهو ليس ذاته وهو عنصر مختلف قابل لإدهاشنا إن فهمنا حساسية الضوء عليه.
هذا التبسيط الذي عمل عليه، كان بحاجة لجرأة كبيرة لتقديمه والذي حصل عندما غدت المادة الغرافيكية حاضرة والأصدقاء المقربون موجودون للنقاش كالفنان يوسف عبد لكي الذي وصف عمل مصورنا بقوله: “الصورة هنا تتجاوز الثرثرة، توضيح الموضوع، لا تخصّ الصورة دمشق وحدها، بل تصبح رصداً للصفاء الذي يحل على المدينة، تصبح احتفاءً بالصمت”.
كان لصداقة الفنانين القوية الأثر في تجربة مصورنا، يقول: “يوسف عبد لكي يتابع كلّ أعمالي منذ خمسة وثلاثين عاماً كما أتابع أنا أعماله، وقد أثر يوسف بي من ناحية الجدية، بالنسبة ليوسف الفن شيء جدي للغاية، تعلمتُ منه ألا أبقى على سطح اللوحة بل أن أغوص عميقاً فيها، فالشام ليست مجرد شكل جميل وأناس وياسمين”.
عمل نصوح على تخريب الرؤية التقليدية لدمشق ليأتي التخريب بمعناه الإيجابي إعادة هيكلة وشطب للنمطية السائدة، فترك بيوتها وحاراتها ومآذنها واتجه نحو ظلالها صانعاً كتلة بصرية مغايرة يتكئ فيها على الظل والنور جاعلاً منهما عاملي تأثير في وحدة المكان ليقع الأخير تحت سطوة الظل تارة وتارة أخرى تحت سطوة النور، لدينا في مجموعة احتفاء بالصمت -2007 استرجاع لصور متقطعة من الطفولة إن أمكن تسميتها بذلك ولعب مع الحنين إلى المكان الذي يبتلعنا ليجعل منا جزءاً منه.
كاميرا وسط كرتونة:
على سطح منزله في حي الدويلعة، وسط كرتونة ثلاجة مموهة بالسجاد وبعض المخلفات استقر المصور نصوح زغلولة ليصور سطوح المدينة من ثقب يغير مكانه بين يوم وآخر خلال ثلاثة أشهر. أربع وستون ساعة من التصوير استخلص منها تسع وعشرين دقيقة، كان هذا المشروع بديلاً عن منع التصوير خلال السنوات الماضية، فاختار تحركات الناس على الأسطح، أطفال يلعبون أو يدرسون، كشّاش الحمام أو كما يصطلح عليه هنا “الحميماتي”، نساء ينشرن الغسيل، حمام لا يصيبه الذعر من صوت القصف، كلبته تتمدد بملل، وعمال البناء يكملون عملهم، كلّ ذلك وسط كادر دائم من القصف والدخان والحرب، ليسمي فيلمه القصير الوحيد “يوم سوري عادي”.
هكذا وجد طريقته السريّة، بعد منع التصوير في شوارع دمشق من جهة، ولتقديم الحرب بقالبه الخاص من جهة أخرى، فيلم مبني على بساطة من تلك النوعية التي تضرب عميقاً، لا دماء، لا أشلاء ولا نحيب، إلّا أنه يذكرك كم أن الحرب حاضرة وذات سطوة لكن بطريقة مستقرّة للغاية، أو أنها تبدو كذلك، محاولاً بقدر المستطاع ألّا يكون هنالك أي استعراض، أن يقدم الحياة كما هي بالضبط، “نحن نستطيع أن نتكلم عن الحرب دون أي نقطة دم، نستطيع أن نقدم لوحة عن الحرب دون وجود اللون الأحمر”، ينهي قوله:” العنف البصري الذي عشناه في الفترة الماضية شيء مؤلم، تاجر بعضهم كثيراً بالناحية البصرية، هي حريتهم في النهاية لكن هذا الأمر يزعجني”
قذيفة في منزلي:
لم يكن سقوط قذيفة في منزل نصوح والتقاطه بعض الصور للدمار الذي خلفته نوعاً من التوثيق على حسب قوله، يستذكر ذهاب زوجته للغرفة قبل سقوط القذيفة ببضع ثوان وعودتها إلى الغرفة المجاورة لتسقط القذيفة بعد خروجها مباشرة، “هنالك ثانية فصلتها عن الموت”، يتابع: “كان هناك غضب كبير في تلك الحادثة ولم يكن لها علاقة أبداً بالفن”، وعندما نشر صور القذيفة على صفحته الشخصية كتب عليها أنها بدون حقوق نشر ويستطيع كلّ الناس استخدامها وقد فعل ذلك كما قال موجهاً رسالة لبعضهم مِمَن يأخذون صورهم من الإنترنت ويبنون عليها لوحات وأعمالاً فنية، يعقّب: “ليس لدي القدرة على ذلك، أن أختلس صورة من الإنترنت وقد يكون من صورها قد مات، لا أستطيع أن أبني عليها أيّ فكرة”.
ومن هنا يجد أن هنالك نوعين من الفنانين خلال الحرب، أولهم من بقي يعمل على ذات الخط الذي عمل عليه سابقاً، وهناك من بدأ بالعمل على الحرب “أصبحت حرباً بالنسبة لي، ولم تعد ثورة” يعقب، هؤلاء بالنسبة له بدأوا بتقديم مقترحات بصرية، لكنها لا تخلو من انتهازيّة في مكان ما، ينهي قوله: “بالنتيجة هناك شيء فني قطعاً، لكن لم أشعر بالإخلاص بل بنوع من الاستعراض”.
وفي حديثنا عن وضع المصورين اليوم في ظل الحرب السورية، يقول: “وضع المصورين داخل مناطق النظام سيئ جداً فأنا مثلاً لم أستطع أن أحمل كاميرا منذ أكثر من ست سنوات، والنتاج الذي نراه اليوم هو لأشخاص في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، هؤلاء الذين ذهب منهم ضحايا وشهداء فعلاً، فقدموا فوتوغرافيا خارقة للعادة، أمثال محمد بدرا، تيم السيوفي”. برأيه فقد قدم أمثال هؤلاء أعمالاً مخيفة وبقوا في تلك المناطق الملتهبة للحظة الأخيرة، بالمقابل يجد أن هناك أناساً كان لديهم مجموعة من الصور في السنة الأولى وما زالوا يبيعون ويتاجرون فيها حتى اليوم، يقول: “هناك أناس يشتغلون ويوثقون بشكل يومي، هناك كمٌّ هائل من العنف في صورهم لكني أستطيع فهمه فهو نتيجة ما يعيشونه في الداخل، ونحن بالطبع لا نستطيع رؤيته”.
حرب بصورٍ مهتزّة:
صور الحرب هي وثائق للمستقبل، في الصورة شيء فلسفي كما يقول، فما أن نضغط على زر الكاميرة حتى تغدو الصورة جزءاً من الماضي ولا يحق لنا مسحها، يقول: “بغض النظر أن جزءاً لا بأس به ينطوي على رؤية فنية” أما على صعيد الفيديو والأفلام لا يفهم نصوح سبب اهتزاز مقاطع الفيديو في المناطق المحاصرة، فهو لم يجد أي فيديو ذي معنى، يتابع: “كل ما شاهدته كان يهتز ولا أعلم سبب ذلك؟ كأنما غدت موضة خاصة بالحرب فيجب على الصورة أن تهتزّ يميناً ويساراً، على صعيد الفيديو لم أرَ شيئاً مهنيّاً أبداً، أمّا في التصوير الضوئي فهناك الكثير مِمن عملوا وقدموا نتائج مهمة”، أغلب هؤلاء المصورين كانوا هواة وأجبرتهم الحرب على حمل الكاميرا لكنهم في النهاية قدموا شيئاً مهنيّاً كما يقول. هذه الصور انتشرت ووصلت عالمياً، لكن مع كمٍّ من العنف الذي كان لا بد منه في فترة من الفترات لكنها لم تؤثر بشكل كبير، فهي حركت الشوارع لكنها لم تحرك الحكومات.
ننهي حوارنا مع مصورنا في جولة على سطح منزله، تتبعنا كلبته، نتنقل بين أقفاص الطيور وطاولة خشب صنعها بنفسه، يعرّفنا على الياسمينة التي زرعها مع ولادة ابنه فصار عمرهما ثلاث سنوات، نراقب المدينة مرة أخرى من على السطح، لكن هذه المرة مع مشهدية أقل قسوة، لا طيران ولا قذائف ولا قصف قريب.
ضفة ثالثة