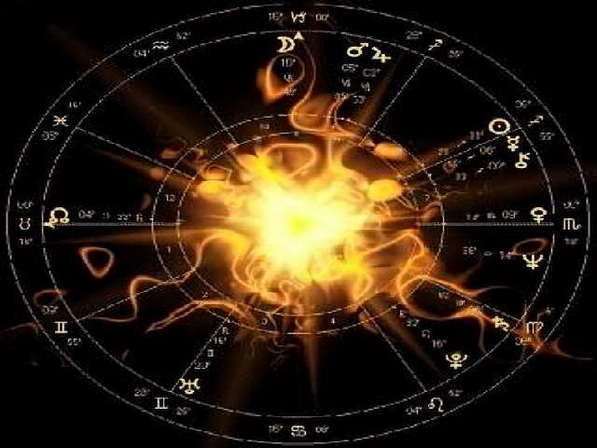القاتل قتيلاً، القتيل قاتلاً؟
فاروق يوسف
في مكان ما، إن اجتمعا سيقول القتيل للقاتل: “لمَ قتلتني؟”. ولأنه يملك حق الرد هناك فإن القاتل ربما سيسأل قتيله: “لمَ دفعتني إلى قتلك؟”. يعرف الإثنان أن تبادل الادوار بينهما كان في لحظة سابقة ممكنا. اي أن يكون القاتل قتيلاً ويكون القتيل قاتلاً. اما الان وقد التصقت كل صفة بحاملها، فإن العودة إلى الماضي لم تعد ممكنة. هذا لا يعني أن المرء قبل أن يكون قاتلاً، قد خرج من بيته ليمارس القتل. كذلك الحال بالنسبة الى الشخص قبل أن يكون قتيلاً وأصبح كذلك في ما بعد، الذي لم يخطط حين الخروج من البيت لكي يكون ميتاً بصفة قتيل.
هل حدث الأمر بالمصادفة؟
شيء من هذا القبيل يحدث في المدن السورية اليوم. قبلها طبعاً حدث الشيء نفسه في الكثير من مدن العالم، ما يجعل تلك العلاقة تطفو على السطح باعتبارها مؤشراً لتغير يضرب بعنفه جوهر الصفات الإنسانية في لحظة ذروة غير مقصودة لذاتها. في حالة من هذا النوع لا يمكننا أن نصف مشهد القتل قبل وقوعه. فما من تخطيط مسبق له. فلا القاتل خطّط لأن يصبح قاتلاً ولا القتيل حضر إلى البقعة التي سيسقط عليها سقطته الأخيرة لكي يمثّل دور القتيل. كما لو أن هناك قوة ثالثة. يداً خفية تضع الاثنين في الحلبة، في حالة مواجهة مصيرية من غير أن تكون هناك أسباب مسبقة لتوتر العلاقة الشخصية بينهما. لا حوار متشنجاً ولا صخب ولا تقاطع مصالح ولا توتر نفسياً ولا حتى معرفة مسبقة، بل كان من الممكن أن لا يكون هناك طرفان ولا تكون هناك مجابهة. غير أن ضربة إصبع على الطاولة، وقوع رأس عصا على الطبل، فرقعة أصبعين في كفّ ثابتة تخلخلُ الهواء ويتحوّل صدى تلك الفرقعة المدوّي إلى ذريعة للاشتباك والاشتباه والريبة، ومن ثم الخوف.
إلى القيامة
في الحروب الأهلية، حروب السلطة على الناس وحروب الناس على السلطة وحروب الناس على الناس، غالباً ما يقل الاهتمام بالاحتراف، ويكون القتلة غير المتوقعين من الهواة المجانيين. ليس المقصود هنا هواية القتل بل بما يؤدي إلى نقيض الاحتراف من معان. وهذا ما يفضي بالقاتل إلى أن يسبق القتيل إلى الخوف. يكون القاتل خائفاً لانه يعرف أنه يقدم على القيام بفعل غير مسبوق، بسببه ستلتصق به صفة سوداء ترافقه إلى القيامة. في الوقت نفسه يكون القتيل مطمئناً، ذلك لأنه لا يعرف أنه سيحمل بعد لحظات صفة بيضاء سترافقه هو الآخر إلى القيامة.
الإنسانية كلها تقع في لحظة الخطر تلك. النقائض كلها. الايمان والكفر، الجمال والقبح، الكرامة والضعة. وهي اللحظة التي يمكنها لو مرّت حاملة أثقالها المزرية، أن تشكل بداية الانهيار، حيث يتشظى جسد القتيل، وفي المقابل تتشظى روح القاتل. وبالقوة نفسها التي يصبح فيها القتيل قتيلاً إلى الأبد، فإن القاتل هو الآخر يصبح قاتلاً الى الأبد. ما من إمكان للعودة إلى ما قبل تلك الواقعة من صفات. هنا بالضبط ينتقل القتل من الهواية إلى الحرفة. سيسمّي القتيل قاتله: “هو”. لأنه لا يعرفه ولم تتح له فرصة مخاطبته، وهو لا يدري أن القاتل يطلق عليه ضمير الشخص الثالث المنفصل نفسه “هو”. ما من “أنت” ولا “أنا”. ستختفي الضمائر الشخصية، فما من شيء شخصي. “مَن يخاطب مَن؟”. يصمت القتيل لأن الموتى لا يحتاجون إلى اللغة للتعبير عن مشاعرهم، أما القاتل فإن صمته يؤكد عزلة وظيفته عن كل لغة، في إمكانها أن تسعى إلى التمييز بين الخطأ والصواب، بين الحق والباطل، بين السرور والألم. “سوري يقتل سورياً”، يقال الآن. من قبل قيل “لبناني يقتل لبنانياً”، من بعدها قيل “عراقي يقتل عراقياً”. وما من أحد يرغب في قياس المسافة الحرجة التي بسببها صار القتل ممكناً. كما لو أن القتل صار مهنة، يشير البعض إلى شركات المرتزقة، الاميركية والاوروبية، باعتبارها شركات أعمال، يتسابق كثيرون من أجل عرض خدماتهم عليها والتوظيف فيها. كان للفرنسيين سبقهم في هذا المجال، في ما شهدته القارة الافريقية من مجازر تخطّت حدود القصور والحقول الرئاسية إلى الغابات وصحارى القبائل المتنازعة. بعد الفرنسيين التحق الاميركيون بالدسيسة المبيتة، وكانت شركة “بلاك ووتر” واحدة من أعظم مآثرهم في هذا المجال، حيث كان لتلك الشركة في العراق أهوال مفزعة. غير أن تنظيم “القاعدة”، وقد اُختبر اميركياً منذ الحرب الافغانية الأولى، قد طرح مفهوماً آخر لهذه المهنة: القاتل الذي هو قتيل في الوقت نفسه. الانتحار بالنفس وبالآخرين: “لنذهب معاً إلى الآخرة أيها الاعزاء”.
معادلات الحزام الناسف
مع هذا التحول الاستعراضي الذي ازدهر انطلاقاً من أوهام عقائدية، انمحى السؤال القديم. لن يقول القتيل للقاتل، اللذان هما الشخص نفسه: “لِمَ قتلتني؟”. الاثنان يتشظيان جسدياً وروحياً في اللحظة ذاتها، ومعها تتشظى أجساد طاهرة وأرواح بريئة. دخول الحزام الناسف سلاحاً لا يمكن الوقاية منه، غيّر الكثير من المعادلات. صار المرء يذهب إلى القتل مسلحاً بعدة عقائدية، لا تتضمن تسويات دنيوية البتة. ذلك لأن الذهاب إلى عالم غير متاح، سيكون ميسّراً من خلال نسف إمكان العيش في عالم متاح. وهذا ما لا يفعله القتلة التقليديون الذين صاروا يحيطون بنا من كل جانب. بعد كل هذه الحروب الأهلية التي عشنا أهوالها، انتقلنا إلى مرحلة الاعتراف بالعالم المتاح، كونه هبة من أولئك القتلة. هل علينا أن نسمّيهم قتلة سابقين؟ القتل لا يسقط بالتقادم، لذلك فما من قاتل سيكون في إمكانه أن ينزع عنه الصفة التي سترافقه إلى القيامة. غير أن الواقع يقول شيئاً آخر. القتلة صاروا، بقوة ما ارتكبوه من جرائم، قادة، زعماء أحزاب، ممثلي طوائف ومشرعين. هم الآن ومنذ زمن بعيد فكرة مجسدة عن القتل تمشي على قدمين. صرنا نرى القتلة من خلال شاشات التلفزيون باعتبارهم أبطالاً افذاذاً. ما من أحد يفكر في أن يوجه إلى واحد من أولئك القتلة أسئلة من نوع: “لِمَ قتلت؟ أو كيف ومتى أصبحت قاتلا؟”.
ترى لِمَ لا نشعر بالتناقض بين شعورنا بالعار بسبب القتل وبين حماستنا للتصفيق للقتلة واحتضانهم باعتبارهم منقذين. كل حرب أهلية لا تنتج إلا قتلة. كما قلت فإن ماضي القتل ليس ماضياً، شبحه لا يقيم في منطقة زمنية بعينها، لذلك من غير المسموح لنا بأن نقول إن ذلك الزعيم كان قاتلاً في الماضي، ونسكت مطمئنين إلى المستقبل. من قال إن القاتل (السابق!) لن يكون قاتلاً في كل لحظة؟ من أين يصدر ذلك الاطمئنان؟ كل الطغاة الذين أكسبوا الجزء الأكبر من أعمارنا طابعاً حزيناً، كانوا قد قتلوا رفاق مسيرتهم، قبل أن يتحوّلوا ماكينة شمولية للقتل لا تفرّق بين أحد وآخر إلا وفق معنى ضيق وغامض للولاء. أعتقد أننا، وأقصد عرب الشرق، قد تماهينا كثيراً مع ثقافة القتل. أتذكر من ثمانينات القرن الماضي مشاهد حفلات الاعدام التي كانت تقام في مختلف الأماكن من العراق (المدن، القرى، جبهات القتال) للشباب المجندين الذين لم تكن لديهم رغبة في الدخول إلى مطحنة الحرب. كان هناك بشر من مختلف الاعمار، نساء ورجالاً واطفالاً وشباباً، يقفون في حلقات في انتظار موت الآخرين الضعفاء الذي يحضر من طريق القتل. كل هذه القسوة، وهناك من لا يزال يتغنّى بعواء العاطفة.
صرنا وحوشاً
هل علينا أن نصدّق أن للقتيل حصة في صنع مشهد القتل الذي كان ضحيته؟ “بصدور عارية يواجه المدنيون الثوار رصاص السلطة”. حتى هذه الجملة الدعائية، وهي جملة أدبية فيها الكثير من المجاز، لا تبرر القتل ولا تفسره ولا تمضي به إلى مستقر قانوني. في حالة من هذا النوع، فإن الجريمة لا تشمل القتيل بل والقاتل أيضاً، كونها انتقلت به (القاتل) من انسانية، كان من الممكن أن تكون محل نقاش إلى حيوانية نزعت عنه القدرة على أن يستعيد ثقته بامتلاكه شروط وجوده البشري. كان مشهد القذافي الهلع وهو يهدد المتمردين على سلطته وحشياً، غير أن مشهد مقتله قد أكد أن ثقافة الوحوش هي التي انتصرت أخيراً، ولا مجال هنا للحديث عن الحرية والديموقراطية والسعي لبناء مجتمعات متماسكة يسودها العدل. لقد صار القتلة يملأون شاشات التلفزيون. ثقافة القتل صارت ميزاناً بحيث صار لدينا معيار يميز قتلاً عن قتل آخر. لولا ما رأيناه، لكنت قد تحدثت عن علاقة متوقعة بين قاتل وقتيل مجهولَي الهوية. لربما التقى الإثنان في أوقات سابقة في الباص أو السوبر ماركت أو ملعب كرة القدم أو الحديقة العامة. ولربما كان القاتل مهذباً وسمح للقتيل بأن يتقدمه إلى شبّاك التذاكر في سينما الحي الوحيدة أو في محطة القطار. ربما شاهدا الفيلم نفسه وأطلقا ضحكات متشابهة. لكن سلوك الوحش وقد فلت من القفص، لا يسمح بأيّ خيال إنساني. لقد صرنا وحوشاً.
النهار