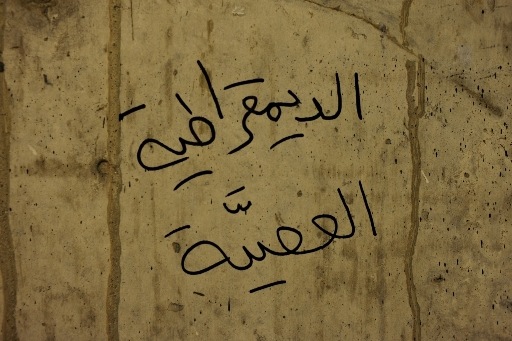المؤسسات الدينية ومسؤولية نزع الشرعية عن العنف باسم الدين/ خالد غزال

السؤال شديد الإلحاح اليوم، حول دور المؤسسات الدينية، الرسمية وغير الرسمية، في ظل الإنفجار الحاصل في الإسلام، الذي يعبّر عن نفسه بصعود التيارات الأصولية، وبإشهار النص الديني سيفاً، وظيفته القتل والذبح والرجم والتفجير باسم الدين، وفي ظل استخراج الآيات القرآنية التي تبيح لـ”داعش” وأخواته، أياً كان اسمها، تشريع العنف.
لا يمكن إنكار أن هذه المؤسسات، وتحت هول العنف الممارس بشكل وحشي، أعطت وتعطي أجوبة تقع حتى الآن في حدود الكلام الذي مفاده أن الدين الإسلامي يرفض هذه الممارسات، التي لا صلة لها به وبجوهر تعاليمه الأخلاقية والإنسانية، وهي أجوبة يبدو أنها تأتي من قبيل رفع العتب. فالنقاش لا يدور حول جوهر الدين الإنساني، بل على نصوص يجري التعاطي معها على أنها مقدسة، ولا تزال تكتسب موقعها ضمن الذي تراه المؤسسات الدينية أنه نزل لكل زمان ومكان، وفيه الأجوبة الشافية عن كل شيء.
تداري المؤسسات الدينية النقاش في الآيات التي تدعو الى العنف، وترفض إعطاء فتاوى رسمية تنكر على هذه الآيات شرعيتها للزمن الراهن، أو تضعها في سياق نزولها التاريخي وأسبابه. هذا السكوت هو تشريع فعلي لممارسات التيارات “الداعشية” في الصراع الدائر. تبدو مسؤولية المؤسسات الدينية الإسلامية ضخمة جداً في التصدي لاستخدام النص المقدس لتبرير العنف، وهي مسؤولية تتطلب جرأة في تجاوز المحرمات الموضوعة حتى الآن على قراءة هذا النص وتحريره من التفسيرات الشكلية والحسم في ما هو صالح فيه لكل زمان ومكان، وما بات خارج التاريخ. هنا ميدان المعركة، لا التصريحات الخجولة والشكلية التي تقول إن الإسلام يقف ضد الممارسات العنفية الجارية. في هذا السياق، يمكن قراءة الموقع الذي احتلته المؤسسات الدينية في تاريخ الأديان التوحيدية والمجتمعات على السواء.
من الوظيفة الدينية الى السلطة
لعبت المؤسسات الدينية أدوارًا مقررة في مسار الأديان التوحيدية على الأخص، بحيث تنوعت هذه الأدوار فطاولت الديني والسياسي والإجتماعي والثقافي. على رغم أنّ بعض الأديان لا ينص على وجود مؤسسة دينية أو كهنوت يمثل الواسطة بين الله والإنسان، كالإسلام مثلاً، إلاّ أنّ هذا الدين تحوّل على غرار المسيحية واليهودية، ليحوي من المؤسسات ما يفوق سائر الأديان، من حيث موقعها ودورها وحجم رجال الدين المنتمين اليها، والسلطات التي باتت تمتلكها.
الميزة الأولى للمؤسسة الدينية، في الأديان التوحيدية، أنها احتكرت السماء، ومعها تفسير النص الديني. من أجل معرفة مضمون الكتب المقدسة، على المرء الاستناد إلى ما تقوله المؤسسة الدينية، في منشوراتها وشروحها. لا يقع الإعتراض هنا على هذا الدور البديهي للمؤسسة تجاه المنتمين إلى الطائفة أو المذهب، لكن الإعتراض التاريخي كان على الإحتكار ومنع الإجتهاد في قراءة النصوص الدينية. لقد دفع فقهاء وعلماء ومجتهدون أثماناً غالية من حياتهم لقاء تفسيرات للنص الديني لم تكن متلائمة مع ما تريده المؤسسة الدينية. يقدم تاريخ الكنيسة المسيحية تراثاً من الاضطهاد والملاحقة لمفكّرين تمردوا على تفسير النص الديني كما تقول به الكنيسة، وهو اضطهاد بدأ من الحرمان ليصل إلى القتل. لم يكن الإسلام أقل رحمة بالمجتهدين في قراءة النص الديني أو لجوئهم إلى التفسير العقلاني والتاريخي، بل أنّ الكثير من الاجتهادات لا تزال تقع في باب “المستحيل التفكير فيه” وفق تعبير لمحمد أركون.
الميزة الثانية التي أعطتها المؤسسة الدينية لنفسها، تقوم على تبيان الفروق الحادة بين الدين الذي تنتمي إليه وبين سائر الأديان. وهو تمييز يقوم على إعطاء الأفضلية لدينها، ورمي سائر الاديان الأخرى بالضلال والكفر أحياناً. إنه، في الغالب، دور تفرقة وتعميق الخلافات اللاهوتية، يشحن نفوس المنتسبين إلى الدين، بفكرة الكره والعداء، وليس بالدعوة إلى التآخي وتعيين ما يمكن الإتفاق عليه أو ما لا يمكن ذلك. لم يحل الإنقسام بين الاديان من انتشار فتاوى التمييز، بل على العكس، ادى الى مزيد من نشر فكر الكراهية بين أبناء الدين الواحد، ونقل هذه الكراهية الى سائر الطوائف والمذاهب. تنشأ كل طائفة أو مذهب بعد الإنشقاق عن المؤسسة الأم. فاذا كانت كتب التاريخ تشير إلى أنّ كل دين من الأديان التوحيدية قد انقسم 72 فرقة، فلنا أن نتخيل وجود أعداد مماثلة لمؤسسات دينية، حيث ترفض كل طائفة أن تنضوي تحت لواء طائفة أخرى في ممارسة أدوارها المتنوعة والمتعددة.
من موقع احتكار تفسير النص، أعطت المؤسسة الدينية نفسها حق الحكم على الإيمان أو عدم الإيمان. على رغم أنّ مسألة الإيمان بالله وبتعاليم الدين هي قضية داخلية وخاصة بالإنسان في العلاقة مع ربه، إلاّ أنّ المؤسسات الدينية شكّلت “محاكم تفتيش” تعطي بموجبها الفتاوى والأحكام في ما إذا كان هذا المرء مؤمناً أم كافرًا، استنادًا إلى آرائه واجتهاداته حول النصوص الدينية وممارسة طقوس الأديان. لم يقتصر الأمر على محاكمة الرأي او الإجتهاد الخاص بالنص المقدس، بل الأسوأ أنّ المؤسسة الدينية باتت تعتبر كل انتقاد لها ككل، أو لرجل الدين فيها، بمثابة مسّ بالذات الإلهية، بما يستوجب العقاب، أسوةً بارتكاب خطيئة نقد النص. يحفل تاريخ المسيحية والإسلام بممارسات معيبة ومخجلة تجاه الدين نفسه وكرامة الإنسان التي تنتهكها سلطة هي بشرية في الأصل، لكنها أسبغت على نفسها زورًا سلطة الحكم الإلهي.
تحوّل الدين على يد مؤسساته ورجاله إلى شكليات وطقوس خارجية، وانتشرت الفتاوى بشكل رهيب حول هذه الشكليات، وكلها أمور متصلة بالحياة الدنيوية وبتصرفات المرء، بحيث بدت احيانا كثيرة فولكلوراً لا علاقة له بجوهر الدين من قريب أو بعيد. تقدم وسائل الإعلام والفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي فيضاً هائلاً من “تعاليم” رجال الدين حول كل أمر، مهما كان صغيرًا أم كبيرًا، وفتاوى تنسب إلى الدين، بما يجعل مَن يخالفها في موقع المرتد أو الكافر.
لم تتوقف المؤسسة الدينية عن الطموح إلى الإستيلاء على السلطة تحت إسم “الحكم الإلهي”، واعتبار السلطة منحة إلهية أعطيت لرجالها. شهدت المسيحية حكم البابوات الذين استمدوا سلطتهم من الله، وخاضت المؤسسة وبابواتها صراعات دموية للتمسك بالسلطة، وهو صراع تسبب في الحروب الدينية والمذهبية التي حصدت مئات الألوف من المسيحيين في أوروبا، قبل أن تتوصل المجتمعات الأوروبية إلى فصل الدين عن الدولة وممارسة كل طرف لمهامه من موقعه الخاص.
في العالم الإسلامي، لا تزال أسطورة الدولة الدينية والخلافة تدغدغ أذهان المؤسسات الدينية الطامحة إلى هذه الخلافة. لم تعرف هذه المجتمعات في يوم من الأيام هذه الدولة الدينية المزعومة، ولم تكن الخلافة يوماً، دولة دينية، بل كانت على الدوام دولة سياسية توظف الدين والمؤسسة الدينية في خدمة هذه السلطة وتسبغ المشروعية الإلهية على قراراتها السياسية وعلى سلطتها بالذات. فكما عرفت المسيحية الحاكم الذي يستمد سلطته ومشروعيته من الله، كذلك عرف العالم الإسلامي هذه المنظومة الفكرية، وظل الحكام خارج المحاسبة الشعبية، لأن سلطتهم مستمدة من الله وليس من الشعب. في القرن الحادي والعشرين، لا تزال دول تدّعي الحكم باسم الإسلام ترى في مرشدها الأعلى (إيران) حاكماً لا مجال لمحاسبته من سلطات وضعية، لأنّ سلطته مكتسبة من الله، والله وحده يحاسبه. تطمح الحركات الأصولية والتيارات الإسلامية الصاعدة إلى خلافة أو دولة دينية يكون الحاكم فيها ممثلاً لله على الأرض، ومعصوماً من الخطأ، بالنظر إلى كونه يحمل شيئاً من الألوهية.
عززت المؤسسة الدينية في الأديان التوحيدية مركز رجال الدين في المجتمع، وتحوّلت هذه المؤسسات إلى سلطات موازية لسلطة الدولة، من خلال الأحكام المتزايدة المعطاة لرجل الدين في التحكم بالشؤون الخاصة للإنسان الذي ينتمي الى هذا الدين. تمثل قوانين الأحوال الشخصية إحدى المعضلات الكبرى التي بموجبها تعطى السلطة الاجتماعية والدينية لرجل الدين للتحكم بمسار المجتمع. لقد قامت علاقة غير مقدسة بين المؤسسات الدينية والسلطة السياسية في العالم العربي، بحيث كانت هذه السلطة تبيح للمؤسسة الدينية نشر ثقافتها وأفكارها وقوانينها على المجتمع، مقابل أن تسبغ المؤسسة الدينية الشرعية الدينية على ممارسات السلطة السياسية. ترتب على هذه الممارسة والعلاقة نشوء “طبقة” من رجال الدين في كل الأديان التوحيدية، تتمتع بامتيازات خاصة، مستخدمةً موقعها الديني لتكريس مصالح خاصة. زاد من حدة الأمر، توسع هذه الفئة بحيث تحولت إلى كيان قائم بذاته، مما يجعل كل إصلاح ديني مدار صدام مع هذه “الطبقة”، لأنّ أي إصلاح سيكون على حساب الدور غير الديني الذي تمارسه هذه المؤسسات الدينية. هذه الممارسة عرفتها المجتمعات الأوروبية في العلاقة بين الكنيسة والدولة، من دون إنكار واقع الصراع بين المؤسستين الهادفة كل منهما إلى إزاحة الأخرى للهيمنة على السياسة والإجتماع. لم يكن الصراع في المجتمعات العربية والاسلامية كبيرًا بين المؤسستين، لأن طبيعة المؤسسة السياسية المهيمنة وطابع السلطة الإستبدادية منذ العصور الأولى للإسلام، جعلا المؤسسة الدينية الإسلامية في موقع التابع للمؤسسة السياسية. وإذا ما حصلت بعض التباينات أحياناً، فسرعان ما كانت تزول لصالح المؤسسة السياسية.
المؤسسة الدينية والإصلاح الديني: الممكن والمستحيل
تحتل قضية الإصلاح الديني في المجتمعات العربية موقعاً مركزياً في تقدم هذه المجتمعات وتطورها الراهن والمستقبلي. فالثقافة السائدة يحكمها العقل الديني، ليس بجوهره ووجهه الإنساني والروحي والأخلاقي، بل بطقوسه وشكلياته وبتوظيفاته في الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية، بحيث سيطرت هذه الشكليات الدينية على الموقع الحقيقي للدين. تمارس المؤسسات الدينية دورًا لا يساعد حتى الآن في تجاوز الطقوس والشكليات من أجل تقديم الدين على حقيقته. فهل يمكن هذه المؤسسات أن تشكل عنصرًا في الإصلاح الديني؟ سؤال أساسي ومؤرق في الآن نفسه. لم يكن للإصلاح الديني في أوروبا أن ينجح لو لم يحصل الإنشقاق في المؤسسة الدينية نفسها منذ البداية. وإذا كانت عملية الإصلاح قد اختلط فيها السياسي بالديني في أوروبا، فإنّ ذلك لم يمنع من اضطرار الكنيسة على امتداد القرون اللاحقة للإستجابة إلى عمليات إصلاح متتالية، كان آخرها وأهمها ما صدر عن المجمع المسكوني 1962-1965 الذي شكل نقلة نوعية في نظرة الكنيسة إلى موقعها ودورها، وإلى علاقتها بالسياسة وبالأديان الأخرى.
في العالم العربي والإسلامي في العصر الحديث، جرت محاولة إصلاحية دينية كانت نقطة الانطلاق فيها المؤسسة الدينية نفسها من خلال قيادة مفتي مصر لها الشيخ محمد عبده، وانضمام لفيف من العلماء المسلمين إلى أطروحاته المتنورة في منظور ذلك الزمن (أواخر القرن التاسع عشر)، وهي مرحلة امتدت إلى النصف الأول من القرن العشرين على يد ممثلين لها من أمثال الشيخ علي عبد الرازق والشيخ مصطفى عبد الرازق ولطفي السيد وطه حسين وغيرهم. لكن هذه المحاولة أجهضت ولم تستطع أن تكمل مسيرتها على غرار عملية الإصلاح الديني في اوروبا. لم تتوافر القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية القادرة على حمل العملية الاصلاحية وترسيخها في وجه المؤسسات الدينية التقليدية، على غرار ما شهدته العملية الإصلاحية الأوروبية، كما لم تكن المجتمعات العربية والإسلامية مهيأة لتقبّل الأفكار الجديدة، وسط هيمنة الثقافة التقليدية السائدة وهيمنة رجال الدين على المفاهيم والأفكار والعادات التي تلقي بثقلها على العقل العربي. لذا كان الإجهاض نصيب الإصلاحات الدينية لمحمد عبده ورفاقه، على رغم أنّ هذه الإصلاحات لم تكن في مستوى الإصلاحات التي طرحها مارتن لوثر وزملاؤه من قادة الإصلاح.
في ظل فوضى الفتاوى والآراء التي يطلقها رجال الدين، كلٌّ وفق ما يناسبه من النص الديني، يصبح من الضروري وجود مؤسسة تنحصر فيها الاجتهادات، بما يمنع التسيّب والحد من الخرافات الواردة على ألسنة “المجتهدين”، الذين في غالبيتهم لا يفقهون من أمور الدين سوى القشور. يمكن مثل هذا الإجراء أن يحصر النقاش مع المؤسسة الدينية وحدها ويساجلها في فتاويها واجتهاداتها بعيدًا من رجال دين مجبولين بالتعصب والكراهية للأديان أو الطوائف الأخرى، وللرأي المخالف لهم.
من جانب آخر، يستحيل أن يتحقق الإصلاح الديني من دون أن تفرز المؤسسات الدينية نفسها، رجال دين وفقهاء متنورين ومطلعين وعارفين بما يحتاجه الدين ليتوافق مع العصر ويخرج من قمقم المفاهيم البالية التي تقادم الزمن عليها ولم تعد تصلح لعصرنا الراهن. هذا الشرط ضروري جدًا، من دونه يصعب الصراع مع المؤسسة الدينية من الموقع الذي تقيم فيه، حيث ليس أسهل على رجال هذه المؤسسة من رمي دعاة الاصلاح من غير رجال الدين بالكفر والهرطقة والإرتداد، فيما لن يكون الأمر على هذا النحو إذا ما تصدى بعض رجال الدين من حملة فكر الإصلاح إلى تلك الفتاوى والإجتهادات التي لا صلة لها بالزمن والعصر. لن تكون هذه المعركة منفصلة عن معركة التصدي لمنع توظيف الدين في الصراعات السياسية، أو عن لجوء المؤسسة الدينية إلى الاستعانة بالسلطة السياسية لمنع أي نقد أو اصلاح في فكرها وممارساتها.
النهار