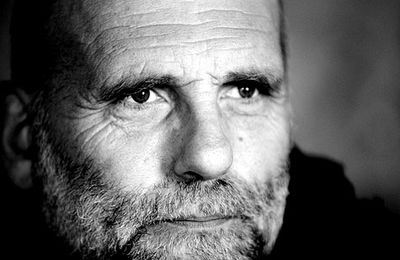المثقفون العرب والعاصمة المصرية: ظروف قاهرة!/ هشام أصلان

هل أصبحت القاهرة حقًا طاردة للثقافة والفكر والحرية؟ هل باتت أضيق من أن تحتمل الاختلاف؟ هل لا تزال متأثرة بمرّات حظر التجوال التي فرضتها الظروف السياسية والسلطوية بعد ثورة يناير التي نحبها ونحب من يحبها؟ تلك أسئلة شغلتني، وتسبب تأملها في التأخر كثيرًا على إنجاز هذا الموضوع صحافيًا. بصراحة، لا أريد تلقيًا قاسيًا لمدينتي. ولكن حسنٌ. دعنا نفصل بين قاهرة الشوارع والمقاهي والبشر والإنتاج الأدبي والثقافي، وبين قاهرة السلطة. الجمال والإنتاج لا يتوقف، ولكن للأسف، هذه جولة انتصار سُلطة مُصرّة على الوجود في خلفية كل المجريات. ربما غيمة ستمُر.
مدينة الليل والمبدعين
كانت الفكرة محاولة لقراءة تطور العلاقة بين مدينة الليل والمبدعين غير المصريين. ولكن أصابتها قلة المصادر المُستعدة للبوح. قلق يحوم. ولم لا؟ إذا كان المثقف المصري بات يتوخى الحذر في الكلام، فما بالك بمثقف صدّق بالكاد أنه وجد مكانًا عربيًا للعيش. فقط للعيش، وربما بعض الكتابة الهادئة. الكتابة الأجرأ من اللازم قد تسجنك بتهمة خدش الحياء، أو تكدير السلم العام. من هنا، توارت أسماء مصرية كانت بالأمس ملء السمع والبصر. بقدرة قادر استطاع المسؤول أن يضع يده فيحول بين كاتب “البيست سيللر” وقرائه. بين إعلامي محبوب ومشاهديه.
في البداية كانت هناك خطوط عريضة للاتفاق أو عدمه. مقولات واحدة مفهومة والخلافات على أرضيات تستحق الجدل. الجميع يكره إسرائيل. المثقف يساري الهوى وإن لم يُنظّم. اليمين لا يلائمنا. وهكذا. اليوم غير. والجميع له ما يبرر وجهة نظره. أعرف كاتبتين سوريتين، إحداهما تكره بشار والأخرى تناصره. الأولى قتل النظام أمها، والثانية قتلت المعارضة أخاها. الاثنتان لديهما وجهة نظر. الحياة أصبحت مُعقدة.
“القاهرة باتّساعها وتنوّع ثقافاتها المتجذرة في تاريخ المكان، صورة ذهنية متخيلة، مثالية، يحملها القادم إليها ليشتبك مع واقع مرتبك وعصي على الفهم”. عبارة الشاعر الفلسطيني، الشاب، يوسف القدرة، وجدتها مُكثِّفة لما أحاول الإلمام به في سطرين، حول تطور شكل العلاقة بين المبدعين العرب وهذه المدينة، بعد ما آل إليه الواقع العربي، الثقافي والسياسي، من تغيير معطوف على أحداث كبرى كان لأجيالنا، المتقاربة، نصيب من رؤيتها، أو بالأحرى المشاركة في صنعها، بغض النظر عن نتائجها، علاقتهم بمدينة القاهرة، التي هي في الحقيقة عدة مُدن.
القاهرة، من العواصم ذات الزخم الثقافي. كان سهلًا أن تجد المبدعين العرب الذين يحيون فيها منخرطين داخل الجماعة الثقافية المصرية. كانت المدينة العربية الوحيدة، ولا تزال، التي يتحدث أغلبية من فيها باللغة العربية، بوصف محمود درويش عندما جاء للمرة الأولى، حيث عمل محررًا ثقافيًا في جريدة الأهرام، برفقة كتاب مصريين. الأهرام الذي ولدت على أيادٍ ليست مصرية!
دخول سلس
القاهرة التي اعتبرت فؤاد حداد، بأصوله غير المصرية، والد شعراء العامية المصرية، ووضعت بديعة مصابني، اللبنانية التركية، أمًّا لنجمات الرقص المصري. هل لا تزال رحبة إلى هذه الدرجة؟ حاولت الدردشة مع عدد من المبدعين العرب الذين يعيشون هنا، برغبتهم أو باضطرار. لم أستطع الوصول لكثير منهم بسهولة، وكأنه شيء يحول دون دخولهم بانسيابية إلى قلب الجماعة الثقافية المصرية، وأماكنها التي وصلت شهرة بعضها إلى كل مثقفي العالم العربي.
“رغم أن خروجي من سورية كان اضطراريًا وقسريًا إلا أن وجودي في القاهرة لم يكن كذلك أبدًا، أتيت إلى القاهرة وأقمت فيها بكامل خياري، ورغم أن الإقامة في أية دولة أوروبية متاحة لي دائمًا، إلا أنني أفضل البقاء هنا، حيث أشعر أنني بين أهلي وفي مجتمع لا يختلف عن مجتمعي، وفي بيئة تناسبني”، تقول الشاعرة السورية رشا عمران، أكثر الأدباء السوريين المقيمين في القاهرة قربًا من الجماعة الثقافية.
رشا تُحب القاهرة، “لا أشعر أنني طارئة أو غريبة، ولا يشعرني أحد أنني سورية”، رغم هذا، ليس طبيعيًا أن تنجو من أشواك الخلافات الأيديولوجية التي أصابت الجميع، وإن لم يكلفها ذلك كثيراً من الأصدقاء: “قلة فقط ممن كنت أعول عليهم هنا كأصدقاء، وأتكلم طبعا عن مثقفين معروفين، اختفوا فجأة من حياتي، لم أفهم السبب بداية، استطعت الانتباه إلى أن الأمر متعلق بالانحيازات السياسية التي حصلت في مصر بين المثقفين بعد 30 يونيو، أنا موقفي من النظام السوري كنظام عسكري أمني مافياوي ومجرم لم يتغير منذ أول طلقة أطلقها في وجه السوريين في بداية الثورة السورية، بعض الأصدقاء هنا صاروا يطالبونني بموقف مضاد، أو على الأقل صرنا نختلف في الرأي بهذا الخصوص، على اعتبار أنهم يرون أن كل من يقف ضد النظام السوري هو إسلامي أو إخواني، وهي نفس الثنائية التي يتعاملون فيها بالشأن المصري، هذه الثنائية طالما رفضتها أنا وطالبت برؤية أكثر اتساعاً، على الأقل بما يخص بلدي سورية والوضع فيها، علاقتي بالمؤسسات الثقافية الرسمية هنا لا تختلف كثيراً عما كانت علاقتي بها في سورية، بالنسبة إلى هذه المؤسسات، فأنا غير موجودة ليس لأنني سورية في مصر، بل لنفس السبب الذي يجعل الكثير من أصدقائي الشعراء المصريين غير موجودين أيضا، اختلاف الرؤية إلى الشعر ومكانه ومكانته، خارج هذه المؤسسات أنا موجودة، لم أشعر بالإقصاء أبداً، في ما يخص الصحافة لم يطلب مني أحد كتابة مقال في أي صحيفة مصرية. أستطيع فهم السبب طبعا ولا يزعجني الأمر أبدًا”.
حساسية الأجيال الجديدة
تُعد وضعية رشا عمران مميزة إلى حد ما، ربما كان انتماؤها لجيل أدبي قد تحقق بشكل ما قبل الأحداث العربية المعروفة، وهذا ساعدها في إيجاد نفسها وسط مثقفين مصريين عرفوها، أو على الأقل قرأوها، قبل أن تقيم في القاهرة، ما ساهم في انسيابية دخولها إلى الدائرة المعقولة داخل الجماعة الثقافية، وسهولة الانسجام معها. هناك مبدعون بدأوا العمل بالكتابة والشأن الثقافي والصحافي، بعدما عاشوا هنا فترة، هؤلاء لا يزالون يتحسسون حدود الدائرة بقليل من الأصدقاء والمعارف بحذر.
عرفت الكاتب والصحافي السوري، المقيم في القاهرة، سامر مختار عبر قراءات متبادلة، حيث تزاملنا في الكتابة لأحد المواقع العربية، غير أنني لا أراه في مثلث وسط المدينة، والذي يعيش داخله المثقفون المصريون، إلا قليلا، وفي الغالب مع أشخاص لا أعرفهم.
لسامر أربعة أعوام في القاهرة، ولا يزال يعتبر حياته اليومية في هذه المدينة أشبه بحالة صراع داخلي وخارجي، والأسباب، في رأيه، واضحة جداً؛ “كاتب سوري مقيم في مصر، يهمّه يومياً أن يتابع ما يجري في سورية، ومن ناحية أخرى كاتب وصحافي مهتم بالشأن الأدبي والثقافي في العالم العربي على وجه الخصوص. داخلياً هناك دائماً ضغط نفسي وغضب مكبوت إزاء ما أراه وما أسمعه من أخبار عن قصف ودمار ومجازر ترتكب بحق أهلنا هناك من قبل نظام الأسد وحلفائه، ولا يمكنني لا على الصعيد الشخصي ولا على المستوى الأخلاقي، أن أتقبل كاتباً ومثقفاً يساند مجرم حرب كبشار الأسد، وبالطبع هذا الموقف ينطبق على علاقتي بمثقفين مصريين وغير مصريين موالين لأنظمة وحكّام مستبدين”. نتيجة هذه الأجواء تشكَّلت علاقة لا هي بالقريبة ولا بالبعيدة أو “القطيعة” المطلقة، بينه وبين المشهد الثقافي المصري اليوم، “لا أرى الحراك الثقافي المصري من زاوية نظر واحدة. تربطني علاقة طيبة وبعضها تحوَّلت إلى صداقات متينة مع بعض الكتّاب والمثقفين المصريين. لكن المشهد العام مخيب للآمال حقاً، فعدا أن الوسط الثقافي المصري غارق بمشاكله وحروبه الشخصية، فترى اليوم مثقفين بلا مواقف، وبعيدين كل البعد عما يجري حولهم في مصر والعالم، مثال على ذلك؛ قلة هم المثقفون المصريون الذين لديهم موقف سياسي وجذري مما يحدث في سورية، فما إن تلتقي بالبعض في مناسبة ما، أو ندوة ثقافية، أو في المقهى، حتى يسألني البعض (من باب الخجل) ما الأخبار في سورية؟!”، هنا يضطر سامر أن يتكلم عما يجري في سورية منذ انطلاق ثورتها، وما حدث وما يحدث خلال السنوات الست الماضية، غير أن عزاءه هو “أن هناك كتّاباً و مثقفين – ولو كانوا قلة – إلى جانب صحافيين وناشطين حقوقيين مصريين متابعين لما يحدث في سورية بنفس المستوى الذي يتابعون به ما يحدث في مصر، وأنا على تواصل دائم معهم، وأتابع ما يكتبونه عن مصر وسورية”.
مسألة مصالح
بينما يتعارك الجميع مع الجميع، حرفيًا، حيث المتفقون في ما بينهم اليوم مختلفون غدًا، حول ما يجري داخل سياق متهتك، بالأحرى اللا سياق، لا يرى الشاعر الفلسطيني يوسف القدرة أن المسألة مسألة انتماءات إلى توجّهات ثقافية، “وإنما الموجود انتماءات إلى المصالح التي يمكن جنيها من الثقافة، لذلك تغيّرت مواقف بعض المثقفين من بعض الثوابت مع تغيّر مصالحها.
الذين نجوا من هذه الفخاخ لم يكن لهم ارتباطات قائمة على المصالح. هذا السيل ما زال في بداية طريقه، القادم سيكون مكشوفاً وفاضحاً أكثر مما نتخيل. ولنا أن نعوّل على الأقلية التي بقيت على إيمانها الراسخ ولم تنجرف في متاهات لا علاقة للثوابت بها”.
يوسف ليس من المتورطين تمامًا داخل الحياة الثقافية المصرية. المفارقة بين الصورة الذهنية لاتساع المدينة وتنوع ثقافاتها، وبين واقعها العصي على الفهم “يضعك في هامشك الصغير كضيف مقيم، فتخلق مجتمعاً صغيراً من الأصدقاء والحياة اليومية التي تتلاءم مع تطلعاتك”.
لا تزال القاهرة قادرة على إثبات ما في مخيلة المثقف العربي كمدينة “غنيّة بفعالياتها الثقافية، التي تستقطب إليها جمهورها”، لكن الشاعر الفلسطيني الشاب يتساءل: “ما هو المشروع الثقافي، وما هي ملامحه، وهل لكل هذه الفعاليات علاقة به؟”، غير أنه لم يجد بعد إجابة في الأفق؛ لذلك “تذهب كفرد إلى مشروعك الفردي، وتنتمي إليه أولاً، وتتابع ما يمكن أن يضيف لهذا المشروع الفردي إن كان على المستوى الأكاديمي أو الأدبي”. ذلك الملاذ الذي يلجأ إليه يوسف القدرة، في تصوري، هو بالضبط ما يجب على المبدع العربي أن يحافظ عليه، في ظل عدم الطموح في مؤسسة رسمية تظلل مشروعًا ثقافيًا محترمًا، وسط سياق رسمي عربي يعيش مرحلة عصية على التعامل معها بمنطق، أي منطق. الإنتاج الفردي ملاذ أخير فعلًا، للحؤول دون الجنون.
التغيرات لم تؤثر على أثرها الثقافي
الزخم لا يزال ملاصقًا للقاهرة في خيال المثقف العربي، لم تزل عندها قدرتها، في رأي البعض، على تقديم المبدع للمتلقي بشكل أفضل. هكذا استطاع الشاعر والصحافي السوري عبد السلام الشبلي أن يطبع ثلاث مجموعات شعرية، إذ “الطباعة فيها، عكس بلدان أخرى، تحتاج لأوراق وموافقات أمنية كثيرة”!
“القاهرة كمدينة ثقافية في خيال المبدع العربي لم تعد كما كانت سابقًا تغيرت كثيرا”، يقول عبد السلام. هذه التغيرات ربما “تقرأ إيجابًا، بظهور عشرات دور النشر، وقد تقرأ سلبًا، بدخول آلاف الأسماء لهذا العالم الصعب والشائك، عالم الإبداع الأدبي، الذي يحتاج لانتقائية صارت اليوم صعبة جداً”.
غير أن المهم في القاهرة، في رأيه، “أنها ما زالت مقصد عشرات الأدباء العرب، الذين تركوا بلادهم بسبب الحروب والأزمات”، ما يرسخ وصفها القديم، “إنه اللي بده ينشر ويصير اسمه يسمّع الناس لازم يبدأ، أو يمر بالقاهرة” .
هذا لا يمنع أن المثقف العربي، في تصور الشاعر السوري الشاب، صار عنده قلق دائم بأن هذه المدينة ترفضه، نتيجة التغيرات السياسية الحاصلة، والتي لا تثبُت على منحى، “الأمر اللّي بيخلّي المبدع في حيرة دائمًا، يستقر فيها أم يهرب من أجوائها المتقلبة. بعتقد أنها كقاهرة، بظل هذه الأحداث، تحمل اسمها فعلًا، لأنها تجبرك على اتخاذ مواقف قد تستعجل في اتخاذها، حيث تحكمك ظروف هذه المدينة القاهرة فعلًا”.
ضفة ثالثة