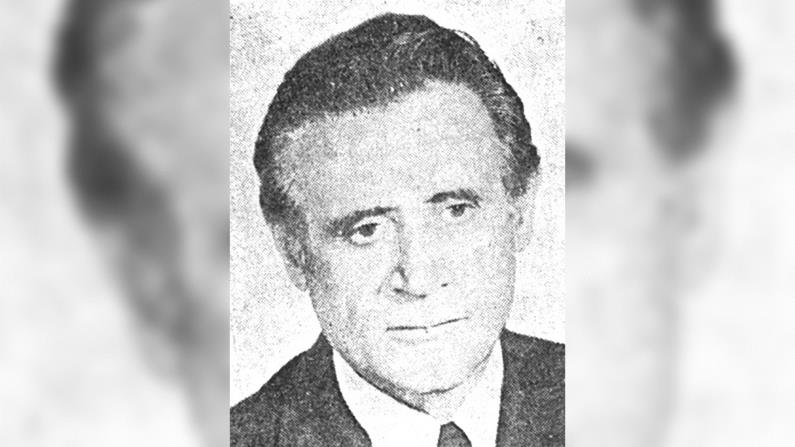النصّ الأصعب والرأي المستحيل
غادا فؤاد السمّان
لم يسبق أن خذلتني الحروف، ولا عصاني قلم، ولعلها أولى المرات التي أعرف معها فداحة ما يعنيه تدهور التركيز، هي ليست الشيخوخة كما يمكن أن أزعم، وإن كانت.. فلا يمكن أن تنتصر بين ليلةٍ وضحاها على مرونتي في تطويع الفكرة وتحويلها إلى لغةٍ حيّة غالباً ما تنتفض على وقع دبيبها السطور، هي الصورة المنقوصة إذاً، والخبر المتعاقب، والأزمة المراوغة، والسياسية الشيطانية، والتصعيد الإعلامي، بكل ما يوازيه من النفي المتواصل.
هي التأجيج، والشحن، والتعبئة، والحضّ، والتفعيل، والـتأثير، والتراكم، والتفريغ في آن معاً..
هي أنا، وأنت، وهم، وهنّ، وأولاء، وأولئك، والذين، وكيف، ومتى، ولمَ، ولعلّ، ولكن، وإن، ولا تحسبنّ….
هي سورية.. الوطن، الكيان، الذاكرة، المستجدّ، الحدث، الاحتمال، الطارئ، التوتر، الصوت، الإرادة، الرصد، المتابعة، التظاهر، الاعتقالات والدم..
من أين تبدأ الحكاية؟ وهل من وقتٍ لسردها؟ أم أنه من الأفضل أن نمعن في لفلفتها كما العادة إكراماً للمواجهة المؤجّلة مع المشروع الصهيوني، والحسم المستحيل.
لا أحد ينكر أنّ الشعب السوري، شعبٌ مسالم آمن بالله، والوطن، والبعث، والصمود، وبمن تولاه من قيادات حكيمة وعتيدة ومهيمنة، إيماناً مزمناً طوعاً ربّما، وقسراً بالتأكيد، لأربعة عقود ويزيد تمكّن منها من تمكّن بالقضاء على الإقطاعية المتجذّرة، والبرجوازية الراسخة، والرأسمالية الأصيلة وعلى كافّة أشكال الحلم، وعلى جميع أعراض التفاؤل، إلى أن استعادت البعثيّة الانقلابيّة، المشهد السابق ولكن بحضاريّة أقلّ، فالبرجوازيات السابقة كانت الارستقراطية وجهها الآخر بكل ما ينطوي عليه من ملامح خلاقة من إبداع ورقي وتسام وقيم ومبادئ وأسس وقواعد وأصول وتقاليد وعائلات وموروث وخصوصيّة اجتماعية تكاد تضاهي قصور النبلاء، ناهيك عن تطلعات تمّ محوها بالكامل وسحقها بالتفصيل باسم التأميم والتصحيح والاستصلاح، وصولا إلى ‘المتبرجزين ‘الجُدُدْ، والمنتفعين على امتداد ضفاف السلطة المترامية على كافّة مفاصل ومسام وعظم الكيان السوري ليس أرضاً وصلاحيات وثروات وقرارات وحسب بل شعباً بجميع أطيافه ورؤاه، وبتوحيد المصالح والأطماع والانتهازية المشتركة، وقد أفسحوا المجال واسعاً لتعزيز الصراع الطبقي بفارق بسيط هو تبديل المواقع لا أكثر، حيثُ صعدت الطبقة التحتية بكامل سلبياتها وتخلّفها وإشكالياتها المُستعصية من نقص ودونية وغلّ وتناقض، لتنقضّ على الطبقة الاجتماعية المترفة ‘الدمشقيّة ‘ تحديداً محور تمركز السلطة ومن معها، دمشق العاصمة بكل ما لها من هالاتٍ وما عليها من أنظار تستقطب القاصي والداني، بعدما رسمت لوحة أنيقة لأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ صدّرت حضارتها السامية إلى الغرب، وحافظت على تألقها وتميّزها حتى يومنا هذا في بلاد الأندلس، لتخبو في دمشق، وتصير المدينة العتيقة آيلة للتآكل بفعل قرار تلو الآخر من قرارات الهدم بتخريبٍ فادح للقماش الديموغرافي، فمن المتعارف عليه في جميع دول العالم، أن تعمد الحكومات على مساندة المناطق القديمة وتهتم بإصلاحها ومساعدة سكانها بكل المنح الممكنة، وفي حال رغبت الدولة في وضع اليد على عقار قديم فإنّ سعره يصل أضعافاً مضاعفة نظير العقار الجديد لإرضاء شاغل المكان سواء كان المالك أو المُستأجر القديم المهم في الأمر كله رضاه التام وموافقته واقتناعه، إلا في دمشق فقد استولت الحكومة على الكثير الكثير من العقارات التي تمتد على جغرافية واسعة من مناطق دمشقية قديمة، وتمّ إخراج أهلها المتأصلين لعقود تصل لنصف قرن وأكثر، بمهلةٍ زمنيةٍ لا تتجاوز الأسابيع أحيانا وإخراجهم على وجه السرعة لمساكن بمواصفات معدمة وبمساحة لا تعادل عشر مساحة العقار الأساسي وبسعر المتر البدائي أي بالعودة إلى تاريخ إشغال العقار القديم قبل 50 أو 60 سنة، يوم كان العقار لا يتجاوز سعره الليرات في حين ارتفع سعره إلى ملايين في أيامنا هذه، ومع ذلك الزيادة من نصيب الدولة فقط، ليجد المالك نفسه في خبر كان.. وبمنأى عن بيئته ومناخه ومجتمعه ومدينته ودنياه التي غالباً لم يكن قد غادرها في يوم من الأيام لقناعته التامّة أنه يسكن أجمل المدن والعواصم والابتعاد عن حيّه لحيّ آخر هي الغربة بعينها، وخير وسيلة للتعبير عن الاستياء والسخط البالغ قبل أن تعرف الناس التظاهر والشوارع، كانت إمّا جلطة دماغية مفاجئة، أو زيادة سكر الدم الذي يوصل إلى تفحّم في الأطراف وحتمية ‘البتر ‘ كما حصل لعمّي شقيق والدي شخصيا، يوم أقدم السيد الوليد بن طلال على شراء أرض ‘4 season’ بقيمة مليار دولار ليتسلّم أصحاب البيوت مساكن لا تشبه المساكن في مناطق نائية أشبه بالمنفى في ضاحية ملحقة بضاحية ‘قدسيا’ شبه عقار بقيمة نصف مليون ليرة سورية لا غير يحتاج إلى إكساء بقيمة أكبر يتمّ تسديدها من نفقة المالك الجديد.
هكذا هي حسبة العدل عقار مملوك لصاحبه منذ ثلاثة أرباع القرن يساوي أكثر من 30 مليونا مع محل تجاري بقيمة مماثلة يعقد صفقة بنصف مليون فقط ليست نقداً بل مجموعة أعمدة ارتفعت على تلّة شاهقة بمنطقة لم يهتد إليها حتى قطّاع الطرق بعد، مما أوصله إلى المشفى محمولاً على الأكتاف ليخرج منها على كرسي متحرك بدون ساقين أتاح له متسعا من البكاء وفقدان البصر في فترة وجيزة لارتفاع السكر وضغط الدم، وعندما طالبتُ ابنة عمي بالتقارير الطبية لإثارة الموضوع إعلامياً، أجابتني: لا نستطيع …. ثمّ بحمد الله شبعنا من والدي على مدار ثلاث سنوات من المعاناة بينما كثيرون من الجوار سلّموا الأمانة عند عتباتهم قبل أن تصادر بيوتهم ومحالّهم التجارية، وكان قبل بيت عمي بيت جدي الذي فقده لصالح وزارة الإدارة المحلية حالياً، وقبله بيت خالي الكبير الذي يحوي 17 غرفة في منطقة ‘ساروجه ‘ ليصير 3 غرف ومنتفعاتهم في منطقة الأكراد، وبيت خالي الثاني في حارة الورد الذي أخرج منه لضرورة فتح طريق عام، بمليون واحد فقط، ليصير محميّا باسم التراث بقيمة 30 مليونا وأكثر، ولو قررت سرد المناطق وتشريد أصحابها لما انتهيت فاكتفيتُ هنا بالمقربين فقط ولستُ بصدد سرد حكايات من الهند أو سري لانكا هي حكايات تحتوي على سرديات لا تنتهي ولكن لا يتسع المقام، ودائما الدولة على حقّ، والمواطن قربان من قرابين الدولة، هكذا أزيح سكان دمشق ليحلموا عند أطرافها بعشوائيّة هنا أو عشوائيّة هناك وهم بأحوال مزرية لا يمتّون إلى أيام عزّهم بأيّ ملمح، في الوقت الذي صار كل الوافدين الجُدد إلى دمشق والذين دخلوها بعقيدة وحذاء ممزّق، بأحسن حال ومآل ومسكن يباهون بامتلاك عقارات بأسعار هستيريّة تصل إلى 50 و60 مليونا، وقياساً لدخلهم السنوي، تحتاج إلى مئات من السنين الضوئية للحصول على واحد منها، إلا أنه في دمشق وفي السلطة كلّ شيء جائز وما أكثر المعجزات لدى البعض، وما أكثر العجز لدى الكثيرين.
هكذا صار الناس أقرب للأرض بعدما تهدّلت بالإحباط المستمرّ جباههم، ونكّست الهموم رؤوسهم، وأثقلت الأحزان مناكبهم، وابتلعت الغصّات ألسنتهم، وقضت أطماع الغير على طموحاتهم، لهذا صار الناس يشعرون أن الإعياء قد طال كرامتهم، افترسها الخرس، ونهشها الخوف، ودفنها الذلّ، والناس في سورية لا تحبّذ الحديث في السياسة ليس لقلّة الدراية بل لقلّة الحيلة، وليس لضيق الفكر بل لضيق الأفق، وحده الاختناق كان الناطق الرسمي دون صوت، كان يتسلل إلى مسامع وجداني ويؤرقني مع كل زيارة لدمشق على تأخيرها المتعمّد، إلى أن كانت زياتي في الصيف الماضي وهالني ما صارت إليه أحوال الناس، اعتباراً من معنوياتهم المنهارة، وصولا إلى أحوالهم المتردية التي كادت أن توصلهم لأن يفترسوا بعضهم بعضاً، وتلك هي آفة الدمشقيين فهم يقدرون الغير ويكدرون أنفسهم، نقيض الوافدين الذين ما ان يصل أحدهم العاصمة ويضع قدمه بأول فرصة حتى يستقطب أخيه وابن عمه وجاره وصديقة وما تبقى من سطر النمل، بخلاف الدمشقي الذي ما إن يضع قدمه بأول فرصة حتى يقطع نفس أقرب المقربين إليه لو فكّر بتحيّته مثلاً.
لم تفرغ المدينة بالكامل لكنها فرغت من معانيها جملة وتفصيلاً، فرغت من رونقها، من بهجتها، من ألقها، حميميتها، عراقتها، وصارت للجميع إلا لأهلها، ولم يفقد الناس سبيلهم إلى جغرافيّتهم الخاصّة، بل فقدوا سبيلهم إلى الطموح، وتحقيق الذات، ومصادر الرزق، ولم يبق إلا الشكوى التي لا تسمعها فقط بل تحسّها كيفما وجّهت وجهك، ولم يكن أمامي سوى أن أكتب، ومع كل سطر كنت أرسخ إدانتي لقلمي في ذمّة قارىء مغرض يعرف من أين تؤكل الكتف، ويعلم كيف يهزّ كتفي ظنّاً منه أنه يزعزعها، هكذا كان لقائي مع وزير الإعلام الذي صار ماضيا الآن، وكما قال أحدهم كانت حكومة مجرمة سنلاحقها، وهذه طامة أكبر، حين نصبر على ما بُلينا سنواتٍ وسنوات وإذا بصبرنا يكون على مجرم كالحكومة السابقة، أو على نائب كنائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام الذي تخرّج من جبّته أجيال وأجيال على مرّ ثلاثة عقود لنكتشف مكره ودهاءه بعد ثلاثين عاماً افترس تلابيب الوطن ومكامن ثرواته نهباً لا يخفى على الدولة بشيء، ليخرج إلى باريس معزّزاً مكرّماً مع أولاده المُدججين بالثروات، ويعود بالمؤامرة المُستشرسة والمستشرية حسب المصادر السورية والتي تهدد أمن الوطن وكيانه.
أعود للمواطن الذي بالكاد يلتقط فضلةً هنا أو رميةً من غير رامٍ هناك، حينها قلت لـ’محسن بلال ‘ الناس تختنق، قال وما شأنك، رددت أنني منهم، بخطى واثقة تقدم نحو الشرفة في الطابق العاشر أزاح الستارة عن إطلالة جميلة قال: انظري ما من مدينة أجمل من دمشق هادئة وديعة والناس سعداء، أجبته وهل شاهدت ما تفرّع عنها وما انطوى فيها؟ قال لا يهمّني، قلت لا يهمّك ربّما، ولكنها مهمّتك، قال كيف، أجبته الإعلام، رئة ثالثة يتنفّس منها المواطن، يا سعادة الوزير الناس تختنق تحتاج إلى رئة والإعلام رئة حقيقيّة الناس على وشك الانفجار، أجاب ساخراً، وهل تعتقدين نفسك، مريم العذراء وقادمة لخلاصهم؟ أجبته طالما النية موجودة ولقاؤك متاحاً لم لا أفعل، انتفض يصافحني لينهي الزيارة قائلاً: لقد فشلت في زيارتك، أنت امرأة غير مريحة، وحوارك لا يصلح لأنثى، ودون أن يترك لي حقّ الرد استنجد بالسكرتيرة طالباً منها أن توصلني إلى المصعد. ولو أردتُ تدوين الوقائع التي خضتها بمحاولاتي المتكررة والمنفردة مع نظرائه لما انتهيت، والتي لا أنتمي معها إلى أحد، ولم أتولّ مهامي من أحد، ولم أعوّل بمعلوماتي على أحد، ولم أندسّ ضدّ أحد، ولم أخطط لإسقاط أحد، فقط كل ما هنالك أنني أجيد الاحتفاء بهموم الغير كما همومي الشخصية، ويعنيني وطني الذي أريده الأوّل على صعيد الأوطان، لكنّ الكلام في وطني ليس متاحاً، والتحفّظ في وطني جنحة يعاتب عليها القانون، والنقد البنّاء في وطني جريمة مع سبق الإصرار والترصّد، والمواجهة في وطني كارثة تقود إلى الجحيم، لهذا ابتعدتُ عن غربتي داخل وطني لغربة أقل منها في وطنٍ مُستعار، على أمل أن يستعيد وطني حواسه فيصير يشعر ويسمع ويرى ويتيح الكلام، كان بودّي أن أهتف مع المؤيدين بأعلى صوتي، لأعلن تمسّكي بالرئيس الشاب الذي دخل من الباب العريض للتغيير والإصلاح، لكنّ الزمن أثبتَ في وطني أنّ الرئيس ليس لي أو لسواي، ليس لمثقّف يجيد الحوار، والنقاش، والاختلاف، والمناورة، بل لمثقّف يضع كامل أدواته لغاية واحدة لا أكثر وهو إدخالها المزاد، كنت أتمنى أن أفدي رئيسي بحرفي عندما يشعرني أنه للجميع وليس لفئة دون أخرى، عندما يكون على يقين أننا نحن من يجيد صياغة الوطن كجملة مفيدة وبيدنا صلاحية المحي والشطب والإضافة كيفما نشاء، بعيداً عن جوقة الببغاوات التي تملي علينا تفكيرها الأجوف، ورغباتها الحمقاء، وتصفيقها الخلّبي، كان بودّي أن أكتب بحريّة لا تعرف التردد، وبثقة أن الكلمة ستصل حيث ينبغي دون رقابة فائقة ومقصّ للرقيب وملفّ مفتوح ومنع سفر، كان بوديّ أن أضمن نشر سطوري في صحف بلدي، دون الاضطرار إلى النشر في الصحف الزميلة، كان بودّي أن أهتف بكامل قناعتي ورغبتي ولهفتي واندفاعي ‘الله سورية وبشار وبس’ وألفّ شوارع دمشق، وشوارع دوما ودرعا والمعضمية والنشابية والميدان وغيرها، لأمارس دوري وحرفتي وأعرف الحقيقة من أرض الواقع ومن إعلام المنطق، رغبة حقيقيّة مني وحقّ مشروع لمهنيّتي، دون إملاء وتلقين وإرغام من أحد يزاحم أنفاسنا في كلّ شيء، ويمنع أبسط طموحاتنا في بلدنا بأيّ شيء، ويهدد كياننا على مدار المحاولة، مع احتساب هذا النص بالتأكيد.
كاتبة من سورية