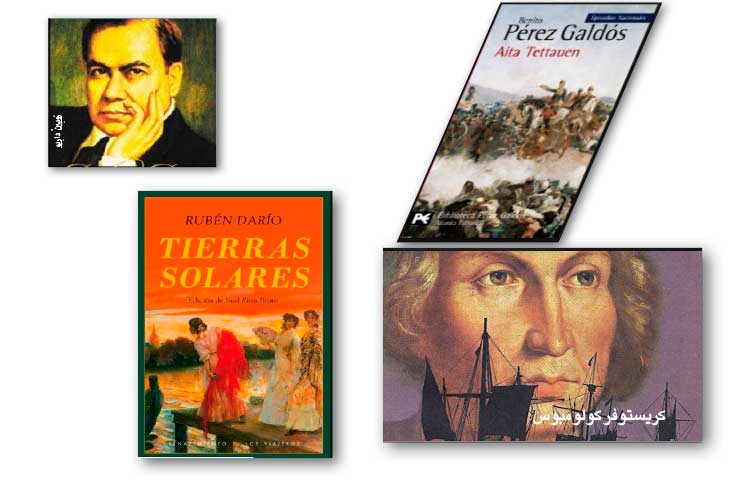النقد العربي: المآزق والبدائل
د.محمد عبيد الله
‘حسنا هذا ما قاله فوكو… فما قولك أنت’ إدوارد سعيد
يواجه النقد العربي الراهن جملة من التحديات أو المآزق المتصلة بشكل أو بآخر بتحولات النظرية وبمآلات تطبيقاتها ومصائر مناقشاتها في الغرب والشرق. كما تتصل من جانب آخر بالآليات والصور والقنوات التي اتصل نقدنا العربي عبرها- بمناهج النقد الغربي والأجنبي ومباهج النظرية النقدية الغربية ومستجداتها. وأول ما يمكن ملاحظته أن اتصالنا وتأثرنا بالنقد الأجنبي قد جرى في مختلف مراحله في صور ووسائل عفوية واعتباطية غير منظمة وغير متراكمة، وفي معظم الأحيان كان الاعتماد على الترجمات المتوفرة التي لا يعلم أحد مدى دقتها ولا مدى أهمية ما تنقله وموقعه في تجربة النقد الأجنبي نفسه، وكثيرا ما ترجم الهامشي قبل الضروري، فقدمنا محتويات الهامش على مكونات المتن. يضاف إلى ذلك أن الاتصال قد تم في ظل صيغة الإعجاب والفتنة والدهشة، وبعيدا عن روح النقد الحقة التي تقتضي الجدل والنقاش والأخذ والرد، وهذا وغيره كأنما قد صادر تجربة التثاقف المتوقعة أو المأمولة، فلم يسمح من جانب بتفهم تلك النظريات والتحولات كما يجب أن يكون الفهم، ولم يتح مجالا لتجربة التوطين وضرورات ‘التبيئة’ أن تنجز في ظروف مواتية، كما أنه لم يفد الأدب العربي كثيرا إن لم يكن قد أضر به إنتاجا وتلقيا، أي بسبب التشويه والتشويش واحتمال تدمير كثير من الظواهر والنصوص والمواهب في ظل توجيهات وفتاوى نقدية تفتقر للأصالة والجدية، ويعوزها النضج والتماسك والانسجام مع سياقات الإنتاج الأدبي العربي. ومع ذلك فإنها مدججة بالاستعلاء والأستذة في تعاملها مع النص الأدبي العربي، في مقابل استسلامها وانبطاحها واندهاشها عندما تمتح من آبار النقد الأجنبي أو تعرض لبعض نظرياته وتذكر أعلامه، فيرد كل ذلك مجللا بما يشبه القداسة لأولئك الآباء، في صورة من صور تصنيم النظرية وغلبتها على النص حتى لو لم تكن مقاساتها مناسبة، فلا بأس بشيء من الخنق والبتر وتقطيع الزوائد حتى ينسجم النص مع مقاييس النظرية أو بما ثقفه الناقد منها.
نحن إذن نتحدث -بنوع من التبسيط والاختزال- عن ظاهرة تتداخل فيها العوامل وتضطرب فيها الصور، ولكن حسبنا في هذا المقام الإشارة إلى بعض معالم هذه العلاقة وبعض مظاهر التفاعل ونتائجه. ولكننا نريد تثبيت بعض القواعد والثوابت حتى لا يفهم عكسها من مجمل حديثنا:
فأولا: لا يقول عاقل بقطع الصلة مع النظرية الغربية ولا يدعو أحد لإغلاق النوافذ والأبواب أمام رياح التغيير والتأثير والتثاقف، فذلك أمر طبيعي تم في مختلف العصور، ولكننا نحاول أن ننظر في قيمة ذلك نوعيا، من ناحية التساؤل عما دخل نوافذنا واقتحم أبوابنا، وهل هو ما نريد ونحتاج أم تسللت وسط أجواء الانفتاح رياح السموم، سهوا وقصدا، فأضرت من حيث تدري أو لا تدري بتجربتنا وبنقدنا وصادرت احتمالات نضجه وتطوره.
وثانيا: فإن ما نسميه نظرية غربية أو أجنبية وكأنه كتلة واحدة منسجمة هو في حقيقته ‘نظريات’ واتجاهات ومدارس لها سياقاتها الفكرية والثقافية والسياسية أي أنها ليست أدوات محايدة بل هي قسيم أساسي ولد من رحم الحركات الثورية والفكرية الغربية، ولذلك فتلك نظريات متعاركة متطاحنة، يلغي بعضها بعضا، ويجادل بعضها بعضا، أما عندنا فقد ترجمنا عشوائيا- تلك المدارس فلم نعرف لها تاريخا ولا سياقا، وتبنينا ما أتيح لنا وما وصلنا دون أن يرتبط ذلك كله بحاجات سياقاتنا الثقافية والاجتماعية، وبعيدا عن أية خلفيات أو مؤثرات أو حواضن تقترب ولو من بعيد مما يشبه ما مرت به الحياة الغربية التي ولدت فيها تلك النظريات وتفاعلت وتتابعت وفقا لتطور مفهوم في سياقاتها وتحولاتها.
* * *
ويجهد النقاد العرب في ملاحقة الجديد في النظرية الأدبية، ومواكبة تحولاتها، وقد تمظهر هذا التوجه في تحولات سريعة عند كثير منهم، لا تعود لتغيير قناعاتهم أو أفكارهم ضمن سياقاتهم الفكرية والثقافية وإنما تبعا لتجدد قراءاتهم ولما يصدف أن يطلعوا عليه، خذ ‘عبد الله الغذامي’ مثلا انطلق بنيويا ثم تحول تفكيكيا وانتهى مبشرا بموت النقد الأدبي لصالح ‘النقد الثقافي’ وثقافة الاتصال والثقافة الشعبية والجماهيرية. وهو في كل هذه التحولات يتبع قراءاته وكأنه يتمرن على تطبيق المناهج وفهم النظريات أكثر مما يتبناها أو يقتنع بها. وحالته هي حالة معظم النقاد العرب في تحولاتهم غير المفهومة وغير المجدية، فكلهم يقمش ويلخص ويعرض من دون أن ننتهي من ذلك كله إلى مرحلة ‘إبداع النقد’ وهي المرحلة المأمولة التي قصر عنها نقدنا حتى اليوم، بل إن الرطانة والاقتباسات والتعكز على أقوال مبتورة من هنا وهناك قد بلغت حدا مزعجا عند الأجيال اللاحقة، دون أن يفضي كل ذلك إلى مرحلة من الهضم تتيح للناقد العربي أن يقول كلمته ويفصح عن رأيه. ‘حسنا هذا ما قاله فوكو فما قولك أنت’ عبارة لإدوارد سعيد تلخص بسخرية ما نشير إليه من بؤس حال نقدنا وظلامية الطريق التي يسير فيها إلى غير غاية.. ولقد تم ما تم من أمر التثاقف على هذا النحو الاستهلاكي بما يشبه استهلاكنا للمواد والأغذية المستوردة بحيث نبدل ونغير وفق ما يتوافر في السوق. ولم يسمح ذلك كله بأية فرصة لتوطين النظريات وتبيئتها وتكييفها مع السياق الثقافي العربي، فظلت غريبة على الإبداع الذي يفترض أن النقد متصل به، وظلت غريبة على القراء فلم تسهم في ترقية أذواقهم ولا في تقريبهم من الأدب، وظلت غريبة على النقاد أنفسهم فدخلنا رطانة عجيبة لا يفهم فيها أحد أحدا، تفتقر حتى للحد الأدنى من المصطلحات والمفاهيم المشتركة.
وهنا يمكن الإشارة إلى تفاعلات مشكلة التبعية التي وسمت النقد العربي وإلى جدل الخصوصية والهوية الذي يواجه معارضة عند كثير من نقادنا: النقد العربي في صيغته المعاصرة نقد تابع، ولا نستطيع الحديث بوضوح عن نظرية عربية للنقد الأدبي، بل أمعن بعضنا في نقد هذه المطالبة بوصفها مطلبا عرقيا وأن النقد ظاهرة عالمية: طيب أين هو إسهامنا العالمي فيها هل يكفي أن تكون أصول إدوارد سعيد ومصطفى صفوان وإيهاب حسن عربية مثلا لنكتفي، المسألة ليست مسألة عرقية وإنما ثقافية. والنقد الأدبي وغير الأدبي وجه أساسي من وجوه الثقافة ومفردة جوهرية من مفرداتها، والثقافة تنهض على الخصوصية والهوية، وتشتق طبيعتها ومعالمها مما له صلة بالأمة أو الجماعة البشرية التي تمثلها. النقد ليس مركبة نبدلها وليس أدوات محايدة كما يقول بعض نقادنا ممن يريدون الاطمئنان إلى ما يعرفون وإلى ما اعتادوا عليه، النقد ينتمي للعالم المعنوي الرمزي من الثقافة، شديدة اللصوق بالهوية والخصوصية، وتجربة الاتباع على النحو الذي نمارسه بتخبط واعتباطية وعشوائية لن تفضي إلا إلى مزيد من الضياع والابتعاد عن معالم الطريق.
ولقد بلغ الاستسلام إلى هذه التبعية وكأنها قاعدة مقررة لا مفر منها، وقد اتضحت مثلا عند عبد الملك مرتاض ذي المرجعيات الفرنسية- وهو يبرر مرجعياته الأجنبية ‘إنني أعتقد أن جميع النظريات التي يروجها النقاد العرب المعاصرون هم عالة فيها على الغرب …لا توجد نظرية نقدية عربية نحن جميعا عالة على النظرية النقدية الغربية المعاصرة’. وهو لا يقول هذا ناقدا أو ناقما وإنما ليجد سببا لتجاوزه المرجعيات العربية وعدم اعتماده عليها في كتابه : نظرية الرواية. ولا يطالب نفسه ولا زملاءه بالخروج من الاتباع إلى الإبداع، ولا ينتبه أنه ومجايليه قد بالغوا في فالنسخ والتلخيص والسلخ من المرجعيات الأجنبية واستهلك ذلك أعمارهم كما أنهم أنتجوا جيلا بل أجيالا من تلاميذهم يشابهونهم في مهارة التلخيص والتعكز على فلان وعلان، مع هبوط تدريجي حتى في مستوى هذه المهارة. وكل ذلك في نظرنا لا ينتج إلا مزيدا من التقليد لا يختلف كثيرا عن تقليد التراث واستنساخه في المراحل المبكرة من عصرنا الحديث. ولكن أصحاب اتجاه إحياء التراث في النقد والإبداع سرعان ما تفوقوا على أنفسهم وانتقل العديد منهم إلى الإبداع ولكنه إبداع صادرته تجربة النسخ العشوائي من المرجعيات الغربية غير المنظمة ولقد طالت هذه الاتباعية وكأنها قدر أسود لا نجد أفقا للخروج منه.
* * *
إذن يوجد عندنا ‘نقاد’ ومشتغلون بالنقد ومتخصصون في النظريات، ولكن ليس لدينا ما يمكن أن يسمى نظرية أو نظريات نقدية عربية. ليس لدينا إلا أقل القليل مما يمكن أن يشكل مقدمة لنقد عربي يستجيب لحاجاتنا وسياقاتنا ونصوصنا. ولو قارنا حالة النقد بحالة الإبداع الأدبي لوجدنا أن الإبداع في الشعر والسرد قد قطع أشواطا أسرع وأوسع في تبيئة التأثيرات الأجنبية وهضم التأثير، ولكن النقد لم ينجح فيما يشبه ذلك، بل ظل مترددا يختلق الحجج ليصادر أية توجهات نحو الخصوصية، ونحو فرصة تقديم إسهامات عربية بالمعنى الثقافي الحضاري وليس العرقي، هناك نوع من اختلاق الحجج لإغلاق أي تفكير أو بصيص أمل..وهناك شكوى متكررة من المبدعين العرب بمختلف طبقاتهم من حالة النقد المزرية ويقع أمر الرطانة النظرية وعدم التفاعل الحقيقي مع النصوص في مقدمة صور الشكوى. وأدى ذلك فيما أدى إليه أن يتوجه بعض المبدعين لممارسة النقد وإلى محاولة الاستغناء عن النقاد. ويمكن أن يكون رأي مريد البرغوثي ممثلا لذلك إذ يقول: ‘الجدل بين الكتاب أنفسهم يثريهم ويعلمهم ويرتقي بذائقتهم المشتركة أكثر بكثير مما يتعلمونه من نقدنا العربي الحالي’.
ولقد برزت ظواهر جديدة في الإبداع العربي والعالمي تنذر النقاد بالاستغناء عنهم إن واصلوا اغترابهم عن النص والتحليق في فضاءات النظرية، فظاهرة ‘الميتا سرد’: أتاحت في إحدى صورها أن تكون من البدائل الضمنية عن النقد الأدبي، وذلك عندما تتولى الأعمال الأدبية نقد نفسها بنفسها، وتتهيأ تدريجيا للاستغناء عن النقد الأدبي المستقل، أو لتكسر هيبته وسلطته. وهي ظاهرة تتوسع في السرد والشعر وكأن النص الأدبي يريد أن يقدم الرأي النقدي والمناقشة المحتملة داخل النص نفسه، دون انتظار لما سيقوله الناقد، ربما يأسا من حالة النقد نفسه، ومن عدم توقع الكثير منه.
وهناك تحدي النقد الثقافي: الذي طرح نفسه دون مواربة صيغة جديدة تغني عن النقد الأدبي ونظرياته وتنبئ بقرب نهايته بل وموته في بعض الأحيان دون شفقة. ولسنا نمانع أن يشتغل بعض نقادنا بهذا الاتجاه أو ذاك، ولكن المشكلة تتمثل في الولع بالنظرية والحماس لها أحيانا أشد من واضعيها وإلغاء ما عداها، نحن لم نمارس النقد الأدبي ممارسة معافاة ولم نستنفد هذه الحاجة بعد، وإنتاجنا الأدبي ما زال في جملته غفلا من النقد، فهل نتحول جميعا إلى النقد الثقافي الذي يقع الأدب في أدنى اهتماماته، أوليس في هذه الدعوى الكثير من المبالغة؟؟
ومن المصاعب والتحديات التي لا تبعد عن السياق الذي نعرض له:
– انغلاق الممارسة النقدية في الجامعات حيث الفرصة للمدرسي والمكرور وحيث الخوف من الجديد وعدم الاعتراف إلا بالموتى وبما لا يثير شجنا أو شغبا.
– النشاط النقدي أقرب إلى نشاط متطفل في حياتنا الثقافية العربية فليس ثم مناخات ولا حواضن ولا سياقات تحترمه وترعاه. ولذلك فإن تطوير البيئة النقدية أمر ضروري وتطور النقد مرهون بذلك، أكثر ما هو مرهون بأشخاص نسميهم نقادا.
– المشكلة اللغوية ومشكلات الترجمة: وتشمل أمورا وملابسات متعددة، ففي المغرب العربي يترجمون عن الفرنسية برطانة ومصطلحات معينة، وفي المشرق العربي تشيع الترجمات عن الإنجليزية برطانة أخرى، وهناك مشكلات في وصول الكتب بين المشرق والمغرب، وفي تكرار الترجمات في البلد الواحد أحيانا، ولو شاء لنا القدر واطلعنا على بعض الترجمات المكررة لهالنا الاختلاف في الفهم وفي التعريب بما يبعدنا عن الأصل مرات وبما يشكك في إمكانية أن توصل هذه الجهود إلى شيء مفيد. ورغم الشكوى من أزمة المصطلح فما زالت المشكلة تزداد تعقدا، لأن أسبابها لم تزل قائمة. ومع ما يقال عن قلة الترجمات فإنني أشير إلى أن المسألة الكمية ليست هي الفيصل ولا المعيار، وإنما الأهم هو المسألة النوعية، فترجمات قليلة ممنهجة وفق الحاجة أهم وأكثر فاعلية من ترجمات كثيرة تزيد البلبلة والرطانة وتزيد التشقق في أنسجة ثقافتنا الحائرة القلقة.
وفي هذا المناخ الذي يقع التغيير في جوهره، فإننا محتاجون لا أن نثور على السلطات السياسية والأنظمة السياسية وحدها، وإنما على نوعية الثقافة والمناهج التعليمية التي نشرتها وحمتها وتساوقت معها وأنتجت فيما أنتجت شيئا مما نعيشه ونشكو منه.
ـــــــــــــــــــ
شاعر وناقد وأستاذ جامعي من الأردن
القدس العربي