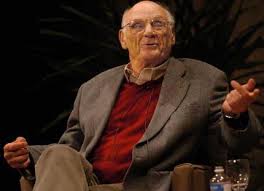النقد وانتفاضة المجتمع المدني
بطرس الحلاق
انتفاضة الشبيبة تفتقت، والفصل شتاء، ربيعا قبل أوانه في زمن عربي شتوي الملامح، أقله منذ ذلك الحزيران الكئيب. بشرى بمسار جديد يعيد تأسيس نهضتنا، إن لم تضل بنا السبل، على ركن ركين: الفرد المواطن إذ يحقق فرديته الإنسانية وينشئ مجتمعا مدنيا متكافلا، فيصوغ مؤسساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية بحرية مسؤولة واعية.
تمتاز هذه الانتفاضة بتجاوزها لجملة من التناقضات أربكت مسيرتنا على مختلف الصعد. لم تأت ثورة تنسخ إنجازات نضال بدأ منذ قرنين، بل تصويبا لمسار النهضة في مقاربتها للواقع العربي. تمثلت، بالحدس وبالوعي، تجارب الأجيال السابقة من رواد النهضة حتى جيلنا، فنبذت مساوئها واستبقت نسغها الحي. نبذت الاسقاطات النظرية الذهنية التي تُكره الواقع العربي على الانصياع لفرضيات تبلورت في سياق آخر بدل أن تقتبسها منه، لكي تستجيب لمنطق حراكه الداخلي، الكفيل وحده بتوحيد كافة فئاته، أيا كانت منازعها، على قاسم مشترك، تاركا المجال لخصوصيات ثانوية. وأبرز ملامح هذه النهضة أنها، كما قلت في سياق آخر: “عربية الهوية دون أن تكون عروبية جامحة تتجاهل الهويات المحلية (كردية كانت أو بربرية على سبيل المثال)، ودعوة إلى العدالة والتضامن الاجتماعي دون أن تكون شيوعية، ومتجذرة في التاريخ دون أن تستغرق في التراث ولا سيما الديني منه بنزعته الاقصائية. نبعت من تاريخ تجاوزت تشنجاته وعبرت عن طموحاته في الحرية والكرامة والعيش المشترك، فطالعتنا هذه الوجوه المتحدة في تعددها: مدنية وريفية، أنوثة ورجولة، بلباس تقليدي أو عصري، تصلي مسلمة أو مسيحية أو تعلن عن علمانيتها، وتنشد معا توقها إلى الحرية والعمل ضمن مشروع جماعي. تؤسس مجتمعا على عقد مدني”.
بهذا الوعي العميق للواقع العربي، تجاوزت انتفاضة شبيبتنا تناقضا آخر فصّلته النظرية: العلاقة مع الآخر، لا سيما ذلك الآخر القريب-البعيد أبدا، أعني الغرب. تناغمت، بفضل شبكات التواصل التي اتقنت استخدامها، مع تطلعات أجيال شابة في العالم تعاني مثلها من عولمة بحت اقتصادية تحول الفرد إلى سلعة وأداة انتاج وآلة استهلاك. فأخذت من العولمة وجهها الحضاري القائم على التواصل بين الناس ورفضت وجهه الوحشي المدمر. خرجت من منطق الانبهار أو النبذ – وكثيرا ما علقنا بين حدّيه – لتتعرف على الآخر ندا لها ومثيلا في الإنسانية، فرأى العالم فيها صورة لما يطمح إليه وشريكا نبيلا في معركة إنسانية جامعة.
ستشهد هذه الانتفاضة، من دون أدنى شك، مخاضا نرجو ألا يشتد عسره، غير أنها فرضت واقعا جديدا لا ردة عنه، لا سيما وأنها نجحت إلى حد كبير في أم مجتمعاتنا العربية، مصر، مركز الثقل الذي يتحكم في الجسم العربي سلبا وإيجابا. إنها انطلاقة جديدة للنهضة ولكن من موقع آخر. وأهم ميزاتها أمران. أنها أولا نبذت العنف المسلح ففضحت عصرا مديدا من “الثورات” و”الانقلابات” قدست العنف فطحنها وفتك بالمجتمع. “ما أخذ بالسيف فبالسيف يسترد”، قول إنجيلي طالما نُعت بالسذاجة والعجز فإذا به حقيقة تشي بجوهر الحياة. حيثما ساد هذا الوعي نجحت الانتفاضة وتفجرت طاقة الحياة. فهلاّ أصبح ذلك الوعي السلمي نبراسا يهتدي به المواطنون وأولو الأمر على السواء؟ وثاني الأمرين أنها انبثقت من قلب المجتمع المدني لا من رأس الهرم. لم تصدر من المتحكمين بالمؤسسات السياسية وبأجهزة الدولة، ولا من قادة الرأي العام، صحافيين كانوا أم زعماء تيارات سياسية، أدباء أم من أهل الفكر أو من العسكريين. جميع هؤلاء يمثلون المثقف في تحديده الإجمالي الشائع، على الأقل منذ بداية الاستقلال، بمن فيهم العسكري الذي ما فتئ منذ بروزه على المسرح السياسي يبرر، عن قناعة أم مكر، نزوعه إلى السلطة بمشروع ثقافي، متلبسا أبدا زي المثقف. ضد هذا المثقف المهيمن منذ عقود وضد أعوانه من مثقفين، قامت الانتفاضة. وبدون المثقفين الآخرين -وجلهم من المناضلين الشرفاء وإن استكان بعضهم لاحقا إلى الراحة بعيدا عن هموم المجتمع- وعلى غفوة منهم، اندلعت الانتفاضة فأخذتهم وهم ذاهلون عن أنفسهم، قبل أن يستجيبوا لندائها السلمي.
لأول مرة في تاريخ نهضتنا الحديثة – ولا أستثني ثورة مصر عام 1919 ولا هبّة المقاومة الفلسطينية وقد استمدتا زخمهما من تماهي الشعب معهما- يأتي الحراك من المجتمع المدني. نصّب مثقف القرن التاسع عشر نفسه، ولأسباب معروفة لا تغض من نبل نضاله، مربيا ومعلما وموجها للشعب، إلا في حالات نادرة (منها أحمد فارس الشدياق في عمله الرائع “الساق على الساق”). وكثيرا ما تحول في النصف الأول من القرن العشرين إلى قائد تيار فكري أو حزب سياسي أو كليهما معا، وقدر له أن يشط أحيانا فيتنزّل نبيا. أما “في العهد الوطني” (حسب عبارة أحدى شخصيات “نجمة أغسطس” لصنع الله إبراهيم) فقد نحا المثقف، ولأسباب كثيرة، منحى سلطويا مباشرا، فاستحلى السلطة وإن كانت وهمية، وتمادى أحيانا فزيّنت له عدته العسكرية أن يقيم نفسه قائدا ملهما وزعيما خالدا، ولم لا مؤسسا نبويا لعهد جديد، شأن “عامل” ليبيا الذي اجترح من خيالاته “جماهيرية” أرساها إلى “كتاب أخضر” خوّله أن يتربع على سدة حكم مطلق فوق المراتب المعهودة وخارجها.
وما للنقد وذاك؟
لا، لم نغادر النقد لحظة. لقد احتل الناقد في الزمن الحديث موقع المثقف بامتياز. ففي أوروبا القرن التاسع عشر، تكلم الناقد بسلطة الفيلسوف والمؤرخ والأديب والخبير بالوضع الاجتماعي (إذ لم يكن علم الاجتماع قد تبلور بعد)، بل والسياسي في بعض الظروف. أما عندنا، فقد أضاف إلى ذلك سلطة “العالم” بمعنييه المتلازمين في ثقافتنا: العليم في ميدان الأدب ولا سيما في الشعر بما يتسم به من هيبة قدسية موروثة من ثقافة عريقة، والعارف بأمور الدين المُلمّ حتما بشؤون الأدب الوشيج الصلة بالفقه. ولنُمثّل على هذا الناقد بطه حسين، وما زال رغم تبدل الظروف نموذج الناقد الناجح عندنا. يؤسس خطابه النقدي على سلطة علمية اقتبسها ونقلها بدون أي تحوير من النقد الفرنسي الأول (من سانت بوف إلى برونتيير)، ويستقوي بسلطة الأزهري (أزهري على النمط الحديث) المسلح بمعرفته الدينية والأدبية معا. بل إنه يضيف إليها لاحقا سلطة “قائد من قادة الرأي العام”، تجلت في معارك فكرية برّز فيها كما في روايات جلها تعليمي بحت، سلطة تناهز في بعض المواقف سلطة السياسي، سلطة لم يأنف عنها قط.
فمن يُعد قراءة أعماله النقدية الآن، يرَ فيها ضمور الإبداع النقدي مقارنة بتألقها الفكري في الميادين الأخرى. طه حسين قامة شاهقة نعتز بها جميعا، غير أنها تتألق في غير ميدان النقد، بالرغم من جهود محمودة، لا سيما إذا ما قارناه بالمقاربة النقدية لدى العقاد وميخائيل نعيمة ثم عند يحيى حقي ومارون عبود. ولعل سر ذلك أنه نظر إلى النص الأدبي (ولنقل إلى الواقع الأدبي المعطى) من علياء نظريةٍ اقتبسها ولم يستخرجها من واقعه. بسلطويةٍ عامل النص، وبسلطوية خاطب المبدع وخاطب القارئ، ليهديهما سواء السبيل. بهذا المعنى فقط يندرج في منطق مثقف النهضة التعليمي، منطق قلبته انتفاضة المجتمع المدني الراهنة رأسا على عقب.
عقب الحرب العالمية، وفي سياق نهوض الفكر الماركسي، احتل الساحة نقدٌ آخر مسلح بنظرية “الواقعية الاشتراكية”. وهي واقعية كان الفكر النقدي الغربي قد تجاوزها، فتلقفها الفكر الماركسي بعد أن ابتسرها إلى أداة فنية اتخذها رديفا للحراك الاجتماعي. نظرة إلى مجمل نقدنا على أربعة عقود، نلمس أسلوبه القائم على إسقاط صورة “الواقع”، وقد تقلص إلى صراع طبقي، على النص الأدبي. فأخذ بالمضمون المباشر -وكأن المضمون مستقل عن اللغة والآسلوب والمتخيل- ليقوم معيارا وحيدا في الحكم النقدي. بذا أيضا صدر النقد من خارج النص (الواقع) ليوجّه الكاتب والقارئ معا إلى سوي السبيل. أفلت الواقع والمجتمع منه وها هو الآن يحاول أن يقول كلمته.
وابتداء من السبعينات، تصدّر المشهد النقدي أخصائيٌ في النقد الحديث، الذي تبلور في فرنسا على هدي علم اللسانيات (ده سوسير) ثم تفرع إلى مدارس شتى (التكوينية، السيميائية، السردية…). مارسه كل ناقد حسب مقدرته، ولكنه غالبا ما تقلص إلى تطبيق آلي للنظرية المقتبسة، تطبيع يصلح بلا ريب تمرينا لطلاب كليات الآداب، ولكنه لا يجدي فتيلا في فهم النص. إذ أنه، على عكس سابقه، ينفرد بالشكل الروائي أو الشعري ليركّب عليه المضمون كيفما تيسر له. بذا أيضا تعامل مع النص (الواقع) بسلطة خارجية، كثيرا ما انبهر بها الروائيون فانهوسوا بالتقنية بحيث حصروا جهدهم في البحث عن الشكل الطريف، واستقاد لها القارئ بإعجاب حتى وإن استغلقت عليه إلى حد كبير، رغبة في مواكبة العصر. ولم ينج بنفسه إلا من “عصم ربك” من نقاد قلائل. من أوائلهم وعلى رأسهم توفيق بكار وخالدة سعيد: تمكنا من المنهجية الحديثة ثم تناسياها، وها هما يباشران النص بصبر العالم وتواضعه، ليكشفا عن ثرائه الخفي من خلال طبقات من العلائق تحبك نسيجه، دون أن يسدا أفق التأويل.
فيتجلى النص، للكاتب والقارئ معا، في شتى أبعاده، ومنها من قد يكون مفاجأة للكاتب نفسه، ولكل أحد حينئذ أن يغتذي بالنص ويغذيه على قدر ثقافته ورهافة حسه.
لا تستنفذ هذه النماذج، ولحسن الحظ، كل ما كتبه النقاد -وفيه مؤونة ثرية لفهم أدبنا. ولا مجال هنا للتنويه بهذه الكتابات كلها. وإني لا استعرض النموذجين السابقين إلا استنفارا لنقد جديد يحل محل النقد المهيمن العاجز حاليا عن مسايرة إبداعنا الأدبي، هذا الإبداع الذي يرقى، في نظري وبدون محاباة، إلى مستوى الإبداع العالمي. لذا يحلو لي أن أكرر أن أدبنا هذا قد يكون أكمل إنجاز حققناه في نهضتنا الطويلة.
إن مبدأ هذين الناقدين في مقاربة النص يتناغم إلى حد كبير مع روح انتفاضة شبيبتنا في التعبير عن وعي مغاير للواقع: ينبع منه ولا ينزّل عليه من عل. فهو يقتضي من الناقد أولا وعيا صادقا بأن مهمته النقدية لا تخوله ادعاء أية سلطة، اللهم إلا سلطة كفاءةٍ يضعها في خدمة المواطنين، مستبعدا أي موقف “رسولي” ينصّبه موجها ومعلما لشعب جاهل عليه أن “يشكّله” و”ينهض” به. إنها مهمة تتساوى ومهمة كل مواطن يشارك على طريقته في الحراك الاجتماعي، كل في ميدانه. فلا نهضة حقيقية للمجتمع إلا بنهضة كل فرد يفيد من عطاء الآخرين، ليمدهم بدوره بما يبدعه. إذاك ينهض الوطن. ولا أفضلية خاصة للمثقف ولا للخبير في قيادة المجتمع بالمعنى السياسي العام إلا وفق الشروط الديمقراطية، أي حيث يفوضه المواطنون وبكامل حريتهم أن يمثلهم، وكل سلطة لا تنبثق من الشعب مغتصبة. آن لنا أن نأخذ على محمل الجد ذلك المبدأ الأساسي الذي قالت به الثورة الفرنسية مبدأ جامعا لمطلق مجتمع: الناس متساوون في ميدان المواطنة للنهوض بالجماعة كل في مجاله الخاص، ولا أحد يستأثر بالتنوير.
أما في الحقل العلمي الخاص، أي النقد الأدبي، فيقول هذا المبدأ باعتبار النص كائنا عضويا مستقلا: – عضوي، لأنه، أسوة بكل كائن حي، لا تُدرَك أجزاؤه ومستوياته إلا نسبة لكليته، أي لا يتسنى إدراك أي منها إلا في النسيج الكلي؛ – ومستقل، لأنه يحكي عن نفسه دون الرجوع إلى المؤلف ودون الاحتكام إلى الواقع الخارجي إلا عبر إحالات جزئية (تفيد للإيحاء بالواقع) يعيد المتخيل تركيبها وفق منطقه الخاص. فالنص حياة تشمل الوعي واللاوعي، الفكر والعاطفة، الثقافة والجسد، الروحي والغريزي، ما يطفو على السطح وما يسكت عنه… والنص كلام، غير أنه لا يقوم نصا بكل معنى الكلمة إلا في صراع مع لغة تختزن رؤية للعالم وفلسفة وجود وأخلاقية تتراكب بكل تناقضاتها، وعلى المبدع أن يقول من خلالها قولا شخصيا متميزا (إذ كل إبداع تميز)، موظفا جمالياتها وإحالاتها، دون أن يعلق في شباكها وفي ايديولوجيتها الضمنية. صراع هو منازلةٌ فروسية، حضورٌ الخصمٌ فيها ضروري للنزال. والنص تشكيل لحكاية متعددة العناصر (من زمان ومكان، من حدث ووصف، من خطاب وسرد…)، يجوز مباشرتها من أي طرف ووفق أي منظور، حسب أي تسلسل زمني ومن مواقع متنوعة. وعلى الخيار المعتمد تترتب الصورة (حتى لا أقول المعنى، منعا للالتباس). من هذا المنطلق، على الناقد أن يتلقى النص مسلحا بموضوعية مطلقة، تخوّله ألا يعلق بشباك ذاتيته (أي رؤيته الشخصية للعالم، أيا كان منحاها)، وبأوسع ثقافة ممكنة، حتى ينفذ إلى أقصى الخبايا، إذ كل نص منسوج -على نحو معين- من نصوص سابقة بشكل صريح أو ضمني، واع أو عفوي؛ ذلك ما يعرف بالتناص بمعناه الواسع. بهذه المفاتيح يفكك الناقد العناصر ليدرك كنهها في إطار علاقتها بنسيج النص الكلي، ثم يركب استنتاجاته على النحو المناسب ليقدمها للقارئ. أما الحكم، أيا كان نوعه، فيرجئه إلى النهاية ليقدمه كموقف شخصي لا يفرض على أحد.
إني على قناعة تامة، تكونت من خلال مطالعاتي لأعمال نقدية فذة ومن خلال مناكفتي لنصوص لم تفصح عن كنوزها إلا بعد معاناة طويلة، أن قراءة جدية لتراثنا الأدبي القديم والحديث حَريّة بأن تكشف عن كنوز طمرتها عجالة القراءة، وقد تفضح زيف بعض أعمال وُضعت في الذروة، وتكشف قصر نظريات توظف الأدب خدمة لإيديولوجتها (منها بعض ما يساق في النقد الثقافي اليوم). وقد يتنسى لي أن أقدم شهادة عن عمل من أعمال عبد الرحمن منيف أهملته طويلا ثم اكتشفته كنزا يذخر بنظرة للحياة قل نظيرها وبرؤى للمستقبل يجدر التأمل بها مطولا.
ويبقى أن النقد فن ملتصق بالذات، يخطئ من يرى فيه علما. ولذا لا تمده التقنية إلا بأدوات عامة تحدد مفاهيم الكتابة الأدبية تجنبا للانزلاق إلى مواقف انطباعية ذاتية، تضع في تصرف الناقد بعض “المفاتيح” الإجرائية، غير أنها لا تصلح بأي شكل من الأشكال للتعبير عن الجوهري الأخص. رحم الله رولان بارت وهو القائل: “إنما الناقد سنكرجي” (من يستخدم في مهمته أدوات صنعت لمهمات فنية أخرى)، يجرب ما لديه من أدوات استمدها من علمه وثقافته ليشرع أبواب النص الإبداعي على مصاريعها. النقد تفتيق لإمكانيات نص كما الحراك المدني تفتيق لإمكانيات أفراد بهم يقوم المجتمع المبدع.
السفير