انتخاب “دونالد ترامب” وتأثيراته على المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص –مقالات مختارة-
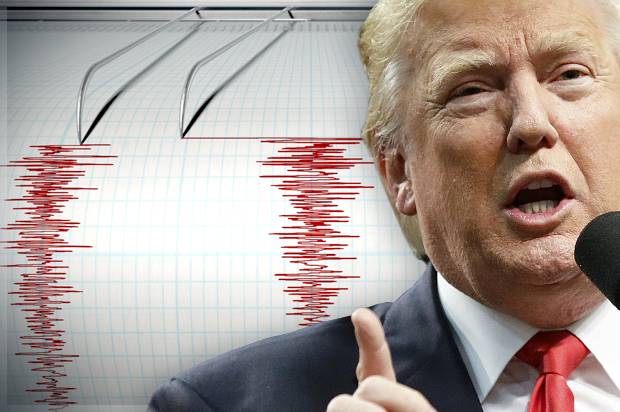
“معارضتنا” وحقبة ترامب/ عمر قدور
سيكون تساؤلاً مثيراً للسخرية، لو وجهناه، عما أعدت المعارضة السورية وداعميها استباقاً لفوز ترامب، ولن يكون الحال بأفضل فيما لو كان التساؤل عما فعلت المعارضة سوى انتظار رحيل أوباما. ما يثير سخرية أكبر أن انتظار رحيل أوباما رسمياً قد يليه انتظار آخر، هو الانتظار التقليدي حتى تنتهي التعيينات في إدارة ترامب وتبدأ عملها فعلياً، وهذا انتظار قد يترافق بالتنويه بمزاجية ترامب وتقلباته ما يستدعي انتظار انقلاب مزاجه لصالح الثورة، أو انتظار تحقيق وعوده في التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، ومن ثم المواجهة المرتقبة معها.
في فترة الانتظار هذه، حشدت موسكو ترسانتها لتغيير الوقائع على الأرض، وذلك لم يكن مفاجئاً إلا لمن يريد التظاهر بالمفاجأة. المعركة على الأرض ليست متكافئة أصلاً، وتبرير خسائر فصائل المعارضة بتفوق العدو الناري وبالزيادة الضخمة في أعداد ميليشياته لا يغير من الوقائع، وإن دلل على بسالة المقاتلين، ففي النهاية يصعب كسب حرب شبه تقليدية مع رجحان كفة العتاد والمقاتلين لجهة الخصم، وبالطبع مع فقدان الحليف الموثوق وخطوط الإمداد المتواصل.
صحيح أن الصراع خرج عن إطاره السوري منذ تدخلت طهران مباشرة، بواسطة حزب الله والحرس الثوري وبعد ذلك بواسطة العديد من الميليشيات الشيعية، ما فتح الساحة السورية على مصراعيها أمام صراع إقليمي. إلا أنه من الصحيح أيضاً أن المعارضة، بشقيها السياسي والعسكري، لم تعمل على تعزيز بنيتها الداخلية، لمواجهة طويلة مع النظام، وأيضاً لتشكيل ثقل حقيقي يمنع استخدام بعض منها وفق أهواء الخارج. يمكن القول بأن المعارضة بقدر ما أهملت عمقها الداخلي، مستندة إلى اتساع رقعة النقمة على النظام، فقدت قوتها إزاء الخارج سواء على صعيد التمثيل السياسي الذي انحسر وزنه باضطراد منذ عام 2012، أو على الصعيد العسكري “في التوقيت نفسه” حيث بدأ الإجهاز على أي طموح لإنشاء تشكيل عسكري وطني جامع.
كما نعلم منذ عام 2012 بدت وظيفة الحرب أميركياً هي الضغط على النظام لإجباره على القبول بتسوية سياسية، هذا هو المعلن مع علم الإدارة باستحالة تحقيقه مع نظام مستعد لتسليم البلاد إلى طهران وموسكو على أن يقبل تسليمها إلى سوريين آخرين ولو كانوا من موالاته. هذا النهج الأميركي كان من الممكن مواجهته بواحد من احتمالين، إما تحقيق انتصارات خاطفة ومؤثرة بخلاف المخطط، وبالتالي فرض أمر واقع على الخارج، أو التلاؤم معه بالتخفيف قدر الإمكان من الخسائر والنزيف المترتب عليه، أي باعتماد تكتيكات قتالية توقع الأذى الأكبر في بنية النظام الأمنية والعسكرية مع الحرص على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
لقد وصل نهج أوباما إلى نتيجته المحتومة التي لم يكن يصعب توقعها، أي إلى تغليب النظام وحلفائه على فصائل المعارضة، لم تفز كلينتون لتغيّر في النهج الأميركي بحسب ما طرحته في حملتها الانتخابية، ومن المرجح أن يتوج ترامب نهج سلفه بنفاق أقل. هذا التخلي المتوقع عن النفاق سوف يجرد المعارضة من أسباب تكاسلها عن مهامها الأصلية، ويسحب منها ذريعة استسهال الاعتماد على خارج لم يكن متشجعاً في أي وقت لحماية السوريين.
يُفترض أن يضع الواقع المستجد المعارضة أمام احتمالين، فإما تقرير أن الحل بيد الخارج الذي لن يزيح الأسد، وتقرير أن الثورة لا تستطيع الانتصار دون اعتماد عليه. بعبارة أخرى: إعلان فشل الثورة نهائياً، أو فشلها عبر حل لا يتعدى إصلاحات شكلية يرحب بها النظام لقاء تطبيع علاقاته دولياً. الاحتمال الآخر، وهو الأكثر مشقة، أن تعلن المعارضة تخليها عن النهج الذي اتبعته حتى الآن، على الصعيدين السياسي والعسكري، وأن تعمد إلى تشكيل تمثيل وطني لها، تمثيل لا يخضع كما هو الحال الآن إلى تجاذبات خارجية، أو ينضوي تماماً تحت مظلة خارجية لها أجندتها الخاصة.
على الصعيد العسكري، يُظهر الاقتتال البيني بين فصائل في حلب المحاصرة الآن، وبين فصائل في الغوطة الشرقية، بؤس ما آلت إليه قيادات فصائل المعارضة من تغليب المطامع الذاتية على المصلحة العامة. فمن المعلوم أن حوادث الاقتتال الدموي هذه تحدث تحت الحصار الخانق وأحياناً تحت القصف الروسي، ولا يشفع لـ”أبطالها” أو لبعضهم مقاومتهم النظام، مثلما لا تشفع المقاومة لبعضهم في ممارسات تعسفية بحق المدنيين الذين يشاطرونهم بؤس الحصار. ذلك من دون التطرق إلى الفصائل المتطرفة التي تجهر بعدائها للحرية والديمقراطية وكافة مثل الثورة، وإلى أيديولوجياتها العابرة للحدود المتنافية مع أي بعد وطني. وليس خافياً أن مشروع تصفية هذه الفصائل، بدءاً بالأكثر اعتدالاً، سار ويسير بخطى حثيثة مع استغلال تشرذمها، وأية استفادة من التجربة لا تلحظ فشل البنى التنظيمية السابقة وفشل التكتيكات المتبعة لن تعني مستقبلاً سوى نوعٍ من العنف العدمي الذي لا يحمل آفاقاً سياسية.
مع الإقرار بأن الظروف لم تكن إيجابية بما يكفي لصالح الثورة، يلزم الإقرار بأن أطر المعارضة كافة أثبتت فشلها خلال خمس سنوات، وتم تعليق الفشل على القوى الدولية، وتالياً تعليق الآمال على تغير في موازين الصراع الدولي. مع مجيء ترامب إلى الرئاسة من المرجح إسدال الستار على هذه الحقبة، ما يتطلب التعويل أكثر من قبل على العوامل الذاتية، وعلى ابتداع أساليب مقاومة أقل كلفة على الثورة، وأقل ارتهاناً للدعم الخارجي، مع قدرتها على منع النظام من الزعم بأنه استعاد سيطرته وأعاد السوريين إلى حظيرته. التحدي صعب لكنه غير مستحيل، فهناك في سجل الثورات العالمية الكثير مما يمكن تعلمه على صعيد الجهد السياسي المديد، والكثير مما يمكن تعلمه عن المقاومة النوعية بأسلحة بسيطة، ولئن برهنت المعارضة السورية على أميتها حتى الآن فالكارثة الأسوأ إذا أثبتت عدم قدرتها على التعلم.
المدن
هل يدفن ترامب إرث أوباما؟/ مروان قبلان
أسابيع قليلة، ويغادر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، البيت الأبيض، تاركاً وراءه حزمة كبيرة من الأزمات المفتوحة، وارثاً مجهول المصير. بمجرد خروجه، سوف يبدأ أوباما، على الأرجح، كتابة مذكّراته، وسوف يتاح لنا أن نقرأ تاريخ الثماني السنوات التي قضاها في حكم القوة الأعظم في العالم، من وجهة نظر أول رئيس أميركي من أصول افريقية. سيخبرنا أوباما كيف أنه انشغل، منذ اليوم الأول لوصوله إلى الرئاسة، بالتحضير لإنفاذ وعوده الانتخابية الخاصة بسحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، وكيف أن نجاحه في انتشال أميركا من الأزمة المالية التي ضربتها عام 2008 كان يعتمد كلياً على وقف النزيف الخارجي للقوة الأميركية، خصوصاً في حرب العراق التي قدرت مصادر تكلفتها بتريليوني دولار.
سيروي أوباما تفاصيل خطته للانسحاب، والنقاشات التي دارت مع الدائرة الضيقة من المساعدين الذين أحاطوا به، خصوصاً مستشاره لشؤون الشرق الأوسط، روبرت مالي، ونائب مستشار الأمن القومي، بنجامين رودس، والذي وصفته “نيويورك تايمز” في تحقيق طويل، نشرته في 5 مايو/ أيار الماضي، بأنه ظل أوباما وعقله. اقتضت الخطة، كما غدا معلوماً، ترميم العلاقات مع حكومات العالم الإسلامي، تبني سياسات واقعية وطي صفحة “أوهام” نشر الديمقراطية. والأهم من ذلك كله تبني خلاصات لجنة بيكر-هاملتون التي أنشأها الكونغرس، بعد انهيار الوضع الأمني في العراق، إثر تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في فبراير/ شباط 2006، لتقييم الوضع هناك. انتهت اللجنة إلى التوصية بالانفتاح على إيران، لتهدئة الوضع في العراق، وتأمين خروجٍ آمن للأميركيين. أوكل تنفيذ الخطة لوزير الدفاع الأسبق، روبرت غيتس، وهو المسؤول الوحيد الذي احتفظ به أوباما من إدارة بوش، للإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة التي كان غيتس من أعضائها، وهو من كتب توصياتها.
هنا، سيطلعنا الرئيس أوباما، على الأرجح، على تفاصيل المفاوضات السرية التي قادها غيتس مع إيران بين عامي 2009 و2011، لتأمين سحب القوات الأميركية من العراق، وكيف أن إدارته أيدت، إرضاءً لطهران، بقاء نوري المالكي رئيساً للوزراء، ضاربةً عرض الحائط بنتائج انتخابات عام 2010 التي خسرها أمام القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي. اقتضت المصلحة الأميركية تعزيز قبضة المالكي على السلطة، وتحويله إلى ديكتاتور، فساعدته، في ولايته الأولى، في ضرب خصومه من الشيعة (الصدريين خصوصاً) وغضّت، في ولايته الثانية، النظر عن سياساته الطائفية تجاه السنة، بهدف بناء سلطة مركزية قوية ترث النفوذ الأميركي المنسحب.
لا بد أن أوباما سيفرد فصلاً خاصاً، وربما فصولاً، عن مفاوضاته السرية مع إيران بشأن ملفها النووي، وكيف أن هذه المفاوضات بدأت مع حكومة محمود أحمدي نجاد التي صدّعت رؤوسنا بخطابات المقاومة وعزمها على إزالة إسرائيل من الوجود. وكما كان مضطراً أن يترك لها العراق خدمةً “للمصالح الأميركية”، سيخبرنا أوباما أنه، من أجل انتزاع اتفاقٍ معها بشأن البرنامج النووي، كان مضطراً إلى التغاضي عن تورّط إيران المباشر في قتل مئات آلافٍ من السوريين، وتشريد الملايين، وابتلاع خطوطه الحمراء التي رسمها، حال استخدم النظام السلاح الكيماوي.
سيدافع أوباما بقوةٍ عن سياساته في الانفتاح على إيران، باعتبار أنها سمحت له بتحقيق اثنين من أهم أهداف سياسته الخارجية في الشرق الأوسط: إتمام الانسحاب من العراق في ولايته الأولى، وانتزاع اتفاقٍ حول برنامج إيران النووي في ولايته الثانية، على الرغم من أنه دمّر العراق، ليحقق الهدف الأول، وأحرق سورية ليحقق الهدف الثاني.
بذل الرئيس أوباما قصارى جهده لإيصال هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، ليس حباً، وإنما سعياً إلى الحفاظ على إنجازاته “الإيرانية”، باعتبار أنها تمثل إرثه الرئاسي “الوازن”. وأما وقد فاز ترامب، فالاحتمال كبير أن يتم دفن هذا الإرث، حتى قبل أن يتسنى لأوباما كتابته. فالرئيس الجديد يرى الانسحاب من العراق خطأً استراتيجياً كبيراً، لأنه سلم العراق إلى إيران على طبق من فضة، كما أنه يعد الاتفاق النووي الذي توصل إليه أوباما معها الأسوأ على الإطلاق. إذا ترجم ترامب هذه التصريحات إلى سياسات سيدخل في جولةٍ جديدة من الصراع مع إيران، يلقي معها كل ما حاول أوباما فعله، ثماني سنوات، في مزبلة التاريخ.
العربي الجديد
سورية.. ترامب بين المعارضة والنظام/ سميرة المسالمة
أثار انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية المخاوف والتساؤلات بخصوص السياسة التي سينتهجها تجاه الصراع السوري، في موقفه من الثورة السورية، أو من النظام، بالإضافة إلى موقفه من الأطراف الدولية والإقليمية المتصارعة إلى جانب المعارضة أو إلى جانب النظام، لا سيما إيران وروسيا.
تشير كل المؤشرات إلى أن الرئيس المنتخب لن يلجأ إلى إحداث تغييراتٍ على الاستراتيجية الأميركية الذي اتبعها سلفه، والقائمة على عدم التدخل أو التورّط، وترك الأطراف تتصارع فيما بينها، لأن هذه السياسة تتناسب مع أهوائه، ومع تصريحاته المعلنة، ومنها تأكيده على أولوية محاربة الإرهاب.
في هذا السياق، يمكن فهم إعلان وزارة الخارجية الأميركية، بعد ساعات من زيارة ترامب البيت الأبيض ولقائه الرئيس باراك أوباما، موقفها الصريح من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بإضافتها إلى قائمة الإرهاب، معتبرة أن تغيير الاسم لا ينفي عنها صفة الإرهاب فعلياً، ولا يحجب حقيقة ارتباطها بتنظيم القاعدة. وبحسب بيان الوزارة، فإنه “على الرغم من محاولات التفريق بينها (فتح الشام) وجبهة النصرة عن طريق إنتاج شعار وراية جديدين، إلا أن مبادئ الأولى ظلت مشابهةً للتي لدى تنظيم القاعدة، والجماعة مستمرة في تنفيذ الأعمال
“لن يلجأ إلى إحداث تغييراتٍ على الاستراتيجية الأميركية الذي اتبعها سلفه، والقائمة على عدم التدخل أو التورّط، وترك الأطراف تتصارع فيما بينها” الإرهابية تحت الاسم الجديد. اسم الجماعة مهما تغير سيظل تابعاً للقاعدة في سورية”. إضافة إلى ذلك، ظهرت تسريبات صحافية (في “واشنطن بوست” مثلا) تفيد بأن الرئيس أوباما أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بالعثور على قادة “النصرة” وقتلهم في سورية. وتضمن القرار نشر مزيد من الطائرات من دون طيار (الدرون) وتعزيز القدرات الاستخباراتية، واعتبرت الصحيفة أن هذا المنحى ضد “النصرة” يُرجّح أن يزداد مع تولّي ترامب الرئاسة مطلع السنة المقبلة.
ولعلّ هذا الموقف الجديد ـ القديم يؤكد أن الاستراتيجية الدولية، وخصوصاً الأميركية، بشأن الصراع في سورية، ما زالت تنحصر في أمرين: أولهما، إعطاء الأولوية للحرب ضد الإرهاب، ويأتي ضمن ذلك السعي إلى فصل قوات “المعارضة المعتدلة” عن جبهة فتح الشام، وهذا يعني العودة إلى تفاصيل الاتفاق الروسي ـ الأميركي (سبتمبر/ أيلول الماضي). أما ثانيهما، فيتعلق بتعويم مصير بشار الأسد الذي بقي نحو خمس سنوات ونصف متأرجحاً بين التصريح أولاً عن فقدانه الشرعية ثم أولوية خروجه من المشهد السوري، وصولاً إلى التسويات الغامضة التي يمكن تفسيرها بأكثر من معنى في بيان جنيف 1، ثم لاحقاً بيان فيينا. وبعد ذلك ما تسّرب عن لوزان1، مع الحديث عن استفتاء شعبي يحدّد مصيره. وللتذكير، فإن لوزان هي المدينة التي يتفاءل بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بسبب نجاحاته، على ما يبدو، بإنجاز الاتفاق النووي مع إيران فيها، وهو الانجاز الذي وعد ترامب المرشح بإلغائه في حال نجاحه، ولا نعرف إذا ما كان ترامب الرئيس المنتخب سينفذ وعده أم لا.
بديهي أن نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية التي أوصلت ترامب إلى سدّة الرئاسة فتحت المجال واسعاً لتوقعاتٍ متشائمة، بما يتعلق بملف الصراع في سورية، لأسبابٍ كثيرة، لا سيما منها تقارب وجهة نظر الرئيس المنتخب مع روسيا في ما يتعلق بأولوية الحرب على الإرهاب، ولا مبالاته بما يحصل في سورية. ومع أنه من المفيد التذكير بأن هذه الأولوية كانت، وما زالت، تحتل الحيز الأكبر في استراتيجية إدارة أوباما، إلا أنه يجدر لفت الانتباه إلى فارقٍ مهم جدا، يتعلق بأن إدارة أوباما اعتبرت روسيا شريكاً لها في هذه الحرب، بدليل الاتفاق الروسي ـ الأميركي بشأن حلب، بينما قد يختلف الأمر مع إدارة ترامب عن ذلك على الأرجح. ولعل هذا ما يمكن ملاحظته في خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس المنتخب، وأكد فيه أن الولايات المتحدة تأتي أولاً، وأنه معني باستعادة عظمة أميركا، الأمر الذي يستنتج منه أن فكرة الشراكة بالمفهوم الأوبامي ستتراجع، لتصبح مجرد إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الأخرى. أي أن “أميركا أولاً”، الترامبية، ربما تعني تولي الولايات المتحدة زمام القيادة والمبادرة، وإظهار قوتها وعظمتها وقيادتها للعالم، وليس شراكتها معه، بل وتخليها عن إعطاء وكالاتٍ للآخرين، ومنهم روسيا. وربما الأهم من ذلك لتعود أميركا العظيمة هو عودتها للدفاع عن حقوق الإنسان، ومبدأ الحريات والتزامها بدورها دولة عظمى.
مع ذلك، ربما ستحتاج الولايات المتحدة، في ظل رئاسة ترامب، إلى فترة فاصلة عن السنوات الثماني الماضية التي حاول فيها أوباما الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، وتوكيل إيران
“نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية التي أوصلت ترامب إلى سدّة الرئاسة فتحت المجال واسعاً لتوقعاتٍ متشائمة، بما يتعلق بملف الصراع في سورية” تارة وروسيا تارة أخرى، للقيام بمهمة لملمة نتائج سياسات بوش الابن، ولاحقاً أوباما، في فترة رئاسته الأولى، تلك السياسات التي كان من نتائجها ترك المنطقة لمصيرها واضطراباتها وانقساماتها الحادة. وكان غزو الأول العراق أدى إلى تفتيت هذا البلد، وتدمير مؤسساته، وجعله مطيةً للنفوذ الإيراني، في حين أن الثاني تعامل مع تداعيات “الربيع العربي” الذي أثمر في تونس، وتعثر في مصر، وأحدث حالة انفلات أمني في ليبيا، وحرباً طويلة الأمد ومتعددة الأطراف في سورية واليمن، بطريقة انتهازية ووظيفية، بعيداً عمّا تعتبره الولايات المتحدة قيمها الأساسية.
اللافت في المشهد، أو في أولويات الإدارة الأميركية في سورية، بعد أن أصبح ترامب رئيساً، ترحيب النظام السوري به، بسبب تقاربه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحليف المغامر، وتعامل المعارضة بإيجابية مع وصوله، على الرغم من أجنداته المعلنة في أثناء حملته الانتخابية، وعلى الرغم من التشكّك بموقفه من الثورة المتساوق مع روسيا، علما أن ترامب المقرّب من روسيا هو نفسه ترامب المرحّب به تركياً.
مما يزيد في توضيح سيناريو السياسة الأميركية في المنطقة أنه سيبقى على النهج السابق نفسه في الملف السوري، أي الحفاظ على ديمومة الصراع، وجعل سورية مكاناً لاستنزاف الدول الأخرى، وأولوية الحرب على الإرهاب، وفصل جبهة النصرة عن المعارضة، وعدم تمكين أي طرفٍ من تحقيق الغلبة على الطرف الآخر، إلى حين فرض الحل السياسي الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه آن أوان فرضه على الجميع، بمن فيهم روسيا. لذا، كان هناك ما يمكن لموسكو أن تقدمه لواشنطن، فهو القبول بوجهة النظر “الترامبية” الآن التي تريد لأميركا “العظيمة” أن تعود لتصدّر المشهد، وعلى كل الشركاء الآخرين في المشهد السياسي والعسكري التراجع إلى الخلف، ولعل ميدان الصراع في حلب المختبر لذلك كله.
يطرح هذا الواقع على المعارضة السورية (السياسية والعسكرية والمدنية) تكييف نفسها للتعامل مع المستجدات في المعطيات المحيطة بالوضع السوري، وفي المقدمة منه تغيير الإدارة الأميركية. كما يطرح على النظام السوري إنهاء حلمه المشترك مع إيران، وبرعاية روسية، بفرض الحل العسكري الذي سيصيب عظمة الولايات المتحدة بمقتل، حتى ولو كان ذلك بالتوافق مع شريكٍ روسي محتمل للعمل مستقبلاً.
العربي الجديد
أما نحن، السوريين، فقد جربناه من قبل/ عمر قدور
لا مبرر قوياً لدى السوريين للتخوُّف، على نحو خاص، من مجيء دونالد ترامب إلى الحكم، فالقضية السورية ليست ضمن أولوياته، مثلما لم تندرج في أولويات سابقه. هذا لا يعني الانسياق وراء القول الموروث الدارج بأن جميع رؤساء الولايات المتحدة سواء، أو أنهم مجرد واجهة لدولة عميقة لا تحول ولا تزول، أو أنهم جميعاً يبنون سياساتهم في المنطقة وفق المصالح الإسرائيلية… مثلما لا يعني عدم التمييز بين ما أعلنه ترامب وهيلاري كلينتون في ما خص القضية السورية أثناء الحملة الانتخابية، حيث تميزت عنه بوجهة نظر أكثر حزماً إزاء نظام بشار الأسد.
ترامب في الرئاسة، بموجب أقواله أثناء الحملة الانتخابية، معروف ومُجرَّب من السوريين. فهو في جوهر ما قاله لم يبتعد إطلاقاً عن سياسة أوباما إزاء القضية السورية، وانتقاده سياسة الأخير لا يعدو كونه مزايدة لفظية تتعلق فقط بسرعة القضاء على تنظيم «داعش». أما عدم الاكتراث بتنحية بشار، فذلك مشترك بين ترامب وأوباما، بل يظهر الأخير متقدِّماً عليه لجهة الفعالية. فإدارته، كما كشف عديد التسريبات، اتفقت مع موسكو على إبقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، في حال حدوثها، ومن ثم الاحتفاظ له بحق الترشح للرئاسة في الانتخابات التي تليها.
إذاً، لندع جانباً الفوارق العامة بين الرجلين والعهدين. في المسألة السورية جرّب السوريون ترامب بهيئة أوباما، بحيث تتضاءل الفوارق بين رئيس ديموقراطي وآخر هو الأكثر يمينية ضمن الحزب الجمهوري. المبررات التي ساقها أوباما لعدم التدخل ضد نظام بشار لا تختلف من حيث المؤدى عن التي يسوقها ترامب. على سبيل المثال، لا يُعدّ الأسد خطراً مباشراً على الأمن القومي الأميركي، بخلاف «داعش» الذي أعدم رهينة أميركية، ولننسَ موقتاً خطاب ترامب العمومي المعادي للمسلمين، لأنه في عمومه يتعلق بقضية داخلية هي الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولننسَ أيضاً موقفه من اللاجئين السوريين، لأن بلاده لم تستقبل أصلاً سوى عدد ضئيل منهم.
في ما يُحكى عن انسجام محتمل بين ترامب وبوتين، جرّب السوريون تنسيقاً على أعلى المستويات بين إدارة أوباما وموسكو، وجربوا أكثر من ذلك مسلسل التنازلات الأميركية التي قدمها جون كيري لنظيره سيرغي لافروف مع كل جولة من مفاوضاتهما. اللقاءات بين بوتين وأوباما لم تكن تتخللها خلافات ذات شأن حول الملف السوري، على العكس من الملف الأوكراني، مع التنويه بأن تصعيد الغرب في الملف الأخير توقّف على وقع التفاهم الروسي- الأميركي في الميدان السوري.
قيل الكثير عن أرجحية الثنائي بوتين- لافروف على الثنائي أوباما- كيري، بحيث يصعب توقع مجيء وزير أميركي للخارجية على الدرجة ذاتها من الانسجام أو قلة الحيلة إزاء نظيره الروسي، مثلما يصعب توقع أن يقبل ترامب بأكثر مما قبل به أوباما من بقاء بشار فعلياً إلى موعد غير محدّد. ففي المحصلة لن تبلغ الحماسة بترامب أن يدفع بالقوات الأميركية ليفرض تصوراً مشابهاً، ولن يفعل أكثر من سلفه عندما اشترط على منتسبي بعض الفصائل الاقتصار على محاربة «داعش» وعدم محاربة النظام مطلقاً.
أما عن عنصرية ترامب، فلن يختبر السوريون عنصرية أشد من تلك التي سمحت بإبادتهم طوال سنوات من حكم أوباما. بل إن عنصرية الأخير كانت واضحة تفصيلاً، ولو على سبيل تبرير سياساته، عندما سخر من المعارضة بوصفها مجموعة من الفلاحين وأطباء الأسنان! كذلك كان خطاب الإدارة مطلع الثورة، عن حماية الأقليات التي لم تتعرض لأي تهديد جدي، في ما ظهر أنه تسامح إزاء استهداف الأكثرية وفق مفهومها نفسه، ها هنا عنصرية تقيم التمييز بين السوريين ومَنْ يستحق الحياة منهم.
يُشاع أن ترامب سيتصرف كرجل أعمال لا كسياسي، ولكن لم يرَ السوريون أوباما يتصرف بمنطق مغاير، ولم يتحلَّ نهجه إزاء القضية السورية بقليل من الأخلاقية التي يُفترض أن تمتاز بها السياسة عن عالم المقاولات. المثال الساطع على هذه العقلية صفقة «الكيماوي» التي عُقدت ضمن المستويات الأدنى أخلاقياً لمعنى الصفقة، وكان تراجع أوباما عن خطه الأحمر الشهير يشبه أيضاً ما يُحكى عن تقلب ترامب، والأهم أنه تعامل بمنطق الكسب غير المشروع من خلال الصفقة، إذ جرّد الأسد من بعض ترسانته الكيماوية بينما دفع ضحايا سوريون الثمن. وكما هو معلوم تجاهل في ما بعد استخدام غاز الكلور على نطاق واسع ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين لأن ترسانة الكلور لا تشكل خطراً على غير السوريين.
أيضاً، تهميش أوروبا إزاء الملف السوري لا يختلف في العمق عما فعله جورج بوش الابن وقت غزو العراق، على رغم التماس الأوروبي مع قضايا المنطقة وموجات اللاجئين إلى دول الاتحاد. وإذا ركّز ترامب في خطاب فوزه على استعادة هيبة أميركا فإن أوباما لم يقصّر في إظهار هيبتها أمام الحلفاء الأوروبيين، أما التفريط الظاهر بها أمام موسكو وطهران فشأن آخر يخدم استراتيجيته في المنطقة، ولندع جانباً الكلام الذي لا سند له في الواقع عن سلبية الإدارة أو سياساتها غير التدخلية، ما دامت نشطت بفعالية ومنعت إسقاط نظام بشار بكل أنواع الضغط.
على الأرجح، لن يضيف ترامب مزيداً من السوء فوق السوء الذي أوقعه أوباما بالقضية السورية، وإذا صدق في انتقاداته للاتفاق النووي مع إيران فربما تترك مواجهته طهران آثاراً أقل سلبية على الملف السوري مما تركه التقارب معها. هو افتراض ضعيف على أية حال، ويرجّح أن يستمر في الخطوط العامة لسياسة أوباما في الملف السوري.
يبقى أكيداً أن ترامب، بموجب الخطاب الذي يقدّمه سيكون أسوأ على الصعيد الدولي، على الأقل لجهة تأثير خطابه في تعزيز التطرف العالمي، الأمر الذي ينبغي أن يعني السوريين بوصفهم جزءاً من العالم. مع الأسف، الشريحة العظمى من السوريين تشعر بأنها مُنعت من أن تكون جزءاً من العالم، ولا تملك ترف التضامن الذي افتقدته وهي تحت رحمة ترامبية أوباما. في المدى المنظور، يعلم السوريون أن الأسوأ آتٍ، لا مع قدوم ترامب وإنما مع ما تبقى من أيام أوباما.
الحياة
ترامب بين أصوليتين: «منقذ» في المسيحية… «مخلّص» في اليهودية/ ةصبحي حديدي
أشارت مواقع إسرائيلية، وكتب معلّقون إسرائيليون راسخو العلم في شؤون وشجون المجموعات الإسرائيلية اليمينية المتدينة، والمتشددة تحديداً، أنّ شرائح واسعة من هذه المجموعات ترى أنّ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يمثّل «معجزة إلهية». كما تنظر إلى شخص الرجل «وكأنه المخلّص المنتظر»، حسب توصيف موزال موعالم، معلّقة الشؤون الحزبية في موقع «يسرائيل بالس»، لأنّ ترامب سوف يسمح بتهويد الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسيحقق البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، خاصة إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية.
تقارير أخرى، وتعليقات مماثلة، يمكن العثور عليها مترجمة إلى العربية في موقع «عربي 21»، بينها ما كتبه بن كاسبيت، أحد أبرز المختصين في سياسات مجموعات اليمين الإسرائيلي المتدين، من أنّ «فورة الفرح» التي اجتاحت هذه المجموعات كانت تشبه ما وقع بعد هزيمة جيوش الأنظمة العربية في حرب 1967.
ونقل كاسبيت عن وزير التعليم المتدين، نفتالي بينيت، الذي يحدث أنه رئيس حزب «البيت اليهودي» أيضاً، قوله إنّ «ترامب يمثّل المسيح المخلّص»، وهذا ما جعله «يطالب بضمّ الضفة الغربية لإسرائيل، إلى جانب إعلانه موت حلّ الدولتين».
فإذا صنّف المرء هذا كلّه في باب هستيريا التشدد الفقهي اليهودي، وثمة هنا فصول أكثر إثارة للعجب، أو في باب خبل التأويل، الناجم عن فورة الفرح الغشيم إياها، فإنّ الأدهى، والأهمّ دلالة، هو مواقف مجموعات الضغط اليهودية، المنحازة إلى إسرائيل على نحو أعمى، إزاء بعض الشخصيات التي رُشحت لاحتلال مناصب رفيعة في فريق إدارة ترامب. على سبيل المثال الأول، عُيّن ستيف بانون مسؤولاً عن ستراتيجيات البيت الأبيض، وكبير مستشاري ترامب، فسكتت عن التعيين أبرز مجموعة ضغط إسرائيلية في أمريكا، الـ«إيباك»، رغم أنّ بانون متهم بمعاداة السامية، وباتخاذ مواقف عدائية من اليهود. كذلك رفض الخوض في الموضوع ـ على غير العادة، بالطبع! ـ غالبية المعلّقين الأمريكيين الذين اعتادوا التطبيل لإسرائيل، والتزمير عند أدنى بارقة خطر تتبدى في واشنطن ضدّ تل أبيب.
ثمّ إذا انتقل المرء إلى أمريكا ذاتها، وإلى المجموعات المسيحية المتشددة، في صفوف البيض تحديداً (وهم أمضى أسلحة الحزب الجمهوري، في مواسم الانتخابات خصوصاً)، فإنّ المؤشرات تقول إن غالبية ساحقة من هؤلاء اختاروا ترامب، بل خاضوا معارك شرسة، «من باب إلى باب» كما يُقال، لدعم حملته، وتسهيل انتخابه. ورغم الارتياب في حقيقة إيمان ترامب، من زاوية دينية مسيحية، فإنّ 80٪ من الناخبين الإنجيليين البيض صوتوا له مقابل 15٪ من الإنجيليين السود والهسبان. وكما هو معروف، انبثقت الحركات الإنجيلية في أواسط القرن العشرين، وبدت غير مكترثة بالسياسة والتحزب، حتى اجتذبتها إلى المعمعة قوانين تشريع الإجهاض، مثلاً، وكانت سنة انتخاب جيمي كارتر، «المتدين» و»الورع» كما صُوّر يومئذ، بمثابة الذروة في التنشيط السياسي للحركات الإنجيلية.
طريف، في المقابل، أنّ هذه الشرائح تتلاقى مع تلك الشرائح اليهودية المتدينة في إسرائيل، حول سلسلة من التفسيرات الفقهية، توراتية المنابع، حتى إذا ظلّت قاصرة في التفسير أو مفرطة في التأويل. ثمة نظرية متكاملة (جرى التبشير بها في القرن الثامن عشر)، تقول بعودة يسوع إلى عالمنا هذا لتخليصه من الشرور، وذلك حين تكتمل جملة شروط: قيام دولة إسرائيل، ثمّ نجاحها في احتلال كامل «أرض التوراة»، أي معظم الشرق الأوسط، وإعادة بناء الهيكل الثالث في موقع، وعلى أنقاض، قبّة الصخرة والمسجد الأقصى، وأخيراً، اصطفاف الكفرة أجمعين ضدّ إسرائيل، في موقعة ختامية سوف يشهدها وادي أرماغيدون (دون سواه!)، حيث سيكون أمام اليهود واحد من خيارين: إمّا الاحتراق والفناء، أو الاهتداء إلى المسيحية، الأمر الذي سيمهّد لعودة المسيح المخلّص!
وكما هو معروف، هنالك سلسلة ولايات تُلقّب بـ «حزام التوراة» نسبة إلى شدّة تديّن أبنائها. وثمة شبح يجوس ليالي، ونهارات، كبار ممثّلي الحزب الجمهوري، خاصة حين تأزف مواعيد انتخابات الكونغرس أو الانتخابات الرئاسية، متخذاً هيئة كابوس يحمل الويل والثبور عند البعض، أو هيئة ملاك حارس يحمل البشرى والسند عند البعض الآخر. وهذا شبح من لحم ودمّ، صاخب، مشاكس، لا يكفّ عن اتخاذ المواقف وإطلاق التصريحات التي تضعه على كلّ شفة ولسان: إنه ماريون غوردون (بات) روبرتسون، المؤسس والزعيم التاريخي لمنظمة «التحالف المسيحي»، أكثر الحركات الدينية القاعدية نفوذاً وسطوة في السياسة الأمريكية المعاصرة.
روبرتسون ذهب إلى حدّ وضع ترامب في مصافّ يسوع، وحكى للمؤمنين هذه «الرؤيا»: «زارني الله في المنام ليلة أمس وأراني المستقبل. أخذني إلى السماء، وهناك رأيت دونالد ترامب جالساً على يمين الربّ مباشرة». أيضاً، استهجن روبرتسون ما تردد حول فضائح ترامب الجنسية، معتبراً أنه «عنقاء سوف تنهض من الرماد»! وليس من الحصافة أن يُنظر باستخفاف إلى موقف كهذا، أو أن يهمله المراقب المعنيّ بالديناميات الداخلية لمشهد الحركات الأصولية المسيحية، من الطراز الذي يقوده روبرتسون على وجه التحديد. الرجل كان مرشّح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التمهيدية لعام 1988، وحركته تضمّ ما يزيد على 1.2 مليون عضو منتسب، وتُقدّر لائحة بريدها الإلكتروني بنحو 2.8 مليون عنوان، وتدير إمبراطورية هائلة عمادها التبشير الديني المتلفز عبر عشرات الشاشات، التي بينها الشبكة المعروفة CBN، فضلاً عن «قناة الأسرة» المستقلة، والعديد من الإذاعات، وجامعة معلنة واحدة على الأقل هي جامعة ريجنت، و«المركز الأمريكي للقانون»
فوق هذا وذاك، التفّ ويلتفّ حول المنظمة كبار أفيال الحزب الجمهوري، ممّن يشغلون أرفع المسؤوليات في الكونغرس (حين يكون الحزب خارج السلطة)، وفي البيت الأبيض حين يكون الرئيس جمهورياً، واللائحة أطول من أن يفصّل المرء أسماءها الشهيرة ومواقعهم الحساسة. والمنظمة، إجمالاً، تسيطر على ممثلي الحزب الجمهوري في أكثر من 12 ولاية، بما في ذلك تكساس وفلوريدا، ولوائحها للانتخابات المحلية بمختلف صنوفها تحصد عادة نسبة تتراح بين 40 و60٪. وفي انتخابات 2000 الرئاسية، كان السناتور الجمهوري جون ماكين (المرشّح آنذاك لبطاقة الحزب) قد اضطرّ إلى خوض معركة شرسة ضدّ روبرتسون، المتحالف مع جورج بوش الابن، قبل أن يلعق جراحه، ويطوي جناحيه، وينسحب من معركة الترشيح.
وفي صيف 2006 سارع روبرتسون إلى إسرائيل، لكي يصلّي مع رئيس وزرائها آنذاك، إيهود أولمرت، من أجل انتصار جيشها في عدوانه البربري على لبنان. هنا فقرة ممّا فاضت به روحه من «مشاعر» خلال تلك الصلاة: «أنا هنا لكي أقول إنني أحبّ إسرائيل. أنا هنا لكي أقول إنّ المسيحيين الإنجيليين في أمريكا يقفون مع إسرائيل في كفاحها. ومن أجلنا جميعاً، لا ينبغي لإسرائيل أن تخسر هذا الكفاح. أعتقد أنّ شعب إسرائيل يعرف أصدقاءه، ويعرف أنّ أصدقاء إسرائيل هم المسيحيون الإنجيليون». ختام تلك «المشاعر» كان المزاودة على أعتى صقور الدولة العبرية، حين اعتبر روبرتسون أنّ مرض أرييل شارون هو «عقاب إلهي»، سببه قرار الأخير بالانسحاب من غزّة!
فهل من الغرابة، والحال هذه، أن تتقلّب النظرة إلى ترامب عند الأصوليتَيْن، اليهودية والمسيحية، بين «المعجزة» و«المنقذ»، دون أدنى اكتراث بسجلّ الفضائح والمخازي، أو بأمزجة العداء للسامية، لدى بعض رجالات الإعجاز والإنقاذ؟ أو، بالأحرى، هل من الحكمة أن يتناسى المرء أنّ التقاء المصالح، في غمرة هستيريا التأويل وعماء التشدد، على غرار ملتقى الأصوليتَيْن، هو القاعدة وليس الاستثناء؟
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
ترامب السوري/ منير الخطيب
تتخذ الحرب على الإرهاب في سوريا بعداً جديداً بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. صحيح أن المعطى الأميركي لم يكن حاسماً ميدانياً خلال سنوات الحرب الخمس الماضية، إلا أن التبدل الجديد كفيل بإحداث نقلة نوعية تعجل بوضع حد لمعاناة السوريين على مشارف العام السادس للحرب المفروضة عليهم.
التبدل مناقض لكل التوقعات التي كانت سائدة خلال ظهور المد التكفيري، والتي وصلت إلى حدودها القصوى في التشاؤم مع السيطرة على أجزاء واسعة من سوريا والعراق وخروج مناطق إضافية عن سلطة بغداد ودمشق لمصلحة دويلة كردية في طور التشكل. اليوم بات محسوماً أن الدولتين السورية والعراقية على طريق استعادة المبادرة، وفرض إعادة استمرار وجودهما ضمن حدودهما المتعارف عليها قبل الغزو «الداعشي».
فكرة بقاء الدولتين في إطارهما السيادي كانت تبدو مستحيلة، حتى بين حلفائهما الأكثر تفاؤلاً. الرغبات الإسرائيلية التقسيمية، والأطماع التركية والطموح الكردي لدولة، والزخم الأصولي التكفيري الذي استقطب عشرات آلاف المجانين من حول العالم للقتال في بلاد الشام، لم تترك مجالاً ولو ضيقاً إلا لاستمرار الحرب إلى أمد طويل.
مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدء التصريح عن سياسة أميركية خارجية تنتهج الانكفاء، وتعيد تعريف العدو بأن تضع الإرهاب التكفيري في طليعة المخاطر الاستراتيجية، صار من الممكن الحديث عن خريطة طريق حقيقية لإنهاء «داعش» وأخواتها. وأول معالم هذه الطريق إعادة ترميم الدولة السورية المركزية ودعمها بالوسائل الضرورية لإعادة بسط سيادتها داخل حدودها من دون تجزئة، بدعم متزايد من روسيا التي وسعت أخيراً دائرة عملياتها العسكرية.
وصول ترامب إلى البيت الأبيض تزامن أيضاً مع تحول أوروبي في التعاطي مع قضية النزوح السوري الذي تتعاظم مخاطره المادية والأمنية والاجتماعية يوماً بعد يوم، وبات المؤثر الفاعل في توجهات الناخبين وصعود اليمين المتطرف الذي يمقته كثر، ومع ذلك يصوتون لسياساته الحمائية.
ترامب لم يتردد للحظة في تأكيد خياراته السياسية في الحرب السورية التي أطلقها خلال الانتخابات وزاد عليها عرضاً بالتعاون في مكافحة الإرهاب خلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قد لا يكون الرئيس الأميركي المنتخب مدعاة للتفاؤل. مواقفه العنصرية وسرعة غضبه وحدة انفعالاته لا تؤهله ليكون حليفاً يركن إليه. كذلك الأمر في مجموعة المستشارين المحيطين به، والمرشحين لتولي الشؤون الخارجية والعسكرية والأمن القومي في إدارته، ولبعضهم مقترحات لحل أزمات المنطقة كفيلة بإشعال الحروب فيها لعشرات السنين: من قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة إلى إقامة دولة «صحوات» سنية في البادية الممتدة بين سوريا والعراق، أو إعادة نشر قوات أميركية في العراق تداركاً لخطأ إدارة باراك اوباما تقليص التواجد العسكري غير المدروس بحسب ما يردد مستشارو ترامب، علماً أن ذلك يتعارض مع سياسة الانكفاء، إلا أنه يعزز أميركا المتفوقة، رأس الحربة في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي بات القوة اللاتقليدية الأخطر والأكثر انتشاراً حول العالم.
ترامب حليف لا يركن إليه محاط بمستشارين ربما أكثر جنوناً منه ولهم دراية بعمل الإدارة الأميركية التقليدية والمؤسسات الدولية، وغالبيتهم من صقور المحافظين. أي أثمان سيادية ووطنية سندفعها للحليف الأميركي الجديد؟
السفير
عن مظاهر الانحطاط في منطقتنا وفي هذا العالم/ هوشنك أوسي
من غرائب النخب المعارضة للأنظمة الشرق أوسطيّة وعجائبها، أنها عارضت سياسات الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش وممارساته ومشاريعه، وخاطت له أطقم الكلام والأوصاف التي خاطتها للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أيضاً، قبل الإعلان عن فوزه في الانتخابات الأخيرة. لكن، حين جرّبت هذه النخب إدارة باراك أوباما وخذلانه المحنة السوريّة، صار الكثير من هذه النخب يترحّم على إدارة جورج دبليو بوش، من دون الجهر بذلك، بحيث تأكّد لهم أن «جنون» بوش كان أرحم من «عقلانيّة» أوباما على الشرق الأوسط.
اللافت، أنه أثناء الحملة الانتخابيّة في أميركا، تعاملت مؤسسات إعلاميّة عربيّة كثيرة، ومنها صحيفة «الحياة»، مع ترامب بشيء من الرفض أو النقد، عبر نشر صور له في حالات غريبة عجيبة، تارةً كأنّه «مهرّج»، وأخرى كأنّه «وحش». علماً أنه كان في الإمكان نشر صور عادية له، تخفف من وطأة مساعي الشيطنة التي مارستها الحملة الانتخابيّة لهيلاري كلينتون ضده، وانزلق نحوها بعض المؤسسات العربيّة أيضاً، من حيث يدري أو لا يدري، ومن دون حساب أن هذا الرجل الذي يظهرونه في صور مرعبة وبشعة، قد يصبح رئيس أميركا الذي سيصافحه رؤساء الدول العربيّة وملوكها لاحقاً!.
وبعد الإعلان عن فوز ترامب، أيضاً دخلنا حلبة التندّر والتشخيص والتحليل لشخصيّة هذا الرئيس وتجربته، وقيل أن الأمر كان مفاجئاً، وينبئ بحالة من التدهور الدولي أكثر من التي تسبب بها أوباما (المثقف والعاقل). وربما تمثلت الخلاصة المشتركة بين غالبية التحليلات بأن العالم ينحدر نحو الجنون، باعتبار أن الخيار الأميركي استقرّ على ترامب. وفي هذا الحكم الكثير من الصحّة. لكن الجنون الأميركي الذي فرز وصول ترامب الى البيت الأبيض، سبقه جنون شرق أوسطي فرز عقوداً من الفساد والاستبداد والإفساد والدمار السياسي وعلى جميع الصعد. وعلى سبيل التذكير لا الحصر:
ما تشهده سورية من حرب يشنّها نظام القرداحة على الشعب السوري منذ ما يزيد عن خمس سنوات، هل فيه شيء من العقل والمنطق أو حتى الضمير؟! وهل الانحياز المصري والجزائري واللبناني… الى هذا النظام الفاشي، فيه شيء من العقل والمنطق؟!
ما يشهده العراق من احتراب وتغوّل وتوحّش طائفي (سنّي – شيعي)، وسيطرة إيرانيّة مطلقة على البلد، والتدخّل التركي فيه، هل في ذلك شيء من المنطق والعقل؟!
تفاقم القمع الإيراني الداخلي، وصمت المجتمع عن ذلك، وعن عودة الآلاف من أبناء إيران في توابيت من سورية والعراق واليمن، هل فيه شيء من المنطق والعقل؟!.
هل ما حصل ويحصل في تركيا، من حرب أهليّة منذ 1984 وحتّى الآن، وإنكار وجود وهويّة وحقوق شعب يناهز العشرين مليوناً، وحملات التخوين والاعتقالات التي تشهدها تركيا قبل الانقلاب الفاشل وبعده، وتحويل الدولة إلى سجن كبير للمجتمع، واحتمالات العودة الى عقوبة الإعدام، فيه شيء من العقل والمنطق؟!
استشراء التطرّف الإسلامي في البلدان الأوروبيّة، بين أبناء الجيل الثالث من المهاجرين العرب والمسلمين الذين حصلوا على الكرامة والعمل والتعليم والحريّة والأمان في هذه البلدان، والهجمات الإرهابيّة الدمويّة التي طاولت مدناً وعواصم أوروبيّة عدّة، وردّة الفعل الأوروبيّة على ذلك عبر ارتفاع منسوب شعبيّة الأحزاب القوميّة المناهضة للأجانب والمسلمين، هل في هذا شيء من العقل والمنطق؟!
على ضوء ما سلف، ثمّة نهوض أو استنهاض للشعبويات في كل بقاع الشرق الأوسط، وقد بات ينقله الشرق أوسطيون إلى مهاجرهم أيضاً. وهذا يتمثّل في تفاقم التمزّق بين الكرد أنفسهم، أو بين الكرد والعرب، أو بين العرب أنفسهم، وبين العرب والفرس، أو بين الفرس أنفسهم، وبين الفرس والترك، أو بين الترك أنفسهم، وبين الترك والكرد، وبين المسلمين والمسيحيين واليهود، بكل مللهم ونحلهم، ما يطيح المتبقّي من مساحة العقل في السلوك البشري السوي، ويغتال كل بصيص للوعي النقدي.
لقد كتب أمين معلوف قبل سنوات «اختلال العالم». وأعتقد أنه بات من الممكن أن يكتب أو أن نكتب «انحدار العالم» أو «انحطاطه». لكن، إلى أي درك سيصل بنا هذا الانحطاط؟!
الحياة
المأساة ليست في ترامب/ نارت عبدالكريم
يُقال أن لون المحيطات والبحار أزرق لأنه انعكاس للون السماء، ويقال أن السماء زرقاء لأنها انعكاس للون الماء في البحار والمحيطات، ومما يقال أيضاً، على سبيل المثل، أن الإنسان في حاجة إلى الطعام للحصول على الطاقة الضرورية من أجل البقاء والتكاثر، وقد عرفنا الطعام ولكن ما هي هذه الطاقة التي نبحث عنها فقط من خلال الطعام؟ ويُقال أن الموسيقى غذاء الروح، وقد عرفنا الموسيقى، ولكن هل عرفنا الروح حتى نغذيها؟ ويُقال أشياء كثيرة نرددها من جيل إلى آخر بانصياعٍ تام وأبله. ثم نطلق على عملية الترديد تلك اسم «عملية التربية والتعلم».
إن لكل فرع من فروع العلم واختصاصاته بضع مسلمات أساسية يقوم عليها، مثل المتوازيين اللذين لا يلتقيان في هندسة إقليدس ومساحة الدائرة الثابتة… إلخ. فإذا كان هنالك خطأ في المسلمات، فإنَّ كل ما بني عليها، مهما بدا جميلاً ومفيداً على المدى القريب، هو باطل وخطأ. فالمأساة ليست في نجاح ترامب ولا في حلب أو في الموصل، بل هي في المسلمات التي تقوم عليها حضارتنا البشرية بالمجمل، ألا تُشير سيرتنا على سطح هذا الكوكب إلى وجود خطأ في مسلماتنا؟ أم إنه الكبرياء والغرور الذي يمنعنا من مراجعتها وفحصها؟
* كاتب سوري
الحياة
الانتخابات الأميركيّة والديكة الروميّة البريّة/ ناصر الرباط
في فيلم وثائقي رائع على التلفزيون الأهلي الأميركي قبل سنوات عدة، قدم باحث في علم الحيوان قصة حياته مع ستة عشر فرخاً من الديكة الرومية البرية التي عاشت معه لمدة عام كامل على أنه أمها وأنها تبعته في كل مكان إلى أن أخذها نداء الطبيعة بعيداً منه واحداً بعد الآخر. الفيلم مؤثر بطريقة مدهشة، لكن أكثر ما جذبني فيه عبارة فلسفية قالها الباحث بعد فقده أولاده الديكة الرومية كلها: «تعلمت منها الكثير، لكن الدرس الأهم أن الديكة الرومية البرية تعيش اللحظة فقط، تتمتع بها من دون اعتبار للماضي أو ترقّب للمستقبل».
ظننت لفترة طويلة بعد سماعي هذه العبارة، أنها ملاحظة عميقة يجب عليّ، علينا جميعاً، الأخذ بها لكي نعيش حياة أقل هموماً وقلقاً. لكني، وأنا أتابع مجرى الانتخابات الأميركية الأسبوع الماضي، وجدتني أتذكر هذه الأمثولة برعب حقيقي. فالشعب الأميركي الذي انتخب دونالد ترامب رئيساً، يبدو أنه فقد القدرة على التعلم من الماضي أو التهيؤ للمستقبل، وأنه أضحى يعيش اللحظة فقط: اللحظة التي تسكن مخاوفه من واقعه وتدغدغ مشاعره بتفوق متخيل، والتي علّبها له دونالد ترامب وآلته الانتخابية بأكثر الطرق فجاجة وسوقية.
لا أريد العودة إلى مقارنة حملة ترامب الانتخابية بحملة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، ولا حتى العودة إلى حملة بيرني ساندرز، التي جعلت كثراً منا يتفاءلون بعودة وعي سياسية إلى الجيل الأميركي الجديد تحاول استعادة زمام المبادرة من طبقات المتنفذين وممثلي المصالح الرأسمالية الكبرى، الذين سيطروا فعلاً على الحياة السياسية الأميركية في العقود الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير، بغض النظر عن كونهم يدعمون مرشحين ديموقراطيين أو جمهوريين. ولا أريد المفاضلة بين البرامج الانتخابية (أو انعدامها في حالة ترامب) التي قدمها المرشحون في هذا الموسم الانتخابي، ومقارنتها ببرامج انتخابية سابقة أو تحليل تغيُّر محتواها ومنحاها باتجاه محافظ أكثر تشدداً عموماً، وبطغيان الأفكار الاقتصادية النيو ليبرالية عليها وعودة الانعزالية الأميركية الشهيرة من بدايات القرن العشرين للإطلال فيها. فهذه كلها نقاط تكرر تحليلها والإشارة إلى أخطارها داخلياً وعالمياً في الصحافة الأميركية والعالمية على حد سواء. ما أريد التركيز عليه هو ما ألاحظه كشخص يقيم في الولايات المتحدة منذ ٣٦ سنة ويمارس حقوقه السياسية هنا بانتظام. وأظن أني لا أبالغ إذا قلت بأني ألاحظ منذ زمن، تدهور الوعي السياسي عند طبقات عدة من الشعب الأميركي وصعود فلسفة انعزالية وتفوّقية في الآن نفسه ترى أن العالم أصبح مكاناً خطراً بالنسبة الى أميركا، وأن أنجع الحلول في مواجهة هذا الواقع هو التعامل معه بعدوانية أو الانعزال عن أخطاره ومقاطعته، بل بناء جدران حقيقية تمنعه من التسلل إلى الفضاء الأميركي الاستثنائي.
الظاهرة الأخطر في الحقيقة هي ظاهرة العيش لليوم أو كما تقول عبارة هوراس، الشاعر الروماني، الشهيرة «انتهز اليوم»، والتي ترمز عادة الى موقف الأبيقوريين أو المتعويين الذين كان هوراس واحداً منهم. لكن هذه الظاهرة المرعبة في أميركا اليوم تجاوزت فكرة التلذذ بالعيش لليوم، التي نهت عنها كل الديانات والمنظومات الأخلاقية، والتي تحدتها الفلسفة الحداثية وقلبتها أدوات الاستمتاع الإلكترونية رأساً على عقب. وهي قد تطورت إلى موقف شبه وجودي اعتنقته شرائح واسعة من الشعب الأميركي، التي وجدت أنها خسرت كل ما لديها في النظام الاقتصادي النيو ليبرالي المعولم الذي فرض عليها فرضاً في العقود الأخيرة، والتي لم تسعفها أجهزة الدولة، سواء كانت بإدارة جمهورية أو ديموقراطية، في استعادة رخائها المادي الماضي أو احترامها لنفسها كمجموعات واعية سياسياً ومتماسكة اجتماعياً. التفكيك الاقتصادي، الصناعي والزراعي والخدماتي، الذي شهدته الولايات المتحدة أخيراً، والنظام المالي الجشع والنهاب الذي سيطر على موارد الناس والشركات من طريق انفلات إدارة الديون والفوائد وصعود منظومات استثمار خطرة ومتهورة، أديا إلى إفقار مزرٍ لجموع كبيرة، ما تسبب بانحلال اجتماعي وأخلاقي لم يسعفه تدهور نظام التعليم أو اضمحلال دور المؤسسات الثقافية العامة بسبب الاقتطاع المستمر لأجزاء متعاظمة من ميزانياتها على مدى الثلاثين عاماً المنصرمة.
هذه هي خلفية الانهيار السياسي والأخلاقي والمعرفي وفكرة الاستقالة من الحياة العامة أو العيش للحظة من دون معرفة بالماضي أو التشوف الواعي للمستقبل، التي طبعت ردة فعل كثر من الناخبين الذين أيدوا انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. ترامب نفسه هو نتاج هذا النهج الاستهتاري الجاهل، وهو قد لقي آذاناً صاغية لدى العديد من الأميركيين الذين يشاركونه المقاربة من الحياة العامة التي تفاخر بها خلال حملته الانتخابية. فهو لا يقيم وزناً لسلطة الدولة ويتهرب من دفع الضرائب بانتظام. وهو لا يحترم النساء أو الأقليات ويفاخر بسوقيته الجنسية التي على ما يبدو تجد استحساناً لدى كثر من الرجال الذين فاجأتهم نجاحات حركة تحرر المرأة التي كادت توصل امرأة إلى سدة الرئاسة. وهو لا يهتم بالتزامات الولايات المتحدة الدولية التي تشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على من يريد التقوقع داخل بلاده الشاسعة والاستمتاع بخيراتها من دون حساب أو التزام تجاه البيئة أو النظام الاقتصادي العالمي. وهو يخاف من صعود الملونين والأقليات واقترابهم من تشكيل أكثرية عددية في الولايات المتحدة قد تهدد سيطرة الرجل الأبيض على مقدرات البلاد، والتي يراها ترامب ومؤيدوه منحة إلهية طبيعية. وهو لا يتوانى عن التباهي بالقوة العسكرية والقتالية للولايات المتحدة، ولن يتردد في استخدامها لحل نزاعات مع دول أجنبية، بخاصة إذا كانت من دول المستضعفين في الأرض أو الأدنى منزلة عرقياً.
في قصة فراخ الديكة الرومية البرية الستة عشر التي كانت تعيش ليومها، ماتت خمسة عشر منها قبل إكمال عامها الأول. ربما ماتت راضية بما أنها لم تعرف التعلم من الماضي أو التخوف من المستقبل. لكنها ماتت. طبعاً لا أظن أن قدراً مشابهاً ينتظر الشعب الأميركي. ولا أظن أن الولايات المتحدة ستفقد ديناميتها العملية أو سيادتها العالمية في أي وقت قريب بغض النظر عن سياسات ترامب التي لا نزال لا نعرف شيئاً واضحاً عنها. لكن شيئا مهماً تغير في هذه الانتخابات، وهو ربما كان تغيراً لا عودة عنه باتجاه نظام سياسي أقل تمثيلاً وأقل وعياً، ولو أني لا أشارك المخرج التقدمي مايكل مور استنتاجه الحدي عن هذه الانتخابات، علماً بتعاطفي مع مشاعره وتخوفاته في شكل عام. فهو أنهى مقالاً غاضباً له عن الانتخابات قبل الإعلان عن نتيجتها بعبارة وجهها لناخبي ترامب: «أردتم أن توجهوا رسالة غاضبة [للنظام السائد]، رسالة محقة ورسالة مبررة. لقد وصلت مع اقتراعكم. لكنكم قد انتخبتم آخر رئيس للولايات المتحدة».
* كاتب سوري وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
الحياة
أوروبا الخائفة/ علا عباس
يغلب الذعر الشديد على المشهد العام في أوروبا، وقد بدأ شعور الخوف الذي ولده السياسيون وضخّمته وسائل الإعلام يتسرّب إلى المواطنين، وهناك قلقٌ من المستقبل وحالة اضطراب، وشعورٌ عام بأن ما سيأتي لا يمكن لأحدٍ التنبؤ به، ولا توقع تبعاته وتداعياته.
وليس سبب الذعر ظاهرةً فلكيةً ما، ولا تحذيرات جيولوجية من وقع كارثةٍ طبيعية ما، ولا انهيارات اقتصادية، ولا تهديدات أمنية جدية أو كبرى. كل ما في الأمر أن الأميركان انتخبوا دونالد ترامب لرئاسة بلدهم لأربع سنوات مقبلة، وتتصرّف أوروبا وكأنها مستهدفة من هذا الانتخاب. وبدأ الناس يشعرون وكأن هتلر يولد من جديد، وربما قريباً ستبدأ الجيوش النازية بالتقدّم لاحتلال المدن الأوروبية. قد يبدو هذا الكلام مبالغةً لفظية، لكنه وصفٌ استخدمته إحدى وسائل الإعلام الفرنسية لتوصيف انتخاب ترامب.
وفي اجتماعاته المكثفة، يتعامل قادة الاتحاد الأوروبي مع نجاح ترامب على أنه “حادثة” انتخاب ترامب التي ستقلب العالم رأساً على عقب، وستغيّر توازناته، وستنسف كل ما عمل العالم على إنجازه خلال السنوات الماضية. وتدور التصريحات الأوروبية حول ملفاتٍ منتهية أو مواضيع باتت، أو تكاد تكون من المسلمات، مثل الاتفاق النووي مع إيران واتفاقية المناخ، وحتى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي بقي مستقراً لم تمسّه أي حادثة منذ تأسيسه. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي من مقره في بروكسل نيته تطوير قدراته العسكرية بشكلٍ مستقل عن الولايات المتحدة، بسبب الشكوك حول سياسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشأن التعاون العسكري والأمني مع دول الاتحاد ضمن حلف “الناتو”. وأكد الاتحاد الأوروبي عزمه مواصلة العمل على تنفيذ اتفاق تغير المناخ، وحماية الاتفاق النووي الإيراني، وجميع الأزمات الدولية، والتي عمل عليها، خلال هذه السنوات الثماني الماضية، جيداً مع الولايات المتحدة الأميركية.
ومجرد عقد هذه الاجتماعات الطارئة لبحث العلاقة بين الولايات المتحدة والقارة الأوروبية، كافٍ لإثارة الذعر في صفوف المواطنين الذين بدأوا يتلمسون خطراً لا يعرفون ماهيته حتى الآن.
قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، كلاماً يثير البلبلة ويزيد المخاوف، مثل “سننتظر إلى حين معرفة جدول أعمال سياسة الإدارة الأميركية المقبلة وتوجهاتها، والكشف عن سياستها الخارجية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي، في الأثناء، عمله، لأن العالم لا ينتظر، وسيمضي في انتظار تحديد الإدارة الأميركية المقبلة مواقفها والأجندة السياسة الخارجية الخاصة بها”.
وقد بنيت هذه التخوفات الأوروبية، إن لم نقل السياسات، على تصريحات دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية، والتي قال فيها كل ما خطر في باله، حتى وصل إلى مرحلةٍ قال فيها إن من حق الولايات المتحدة أن تأخذ ثمناً مقابل حماية حلفائها والدفاع عنهم، وإن الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفاء، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، ستكون مشروطة. وفي الوقت نفسه، عبر عن مواقف شديدة الاختلاف حول قضايا، مثل اتفاقية المناخ والاتفاق النووي الإيراني وعلاقات الولايات المتحدة مع العالم.
كان المواطنون الأوروبيون، حتى اللحظة، يتابعون الانتخابات الأميركية، وكأنها واحدة من برامج تلفزيون الواقع. وكانت شخصية ترامب مسليةً لهم، لكن تصرفات قادتهم، أخيراً، وتصريحاتهم تقلقهم، ففور إعلان نتائج الانتخابات الأميركية أعلنت دول أوروبية عن قلقها من تداعيات فوز ترامب، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، وهذا حدث غير مسبوق في الأعراف الدبلوماسية، كذلك فإن السياسة الأوروبية حيال انتخاب ترامب بدأت تنقل شعوراً شعبياً بأن الأمر خطر جدي، وقد يشكل، في المستقبل، تهديداً يمسّ حياتهم، ويمكن تلمس هذا الشعور من خلال وسائل الإعلام، ومن خلال الاحتكاك بالناس في الحياة اليومية.
ربما يكون لهذا القلق ما يبرّره، وربما يكون فيه بعض المبالغة، والمعروف أن تصريحات الانتخابات لا تتطابق، بالضرورة، مع السياسة التي سينتهجها المرشح، لكن حالة الخوف الشعبي تم زرعها وتعميمها، وقد يكون لها نتائج غير متوقعة على الانتخابات المقبلة، لا سيما هنا في فرنسا، والتي لم يبق لها سوى بضعة أشهر. وربما يكون لها آثار أبعد قليلاً، فقد بدأت تصدر تصريحاتٌ خجولةٌ عن ضرورة إعادة النظر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وأن المتغيرات الجديدة في الولايات المتحدة ستجعل البريطانيين، وبقية الأوروبيين، بحاجة أكثر لبعضهم.
(إعلامية سورية)
العربي الجديد
منطقتنا في عهد دونالد ترامب/ جلبير الأشقر
أسبوع واحد مضى منذ أن أرسلتُ مقالي السابق إلى قلم تحرير «القدس العربي»، والعالم لا يزال تحت وقع الصدمة الهائلة والقشعريرة اللتين أصيب بهما غداة ذاك اليوم، يوم الثلاثاء الماضي الواقع في الثامن من الشهر الجاري وهو تاريخ الانتخابات الأمريكية. قررت يومذاك أن أخصّص مقالي للسياسة الشرق أوسطية للرئيس/ة الجديد/ة، وقد سبق أن طلب مني موقع «الجزيرة» باللغة الإنكليزية مقالاً حول الموضوع نفسه قبل أيام من الانتخاب وأجبت أن الأمر يعتمد على من سوف يتم انتخابه. فتم الاتفاق بالتالي على أن أكتب مقالين، واحد عن كل من الاحتمالين، وأن يجري نشر المقال المناسب حالما تُعلن النتيجة. أما ومقالي في «القدس العربي» يصدر يوم الأربعاء وينبغي عليّ إرساله يوم الثلاثاء، فلم يكن الانتظار ممكناً. واضطررت بالتالي إلى الكتابة عن أحد الاحتمالين مرجحاً ذلك الذي وصفته الاستطلاعات بالأوفر حظاً طوال ذاك النهار الطويل، ألا وهو احتمال فوز هيلاري كلينتون (مع التحفظ بكتابة المقال بالصيغة المشروطة).
وللأسف الشديد جاءت النتيجة صدمة لا تضاهيها وقعاً في الذاكرة العالمية الحديثة سوى صدمة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، يوم اعتداءات تنظيم «القاعدة» في نيويورك وواشنطن. فاستفاق العالم يوم الأربعاء الماضي على تأكد خبر فوز رجل أرعن بنى حملته الانتخابية على مسايرة أسوأ النزعات الكامنة في مجتمعه، رجل سوف يرتهن مصير العالم بنزواته لمدة أربع سنوات على الأقل، هذا إن استكمل ولايته (اشتراط متفائل) وإذا لم يفز بثانية (اشتراط متشائم).
وقد صدرت خلال الأسبوع المنصرم مقالات وتعليقات لا تُحصى تحاول سبر نوايا الرئيس المنتخب في السياسة الخارجية بوجه عام وشؤون الشرق الأوسط بوجه خاص، وقد ساهمتُ شخصياً في التخمينات بوسائط شتى. لذا أودّ الآن أن ألتفت بسرعة إلى بعض ردود الأفعال الإقليمية على انتخاب دونالد ترامب. وأبدأ من إيران حيث يُخبرنا مراسل صحيفة «فايننشال تايمس» أن المتشدّدين في النظام الإيراني ينظرون بتفاؤل إلى أمرين متناقضين: فهم يرون أن تنفيذ ترامب لوعيده بسحب الموافقة الأمريكية على الاتفاق النووي الذي عقدته المجموعة الدولية مع طهران من شأنه أن يدعم سيطرة المتشدّدين على سياسة إيران الداخلية والخارجية على حساب الإصلاحيين، كما ينظر المتشدّدون بسرور إلى وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بالتقارب من روسيا، حليفتهم في سوريا، والتعاون معها في تثبيت بشّار الأسد في سلطة البلد المنكوب.
وتأتينا أصداء الترحيب بدونالد ترامب من قبل كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتمنّى أن يدعم الرئيس الأمريكي الجديد سياسته السلطوية الداخلية وحربه على الحركة الكردية، والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي الذي هو الرئيس العربي الوحيد الذي التقى بدونالد ترامب عندما كان هذا الأخير لا يزال مرشحاً، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أو من يتكلّم باسمه) الذي استاء من معارضة واشنطن، ومعارضة هيلاري كلينتون نفسها عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية، لتمديد رئاسته.
أما الأمر المشترك بين الأطراف الأربعة المذكورة فهو النزعة السلطوية المتأسفة على زمن الحرب الباردة الذي كانت فيه كل من واشنطن وموسكو تؤيد الدكتاتوريات بلا حرج ما دامت نصيرة لمصالحها. وهو ما حدا بتلك الأطراف إلى التقارب من روسيا التي بات رئيسها فلاديمير بوتين أبرز ممثل عالمي للاستعداد على دعم الأنظمة السلطوية بلا أدنى حرج، لا سيما وأنه يشرف بنفسه على نظام سلطوي في بلده، وإن كان يحظى بدعم شعبي. وليس من تناقض بين الدعم الشعبي والسلطوية كما هو معلوم، والحال أن كل طرف من الأطراف الإقليمية الأربعة المذكورة يحوز على قدر ما من القاعدة الشعبية.
وينضاف إلى تلك الأطراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتمنّى أن يُطلق ترامب يديه تماماً في وجه الشعب الفلسطيني، بدون حتى إبداء ذلك التذمّر الخجول الذي صدر عن إدارة أوباما بين الحين والآخر. فيكتمل المشهد الذي يجعل من انتخاب دونالد ترامب على رأس الولايات المتحدة حلقة إضافية بل أساسية في تعميق المنعطف الرجعي الذي خيّم على المنطقة العربية منذ ثلاثة أعوام. فتلتقي الأعراض المرَضية الخاصة بمنطقتنا بالأعراض المرَضية التي تولّدها الأزمة العالمية حتى عقر دار أعظم قوة عالمية، بما يُنذر بعواقب وخيمة فوق ما أصابنا حتى الآن. ويبقى لنا أن نقاوم، ونحن شعوبٌ تعوّدت المقاومة، وتعزيتنا الوحيدة أن فوز ترامب من شأنه أو يُسهم إسهاماً كبيراً في توسيع صفوف المقاومة على النطاق العالمي.
٭كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
سقط المركز… ولكن/ سامر فرنجيّة
امتلأ الحائط بالكتابات لمن كان يريد أن يرى. أزمات اقتصادية هزت دولاً بأكملها، انهيار لمنظومة دولية حكمت العالم منذ أكثر من عقدين، صعود للعنصرية مع أزمة اللاجئين، تمدّد للعنف في العالم، سقوط لإجماع ليبرالي في شتّى المجالات. الإشارات لم تكن مبهمة، بل كانت واضحة عند كل استحقاق جرى منذ سنتين. النمسا، بولندا، المجر، فرنسا، بريطانيا، جميعها وبأشكال مختلفة سقطت في فخ إغراء اليمين المتطرف والعنصري. لكن كل هذه الإشارات لم تكن كافية لتحضّرنا لـ«اللا-معقول»: سقوط معقل «النيو-ليبرالية» و«الاستعمار» و«الرأسمالية» في فخ هذا الإغراء.
دخلنا الانتخابات بفرضيتين، الأولى أن الفوز مضمون للمرشحة الديموقراطية، وأنه ليس من فارق جوهري بين المرشحَين كونهما صنيعة النظام ذاته. سقطت الفرضية الأولى مع ظهور النتائج الكارثية، ولحقت بها الفرضية الثانية عندما اضطررنا للنظر مليّاً إلى ما ستعنيه رئاسة ترامب. فظهر الفارق الذي رفضنا أن نراه أو واجهناه بالمكابرة.
امتلأ الحائط لكنّنا لم نر، ربّما لأنّه على رغم كل انتقاداتنا لهذا العالم، بقينا نؤمن بشيء من التفاؤل بأن التاريخ قد يتباطأ أو يقف، لكنه لا يعود إلى الوراء. فاعتبرنا أن لا عودة عن سقوط جدار برلين وإن كان هناك مجنون يهدد ببناء جدار بين قارتين. وظننا أنه لم يعد هناك مكان لمجازر بعد روندا، وإن كانت المذبحة لم تهدأ منذ خمس سنوات في سورية. واعتقدنا أن العالم ذاهب نحو انفتاح أكبر وإن كان البحر المتوسط مليئاً بضحايا الجدران الأوروبية الجديدة. وبنينا فرضيتنا على أن الحاضر هو القعر، ولم ننتبه إلى أن زواله قد يفتح المجال لمستقبل أخطر.
في وجه من كان يجزم بأن التاريخ انتهى، ردّدنا بأن لا طريق إلى الصعود من هذا القعر. انتقدنا فوكوياما ومقولة نهاية التاريخ، لكنّنا ربّما كنا الأكثر إيماناً بها.
كتبنا على الحائط ولكن لم نصدق ما كتبناه أو لم نأخذه على محمل الجد. فعلى رغم التفاؤل، كان نقد النظام الدولي والليبرالية المنتصرة والرأسمالية المتوحشة والخطاب الاستشراقي والعنصرية الخفية خطابنا العام، وحتمية انهيار هذه المنظومة أو تحولّها إلى نوع من الفاشية خلاصتنا الوحيدة. وعلى رغم ادعاءات النقد، تحوّلنا إلى الأيديولوجية الفعلية لنظامنا الحاكم، ننظّر لحالة كلبية (سينيكية) معمّمة. فأكدنا أن العالم غير قابل للإصلاح، واضطررنا للاعتراف بأن الثورة ليست على الأبواب، وصببنا آمالنا كلها على أزمات العالم الداخلية. اختبأنا في الجامعات التي أطلقت سراح مخيلاتنا الراديكالية ليصبح العالم بأكمله صورة يمكن إغلاق العينين لكي تزول. فككنا كل كلمة في الخطاب المنتصر ودققنا بكل رقم عن الاقتصاد العالمي وانتقدنا الحلول الوسطية لكونها مجرّد تلطيف لنظام مبني على الاستغلال والقتل.
قرأنا كل هذا وتوقعنا شيئاً يشبه ترامب، لكنّنا لم نصدّق عندما رأيناه ينتصر. ربّما كنّا متفائلين بأن هذا النقد قد يشكّل مدخلاً لمشروع أفضل، وإن لم تكن هناك أي أرضية موضوعية لظهور مشروع كهذا. أو ربّما كنا «متفائلين» بأن نقدنا للنظام العالمي والرأسمالية لن يتحقق لكي تستمر لعبة الكتابة على الحائط إلى الأبد، مؤمّنة للنقاد أدوراً بطولية وهمية. اعتدنا على سهولة النقد الوهمي، وابتعدنا عن القضايا المعقدّة أو الفعلية. فجاء ترامب ليؤكد لنا صحة نقدنا ولكنْ أيضاً خطورته.
فالنقد كان مرهوناً بصمود المركز وإن لم نكن نريد الاعتراف بهذه الحقيقة، وما زال البعض يكابر على هذا الشرط للنقد.
ملأنا الحائط بكتابات معقدة كشفنا بها رياء «الليبراليين» لنؤكد تماثلهم مع خصومهم المتطرفين، هذا إن لم يكونوا أخطر لكونهم منافقين. لكنّنا لم ننتبه لوجود لاعب أخطر دخل الساحة، وبات اليوم في مقدّمها. فالحائط بات مليئاً بكتابات عن التدخلات الأميركية في سورية ولكنْ ليس هناك من كلمة عن التدخّل الإيراني، وهناك أطروحات عن الديموقراطيات المزيفة في الغرب وليس من صفحة عن القمع الفعلي في روسيا، ونقد لا نهاية له لأوباما، وليس من كلمة عن الخطاب الذي يمثلّه ترامب. «الإستمبلشمنت» الفكري اعتاد على نوع من النقد الكسول والمريح، بل بات مدمناً عليه، ما منعه من رؤية هذا الخطر الجديد والواضح المعالم. اعتدنا نقد المستور والخفي والقابع بين الكلمات، ولم ننتبه للخطر الواضح والعلني، بل ضحكنا عليه لكونه مبتذلاً وسوقياً. لم يكن ترامب يستحق نقدنا، فاستحققناه رئيساً.
لم يكن جمهور ترامب من يعاني من «وعي مزيف»، بل منطق النقد الذي سيطر على العالم منذ عقدين. هذا ليس للقول أننا مسؤولون عن صعود ترامب، بل للتأكيد على أنّنا أضعنا وقتنا في التفاصيل ولم نر الخطر الأوضح والصاعد، على رغم كل ادعاءاتنا الطليعية. وفي وضع كهذا، سيحاول بعض المتذاكين الذين برعوا في المرحلة الماضية، أن يخففوا من وطأة هذا الحدث. فما الفرق بين كلينتون وترامب أصلاً، وكلاهما نتيجة الرأسمالية وداعم لإسرائيل؟ سيرددون. وماذا سيتغير إذا نجح وجه أميركا «الحقيقي» وليس القناع المزيف الذي اعتدنا عليه مع باراك أوباما؟ وفي آخر المطاف، ألم تنتج الرأسمالية وأزماتها ترامب؟ ومع أسئلتهم، سيعودون كما عادتهم مع كل أزمة، يجرون عربة أفكارهم العفنة محاولين إقناع العالم بأن غياب خيار آخر هو سبب الأزمة. وسيأتي آخرون، متعالين عن وطأة الحدث، ليقدموا تحاليل عما جرى. والتحاليل اليوم، قبل الاعتراف بضخامة الحدث، أشبه بالإحصاءات التي انتشرت قبل الانتخابات وأكّدت جميعها فوز كلينتون. فهناك تحول بنيوي أو قطيعة لم تلتقطهما الإحصاءات كما لن تفهمهما التفسيرات المعتادة. فتكرار أن الحدث نتيجة الفروقات الاقتصادية قد يؤمن لصاحبه وهم التحليل العميق، بيد أنّه لا يفسرّ شيئاً.
اليوم ليس وقت التحاليل، فغداً يمكن دراسة الأرقام والبحث عن الأسباب وراء التصويت. والوقت ليس للنضال، ووهم الكفاح. اليوم هو لحظة الحدث، لحظة يجب علينا فيها هضم معانيه الكثيرة وعدم المكابرة عليه. وفي لحظة الهضم هذه، ربّما كان على كل واحد منا أن يعود إلى هذا الحائط ويعاود قراءة ما كتبه على مدار السنوات، وطعم الحدث ما زال في فمه. فإعادة قراءة هدفها أن تسيطر حالة الغثيان على القارئ. عندها يمكن للتحليل أن يبدأ.
الحياة
ترامب والديموقرافاشيّة/ سنان أنطون
تساءلت في هذه الفسحة قبل فترة عن احتمال فوز ترامب ودخول أميركا عصر الفاشيّة. فاز ترامب والمناخ مهيّأ لصعود الفاشيّة. وستقتضي هيمنتها تغييرات مؤسسية لن تكون يسيرة وستواجهها مقاومة عنيفة. لكن ذريعة الحفاظ على الأمن القومي والسوابق والآليات التي وفّرتها الحرب على الإرهاب في زمن بوش يمكن أن تُستغل بسهولة لتغييرات خطيرة لم تكن في الحسبان. تنبئ قائمة الأسماء التي رشحت لاستلام أهم المناصب في إدارة ترامب إلى الآن بواحدة من أكثر الحكومات يمينية وعنصرية في ماضي البلاد القريب. كما أن سيطرة «الجمهوريين» على الكونغرس ستسمح لترامب باختيار اثنين من قضاة المحكمة العليا في البلاد لشغل المقعد الذي أُخلي بوفاة سكاليّا ومقعد آخر بعد تقاعد متوقّع لأحد الأعضاء. وستترك قرارات محكمة عليا مكدّسة بغلاة المحافظين آثاراً سلبية طويلة المدى اجتماعياً وسياسياً.
دشّن الكثيرون عهد ترامب باعتداءات وممارسات عنصريّة وبكتابة شعارات ورسم صلبان معقوفة وتوجيه رسائل احتقار وتهديد ضد الأقليّات من السود والمسلمين واللاتين. وقد سُجِّل عدد منها في جامعات النخبة ومعظم طلابها من عوائل غنية. بالمقابل، خرج الآلاف في عدد من المدن الأميركية في شرق البلاد وغربها متظاهرين لخمسة أيام متتالية ضد ترامب معبّرين عن رفضهم لسياساته وما يمثّله.
في تموز من العام الماضي حذّر كيث إليسون، وهو نائب «ديموقراطي» في الكونغرس عن ولاية مينيسوتا وأول مسلم أسود انتخب إلى الكونغرس (العام 2007)، حذّر حزبه من احتمال فوز ترامب، وحثّ «الديموقراطيين» على الوقوف ضده والاستعداد له بجديّة. لكن مضيفه في البرنامج، جورج ستيفونابولس، وهو من النخبة الإعلامية وكان من مستشاري بيل كلينتون قبل انتقاله إلى الإعلام المرئي، ضحك بصوت عال وشاركته الضحك خبيرة أخرى. وكان مايكل مور، المخرج اليساري والناشط المعروف، قد توقّع هو الآخر قبل أشهر احتمال فوز ترامب. أذكر هذين المثالين لأنّهما الاستثناء والنقيض لسواد النخبة الإعلامية الذي كان مؤمناً بفوز كلينتون ومرجِّحاً له.
كشف فوز ترامب، من جديد، الهوة بين خطاب الإعلام النخبوي الليبرالي، التابع لكبريات الشركات والمتمركز على الساحلين والمدن الكبرى من جهة، وبين شرائح كبيرة ومهمّة في وسط أميركا وأريافها، تتصّف بكونها، عموماً، أقلّ دخلاً وتنوّعاً (عرقيّاً) وأكثر محافظة. وهي تستقي معلوماتها إمّا من قناة «فوكس» اليمينية أو من وسائل التواصل الاجتماعي. وليست هذه، خلافاً لما يظنّه البعض، فضاءات مفتوحة، بل تقطنها مجموعات تتناقل الأخبار نفسها وتشاهد الصور ذاتها وتفصل بينها وبين مجموعات تختلف عنها في ميولها الثقافية/السياسيّة وموقعها الاقتصادي جدران إلكترونية وآليات الحظر وخوارزميّات (آلغوريتمات) تحدّد مسبقاً ما يستهلكه المرء. وينطبق هذا علينا جميعاً.
نزع معظم المحلّلين والمعلّقين لإرجاع (واختزال) فوز ترامب إلى عامل واحد فقط: الوضع الاقتصادي (الطبقة)، أو العنصرية (العرق)، أو حتى الذكوريّة. والأرجح هو تفاعل هذه كلها (لماذا يتجاهلون تداخل وتقاطع العرق والطبقة؟) وعوامل أخرى. هبط مستوى المشاركة في الانتخاب بين «الديموقراطيين» وامتنع كثير من الذين اشتركوا عن اختيار مرشّح رئاسي. لم تحسّن فترة حكم أوباما شيئاً في الأوضاع الاقتصادية لأولئك الذين كانوا متضررين قبل قدومه. ومثّلت كلينتون، التي تلفّعت بعباءته، الوضع السائد والنخبة الطرشاء التي لا ترى ولا تسمع أصوات الخاسرين اقتصاديّاً والغاضبين من المؤسسة السياسيّة. وكان الغضب ساطعاً ومكلفاً لا لكلينتون وجناحها في «الحزب الديموقراطي» فحسب، بل إن آثاره قد تطالنا جميعاً أينما كنّا.
السفير
ترامب وبعض العرب/ حازم صاغية
ظهرت أصوات عربية تعلّق على انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتّحدة الأميركيّة، فرأى أصحابها أنّ الأمر لا يعني العرب ولا ينعكس على قضاياهم. ذاك أنّ هذه الأميركا لا تعدو كونها تنافساً محموماً بين السيّء والأسوأ.
والتأويل هذا إنّما يفضي إلى نتيجة خطيرة مفادها أنّ المسائل التي لا تعني العرب ولا تنعكس على قضاياهم تشمل ما يلي: الموقف من المرأة ومن الدين ومن الجنس ومن اللجوء واللاجئين، ومن الهجرة والمهاجرين، ومن العنصريّة، ومن حرّيّات التعبير، ومن أشكال الحاكميّة وفصل السلطات، ومن تصوّر شكل العالم بانفتاحه أو انغلاقه، ومن العلاقات الاقتصاديّة والحروب التجاريّة، ومن تصاعد التطرّف والعنف، ومن دمار البيئة، ومن اتّجاهات السينما والفنون والإعلام ووسائط الإعلام الاجتماعيّ، ومن أخلاق السياسة وصورة السياسيّ، بل أيضاً من مستقبل العالم العربيّ نفسه بلداناً وشعوباً، مقيمين ومهاجرين ولاجئين…
فإذا كانت هذه المسائل وسواها لا تعني العرب حقّاً ولا تنعكس على قضاياهم، يشجّعهم على ذلك بعض أقصى اليسار الغربيّ، كانت الخلاصة الكارثيّة أنّ قضايا العرب مزعومة وبائدة، لا تؤثّر بشيء ولا تتأثّر، وأنّهم هم أنفسهم غير موجودين، وفي أحسن أحوالهم، زائدة طفيليّة على هذا العالم.
وهذا بالتأكيد غير صحيح، إلاّ أنّه النتيجة المنطقيّة التي تُبنى على ما يقوله بعض فرسان الدفاع عن العرب والعداء لأميركا.
هكذا، مثلاً، يقال أحياناً أنّ لا فارق بين باراك أوباما وترامب، أو بين هيلاري كلينتون وترامب، وأنّ لا جديد بالتالي تحت الشمس، علماً بوجود فوارق بعضها فلكيّ في ما خصّ العناوين المذكورة أعلاه. لكنّ ما يُحسّ ويُلمس، بطرق مختلفة، في سائر بقاع الأرض، لا أثر له في العالم العربيّ وحيال قضاياه!
إلاّ أنّ أصحاب الفرادة يحفرون بأيديهم قبر فرادتهم. فالذي لا يلاحظ الأثر الكبير الذي يتركه العالم عليه يفوته أيضاً أثره الصغير على هذا العالم نفسه. ذاك أنّ ما يجري إغفاله وتفويته هنا هو بالضبط فكرة العلاقة بين طرفين، بما تنطوي عليه دائماً من تبادل في التأثّر والتأثير. وهذا، والحقّ يقال، إنّما هو الوجه الآخر للترامبيّة، أو أنّه قفاها، حيث العالم عديم العلاقات، ينبغي أن تفصل الجدران بين أطرافه، وأن تُطرد أعداد من بشره من الأمكنة التي تقيم فيها، إذ الشراكة في علاقة جامعة لا تشبه إلاّ العدوى ولا ينجم عنها إلاّ الأذى.
وتتمّة هذا المنطق هو ما يقوله هذا الوعي الكونكريتيّ في صيغة أخرى: إنّ ترامب يستحقّ الشكر على كشفه «حقيقة» أميركا التي كان أوباما وكلينتون يموّهانها بالخداع. وهذا، بدوره، يوازي ما قد يقوله أيّ ترامبيّ أميركيّ «أصيل» من أنّ أسامة بن لادن وأبا بكر البغدادي يستحقّان الشكر على كشفهما «حقيقتنا» نحن العرب والمسلمين. فلنعجّل إذاً في قدوم الكارثة التي تسرّع الانكشاف الكامل للحقائق!
والبائس أنّ هذه اللغة مرشّحة للازدهار مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض: حقائق جوهريّة مزعومة تصف شعوباً وجماعات وأدياناً بكاملها، وعلاقات مسمومة ليس فيها ما يستحقّ الرعاية والاهتمام إلاّ ردّ العنف والأذى المترتّبين عليها. والأمر الأرجح هو أن تخترق هذه النظرة دواخل كلّ واحد من المجتمعات فلا تبقى محصورة بين جماعتين أو مجتمعين.
حينذاك يسطع النور بعد طول ظلمة.
الحياة
العنصريّة الصاعدة وأخطار الديكتاتوريّة/ خالد غزال
سلطت الانتخابات الأميركية الضوء على خطاب سياسي يشهده الغرب منذ سنوات عدة، قوامه انبعاث النظرة العنصرية والتمييز العرقي والديني داخل المجموعات التي يتكون منها كل بلد. لعل أحد العوامل التي ساعدت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النجاح في الانتخابات، دأبه على خطاب عنصري فج بدأ بالهجوم على المسلمين والوعد بمنع دخول جدد منهم الى أميركا، والتهديد بطرد الساكنين على الأرض الأميركية. تضاف الى ذلك، حملته على المهاجرين الآتين من البلاد العربية وأفريقيا، والتشديد على أهمية العنصر الأبيض وتفوّقه مقابل السود والأميركيين من أصل إسباني. هذا الخطاب أجج «شعوراً قومياً» أميركياً ضد غير الأصليين من السكان أي العنصر الأبيض، على رغم أن الهنود هم السكان الأصليون الذين أبادهم البيض. لم يكن خطاب ترامب لينجح في استقطاب هذا العدد من المقترعين لولا أنه ضرب على وتر التناقضات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تصيب المجتمع الأميركي، فتزيد من عدد الفقراء، وترفع نسب المهمشين الى مستويات عليا. أتى خطاب ترامب ليزوّر أصل المشكلات الاجتماعية ويبعدها من أسبابها الداخلية المتصلة بطبيعة النظام الرأسمالي الأميركي، ويلقيها على عاتق المهاجرين وغير الأميركيين، ويصنّفهم بأنهم السبب في تفاقم أزمات هؤلاء الأميركيين.
لم يغب عن ترامب حجم العنف المتزايد داخل المجتمع الأميركي، لكنه أعاد أصله، في السنوات الأخيرة، الى ما تعرضت له أميركا مطلع هذا القرن عبر هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001، وما تركته هذه الهجمات من أحقاد تتفاعل دوماً ضد العرب والمسلمين. كما لم يغب عن نظره حجم الصراعات بين السود والبيض والقتل المتبادل خلال السنوات الأخيرة، ليصعّد من التمييز العنصري والعداء للسود، في بلد لم تشف ذاكرته بعد من الحروب الأهلية التي اندلعت منذ قرن ونصف القرن، من أجل المساواة في الحقوق بين سائر الأميركيين الى أي عرق انتموا. هذا العنف المتصاعد لم يقرأه ترامب سوى نتيجة السياسة الأميركية «المتسامحة» مع هذه العرقيات والإثنيات والطوائفيات. لكن هذا العنف المندلع سابقاً، بدأت أميركا تشهد فصولاً جديدة له مع اندلاع التظاهرات ضد انتخاب ترامب وصلت في بعض المقاطعات الى الاصطدام بالشرطة وإحراق العلم الأميركي.
صحيح أن الخطاب الشعبوي لترامب قبل أن يصبح رئيساً، سيكون خاضعاً للتبدل عند استلامه السلطة، خصوصاً في بلد تحكمه مؤسسات ومجمعات نافذة في التسليح والنفط والتجارة… تتحكم بمفاصل القرار الأميركي في وصفها تعبيراً عن هذه المصالح. لكن ما زرعه ترامب من فكر وثقافة ليس من السهولة في مكان محوه من ذاكرة الأميركيين. فخطاب ترامب، إضافة الى السياسي المباشر فيه، كان خطاباً يلتزم مقولة صراع الحضارات الذي بشر به برنارد لويس وأكمل منظومته صموئيل هانتنغتون، والقائل بأن الصراع المقبل هو صراع بين الحضارة الغربية المسيحية وبين حضارات الشرق، الإسلامية منها والآسيوية.
ما تمت الإشارة إليه في شأن أميركا، له ما يقابله في القارة الأوروبية التي تشهد أيضاً منذ سنوات، تصاعداً في العنصرية ضد غير الأوروبيين، وتحميلهم مسؤولية الأزمات التي تعاني منها شعوب هذه القارة. فاقم الأمر ما تسببت به الانتفاضات العربية والحروب الأهلية التي نجمت عنها في ميدان الهجرة التي وصلت أوروبا بأعداد كبيرة، وما رافقها أحياناً من عنف المهاجرين، ومن مخاوف على الديمغرافيا الأوروبية نفسها. كما في كل بلدان العالم، تضرب الأزمات الاجتماعية الشعوب في كل بلد، فلا يأتي الجواب غالباً من الداخل ليرى الأسباب البنيوية للأزمات، بل يجري تصريفها وتحميل مسؤوليتها الى هذه القوى «الغريبة» المسؤولة عن البطالة والفقر. فنجم عن ذلك صعود في شعبية وقوة أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وبريطانيا، وعودة أحزاب نازية الى ألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية.
ما يشهده الوضع العالمي من تحولات مقرونة بتصاعد الأزمات البنيوية والاجتماعية كانت ذروتها ما عبر عنه انتخاب دونالد ترامب في أميركا، يذكر بالربع الأول من القرن العشرين الذي شهد موجة تطرف قومي في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا، وكان سبباً في صعود النازية والفاشية وتفجير الحرب العالمية الثانية لاحقاً. في هذا المجال، يجب القول أن الديموقراطية في شقها الانتخابي ليست ضمانة في منع صعود قوى معادية لمنطق الديموقراطية نفسها. وللتذكير، أتى هتلر وموسوليني عبر انتخابات كاسحة شعبياً لمصلحتهما، وكانا من أشد المعادين للديموقراطية وقيمها. فلن يكون غريباً أن تكتسح لاحقاً الأحزاب المتطرفة والعنصرية الانتخابات في أوروبا، وتنتج أنظمة تحمل في جوفها عنفاً قائماً على التمييز العرقي والديني، وتمهد السبيل لاندلاع حروب أهلية داخل البلد نفسه أو بين بلدان مختلفة.
* كاتب لبناني
الحياة
لنتساوَ في طرد المهاجرين/ امين قمورية
ترامب صار رئيساً منتخباً بأرقام قياسية في صناديق الاقتراع. ومن الآن وصاعداً صار كلامه كلام “رئيس” وليس كلام مرشح مهرج يرمي شباكاً لاصطياد أصوات. وعندما ينتقل الرجل من التهديد الى الوعيد بطرد أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي من الاراضي الاميركية، ينبغي أخذ ما يقوله على محمل الجد. ولا حاجة الى نعته بأنه عنصري أو شوفيني أو يميني متطرف، فمثل هذه الصفات باتت على ما يبدو مرغوباً فيها ومطلوبة لدى شرائح واسعة من الاميركيين ولعلها سر النجاح الكبير لهذا الرجل الذي لم يكسر قواعد اللعبة السياسية الاميركية التقليدية فحسب، بل أظهر السياسة الاميركية عارية بلا مساحيق ماكياج وعمليات تجميل.
لم يترك رذيلة الا ووصم بها المهاجرين، فهم مجرمون رجال عصابات وتجار مخدرات، وفي نظره ليست هي الصفات الاخطر، بل الاخطر انهم من لون آخر ومن ثقافة أخرى وجاؤوا ليشاركوا الاميركيين في لقمة عيشهم وحلمهم أيضاً، وهنا يكمن الشر المطلق واخطر اللعنات.
أميركا “سيدة”، “حرة” و”ومستقلة”، ومن حقها ان تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات على أراضيها لحفظ امنها وسلامها. لكن، وعلى قاعدة المعاملة بالمثل، يحق للدول الاخرى ان تعامل “ضيوفها” بالطريقة المناسبة. ففي أرجاء العالم تنتشر اكثر من الف قاعدة عسكرية أميركية، والمقيمون فيها ليسوا رسل تبشير ولا فاعلي خير، بل هم في نظر شعوب الدول المضيفة ” جنود احتلال”، وهذا أسوأ الأوصاف وأحطها. واذا كان صحيحاً ان وجودهم من الفيليبين الى غوانتانامو مروراً بالخليج والقرن الافريقي والمانيا وايطاليا وغيرها، مغطى باتفاقات ومعاهدات قانونية، فإن جل هذه الاتفاقات فرض بالقوة ومن جانب واحد وفي ظروف قاهرة وبحجة وجود أعداء وهميين. ولا شعب واحداً في العالم يقبل بوجود جنود غرباء على ارضه، فماذا لو قرر المهاجرون العائدون من أميركا طرد الجنود المحتلين من بلادهم رداً على قرار ترامب، ذلك ان العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.. وليس لدى الحفاة ما يخسرونه سوى شقائهم! وهنا أيضاً، ما رأي السيد ترامب في المستوطنين اليهود في فلسطين الكبرى؟ واذا كان وصف اللصوص ينطبق على المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، فأي وصف يمكن ايجاده لوصف ارتكابات اصدقاء ترامب الاسرائيليين وجرائمهم؟ واذا كان رهط من فقراء المكسيك وكوبا وجامايكا يستحقون السجن لانهم عبروا خلسة الحدود الاميركية من اجل حفنة من الطعام، فأي قصاص يجب انزاله بالذين تجمعوا من اصقاع الارض في فلسطين وفعلوا ما فعلوا بأهلها قتلاً وتشريداً واذلالاً حتى تتحقق العدالة؟ هل تكفي مطالبة الفلسطينيين بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، أم بات يتعين عليهم اعلانها انتفاضة مستمرة لارجاع كل مهاجر الى بيته الاصلي أياً كان الثمن، مادام وصول ترامب أخمد آخر رمق لاقامة دولة فلسطينية مستقلة؟
مع ظاهرة كهذه في البيت الابيض، انتظروا أربع سنوات على الأقل من الجنون العالمي بلا توقف أو استراحة.
النهار
ترامب و«طرنيب» الانحطاط/ الياس خوري
«أكلناها»، قال صديقي العربي الأمريكي.
«من أكلها»؟ سألته.
«نحن العرب»، قال.
«نحن أكلناها من زمان»، قلت.
«ولكن ترامب عنصري»، قال.
«صحيح»، جاوبته، «ومقزز أيضا».
قلت لصديقي انني لا أفهم كيف صوتت له النساء، «هل هذا معقول»؟
«انها غيرة النساء من هيلاري وكيدهن»، قال.
«هذا تصريح ترامبي»، قلت، «يوجد ترامب صغير فيكم جميعا».
«هل تعلم ماذا تعني كلمة ترامب بالانكليزية»، سألني، وتابع شارحا أن معنى ترامب هو «الطرنيب»، أي أن الرجل «طرنب وقش الطاولة».
وعندما تعجب الرجل من عدم اندهاشي بترجمته للكلمة افترض أنني لا أعرف معنى «الطرنيب»، فشرح لي أن «الطرنيب» هو من ألعاب ورق الشدّة، وأن ما يُطلق عليه اسم الطرنيب محصور بأوراق «الكُبة» التي تحمل اشارة القلب الحمراء، وأن ورقة طرنيب مهما كان رقمها أقوى من أية ورقة تنتمي إلى احدى الفئات الثلاث الأخرى، يكفي أن تملك أوراق الطرنيب هذه كي تنتصر.
قال إن طرنيب ترامب كان احتقار الآخر سواء أكان ملونا أم أنثى أم مسلما، وبهذه الورقة التي دغدغت مكبوتات الرجل الأبيض، «طرنب» دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وخيّب جميع التوقعات وانتصر.
أعجبني تحليل صديقي الذي بسّط الأمور مستعينا بلعبة ورق الشدّة التي لا أستسيغها، بصفتها طريقة لقتل الوقت، وأنا لا أفهم لماذا يوحي الناس لأنفسهم، عبر هذه اللعبة وألعاب أخرى مشابهة، بأنهم يقتلون الوقت، بينما يقوم الوقت بقتلهم فعليا.
«طرنب» ترامب كي يقتل الوقت، ولم يقتله رمزيا فقط، مثلما يفعل لاعبو الورق والنرد، بل قتله فعليا، وأعاد العالم إلى مزيج من لغة القرن التاسع عشر القومية، ولغة الزمن الفاشي.
هذا التحليل المسلّي الذي قدمه صديقي العربي الاميركي، وهو يحاول التغلّب على خوفه من احتمال وضع عرب أمريكا في معسكرات اعتقال، على غرار ما قام به الامريكيون خلال الحرب العالمية الثانية، جعلني أشفق عليه وأشفق على نفسي، فنحن وأمثالنا نواجه مفاجأة الصعود الجديد للفاشية في العالم، من دون أن نملك سوى لغة قديمة لم تعد تصلح للمواجهة.
الظاهرة الترامبية كانت مفاجأة المثقفين والصحافيين وكل «الاستابليشمنت»، في أمريكا والعالم، كأن الرجل جاء من لا مكان، كي يمسح الأرض بواشنطن ويبهدل الطبقة السياسية الامريكية، ويطيح بالقيم الديموقراطية بضربة واحدة.
لكن الظاهرة الترامبية أكثر تعقيدا من تبسيطها في مقولات ثقافية.
صحيح ان الديمقراطيين قدموا مرشحة تقليدية لم تثر حماسة أحد، كأنهم يسخّنون طبقا بائتا لمدعوين يسعون إلى نكهة جديدة. مؤسسة الحزب الديمقراطي نجحت في ابعاد اليساري ساندرز عن الحلبة، ومعه استبعدت الحماسة والتألق والأفكار الجديدة والرؤية اليسارية، لتعيدنا إلى عهد بيل كلينتون، أي إلى ما قبل قبل أوباما. وفي المقابل فشلت المؤسسة الجمهورية في استبعاد مرشح جاء من خارجها، فأستطاع هذا الرأسمالي أن يحدث المفاجأة، وجاء مع أكثرية مريحة في الكونغرس، كي يطبق سياساته.
استبعاد ساندرز كان بداية الفشل، لكن هذا لا يكفي لفهم ظاهرة ترامب، التي تأتي وسط صعود عارم لليمين الفاشي في الغرب. فالمسألة لا يمكن فهمها بمعزل عن حقيقتين:
الأولى هي العنصرية، الناجمة عن العولمة، التي هشمت الكثير من القطاعات الاقتصادية، وتهدد الطبقة العاملة البيضاء، بالانحدار الاجتماعي. هذه المشكلة الاجتماعية التي لم تستطع القوى الليبرالية ايجاد حلول لها، امتزجت بالخوف من المهاجرين، مشكلة أرضية خصبة للفاشية.
والثانية هو ميل نجم الامبراطورية الامريكية إلى الأفول. وفي أزمات الأفول، تحتل لغة الهوية وكراهية الآخر الصدارة.
ظاهرة صعود الاسلام التكفيري بأصولياته المتنوعة لم تكن صحوة، الا إذا كان المقصود هو صحوة الموت. المشرق العربي منذ الهزيمة الحزيرانية المروعة، وسقوط الدولة القومية، يتمرّغ في وحل التاريخ، لذا جاءت هذه الصحوة كرد فعل على الموت لا وظيفة لها سوى تسريعه.
امريكا التي فقدت هيبتها بشكل مخزٍ في حربها الهمجية الفاشلة على العراق، دخلت في وحل المجهول، اقتصادها يعاني ازمة نمو، وصورتها تهشمت في العالم، ولم يبق سوى تسريع عملية الأفول، عبر لعبة «طرنيب» صنعت مفاجأة الانتخابات الامريكية.
الذهول الذي أصيبت به النخب طبيعي، فلقد حاربت ترامب بمجموعة من القيم الأخلاقية، التي نجحت في استبدال النضال الاجتماعي والطبقي بالنضال الثقافوي. وكانت النتيجة أن ما اعتبر قدحا وذما في الرجل كان سلمه إلى الصعود. ظهرت كل المكبوتات دفعة واحدة، ذكوريته وفظاظته وعنصريته وبجاحته وقلة حيائه وتهربه من دفع الضرائب، كلها اجتمعت في شخصه لتقدم صورة نمطية عن الغباء، الذي يدغدغ اوهام السيطرة عند الرجل الأبيض. انه عالم جديد لا نملك ادوات فهمه، أو تناسينا هذه الأدوات عندما غرقت النخب المثقفة في العالم في خطاب ثقافوي حملته المنظمات غير الحكومية NGO بصفتها بديلا سياسيا لليسار المتهافت، فكانت النتيجة الغاء للعمل السياسي النضالي، وتضخيما لرؤى اخلاقية ثقافية، لا يكون النضال من أجل تحقيقها مجديا إلا اذا ارتبط بمشروع سياسي طبقي يقاوم الرأسمالية المتوحشة.
مع ترامب جاءت الرأسمالية المتوحشة عارية الى السلطة بعدما خلعت جميع اقنعتها لنكتشف أنها بربرية جديدة.
«على البشرية ان تختار بين البربرية والاشتراكية»، كما كتب كارل ماركس مرة. ويبدو أن الخيار البربري الأمريكي جزء من سياق سياسي عالمي جديد.
القدس العربي
زواج الفاشية المعولمة/ زهير قصيباتي
قلبه مع الشعب، لكن عقله وأفكاره وميوله كلها مع زواج استثنائي بين اليمين المتشدّد- وبعضه عنصري فاشي- ورموز الصقور من المحافظين الجدد الذين دافعوا بشراسة عن غزو العراق، رغم الكذبة الكبرى المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
قلب الرئيس الأميركي المنتخب، مع الشعب الذي ما زال تحت صدمة فوز البليونير الشعبوي. دونالد ترامب، سارع قبل ترك المتظاهرين الشوارع، إلى كشف توجهات إدارته «الغامضة»، باختيار شخصيات معروفة الميول والأفكار، وتشبثها بها لا يوحي بأن إدارة ترامب جدية في طمأنة الأميركيين والحلفاء الأوروبيين والعالم إلى أن البليونير سيكون «براغماتياً» كما قال الرئيس باراك أوباما، ولن يجرّهم إلى مزيد من الحروب بوقود تعصُّبٍ، هذه المرة.
يكفي أن ستيف بانون، الذي اختير مخططاً استراتيجياً للبيت الأبيض، هو نفسه صاحب موقع يصرّ على تفوّق العرق الأبيض، بالتالي صاحب مشروع قادر على إضرام شرارة حرب أهلية مع السود، وتفكيك الديموقراطية الأميركية بل تدميرها. ألا يكفي لإثارة الذعر أن بين أوساط الحزب الجمهوري مَن اعتبر أن اليمين المتطرف العنصري والفاشي يستعد لينضم إلى سكان البيت الأبيض، في عهد ترامب؟
ديفيد ديوك، القيادي سابقاً في تنظيم «كوكلاكس كلان» العنصري، لم يخفِ سعادته بانتخاب البليونير رئيساً للولايات المتحدة، كما فعل اليمين المتطرف في أوروبا، ناصحاً الجميع بانتظار المزيد من المفاجآت.
ولعل دونالد بتذكيره الأوروبيين بأن الوقت حان ليتحمّلوا قسطهم من فاتورة الدفاع عن القارة (70 في المئة تدفعها أميركا)، يكرر بصيغة أخرى ما قاله دونالد الأول، رامسفيلد أحد صقور المحافظين الجدد الذين نظّروا للحرب على العراق، وسخروا من «القارة العجوز».
تلقّف الاتحاد الأوروبي رسالة الانتخابات الأميركية، وشعارات الشعبوي الذي لم يستقر بعد على نهج واضح، إلا ما يتعلق بالإنفاق وبدعم إسرائيل، والعداء للمهاجرين والمسلمين. وربما لا يبطن الأمر مبالغة إذ اعتبر بعض مَنْ في «القارة العجوز» أن الرئيس الأميركي المنتخب مارس انتهازية بشعة، وهو يشدّد الضغوط على حلفاء في صفوف الحلف الأطلسي، فيما لا يزالون يعانون ارتدادات زلزال الهجرة إلى الشمال، هرباً من الجحيم العربي (سورية والعراق وليبيا…).
لكن مشكلة غالبية الأميركيين مع ترامب- حتى مِن الذين انتخبوه- أن شعاراته المضطربة قد تتحول سريعاً إلى قنابل موقوتة في الداخل، إذا سيطر التيار الفاشي على قرارات البيت الأبيض، مستغلاً جهل ساكنه الأول بالسياسة.
ومشكلة غالبية الأوروبيين مع عهد ترامب، وصعود فاشية اليمين المتطرف لن تقتصر على انعزالية متوحّشة، بذريعة معاداة النخبة، ما دام الفقراء هم الخاسر الأكبر في كل الأحوال. لا تكفي هنا وعود رمادية بزيادة الضرائب وتحسين الرعاية الاجتماعية، بمجرد إغلاق الحدود في وجه كل مَنْ هو «غير وطني». فمآل العنصرية هو حتماً إلى صدام مع أجيال من المهاجرين، فشلت أوروبا في دمجهم في مجتمعاتها. والمخرج السهل أمام دعاة الفاشية هو عودة إلى صدام الحضارات والأديان… فهل من المستحيل افتراض حروب أهلية «صغيرة»، خصوصاً أن معظم «الغرباء» منبوذ ينتمي إلى ديانة أخرى؟
مرعب أن نتخيّل كثافة القصف الجوي الروسي على شرق حلب، بعد ساعات على اتصال بين البليونير وقيصر الكرملين الذي ما زال مصرّاً على أن أول شروط التطبيع بين روسيا وأميركا، هو عدم تدخُّل واشنطن في «الشؤون الداخلية» لبلاده… حلب باتت شأناً داخلياً لدى القيصر، وما على دونالد المعجَب به إلا أن يتفرّج.
ألم يكن ذلك ما مارسه باراك أوباما بجدارة مكّنت النظام السوري من ترميم آلته العسكرية تحت المظلة الروسية- الإيرانية؟ وإن كانت طهران لم تكشف بعد مبررات توقّعها نهاية للحرب في سورية خلال آذار (مارس) المقبل، فالأكيد أن حليفها الروسي حريص على تعزيز ترسانتها رغم مخاوف العرب، ويسعى إلى حسم عسكري قريب، قبل التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة.
بعد تدمير العراق وخراب سورية، لِمَن الترسانة الإيرانية، في ظل الزواج المخيف بين الفاشية المعولمة وجنون العظمة؟
الحياة
التصادم التاريخي بين العولمة والسيادة الوطنيّة/ مرزوق الحلبي
نتائج الانتخابات الأميركية ليست «أميركية» فقط، بل عالمية أيضاً. وليس بسبب دلالات قد تحملها بالنسبة الى السياسة الدولية و»النظام» الدولي القائم فحسب، بل لكونها نتائج تتصل، أيضاً، بتحولات دولية أبرزها ذاك التوتّر المتنامي بين «الوطني» و»العولمي»، بين مفهوم السيادة الوطنية وبين سيرورة العولمة التي قوّضت هذا المفهوم و»غدرته» إذا صحّ القول.
معروفة تلك المقولة التي تصف سلوك الناخب الأميركي الذي يذهب إلى صندوق الاقتراع وقد اختار وفق المبلغ في جيبه وهاجسه الاقتصادي. للحقيقة، هو اعتبار يعمل في كل جولة انتخابية حيثما كانت وليس في أميركا حصراً. ومع هذا، سنجد أن دونالد ترامب، بواسطة مستشاريه طبعاً – وليس بفضله – تمحور في اجتماعاته الشعبية وفي الولايات المأزومة اقتصادياً على هذا الجانب من حياة الأميركيين. كان من السهل عليه أن يجتذب المحتجين على سياسات العولمة التي كانت هيلاري كلينتون مرشحتها بامتياز وداعية لها بوضوح. مقابل ضلوعها و»تورّطها» في سياسات العولمة الاقتصادية والسياسية، لعب ترامب على وتر الوطنية الأميركية والحماية، وصعد فوق خرائب مدن أميركية أفرغتها الأزمات الاقتصادية من مشاريعها وسكانها، وركِب ظهر ريف قلق غير واثق بمستقبله ليستقطب ضحايا العولمة بصيغتها الأميركية، أولئك الضعفاء والمهمشين ومجمّع الصناعات الوطنية الخائف من غزو الصناعات العالمية ومن اتساع حصتها في الاقتصاد الأميركي. وكل مُجتمع يتأثّر، وفق إكسل هونت الألماني، من سياسات الإقصاء والاعتراف وما تتركه من أثر في الفئات التي يتمّ إقصاؤها وتهميشها.
ينضم فوز ترامب إلى انتصارات أخرى حققها دُعاة الوطنية والمتحفظون من الليبرالية والانفتاح بصيغته الأكثر اندفاعاً، في كثير من بقاع العالم. في بريطانيا من خلال تأييد غالبية بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو في انتصار أحزاب وحركات وطنية ألمانية محافظة ويمينية في الانتخابات المحلية على حزب المستشارة أنغيلا مركل، وفي ارتفاع نجم اليمين الفرنسي في كل الاستطلاعات الأخيرة، إلى نزعات يمينية متنامية في دول شمال أوروبا، حتى تلك المعروفة بتسامحها وانفتاحها على اللاجئين والمهاجرين، في يمينية صينية ويابانية متعاظمتين.
ينسجم هذا التطور الكوني مع بروز أفكار وتنظيرات جديدة في العلوم السياسية والفكر السياسي تميل إلى يمينية واضحة تقول بأولوية الإبقاء على الدولة والسيادة والنظام العام حتى على حساب الحقوق والحريات، بخاصة المتصلة بالمهاجرين واللاجئين وطالبي العمل. بل يبدو العالم متفهماً ومتعاوناً تماماً مع أنظمة قامعة وشوفينية وقومجية على طول الكرة الأرضية وعرضها. وهي أفكار توازي قي قوتها وزخمها تلك المتصلة بالليبرالية على مذاهبها. وهي ردّ فعل طبيعي على ما أفضت إليه العولمة حتى هذه المرحلة. فهي لم تؤسس لجريان في السلع وخطوط الإنتاج ورأس المال فحسب، بل أفضت إلى تعميق الفقر والفوارق الاجتماعية والإجحاف والتمييز، وتسريع الهجرة وتغيير الديمغرافيا في كثير من المواقع، إضافة إلى دكّها حصون السيادة الوطنية وأنظمة الحماية. بمعنى، أن هذه السيرورة الكونية لم تحسّن من وضع الفئات الوسطى والفقيرة بقدر ما وسّعت منها ومن تدني مدخولاتها، وهو ما تثبته أبحاث اقتصادية نوعية مقارنة في العقود الأخيرة. بل إن العولمة زادت من تضعضع أمنها الاجتماعي الاقتصادي وغموض مستقبلها وغياب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لم تحسن الأوضاع في دول الجنوب بقدر ما سرّعت في هجرة سكانها نحو الشمال والدول الغنية.
الولايات المتحدة – غير محصّنة البتة أمام هذه العواصف وهذه التأثيرات في العولمة ومفاعيلها، على رغم كونها مُصدّرة بامتياز لهذه السيرورة. وها هو ترامب، يحصد آثارها على المجتمع الأميركي كما حصدها من قبله مؤيدو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. الخوف من الراهن غير الواضح والمستقبل المهزوز حرّك فئات أميركية إلى المحور الذي ترأسه ترامب، وكان يُمكن أن يترأسه شخص آخر.
نشرت وسائل الإعلام الأميركية عن نتائج استطلاع مفادها أنه لو جرت الانتخابات بين ترامب الجمهوري، وبين بيرني ساندرز الذي نافس كلينتون على ترشيح الديموقراطيين، لفاز ساندرز على ترامب. وهذا، في حدّ ذاته يؤكّد ما ذهبنا إليه. فساندرز كان مرشحاً يسارياً بامتياز (حقق في حملته الانتخابية الداخلية الكثير من نقاط الفوز على هيلاري) وأقرب إلى الفئات المسحوقة والاحتجاجية على آثار العولمة ومفاعيلها.
لا يُمكننا أن نؤسس مفهومنا لنتائج انتخابات كالتي في أميركا على عامل واحد مهما يكن أساسياً وحاسماً. واعتقادنا أن هناك جُملة أسباب وجيهة أفضت إلى النتائج. ومع هذا أردنا أن نشير بقوة إلى ذاك التصادم التاريخي الحاصل بين عولمة مندفعة ومفهوم السيادة الوطنية كغاية من غايات العقد الاجتماعي ومكاسبه وما تركه من أثر في الفرد الأميركي. وأكثر، هناك نظرية مهمة ليورغن هبرماس، يقول فيها ما معناه أن الديموقراطية مفصّلة على مقاس الدولة الإقليمية وحدودها، وأن العولمة كسيرورة متجاوزة، تنتقص من هذه الديموقراطية لكونها تؤثّر من خارج الدولة وفي شكل قوي في الأوضاع فيها، في شكل يجعل من اللاعبين المركزيين ومن المواطنين رهائن مراكز خارجية. في حالة كهذه، ستتواصل في رأينا انتصارات القوى اليمينية المحافظة المناهضة لليبرالية بصيغتها المُعولمة في مواقع أخرى من العالم في الانتخابات أو من دونها.
الحياة
“بدّلوا ثيابكم” ولاقوه في منتصف الطريق/ جورج سمعان
فوز دونالد ترامب ظاهرة جديدة في تاريخ الديموقراطيات الغربية. ولا يمكن فصلها عما تعانيه ضفتا الأطلسي. فوزه اعتراض جلي على ما تمثله النخب والأحزاب والنيوليبرالية ومؤسساتها. جاءهم من خارج الثنائية الحزبية وإن سلم له الجمهوريون القياد مرغمين. ألم يتوعدهم بإفراغ «المستنقع» وتنظيف البيت الأبيض والمؤسسات الحاكمة في واشنطن والتي تحكم قبضتها على كل شيء؟ إنه زمن العودة إلى الوطنية ومفاهيم القومية والسيادة المطلقة التي طواها العالم وهو يخرج من تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية. والتعبير الصارخ عن الاعتراض على العولمة والتجارة الحرة اللتين كسرتا كل الحدود. وهددتا النسيج التقليدي للمجتمعات. إنه اعتراض على انتقال البشر والرساميل والسعي إلى بناء الجدران ورفع الحواجز في وجه المهاجرين والشركات العابرة للقارات. إنه زمن الخوف من التغيير ومن الآخر. زمن التحولات الكبرى. وفي كل مكان. إنها محاولة للعودة إلى الوراء، لـ «استعادة بلادنا»، كما عبر بريطاني أيد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ركب ترامب قطار التذمر في أوساط الطبقات المهمشة وسكان الأرياف الذين أفقرتهم السياسات الاقتصادية المتعاقبة من أيام رئاسة بيل كلينتون وقوانين التجارة الحرة وما ألحقته من أضرار بالصناعات الوطنية وإقفال لكثير منها وتفشي البطالة. لكن قطاره الجارف خلف جروحاً وانقسامات لن تقتصر آثارها على بلاده بل على العالم.
وفى الرئيس باراك أوباما بوعود أطلقها أيام حملته في 2008. أعطى دفعة للاقتصاد بعد الانهيار الكبير قبل سنوات. وداوى بعض ما ألحقته الحرب على أفغانستان والعراق من آثار في النفوس والبنى الاقتصادية. لكن هذه المنجزات لم تبدل في حياة كثير من الأميركيين. بل عمقت اللامساواة، فضلاً عن تنامي العنصرية والعنف. لذلك لم يحقق أوباما رؤيته التي بشّر بها مطلع ولايته الأولى. رأى إلى أميركا واحدة موحدة، لا بيضاء ولا سوداء، لا لاتينية ولا آسيوية. لكنها اليوم كل هذه. إنها أمام انقسام خطير وهي تتحدى الشعبوية والغوغاء والعنف والتطرف والعنصرية المتصاعدة، والتي عبرت عنها مواقف الرئيس العتيد أثناء السباق على البيت الأبيض. الشعبوية التي وصفها دومينيك دوفيلبان بأنها كثيراً ما تكون «نابعة من شعب مجروح». دوي جرس الإنذار يتردد صداه في كل مكان، وليس في شوارع المدن الأميركية حيث الاعتراض على الوافد إلى المكتب البيضاوي ظاهرة لم يألفها تاريخ البلاد. لكن الجرس كان يقرع من زمن في شوارع أوروبا مع تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز. ومع انتشار الإرهاب الآتي من كل حدب وصوب. من الشرق الأوسط الكبير ومن شمال أفريقيا.
من حق الأميركيين أن يخافوا، ويخرجوا إلى الشوارع اعتراضاً. كشفت الحملة الأخيرة في السباق على الرئاسة عمق الانقسام في مجتمعهم. انقسام افقي وعمودي. وكشفت حدة الصدام بين رؤيتين إلى العالم: رؤية تقليدية تواصل نهجها السلطات الحاكمة في الغرب عموماً والنخب المالية والثقافية، ورؤية تترسخ في أوساط طبقات أقل تعليماً تكره أهل الحكم ورجال المال والأعمال وما أتاحته الحدود المفتوحة على مصراعيها أمام انتقال الرساميل ورؤوس الأموال التي تعبر فوق رؤسهم ولا ينالهم منها ولو القسط القليل. كان الأميركيون يحلمون بتصحيح مسيرة الانكفاء الحاد والجذري في سياسة الرئيس أوباما. وهو ما وعدت به هيلاري كلينتون، ابنة المؤسسات. ولكن جاءهم حامل لواء عدم التدخل، أي مواصلة نهج الانعزال. وهذا ما قد يفقد الولايات المتحدة تدريجاً صورتها قائدة ورائدة للعالم. «أن تستعيد أميركا عظمتها»، كما أراد ترامب، شعار لا يحققه التقوقع داخل الحدود وتوجيه المدافع في كل الاتجاهات. يعرف الأميركيون أن عظمة بلادهم لا تقوم فقط على ما تقدمه إلى العالم في مختلف ميادين العلم. تلوذ عن موقعها الأول بأساطيل من كل نوع تجوب بحار العالم. وهو ما تحاول تقليده الصين اليوم. ولا تتحقق لاقتصادها المنعة والقوة إلا بانتشار قواعدها وقواتها حماية لهذه المصالح التجارية والصناعية والثقافية والأمنية… وكل ما تقدمه البلاد في شتى ميادين التقدم البشري.
ومن حق أوروبا أن تقلق. ليس لأن السيد ترامب هددها وأنذر حلف شمال الأطلسي في من أنذر وهم كثر من منظمة التجارة الدولية إلى بعض العرب وإيران واتفاقها النووي وحتى الصين التي تغرق العالم بمنتجاتها. من حقها أن تقلق. فبعد بريطانيا وتمردها على سلطات الاتحاد الأوروبي، تقدم حزب «البديل» اليميني في ألمانيا على حساب الأحزاب التقليدية في محطات انتخابية أخيراً. والوضع نفسه في النمسا والدول الاسكندينافية وهولندا التي عد زعيم المتطرفين فيها غيرت فيلدرز فوز ترامب «انتصاراً تاريخياً لنا جميعاً». ويراقب الفرنسيون بحذر تقدم «الجبهة الوطنية». الخطر أن يرى أهل اليمين المتطرف في الغرب فوز ترامب سنداً وعوناً لهم في سياق المواجهة مع الساسة التقليديين والمؤسسات الحاكمة. كانت أوروبا تجاهد لتطويق المتطرفين في مدنها وشوارعها فجاءهم الغيث والمدد من وراء المحيط. رحبوا بـ «عصر جديد». ونبه الرئيس فرنسوا هولاند من أن نتيجة السباق في أميركا ستخلف آثاراً كبيرة تعزز صفوف اليمين المحافظ في القارة، والشعبويين الذين عبروا عن شوقهم إلى العودة ببلدانهم إلى حدودها المعروفة. وتحدث الرئيس الفرنسي عن مرحلة من عدم اليقين! وهذه ألمانيا التي انتقدها الرئيس الأميركي العتيد بالاسم، يحذر وزير خارجيتها فرانك فالتر شتانماير من «أوقات صعبة». ويذهب زميله نوربرت روتغن المسؤول في حزب أنغيلا مركل أبعد منه في وصف فوز ترامب. اعتبر أنه «شرخ خطير ذو أبعاد تاريخية»، مذكراً بتصريحاته أثناء السباق: «كان صوت التعصب والكراهية وحتى العنف». زعماء أوروبيون آخرون يعترضون على السلطات الواسعة لبروكسيل هللوا ورحبوا.
من حق أوروبا أن تخاف من يمينييها. وأن تخاف أكثر من نزعة ترامب الانعزالية، وتالياً من غرق العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة في مياه الأطلسي، في وقت يسعى حلف «الناتو» إلى تعزيز قدراته لمواجهة الشهية المفتوحة لروسيا سواء في أوكرانيا وأوروبا الشرقية أو الشرق الأوسط. خصوصاً أن تركيا التي كانت ركيزة أساسية في الحلف تقترب أكثر وأكثر من موسكو على حساب علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة. فضلاً عن ترحيب الروس بفوز «مرشحهم» في الانتخابات الأميركية واستعدادهم للتدخل في الانتخابات الألمانية، كما حذرت المستشارة مركل. ومن حق الشرق البعيد أن يقلق. فالتركيز الاستراتيجي للرئيس أوباما على منطقة آسيا المحيط الهادي، القوة المحركة للاقتصاد العالمي، لم يلجم سياسة الصين في التوسع في بحرها وبحور جيرانها، حلفاء أميركا. ولا يبدو أن بمقدور واشنطن أن تجاريها في فضائها الحيوي وإن جهدت في بناء اصطفافات من الدول المعترضة على صعود بكين. في حين نجح الرئيس فلاديمير بوتين في بعث الحرب الباردة من دون أن تقوى أميركا أوباما وحلفاؤها على ردعه من ضم جزيرة القرم ووقف زحفه إلى المتوسط وتهديده دول البلطيق وغيرها التي تنتظر وفاء شركائها في «الناتو» بإرسال كتائب يمكن أن تردع القيصر عن أي مغامرة جديدة وكف تهديده الاتحاد الأوروبي بتقويض أسسه.
وتكفي العالم العربي رياح «الربيع» حروباً لم تفتت دوله ومجتمعاتها ومكوناتها فحسب، بل هددت تداعياتها دول العالم والمجتمع الدولي وقوانينه ودساتيره. وكان للإرهاب المتنقل وما خلفته موجات اللاجئين الأثر الكبير في تعزيز ميل الغربيين نحو التشدد والتعصب. وهذا ما ساهم في صعود اليمين المتطرف والشعبوية الساعية وراء مواجهة «الآخرين» الآتين من خارج حدود الدولة الوطنية. وما دفع بحكومات إلى التراجع عن نظم وقوانين وتقاليد وقيم لتحل محلها إجراءات تقيد الحريات وتتيح التدخل في الخصوصيات. ولا حاجة إلى التذكير بما حفلت به مواقف ترامب حيال المسلمين وعدد من الدول العربية. وما تودد به إلى الناخبين اليهود وإسرائيل. وهو ما يستدعي جهوداً عربية جبارة لاستعادة ما خلفته سياسة أوباما وما قد يقدم عليه خليفته. وقد لا ينجح الرهان على صدام آت مع إيران!
أما الآن وقد وصل إلى قيادة أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وأكبر قوة علمية وصناعية وتقنية، فلا ينفع العالم، والغرب خصوصاً، أن يطلق النعوت والصفات على الوافد الجديد. وقد لا ينفع الرهان أو الاطمئنان إلى مقولة أن الفائز بالرئاسة لن يكون شبيهاً بالمرشح. وأن المنظومة السياسية وتكتل المصالح والشركات الكبرى كفيلة بتصحيح مواقف الرئيس التي أطلقها في الحملة الانتخابية. المأزق لا يتجلى في نمو الشعبوية وحدها. فهي تعبير رافض للقائم والسائد. وعلى النخب والمؤسسات الحاكمة والأحزاب التقليدية أن تعترف بمسؤوليتها. فالرجل لم يأت من فراغ أو عدم. عليها أن تبدل «ثيابها» لتلاقيه في منتصف الطريق. أن تعيد النظر ببعض من مؤسساتها وسياساتها ونظمها المختلفة. على هذه القوى التي أدارت وتدير شؤون العالم أن تتقدم نحو التغيير لتبديد مخاوف المهمشين، وملاقاة المعادين للعولمة والتجارة الحرة والمعترضين على مصادرة تمثيلهم لحساب اتحاد هنا يهتز، ومصالح وشركات وتجارة هناك لا تقيم اعتباراً لكل مكونات المجتمع. وأن تتقدم نحو قيادة مسؤولة لحل أزمات العالم. صحيح أن الأزمة في الرئيس الجديد، لكنها أيضاً في أوساط النخب والأحزاب الحاكمة. فالزعيم الجديد لأميركا والعالم لم يأت من صفوف سياسييها ولا حتى من صفوف حزبيها. هزم الجميع وحده. هزم الإعلام وأهل الثقافة والأكاديميا والفن وهزم رجال الأعمال. لم يصدر عن الجمهوريين الذين تبرأوا منه واعتبروا أن وصوله سيخلق مشكلة لحزبهم. تخلوا عنه الواحد تلو الآخر. أما الديموقراطيون فكانوا حاملي راية تشويه سمعته يعينهم جيش من كبريات وسائل الإعلام والفضائيات. لكنه تجاوز كل الحواجز. استنهض البيض وهم الكتلة الأكبر من الأميركيين. إنه ثمرة ما زرعوا في العقود الأخيرة، من أيام بيل كلينتون وربما من أيام رونالد ريغان مروراً بجورج بوش الابن… وهم يحصدون ما زرعوا! تغيرت أميركا وتتغير وعلى العالم أن يعتاش مع هذا التغيير.
الحياة
صعود ترامب … نزاعات جديدة داخل أميركا وخارجها/ شفيق ناظم الغبرا
وقع الزلزال وأصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بينما لسان حال الكثير من الناس: كيف لترامب الذي تنقصه الهالة التي تحيط بكل رئيس أميركي وصل الى البيت الأبيض، أن يصبح رئيساً؟ بل كيف يمكن من جاهر بعنصريته أن يصل الى البيت الأبيض؟ ويعكس ترامب ذلك التناقض بين المثل الأميركية الليبرالية وبين العنصرية تجاه الأقليات والفئات المهمشة والمسلمين. فالولايات المتحدة ما زالت تعيش اهتزازاً ناتجاً من أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وحربي العراق وأفغانستان والنتائج المدمرة لهما. لقد جاء ترامب رئيساً في دولة تتميز بقدرتها على الإبداع، لكنها دولة تحمل مشروعاً إمبراطورياً سبّب لها مكاسب في مراحل، وصنع لها أخيراً اهتزازاً في مكانتها. اليوم، الولايات المتحدة تعاني، كما تعاني دول أخرى في أوروبا، من مأزق بين الطبقات حول التوزيع والعدالة. إن الرسائل الشعبوية والوعود الكبيرة لاستعادة العظمة وحل المشكلات كما طرحها ترامب، تكون عادةً مقدمة لصراعات أعمق في المجتمع كما في النظام الدولي.
يسعى ترامب الى حماية ما يعتبره مصالح الولايات المتحدة الأساسية، وهو أول رئيس يفوز في الولايات المتحدة رافعاً شعار “أميركا أولاً”. فالانطباع كان دائماً بأن الولايات المتحدة هي قائدة العالم، لهذا يمثل شعار ”أميركا أولاً“ بداية الاعتراف بتراجع الولايات المتحدة عن قيادة العالم. وهذا سيقود بالتالي الى التصارع والتعاون في الوقت نفسه، مع دول ومؤسسات دولية شتى هي الأخرى لديها مصالحها وستحاول تعبئة الفراغ الأميركي.
تؤثر السياسة الأميركية في العالم في صورة مضاعفة، وذلك لشدة ترابطها بالموقف العسكري السياسي كما ولترابط الاقتصاد والدولار الأميركيين بالعالم. فعندما تنسحب الولايات المتحدة من مؤسسة دولية ستدفع المؤسسة الى فقدان الفاعلية، وعندما تفرز رئيساً يؤمن بالعنصرية فستساهم في تشجيع العنصرية في العالم، وعندما تبني سوراً على حدودها مع المكسيك لن تنجح في منع الهجرة، بل ستعزز التقوقع والخوف تماماً كما تفعل إسرائيل حول الضفة الغربية وغزة. الضحية الأولى من ضحايا ترامب على المستوى العالمي، ستكون حقوق الإنسان والحوكمة والحريات، لهذا فالعنف في عهد ترامب سيكون مضاعفاً، ومقاومة آثار سياساته في الشرق الأوسط وفي الداخل الأميركي ستساهم في مزيد من عدم الاستقرار.
وسيزيد من تناقضات الموقف، أن ترامب سيجد نفسه في موقع مشترك مع بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا قلما يقع على هذه الدرجة من التوافق والتطابق في السياسة الأميركية. المرة الأخيرة التي وقع فيها هذا التطابق كانت مع الرئيس السابق جورج بوش الابن عام ٢٠٠٠، وقد أدى الى حروب وكوارث. التداخل مع إسرائيل والتناغم في الملفات سيجعلان الأثر الإسرائيلي في هذه الإدارة كبيراً. ترامب لن يدافع عن الفلسطينيين وعن الضعفاء والمهمّشين في العالم العربي، فهو لا يدافع أساساً عن ضعفاء الولايات المتحدة بينما يستخدم نقاط ضعف البيض لحشد تأييدهم. وفي الوقت نفسه، يتشارك ترامب مع الرؤية الإسرائيلية تجاه إيران. سيكون من الصعب أن تنسحب هذه الإدارة من الاتفاق النووي، لكن ستخفف من وتيرة الاندفاعة الأميركية تجاه إيران.
وينسجم الرئيس المنتخب ترامب مع نمو اليمين في فرنسا وأوروبا وبريطانيا، هذا اليمين الجديد غير مهتم بأسس الوسطية التي ميزت الغرب منذ الحرب العالمية الثانية، وهو بالتالي يمين أكثر صدامية، من دون أن يعني ذلك أنه يمتلك حلولاً لمشكلات أوروبا والولايات المتحدة والعالم.
سيجد رئيس الولايات المتحدة الجديد، أنه يتعاون مع روسيا ومع الأنظمة بغض النظر عن مضمون سياساتها وطبيعة علاقاتها بشعوبها. بالنسبة الى الرئيس الجديد ترامب، العلاقة مع العرب مفيدة لموازنة إيران، وسنجده يركز على مصر والأردن وإسرائيل انطلاقاً من حرصه على الموقف الاستراتيجي الإسرائيلي، بينما يركز على مواجهة ما يعتبره الإرهاب الإسلامي وحشد كل من يقف ضده. ونظراً الى نظرته الثاقبة الى عالم المال والأموال، فسيسعى الى مشاركة الدول العربية الأغنى في المصاريف الأميركية. لن يعتني هذا المنطق بالديموقراطية والحقوق، فكل الحلول مالية وأمنية. نظرة فريق ترامب الى المنطقة العربية تشكو من السلبية وضعف المعرفة وقلة الخبرة، وهذا سينعكس على السياسات المقبلة. ترامب لا يحب القراءة، وهو بالتالي سيعتمد على من يثق بهم من خارج أسرته ومن داخلها، وفي هذا ستكون إشكالية إدارة إمبراطورية تتراجع كإدارة شركة تجارية تتعامل مع الأرباح والخسائر.
من جهة أخرى، سيتعمق شعور السوريين باليأس من النظام الأميركي، ما سيجعلهم لا يعولون على دور أميركي أكثر حزماً. فصراعهم وحربهم مستمران حتى لحظة الوصول الى حل وتسوية تحتوي على قيم للعدالة، وهذه الرسالة هي نفسها التي سيتلقفها الفلسطينيون. ترامب سيدفعهم كما سيدفع غيرهم الى اليأس من السياسة الأميركية، وهذا ينطبق على فئات مختلفة من الشعوب العربية. هكذا سيدفع ترامب بحركة التاريخ الى الدوران في ظل عملية تكثيف للتناقضات وللغضب والخوف في الداخل وفي الخارج. وسيكتشف ترامب كم أن الشرق آيل للمفاجآت في عهده وفي كل العهود. في عهد أوباما، جاءت الموجة الأولى للربيع العربي، فهل تأتي الموجة الثانية الأكثر راديكالية أو غضباً في عهد ترامب؟ وفي عهد ترامب ستستمر القوة التركية والإيرانية على الأغلب في التصاعد، وسيزداد الوضع الفلسطيني احتقاناً وثورية.
من جهة أخرى، فإن ضغوط ترامب على الخليج ستخيف الخليج وتدفعه الى البحث عن خيارات أقل كلفة. فالخليج يريد سياسة أميركية مسؤولة، وهو أيضاً يدفع ثمن السياسات الأميركية الخاطئة (مثلاً سياسة الولايات المتحدة في العراق عام ٢٠٠٣ في عهد الرئيس بوش). فهل تكون مرحلة ترامب مرحلة تغير في العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج؟ هل يندفع الخليج في جانب منه نحو الصين وفي جانب آخر نحو تركيا من دون أن يعني ذلك إيقاف التعاون الاستراتيجي والاقتصادي مع الدولة الكبرى؟ وهذا يثير السؤال: هل أصبح إشراك قوى أخرى في أمن الإقليم ضرورة؟
ويواجه ترامب من جهة أخرى، معضلة حزبه، فالحزب الجمهوري أصبح تجمعاً من الأفكار والأيديولوجيات المحافظة واليمينية من مدارس ومشارب مختلفة. وهو حزب لا تجمعه المصالح والقضايا الأساسية بقدر ما تجمعه الأيديولوجيا، وهذا يعني أن تناقض الأفكار المحافظة واليمينية مع الواقع سيؤثر سلباً في الحزب الجمهوري. سيلوم كل طرف الآخر عند الوقوع في سياسات خاطئة، وهذا سيعيق مقدرة ترامب على تنفيذ الكثير من وعوده. لهذا، فسعيه الى طرد ملايين اللاتينيين بتهمة الوجود غير الشرعي لن ينجح لأنه لن يحظى بإجماع الجمهوريين، كما أن بناء السور مع المكسيك سيتحول الى كارثة على البلدين. وحدة الجمهوريين مرهونة في جانب كبير منها بمواجهة التيار الذي يقوده الحزب الديموقراطي. لكن خسارة الديموقراطيين المواقع الأساسية في الكونغرس ستنقل الصراع نحو الجمهوريين الذين لن يجدوا عدواً يوحدهم.
وسيكتشف ترامب، كما يكتشف الكثير من الزعماء العرب، أن الملونين والأقليات والمثقفين من البيض والحداثيين الرافضين أطروحاته في الولايات المتحدة، سيزدادون معارضة وحشداً. ستتحول الاحتجاجات الشعبية التي بدأت بمجرد انتخابه، وسيلة لإعادة بناء الحزب الديموقراطي من حزب تحكمت به المصالح الضيقة الفوقية في المراحل الأخيرة الى حزب شعبي يستند الى مجتمع متجدد ومائل الى اليسار في مسائل الأغنياء والفقراء، كما ومائل أيضاً الى تبني قضايا العدالة في النظام الدولي. هذا بطبيعة الحال سيدفع بشخصيات كبرني ساندرز ومن يشبهه الى الواجهة. إعادة بناء الحزب الديموقراطي ستمهد لانتخابات الكونغرس عام ٢٠١٨، ثم والأهم للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات، بخاصة عندما يفشل ترامب في تحقيق الوعود التي وعد بها سكان المناطق الوسطى الأميركية والبيض من غير المتعلمين. ربما إذا استثمر ترامب في التعليم سيخلق الأساس الذي يسمح للكثير من البيض بالعودة النوعية الى سوق العمل، لكن هذا لن يكفي.
لقد غير انتخاب ترامب الكثير من المعادلات، فهو حدث كبير يعكس ردة فعل على العولمة التي قادتها الولايات المتحدة، ويعكس في الوقت نفسه ردة فعل الغرب تجاه الشرق وتجاه العالم الثالث، وردة فعل البيض تجاه قوة صعود الأقليات والمهمشين، بل وردة فعل الإمبراطورية الأميركية على استهدافها وتراجعها العالمي والطبيعي بعد كل الحروب التي تورطت فيها. أيديولوجية ترامب تعكس الخوف، لهذا سيجد ترامب أنه في حالة تفاوض دائمة مع الدولة الأميركية التي ستسعى الى استيعاب سياساته والتقليل من الفوضى التي قد تطلقها. صعود ترامب سيؤسس لنزاعات جديدة في الداخل والخارج، لكنه سيفتح الباب لفرص جديدة في الشرق الأوسط كما في الداخل الأميركي.
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت
الحياة
وقف التخريب الإيراني أجدى من إلغاء الاتفاق النووي/ عبدالوهاب بدرخان
يبقى عدم اليقين مرجّحاً مع دونالد ترامب، الى أن يثبت العكس. ولا تبدو المؤشّرات الحالية ذات دلالة، فالمسألة لا تقاس بتشاؤمٍ أو تفاؤلٍ، ولا بالخوف والحذر أو بالاطمئنان، إذ إن الرئيس الأميركي الجديد أطنب في الكلام وأثار الكثير من القلق وقليلاً من الآمال، لا للعرب وحدهم بل لمجمل العالم. وهناك مَن يدعون الى عدم الأخذ بحرفية ما قاله لزوم المعركة الانتخابية، بل الى استخراج الجدّية الكامنة في مواقفه. وهناك مَن يقولون أنه أحدث لتوّه انقلاباً في السياسة الأميركية بلونيها التقليديين، الجمهوري والديموقراطي، اللذَين قدّما في الستة عشر عاماً الأخيرة نموذجَين في المنطقة العربية، الأول تدخليٌّ جداً وكارثيٌّ مع جورج دبليو بوش في العراق الذي انتهى تحت الهيمنة الإيرانية، والآخر غير تدخليّ وأكثر كارثية مع باراك أوباما في سورية التي أصبحت تحت الاحتلال الروسي – الإيراني. أي أن الثابت الوحيد في هذين العهدَين، اعتمادٌ مباشر أو غير مباشر على إيران، وبالتالي على الشيعية السياسية في مواجهة السنّية السياسية باعتبارها مسؤولة عن ظهور «الإرهاب السنّي».
فهل أن اختراق ترامب «مؤسسة الحكم» يشكّل انقلاباً فعلياً في السياستين الداخلية والخارجية؟ ثمة مؤشّرات قليلة، والباقي مجرّد افتراضات ومراهنات قد تنطبق أو لا تنطبق على الواقع، في انتظار توجّهات حقيقية لن تتضح قبل شهور. لم يكن جديداً ولا مفاجئاً (ولا انقلابياً) تشديد ترامب على علاقة خاصة مع إسرائيل، فهذا عنوان حَكَم عقلية الإدارات الأميركية واختصر سياساتها تجاه المنطقة العربية طوال العقود الماضية، وتحته اندرجت المراحل المتقلّبة مع العرب من التقارب والتنافر والعداء، وبموجبه ظلّت «الصداقات» هشّة على رغم «المصالح»، بل استحال الارتقاء بهذه المصالح الى تحالفات على رغم إلحاح الظروف. وإذا كانت طرأت تغييرات طفيفة، غير ثابتة وغير جوهرية، على المقاربة الأميركية للعالم العربي بعد تخلّي العرب عن خيار الحرب ضد إسرائيل، إلا أنها استمرّت متماهية مع المقاربة الإسرائيلية، ثم جدّدت سلبيتها منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) محمّلة مسؤوليتها للعرب حكوماتٍ (قانون «جاستا» آخر التجلّيات وليس الأخير) وشعوباً (بدءاً بإجهاض مشروع السلام الفلسطيني – الإسرائيلي، ثم بالتضحية بالشعب الفلسطيني ومن بعده العراقي والسوري واليمني) ودولاً (بالمساهمة في تفتيت المنطقة الى دويلات).
في الأعوام الستة الأخيرة، أتاحت اضـطرابات «الربيع العربي» لواشنطن فـــرصة تاريخية لتبرهن صدقية نياتها بترجيح الاعتدال على التطرّف وتغليب الاستقـــرار علـــى التوتر في المنطقة. لكنها اتّبعـــت سياسة لمـــ يستفد منها ســـوى دعاة العنف والتطرّف والتخلّف، وكان واضحاً أن المتضرّرين هم رموز الاعتدال والاستقرار فضلاً عن دعاة الإصلاح والتطوير. وحتى «الحرب على داعش» بدت وتبدو ذريعةً ووسيلةً لتطبيق مشروع «الشرق الأوسط الكبير» كما بلوره المحافظون الجدد أيام بوش الابن، ولم يتخلَّ عنه أوباما بل تولّى متابعة «تمكين إيران» الذي بدأ عملياً بـ «التفاهم» على العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي. وإذ أضاف أوباما تمكيناً لإيران في سورية واليمن ولبنان، مع جهد لمدّ هذا التمكين الى البحرين، فإنه مرّر كل الانتهاكات الإيرانية لقاء الحصول على الاتفاق النووي، واتّبع بعد ذلك نهج حماية لمكاسب إيران، ولذلك تأبّطت طهران الاتفاق كصكٍّ يشرّع تدخّلاتها ويعترف بنفوذها الإقليمي مقابل «التنازل» الذي قدّمته في برنامجها النووي. وبناءً على هذا «الاعتراف»، أخرجت دورها في العراق وسورية الى الواجهة، ولو أتيح لها لفعلت ذلك في اليمن، لكنها تلعب يمنياً ورقة عدم وجودها على الأرض لتمكين إدارة أوباما من مواجهة السعودية و»التحالف العربي» وإحراجهما بأن ما يقال عن تهديد إيراني ليس واقعياً.
يدخل الرئيس الأميركي الجديد الى هذا المشهد الخليجي – الشرق أوسطي، بما فيه من كوارث ووقائع وخيارات ساهمت فيها أميركا نفسها أو حسمت وجهتها، ليجد حتى أن الدور الإيراني كان الثابت الوحيد في «تفاهمات» واشنطن وموسكو للتعاون في سورية، فهل يريد تغيير هذا الواقع؟ المعروف أن الأميركيين والروس لم يتطرّقوا يوماً الى حدود الدور الإيراني أو الى وجود الميليشيات الموالية لطهران وانعكاساته التخريبية على أي حل سياسي أو حتى عسكري للصراع. وعلى رغم غموض الأفكار الترامبية، تم التركيز على نيّته تغيير الخط الأوبامي، أولاً بتطوير مسارٍ للتعاون مع روسيا، وهذا يتوقف على أجندة «صديقه» فلاديمير بوتين الذي استغلّ تعاون أوباما لإضعافه، وثانياً باستعادة شروط «الاحتواء» في التعامل مع إيران إذا كانت لا تزال صالحة للتطبيق مع الإبقاء على الاتفاق النووي «معدّلاً» أو إلغائه وربما الانسحاب منه.
قد يتناغم تعاون ترامب مع روسيا مع جهود بذلها العرب للانفتاح على موسكو ومحاولة التفاهم معها من دون أن تعدّل شيئاً في السلوك أو السياسة الروسيَّين. ومن غير المؤكّد أن معادلة التهادن مع روسيا مقابل المواجهة مع إيران لا تزال ممكنة في ظلّ حاجة الروس والإيرانيين الى بعضهم بعضاً في سورية، كما أن شيئاً لا يضمن أن تنعكس علاقة ترامب مع بوتين إيجاباً على المنطقة العربية. فأي تقارب بينهما ينجح استراتيجياً أولاً أو لا ينجح إطلاقاً، ويسعى الى التفاهم على السياسة الدفاعية وملف أوكرانيا بما فيه رفع العقوبات المفروضة على روسيا ليتوصّل الى تفاهم على القضايا الإقليمية. وقياساً الى التجربة مع أوباما، فإن عدم التنازل لروسيا في المسائل الكبرى هو ما أفشل التعاون في سورية على رغم كل التنازلات الأميركية، وإذ يستند ترامب الى تلك التنازلات (1 – بإعلانه حجب الدعم التسليحي (غير الموجود أصلاً) للمعارضة، (2 – وإخضاعه الصراع الداخلي السوري لأولوية محاربة الإرهاب وموجباتها، (3 – وعدم اهتمامه ببشار الأسد ومصيره بل اعتباره «شريكاً» مع إيران في محاربة الإرهاب، مع ما يفترضه ذلك من تجاهل وتمييع لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الأسد ونظامه… فإنه يتطلّع الى أن يكتفي بوتين بسورية كمقدمة لتعاونهما، في حين أن بوتين يوجّه نظره الى ما يعتزمه ترامب من تغيير في المفاهيم الدفاعية المعتمدة داخل حلف «الناتو».
في أي حال، لم تكن للعرب مشكلة مع هذا الاتفاق النووي بل مع استخدامات إدارة أوباما ونظام الملالي لهذا الاتفاق، خلال التفاوض عليه وقبل إبرامه وبعده. فإلى أي حدّ سيكون ترامب معنيّاً بـ «تصحيح» السلوك الإيراني، خارج المسألة النووية، وهل سيكون لديه تصوّرٌ لـ«مصالح أميركا» مختلفٌ عن ذلك الذي رسمه أوباما وجعل فيه لإيران موقعاً بارزاً ودوراً مستقبلياً؟ وإذا كانت للحرب على الإرهاب، وتحديداً ضرب تنظيم «داعش»، الصدارة في أي استراتيجية ترامبية، فهل يتجاهل حقائق دورَي النظامين السوري والإيراني في رعاية الإرهاب وتوظيفه ليحافظ على المهادنة المجّانية غير المجدية التي أقامها أوباما معهما؟
قد يبدو تلويح ترامب بإلغاء الاتفاق النووي والعودة الى احتواء إيران، نبأً جيداً – نظرياً – بالنسبة الى العالم العربي، إلا أنه لن يكون مجدياً عملياً من دون استراتيجية تعاون شاملة تتوافق فيها أميركا وروسيا على خفض التوتّرات بينهما وكذلك التوتّرات الإقليمية، وعلى محاربة جدّية للإرهاب والمستفيدين منه في دمشق وطهران وبغداد، وبالتالي على دعم حلول سياسية لنزاعات عربية أهلية بات مؤكّداً أنها تهدد الاستقرار العالمي سواء بعمليات الإرهاب أو موجات اللاجئين. وكل توجّه آخر سيكون مجرّد استمرار لنمط الحروب بالوكالة والمتاجرة بمآسي الشعوب والمجتمعات، وهو ما يبقى مرجّحاً لأن مصطلحات السلام على أنواعها لم تتسلّل الى قاموسَي بوتين أو ترامب.
أن يعمّ القلـــق والشك معظم أوروبا والعالم العـــربي إزاء انتخاب ترامب، مقابل ارتيـــاح في موسكو ودمشق وإسرائيل وحتى تركيـــا وأوساط اليمين الأوروبي المتطرّف، فهل في ذلك دلالة على أين ينتمي ترامب (وناخبوه؟) أو على أنه قد ينتهج حيال العــرب سياسة مناقضة لسلبية مواقفه خلال الحمــلة الانتخابية؟ لا بدّ للرئيس الجديد أن يتعامل مع الواقع الذي ساهم معظـــم مريديه في تخريبه والدفع ببعض الدول العــربية نحو التفكّك، وستتوقف على خياراته احتمالات إضعاف الإرهاب أو مضاعفته، كما وحدة الدول أو تقسيمها.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
ترامب يتبنى إرهاب الدول/ حسان حيدر
لا يقدم دونالد ترامب جديداً بقوله أن المهمة الرئيسية لبلاده في الشرق الأوسط خلال ولايته، ستكون «مكافحة الإرهاب» والقضاء على «داعش» وسواه من التنظيمات الإرهابية، فهذا شعار تعاقبت على رفعه إدارتان، جمهورية وديموقراطية، منذ اعتداءات 2001، لكن الجديد أنه يخلط عمداً بين الإرهابيين وبين المعارضين المتطلعين إلى استعادة حقوق بدهية، ويضفي في المقابل «شرعية» من لدنه على دول وأنظمة تمارس الاستبداد والإرهاب داخل حدودها وخارجها، بذريعة أنها تشاركه مهمته.
وعندما يقرن معركته المزمعة باستعداده للتعاون مع روسيا والنظام السوري، وبالنتيجة إيران، في محاربة «الإرهابيين» في سورية، ويشدد في الوقت ذاته على انحيازه التام إلى إسرائيل في شكل يقارب الوقاحة أحياناً، يكون اختار عملياً الوقوف في صف إرهاب الدول بحجة مواجهة إرهاب الجماعات، ضامّاً إلى هذه الأخيرة الشعب الفلسطيني بأكمله، بعدما انتقى بين معاونيه بعض كبار المغالين في تأييد الدولة العبرية وسياساتها العنصرية.
وإرهاب الدول والأنظمة سابق على إرهاب الجماعات ومشجع عليه. ولو لم يلجأ النظام السوري إلى العنف وسيلة وحيدة للرد على مطالبة شعبه بإصلاحات سياسية لما حمل المعارضون السلاح. وكان فرض قيام دولة إسرائيل بالقوة المسلحة وطرد الفلسطينيين من أرضهم سبباً للمواجهة المستمرة منذ سبعة عقود، ولا تزال إسرائيل تمارس عنفها اللامحدود على سائر محيطها وترفض الاعتراف بدولة فلسطينية ولو على جزء من فلسطين التاريخية.
وقد يعتبر البعض أن ما يقال خلال الحملات الانتخابية أو يتخذ من مواقف في حمأة الفوز بها، إنما هدفه تحفيز الناخبين ومواصلة تعبئة المؤيدين وطمأنتهم، وليس بالضرورة أن يستمر لاحقاً أو يطبق. لكن هذه التصريحات والمواقف تعكس عقلية سياسية وتعبر عن قناعات عميقة لدى فريق ترامب ومؤيديه ستجد بالتأكيد طريقها إلى التطبيق ولو جزئياً.
وباختياره حلفاءه الثلاثة، بوتين والأسد ونتانياهو الذين يعربدون في سورية وفلسطين والمنطقة، يصبح من المنطقي توقع أن الحرب على المعارضة السورية التي حشدت لها روسيا أفضل ما في ترسانتها البحرية والجوية والصاروخية، والتي تشارك فيها إيران بمروحة واسعة من الميليشيات المذهبية، مرشحة للتصاعد بهدف خنق الثورة وإنهائها. ويعني ذلك أيضاً أن العسف الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة سيشهد طفرة واضحة بدأت إشاراتها قبل أيام باتخاذ سلسلة من القرارات تستهدف هوية الفلسطينيين من خلال الإمعان في مصادرة أراضيهم لمصلحة المستوطنين، ومنعهم من تأدية مشاعرهم الدينية في مدينة القدس.
وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس التي وصفها بأنها «العاصمة الأبدية للشعب اليهودي»، ودعا الفلسطينيين إلى التخلي عن «مناهج الكراهية التي يدرسونها لأولادهم» والامتناع عن تسمية الساحات في مدنهم وقراهم بأسماء «الإرهابيين». واعتبر أيضاً أن «داعش يشكل خطراً على أميركا أكثر بكثير مما يشكله الأسد»، واتفق مع بوتين على «ضرورة تضافر الجهود في إطار مكافحة العدو الرقم واحد المتمثل بالإرهاب الدولي والتطرف».
لكن ما قاله وما قد يفعله يتناقض تماماً مع حديثه عن «إعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط»، لأنه يفتح الطريق أمام المزيد من العنف والقهر والاستباحة، ويشجع المتطرفين الذين سيجدون في خطواته المنحازة مزيداً من المبررات لرفضهم نهج الاعتدال والبحث عن تسويات عادلة. أي أن ترامب يدعم في شكل غير مباشر الإرهاب الذي يدعي محاربته عبر تبنيه الإرهاب المنظم الذي يمارسه حلفاؤه الثلاثة الجدد، وإلى جانبهم إيران.
الحياة
الأميركيون انتخبوا ترامب لاستعادة “القوة العظمى”/ ارشد هورموزلو
لنصارح بعضنا البعض. كدنا نفقد شعور المواطنة، وهذا أخطر ما يمكن للجنس البشري أن يفقده. أفرزت العقود الأخيرة تناقضاً بارزاً بين ما نعيشه وما يعيشه الآخرون. أخذ البعض هنا يبشر بالتقوقع الإثني والمذهبي والدعوة الى كانتونات ودويلات ومناطق محررة. بينما عمد الآخرون هناك الى نبذ خرافة صكوك الغفران والتناحر المذهبي والعرقي.
كانت النتيجة أن ارتقت الدولة لديهم الى مصاف عالية، بينما استمر الناس هنا في مناقشة من يحصل على الحقيبة الوزارية والسيطرة على هذه المنطقة أو تلك. أخطر ما في الموضوع اتجاه هذه الطروحات الى العنف وليس الإقناع، وعندما تتجه دولة ما الى محاربة التطرف والعنف وترويع المدنيين تتهم عادة من جانب من حزموا أمرهم وأسسوا دولتهم المدنية باستعمال القوة المفرطة.
خذوا مثلاً الصحافي المخضرم الذي سبق أن ناقشنا طروحاته في أكثر من مرة عندما يصر على أن تركيا أو بالأحرى «السلطان أردوغان»، كما يسميه يقمع الأكراد جميعاً. قلنا له أن الذين يحاربون «القاعدة» أو تنظيم «الدولة الإسلامية» المزعومة لا يحاربون العرب مثلاً، وإنما الإرهابيين منهم. هناك في تركيا غير الأكراد، الكثيرون من العرب أو المسيحيين أو الشركس وآخرون، هل سمعنا نداءات تقول أنهم يتعرضون للقمع؟
هناك الملايين من الأكراد الذين هم شركاء في الوطن التركي، شأنهم في ذلك شأن وجودهم في أكثر من قطر مجاور. ولأقوم مسبقاً بالإقرار بأن مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في الحفاظ على كيانهم العرقي والسياسي والثقافي أمر مشروع بل مطلوب. ولكن شعور المواطنة يجب أن يطغى على التطلعات لإنشاء بلد حضاري متمدن يسود فيه القانون وتحترم فيه حقوق الإنسان وينخرط الكل في بناء الدولة العصرية التي يأملون بأن يورثوها أبناءهم وأحفادهم مع الاحتفاظ بحقوقهم المشروعة.
ولكن هناك من يعتبر الوزراء والتكنوقراط والكتاب والأساتذة من الكرد الذين هم ضمن اللحمة الوطنية بأنهم «خونة»، لأنهم لا يؤيدون التوجه الإرهابي والعنف واستعمال ما تحت أيديهم من معدات وإمكانات لحفر الخنادق وقصف الأماكن الآمنة وترويع المدنيين حتى لو كانوا من أبناء جلدتهم.
لا أريد أن أتهم الأكراد فكلنا مسؤولون عن هذه المحنة، وهناك من يتهم من يدعو الى التعايش بين المذاهب الإسلامية بالخيانة لمطالب الاستفراد ونعرات الثأر. خلاصة الأمر أننا لم نتعلم بعض ثقافة الحوار الهادف وتغليب شعور المواطنة الذي يقتضي القبول بالآخر.
الذي أفقدنا شعور المواطنة هو الحماس المتعلق بالمتاجرة بالشعارات، بينما أدرك الكل أن الشعارات الحماسية غير الواقعية لا تبني البلد ولا تسهم في رسم سياسة واضحة للدولة. من هذا المنطلق أقول أنه يجب عدم التحدث عن النموذج التركي أو الأوروبي أو الأميركي أو أي نموذج آخر. لكل واحد منا خصوصيته التي يجب أن لا ننال منها بتقليد الآخر وإن كان من الممكن استلهام تجاربه.
كنت مع سياسي تركي كبير يتحدث الى مواطني دولة عربية كبرى، قال لهم: لا أرى صحيحاً أن ترفعوا العلم التركي في تظاهراتكم إمعاناً في الحب والتقدير. ارفعوا أعلامكم الوطنية فهي الجديرة بتقديمها، فنحن لا نرفع علم بلدانكم في تظاهراتنا، غير أننا نزين شوارعنا وأزقتنا بعلم بلادكم عندما يزورنا زعيم هذه البلاد في زيارة رسمية. هناك استثناء واحد هو العلم الفلسطيني الذي تتناوله الأكف لأن المأساة الفلسطينية هي جوهر آلامنا وهي قضيتنا المركزية مثلما هي قضيتكم، وأرجو أن لا يشوبها النسيان.
وقد كثر الحديث عما حصل في الانتخابات الأميركية الأخيرة والفوز غير المتوقع للسيد دونالد ترامب في هذه الانتخابات كرئيس لأكبر دولة يفترض أنها القوة العظمى على وجه الأرض. وباعتقادي أن الخطأ الذي وقعت فيه مؤسسات الاستطلاع التي أجمعت على حتمية فوز هيلاري كلينتون كان يكمن في أن معظم أطياف الشعب الأميركي قد حزم أمره في ضرورة انتخاب رئيس يعطي الأولوية للمواطنة وتضخيمها آملين بأن تعود الولايات المتحدة الأميركية قوة عظمى كما كانت وقبل أن ينالها التخاذل والتردد وعدم الشفافية.
ولكن لماذا أخفوا هذا الأمر عندما تحدثوا الى مؤسسات الاستطلاع؟ أعتقد أنهم خجلوا من الإفصاح صراحة عن تأييدهم لرئيس محتمل لا يتوانى عن إظهار العداء العنصري للمهاجرين والأقليات والمسلمين والمرأة. ولكن شعورهم الداخلي كان مع انتخاب شخص يعطي الأولوية للمواطنة الحقة ويبشر بولايات متحدة عظيمة مجدداً.
ألم يحدث ذلك؟ نعم فقد أخطأت جميع مؤسسات الاستطلاع وجميع الصحف الأميركية عدا «لوس أنجليس تايمز»، وحزم المواطن الأميركي أمره فهو يريد بلاداً تطغى فيها المواطنة الحقة.
* كاتب تركي
الحياة
ترامب والبداية المتعثرة والمقلقة/ هشام ملحم
بعد اسبوع من انتخابه يواجه دونالد ترامب انتقادات قوية بسبب تعييناته الاولية، ولان فريقه الانتقالي تعثر لاسباب سياسية وقانونية ونتيجة الخلافات الشخصية، بدأ التعثر فور اقصاء الحاكم كريس كريستي رئيس الفريق الانتقالي واستبداله بنائب الرئيس مايك بنس (لاكثر من سبب بينها ان صهر ترامب جاريد كوشنر حاقد على كريستي لانه حاكم والده وسجنه بتهمة الاحتيال في 2004 عندما كان كريستي المدعي العام لولاية نيوجيرزي). وواصل كوشنر، المقرب جداً من ترامب والذي كان من أبرز مستشاريه غير الرسميين خلال الحملة، تطهيره للفريق الانتقالي، حين ارغم النائب السابق مايك روجرز، الذي عينه كريستي المستشار الامني للفريق الانتقالي، على الاستقالة.
وفي الايام الأخيرة كان دور أولاد ترامب في الادارة الجديدة محور اهتمام وسائل الاعلام بعد تسريب أنباء عن احتمال اعطائهم تصاريح أمنية تعطى فقط لكبار المسؤولين. ولا يحق للرئيس الاميركي توظيف أي فرد من عائلته. ومن المتوقع بروز تضارب في المصالح، لان الرئيس المنتخب متورط في دعاوى قضائية عدة، واذا أبقى أولاده مسؤولين عن شركاته، كما يبدو، فان ذلك سيتسبب بمشاكل قانونية، لانه يفترض في أي رئيس منتخب ان يضع ثروته في ائتمان مغلق بحيث لا يعرف عن استثماراته أي شيء خلال ولايته. واذا أبقى ترامب شركاته في عهدة أولاده، فانه سيبقى على اطلاع على استثماراته.
لكن التعيينات الاولية لترامب والشخصيات التي تطرح لاحتلال المناصب الحساسة في ادارته أثارت وستثير الكثير من الجدل والاستهجان. قرار ترامب تعيين راينس بريبوس رئيس الحزب الجمهوري مديراً للبيت الابيض قوبل بالارتياح من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس لان بريبوس مقرب منهم، واعتبر تعيينه محاولة لاسترضاء “المؤسسة الجمهورية التقليدية” في واشنطن. لكن تعيين ترامب ستيف بانون مدير حملته مستشاراً خاصاً، أثار عاصفة من الاحتجاجات لان بانون المدير السابق لموقع “برايتبارت” الالكتروني معروف بتصلبه وعدائه لقادة الحزب الجمهوري وبمواقفه السياسية المتعصبة، ونشر موقعه مقالات معادية لليهود والمسلمين والمثليين. وجاء تعيين بانون على خلفية الزيادة الكبيرة في أعمال التحرش والترهيب التي قام بها متطرفون أيدوا ترامب في حق المسلمين واليهود والاميركيين ذوي الأصل اللاتيني.
الاسماء المرشحة لمنصب وزير الخارجية أثارت المخاوف أيضاً لأن أبرزها هو رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك خلال هجمات 11 أيلول 2001 والمعروف بطبعه الناري وتطرفه ولانه يفتقر الى الخبرة الديبلوماسية. الاسم الآخر هو جون بولتون، المسؤول السابق في الوزارة وأحد أبرز “المحافظين الجدد” والذي دعا في السابق الى قصف المنشآت النووية الايرانية. مواقف ترامب المتصلبة أبعدت عنه شخصيات جمهورية جدية مؤهلة لمساعدته، وهذا سيساهم أكثر في تعثره.
النهار
عقلانية الدولة الليبرالية في مواجهة الفاشية الجديدة/ د. بشير موسى نافع
كان فوز الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب، مفاجأة صاعقة لكثير من الأمريكيين، بما في ذلك قيادات وخبراء الحزب الذي ترشح باسمه، الحزب الجمهوري، وللغالبية العظمى من السياسيين في العالم، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم. لم تنجم المفاجئة من خطأ حسابات استطلاعات الرأي، لأن استطلاعات الرأي كثيراً ما تخطئ. ليست السياسة علماً بالمعنى الذي توصف به الفيزياء أو البيولوجيا، ولا تتمتع استطلاعات الرأي باليقين الرياضي. جاءت المفاجأة من حجم التباين بين خطاب ترامب ووعوده، من جهة، وما تعنيه الدولة في تجليها الرأسمالي الليبرالي، دولة ما بعد الحرب الباردة، من جهة أخرى، وما تعنيه أمريكي في المنظومة الغربية، بصورة خاصة.
لقطاع من الأمريكيين، مثّل فوز ترامب كابوساً ثقيل الوطأة. المرشح، الذي أهان ملايين المكسيكيين المهاجرين، ووصفهم بتجار المخدرات والمغتصبين والمجرمين، وتعهد بطرد ما يزيد عن عشرة ملايين من المقيمين غير المسجلين منهم، الذي لم يتردد في وصف المسلمين بالإرهاب ووعد بمنعهم من دخول البلاد، الذي سخر من المعاقين جسمياً، والذي لم يخف احتقاره للمرأة وتعامله معها كمجرد سلعة للاستهلاك، المرشح الذي رأى معارضيه، وهم أكثر من نصف الأمريكيين، مجرد ليبراليين منحلين أخلاقياً، المرشح الذي لم يستطع حتى الفوز بأغلبية أصوات الناخبين، سيصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. لحلفاء واشنطن، كان الحدث أكثر مدعاة للخوف، فترامب لم يخف إعجابه بنموذج الزعيم القوي المستبد، وحسب، بل وهدد بتقويض الأسس التي يستند إليها النظام الليبرالي الغربي منذ ما بعد الحرب الباردة.
أنذر ترامب شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو بالتخلي عن الحلف إن لم يستجيبوا لشروطه، بما في ذلك التحلل من مسؤوليات الدفاع عن دول تتعرض لمخاطر روسية، لم يخف عزمه على التخلي عن اتفاقية باريس لحماية المناخ والبيئة، وأعلن عن سعيه إلى إطلاق حرب تجارية ضد الصين (التي تقوم باغتصاب الاقتصاد الأمريكي، كما كرر في حملته الانتخابية)، وقال إنه سيضع الاتفاقية حول الملف النووي الإيراني في سلة المهملات.
لم يتردد ترامب مطلقاً، طوال أكثر من عام من الصراع الانتخابي، في الكشف عن ميوله القومية المتطرفة. وفي السياق الأمريكي، في دولة المهاجرين من كل أنحاء العالم، الدولة الأكثر تعددية وتنوعاً، إثنياً وعرقياً ودينياً، تأخذ القومية المتطرفة معنى ودلالة خاصتين، معنى الفاشية ودلالاتها.
أراد ترامب استنهاض الكتلة الأمريكية البيضاء، التي تشعر أنها مهددة بالمتغيرات الديمغرافية الحثيثة في بلاد المهاجرين، بسياسات المساواة بين المواطنين، وبالمتغيرات الاقتصادية العميقة التي جاءت بها التقنية الحديثة والتجارة بين الدول. كل الرؤساء الأمريكيين، ديمقراطيين كانوا أو جمهوريين، تبنوا سياسات محافظة في المجال الاجتماعي، أو الثقافي، أو الاقتصادي. ترامب هو الأول الذي يعرب عن ميول بالغة المحافظة في المجالات الثلاثة معاً: نزعة معادية للتبادل التجاري بين الدول، كراهية عمياء لمعظم البشر من غير البيض المسيحيين، ودعوة صريحة للتخلي عن مكاسب المساواة والحرية التي حققتها فئات المجتمع الأمريكي المختلفة خلال العقود القليلة الماضية.
تكاد أمريكا أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي بنيت على فكرة، وليس على تصور قومي حصري لأمة تقطن قطعة معينة من الأرض. وحتى وهي تقتلع السكان الأصليين من مواطنهم، وهي تستعبد الأمريكيين من أصول إفريقية، وهي تخوض حرباً إمبريالية وراء الأخرى، لم يستطع رئيس أمريكي واحد إلغاء وعود الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية التي حملها إعلان الاستقلال، أو إعادة كتابة الدستور بما يوافق هواه. ترامب هو النقيض الكامل للفكرة التي بنيت عليها أمريكا، للوعود التي حملها إعلان الاستقلال والدستور الأمريكيين.
ثمة أسباب لفوز ترامب، بالطبع. استطاع ترامب، في ولايات محددة وحاسمة، أن يقدم نفسه متحدثاً باسم، ومعبراً عن أزمة الناخب الأبيض من الطبقة العاملة والشرائح السفلى والوسطى من الطبقة المتوسطة. تقليدياً، كانت هذه الفئات الاجتماعية ضمن القاعدة الانتخابية للديمقراطيين.
خلال السنوات القليلة الماضية، سيما بعد أزمة 2008 المالية/ الاقتصادية، ترك الديمقراطيون هذه الفئات خلفهم. لم ينجح ترامب في كسب هؤلاء إلى صفه، وحسب، ولكنه نجح أيضاً في دفعهم للتصويت، ورفع نسبة المصوتين البيض بين عموم الناخبين من 60 إلى 70 في المئة. لا يريد أغلب هؤلاء رؤية الدور الذي يلعبه التقدم المتسارع في وسائل الإنتاج في إغلاق المصانع التى اعتادوا العمل فيها، وتراجع فرص العمل في الولايات الصناعية التقليدية. ما يرونه أنهم يخسرون الامتيازات التاريخية التي تمتعوا بها، وأن خسارتهم تعود إلى منافسة السلع الصينية الرخيصة، إلى اتفاقيات التجارة الدولية غير المنصفة لأمريكا، إلى مزاحمة أيدي المهاجرين العاملة الرخيصة، وإلى استيلاء مجموعة من الليبراليين، دعاة المساواة بين السود والبيض والنساء والرجال والمثليين وغيرهم، والمسلمين والمسيحيين، والمهاجرين اللاتينيين ومن بنيت الولايات المتحدة على أكتافهم، على مقاليد الحكم والقرار.
قام ترامب بواجبه تجاه الكتلة البيضاء العاملة كما لم يفعل مرشح رئاسي من قبل، ولم يتردد في صياغة رسائل فاشية مستبطنة، تستجييب لمخاوفهم وشعورهم بالتهديد. ثمة كثير من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم عظيمة بالفعل، بعد أن انتخبت رئيساً أسود لدورتين متتاليتين، ونجاح هذا الرئيس في إنقاذ البلاد من الهوة الاقتصادية، وأخراجها من حروب خاسرة ومدمرة، وأعاد بناء صورتها في العالم. ولكن شعار حملة ترامب الأبرز كان «لنجعل أمريكا عظيمة من جديد»، بمعنى أن الرئيس الليبرالي الأسود، باراك أوباما، تسبب في انهيار أمريكا وضياع مقدراتها.
صيحة ترامب الثانية: «لنستعد حكومتنا»، تفترض أن الرئيس الأسود وحفنة ليبراليي واشنطن من حوله سلبوا الدولة الأمريكية من أصحابها الحقيقيين، الكتلة الناخبة البيضاء.
ترامب، بكلمة أخرى، فاز بتعزيز حدة الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، بتصعيد الخوف من المستقبل، بتعميق الكراهية بين فئات الأمريكيين المختلفة، وقيادة انقلاب كامل الأركان على وعود الدستور وإعلان الاستقلال.
ولكن هذه ليست نهاية الطريق، بالتأكيد. ولدت الدولة الحديثة أصلاً على جانبي الغرب الأطلسي. ولم ينجح الغرب في دمقرطة هذه الدولة وجعلها أكثر استجابة لإرادة الأغلبية، ولكنه نجح أيضاً في توطيد عرى المؤسسات التي ينبغي للدولة أن تستند إليها: البيروقراطية المحايدة، حكم القانون، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، وحرية التنظيم المدني. هذه المؤسسات، وليس الدورات الانتخابية، وحسب، ما يلعب دوراً هائلاً في عقلنة السلطة الحاكمة. والرئيس الأمريكي، كل رئيس أمريكي، يحكم ضمن شروط بقاء واستمرار الدولة ومؤسساتها. وعلى ترامب، فوق ذلك، أن يأخذ في الاعتبار المعارضة الليبرالية واسعة النطاق لخطابه وبرنامجه المفترض، إذ مهما كانت أسباب فوز ترامب ودلالاته، فليس ثمة شك أن المجتمع الأمريكي اليوم أكثر ليبرالية عما كان عليه قبل جيل.
وربما تؤشر المظاهرات المبكرة على فوز الملياردير النيويوركي بداية مواجهة واسعة، لن يكون باستطاعة إدارته تجاهلها.
ليس ثمة الكثير مما يمكن قوله بيقين عن الطريقة والسياسات التى سيحكم بها ترامب. ما يمكن التأكد منه أن رئاسته ستمثل حلقة صراع محتدم بين النزعات الفاشية، من جهة، وعقلانية الدولة وقيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، من جهة أخرى.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
القدس العربي
دونالد ترامب رئيسًا: محاولة في التفسير
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
على الرغم من أنّ احتمالات نجاح المرشحيْن لانتخابات الرئاسة الأميركية كادت تتساوى إحصائيًّا، فإنّ نجاح دونالد ترامب جاء صدمة لكثيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها. وسبب المفاجأة أنّ الفئات التي يُعتقد أنها تصنع الرأي العام (وسائل الإعلام، ومؤسسات الاستطلاع، ومراكز الأبحاث) اعتقدت أن من غير المعقول أن ينجح، لمجرّد أنه يبدو شخصًا غير عقلاني وغير مؤهل. وكانت استطلاعات الرأي تشير، حتى قبل ساعات من بدء التصويت، إلى تقدّم هيلاري كلينتون، وإنْ بفارقٍ ضئيلٍ على منافسها. كما كانت تقارير تشير إلى أنّ أكثر الأصوات التي جرى الإدلاء بها في عملية التصويت المبكّر التي استفاد منها نحو 41 مليون أميركي جاءت نتائجها في معظمها لمصلحة كلينتون، بحسب ما يسمّى نتائج الخروج (Exit poll). علاوة على ذلك، كان الاعتقاد السائد أنّ حظوظ ترامب قد تضرّرت بما لا يمكن إصلاحه، نتيجة إساءاته المتنوعة لشرائح اجتماعية عديدة، مثل النساء والأقليات والمسلمين وغيرهم، كما بدا أنه من غير المنطقي أيضًا أن يصوّت عدد كبير من الأميركيين لمرشح شعبوي، لا يطرح برامج سياسية فعلية، ويستخدم خطاب الكراهية والعنصرية على نطاق واسع، في حملته الانتخابية، وتلطخ اسمه بفضائح عديدة.
ما حصل أنّ ترامب خيّب كل هذه التوقعات، وحقق فوزًا مريحًا على خصمه الديموقراطي، وحصل على ما مجموعه 279 صوتًا، علمًا أنّ المرشح الناجح يحتاج إلى 270 من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538. ليس هذا فحسب، بل فاز ترامب في أغلب الولايات المتأرجحة التي أعطت أصواتها في الانتخابات الرئاسية السابقة للديموقراطيين، مثل فلوريدا وبنسلفانيا وويسكنسن وأوهايو وغيرها. فما هي الأسباب التي أدت إلى تحول “الكابوس” الذي تخيله الكثيرون إلى حقيقة؟ وكيف غدا المرشح الرئاسي الذي لم يكن أحد يأخذُه قبل عام على محمل الجد إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية؟
حشد دعم الأميركيين البيض
منذ رشح نفسه رسميًا لانتخابات الرئاسة، صيف العام 2015، راهن ترامب على دعم الطبقة العاملة الأميركية البيضاء التي لم تتعافَ قط من سياسات إدارة بيل كلينتون الاقتصادية، والتي عمّقها الركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة، بعد الأزمة المالية العالمية عام
“جاءت النتائج متوافقة مع ميلٍ تاريخي في النظام السياسي الأميركي، يبيّن أنه نادرًا ما تمكّن حزب السلطة من الاستمرار في الحكم أكثر من دورتين انتخابيتين” 2008، وما نتج عنها من فقدان للوظائف الصناعية وانتقال المصانع إلى خارج الولايات المتحدة. وحتى يصل إليهم، اختار ترامب، على عكس المرشحة الديموقراطية، كلينتون، تقديم رسائل واضحة ومباشرة، وإنْ كانت شعبويةً وحادّةً في أغلب الأحيان، مفادها بأنّ السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة التي اتبعها الديموقراطيون لم تؤدّ إلى خسارة الطبقة الوسطى الأميركية البيضاء (WASP) وظائفها فحسب، بل أخذت أيضًا تهدّد بسيطرة المهاجرين والملونين (الهيسبانك والسود خاصة) على مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، في ضوء تزايد المؤشرات على تحول البيض الأميركيين إلى أقليةٍ عدديةٍ خلال أقل من ثلاثة عقود؛ وكان فوز باراك أوباما بالرئاسة، عام 2008، قد أيقظ مخاوف هؤلاء حيال قدرتهم على الاستمرار في حكم الولايات المتحدة. وقد تمكّن ترامب من تعزيز هذه المخاوف (أي إنّ البيض يخسرون أميركا) لتحقيق اختراقاتٍ كبيرةٍ، حتى في معاقل الحزب الديمقراطي، كما حصل في ميتشيغن، وويسكنسن، وبنسلفانيا، وهي ولايات ذات أكثرية بيضاء. وتعدّ هذه الاختراقات دليلاً على نجاح ترامب في استثارة المشاعر العنصرية لدى البيض، وفي استقطاب طبقة العمال والطبقة المتوسطة البيضاء التي درجت تاريخيًا على التصويت للحزب الديموقراطي. في المقابل، فشلت كلينتون في استنفار المعسكر الديموقراطي، خصوصاً الأقليات والنساء الذين راهنت على خروجهم والتصويت بكثافة لفائدتها.
الاستفادة من الانقسامات المناطقية والقيمية
أوضحت نتائج الانتخابات وجود حالةٍ من الاستقطاب والانقسام الشديدين في القيم والاهتمامات والمصالح والتوجهات بين سكان المدن الكبرى من جهة وسكان الأرياف أو البلدات الصغيرة (small towns) من جهة أخرى، وبين سكان ولايات الساحلين الشرقي والغربي الأغنى والأكثر انفتاحًا على العالم من ناحية، وسكان المناطق الداخلية، خصوصاً ما يسمى “الغرب الأوسط” من ناحية أخرى، وبين مجتمع متحرّر اجتماعياً نجح في فرض قوانين حول الإجهاض وزواج المثليين، ومجتمع محافظ يرفض بشدة كل هذه التوجهات. وقد استفاد ترامب من هذا الانقسام، بحيث تمكّن من حصد أصوات أكثر الولايات الواقعة بين الساحلين الشرقي والغربي.
تصويت احتجاجي ضد كلينتون والمؤسسة
جاء التصويت لترامب بمنزلة تصويت احتجاجيٍّ ضد ما تسمى، في واشنطن، مؤسسة الحكم ونخب الساحل الشرقي (واشنطن ونيويورك) التي انفصلت عن قواعدها وجمهورها، وغرقت في قضايا الفساد المالي والسياسي، كما يتهمها ترامب. وكان الممثل الأول لهذا الاحتجاج بيرني ساندرز مرشح الحزب الديمقراطي الذي خسر الترشيح. وبات مؤكدًا أنّ جزءًا من أنصار بيرني ساندرز رفض التصويت لكلينتون، بصفته إجراء احتجاجيًا على خسارة مرشحهم الانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي، ولأن كلينتون تمثّل ما يحتجون ضده. وهكذا، فقد خسرت كلينتون قسمًا من أصوات هؤلاء الذين إمّا عزفوا عن التصويت أو صوّتوا بورقة بيضاء، في حين تمكّن ترامب، في حالات أخرى، من استقطاب شرائح منهم بعد أن أقنعهم، وأكثرهم من الفئات الشعبية والعمالية، بقدرته على تمثيل مصالح.
من جهةٍ ثانيةٍ، بدا أنّ هناك حالة من الملل والتعب من نحو ربع قرن من سياسات آل كلينتون ووجودهم تحت الأضواء (في البيت الأبيض بين 1992 و1998، ثمّ خدمة هيلاري كلينتون بصفة سيناتور عن ولاية نيويورك من 2000 إلى 2008، ثمّ وزيرة خارجية في عهد أوباما، ثمّ مرشحة رئاسية أخيرًا). فضلًا عن وجود اعتقاد واسع بأنّ آل كلينتون جنوا ثرواتٍ طائلةً، ويتصفون بعدم الصدقية واللامسوؤلية، خصوصاً في ظل تحقيقات في تهم وجهت إلى هيلاري كلينتون، منها استخدام بريدها الشخصي غير المحمي لمراسلاتٍ سرية، عندما كانت وزيرة للخارجية، وتحميلها مسؤولية الإهمال في قضية مقتل السفير الأميركي في بنغازي في سبتمبر/ أيلول 2012، وغير ذلك من قضايا جاء الكشف عن بعضها، قبل أيام فقط من بدء عملية الاقتراع. وعلى الرغم من أنّ رموز الحزب الديموقراطي نزلوا إلى الميادين الانتخابية لحشد الدعم لها، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما الذي يحظى بأكبر شعبيةٍ لرئيس أميركي في أيام ولايته الأخيرة (54%)، كما محضها الدعم كل من ميشيل أوباما (زوجة الرئيس) وجو بايدن نائب الرئيس، فإنّ ذلك كله لم يجدِ على ما ظهر نفعًا.
خطاب ترامب
بدا خطاب ترامب للنخب المثقفة بسيطًا ومسطحًا واستفزازيًا، ولكنه كان مدروسًا ليخاطب
“فاز ترامب في أغلب الولايات المتأرجحة التي أعطت أصواتها في الانتخابات الرئاسية السابقة للديموقراطيين” مشاعر عدد كبير من بسطاء الأميركيين الذين يميلون إلى تصديق الرجل الذي حقق نجاحًا في القطاع الخاص (تجسيد الحلم الأميركي)، ويشكّكون في السياسيين المحترفين، ويميلون إلى الخطاب المباشر الذي يبدو لهم لسببٍ ما غير منافق، ولا يخطر لهم أنّ غير المنافق قد يكون كاذبًا. ويؤمن كثيرون منهم بما يقوله ترامب عن المرأة والأجانب، ولكنهم لا يصرّحون به، ووجدوا في ترامب لسان حالهم.
ثمّة مفارقة سوسيولوجية غريبة، متجسّدة في مسألة الثقافة السياسية، فالغني البليونير يبدو لسكان الأرياف والمناطق العمالية الصناعية غير نخبوي، لمجرّد أنه يتبنى خطابًا شعبيًا، والطبقات الوسطى الليبرالية في المدن تبدو أكثر نخبويةً، وأبعد من ترامب عنهم مسافات بسبب الأفكار والقيم، حتى لو كانت أقرب طبقيًا في مصالحها.
محاولات ترامب الظهور بمظهر الضحية
نجح ترامب في الظهور بمظهر الضحية، بعد استهدافه بسلسلة من الفضائح المالية والأخلاقية، يعود بعضها إلى سنواتٍ طويلة مضت. كما أنّ وقوف المؤسسات الإعلامية الكبرى في أميركا (mainstream media)، مثل صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ومحطات تلفزية على المستوى القومي مثل سي. إن. إن، ضد ترشح ترامب وانتخابه عزّز الانطباع الذي حاول رسمه عن نفسه بأنه ضحية “مؤامرة ليبرالية” لإسقاطه. وهو ما حاول أن يعزّزه بادعائه وجود محاولاتٍ لتزوير الانتخابات للحيلولة دون وصوله إلى الرئاسة. وحدا هذا الأمر أيضًا بالحزب الجمهوري، في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، إلى الإلقاء بثقله وراء ترامب، بعد أن كان تخلى عنه رموزٌ في الحزب وقادة كبار فيه، ما مكّنه من الفوز بأصوات نحو 30% من الناخبين من أصولٍ لاتينية في فلوريدا. تمّ ذلك بسبب الماكينة الانتخابية الجمهورية، وتحديدًا الحملة الانتخابية للسيناتور ماركو روبيو الذي كان ترامب قد أزاحه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وقد أسهم ذلك في تمكين ترامب من الحصول على أصوات الولاية الـ (29) بعد أن نجح في تجاوز المشاعر المعادية لخطابه بشأن المهاجرين، وتهديداته بترحيل الملايين منهم، والقادمين، في أغلبهم، من دول أميركا اللاتينية.
المرشح غاري جونسون
ربما أسهم وجود مرشح ثالث، هو غاري جونسون، في الانتخابات في فوز ترامب في بعض
“الاختراقات التي حققّها ترامب تعتبر دليلاً على نجاحه في استثارة المشاعر العنصرية لدى البيض” الولايات المتأرجحة الكبرى، فالأصوات التي حازها جونسون في ولاية فلوريدا (29 صوتًا) ونورث كارولينا (15 صوتًا) حسمت من الكتلة الانتخابية التي كان مفترضًا أن تذهب للمرشحة الديمقراطية. وقد شهدت الولايتان تنافسًا حادًا وتقاربًا كبيرًا في النتائج، إذ وصل الفارق أحيانًا إلى بضع عشرات من الأصوات، ما أسهم في خسارة كلينتون هذه الولايات الحاسمة.
خاتمة
قد تكون أسباب عديدة أخرى أسهمت في وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وإلحاق هزيمة كبرى بالمرشحة التي كانت تعدّ، حتى أسابيع قليلة، فائزًا حتميًا في انتخابات 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الرئاسية، ومن ثمّ تحقيق مفاجأة. إنّما في المحصلة جاءت النتائج متوافقة مع ميلٍ تاريخي في النظام السياسي الأميركي، يبيّن أنه نادرًا ما تمكّن حزب السلطة من الاستمرار في الحكم أكثر من دورتين انتخابيتين، حتى يتخذ الشعب قراره بضرورة حصول تغييرٍ وتجريبٍ لنهج رئاسي جديد. قد يتمكّن ترامب، خلال السنتين المقبلتين، من الحكم مرتاحًا نتيجة استمرار سيطرة حزبه على مجلسي الشيوخ والنواب، لكن سيكون عليه أولًا أن يتعامل مع تبعات الحملة الانتخابية المريرة التي بيّنت وجود انقساماتٍ تكاد تكون غير مسبوقة في المجتمع الأميركي. فحتى الديموقراطيات العريقة، يمكن أن تتعرّض لتصدّعات كبرى، وترتكس ممارساتها الديمقراطية، إذا تركت الشقوق التي يتعرّض لها النظام تتسع، والفجوات تكبر بطريقةٍ قد تؤدي إلى الانهيار. قد لا يجد “الديماغوجي” مشكلةً في اتباع سياسةٍ غير الخطاب الذي صمم لكسب الأصوات، لكن الطاقم الذي سيعيّنه للعمل معه سيمثّل أحد المؤشرات المهمة على نوع السياسات التي سوف يتبعها.
جميع حقوق النشر محفوظة 2016
استعراض روسيا الدموي في سوريا..لإثارة ترامب/ بسام مقداد
نشرت صحيفة “vzgliad” الثلاثاء، مقالة قالت فيها، إن نموذجاً جديداً من السلاح الروسي تم اختباره، للمرة الأولى، في سوريا، حيث عرضت وزارة الدفاع عمل الصواريخ المجنحة “أونيكس” إلى جانب صواريخ “كاليبر”. وهكذا تكون قد بدأت العملية “الحاشدة” للمجموعة الروسية في سوريا، وإن كان ليس بالشكل الذي تم التخطيط له في البداية.
وتقول الصحيفة إن روسيا كانت بصدد اختيار اللحظة المناسبة لبدء العملية منذ نهاية الأسبوع الماضي، حين وصل الأسطول الحربي بقيادة حاملة الطائرات “الأدميرال كوزنتسوف” إلى الشواطئ السورية. وخلافاً لما كان يتوقعه كثيرون من المراقبين، لم توجه المجموعة الروسية ضرباتها إلى حلب، بل قصفت أهدافاً في إدلب وحمص. وتنقل الصحيفة عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله، إنها المرة الأولى في تاريخ البحرية الحربية الروسية، التي يتم فيها استخدام “الأدميرال كوزنتسوف”، وإن الضربات تم توجيهها “إلى مصانع، وليس مشاغل لإنتاج انواع مختلفة من وسائل القتل الجماعي للسكان.. وسوف يستمر توجيه الضربات لهذه الأهداف”.
وتنقل الصحيفة عن رئيس تحرير مجلة “ترسانة الوطن” فيكتور موراخوفسكي، تأكيده على نجاج التجربة الأولى لاستخدام “الأدميرال كوزنتسوف” ووسائل التوجيه والتصويب والدقة في إصابة الأهداف “التي تم اختيارها جيداً”. لكن موراخوفسكي يحذر من أن “الإعتقاد بأن كل هذا سوف يؤثر على نحو حاسم في الوضع في سوريا هو تفاؤل مبالغ فيه جداً”.
وتقول الصحيفة، إنه على الرغم من أن وزارة الدفاع، وبعد سقوط الطائرة “ميغ – k29” في البحر، لم توقف رسمياً جميع الطلعات من الحاملة، إلا أن هذا الحظر قد تم فعلياً الثلاثاء “إلى حين الإنتهاء من التحقيق في سقوط الطائرة”.
وتنقل الصحيفة عن خبير روسي آخر في “نزاعات الشرق الأوسط والقوات المسلحة في المنطقة” أنطون ماررداسوف قوله عن المشاهد التي بثتها وزاة الدفاع الروسية عن اختبارات “جميع الأسلحة المتوفرة لدى القوات المسلحة”، بأنها “مشاهد مثيرة للإعجاب لم نر مثلها سابقاً سوى لدى الأميركيين.. وهي تساعد في تحفيز المشاعر الوطنية”.
وتقول الصحيفة، إن الخبراء العسكريين والجيوسياسيين سبق أن أشاروا إلى أن الضربة المكثفة للقوات الجوية الروسية على حلب “ليست في صالح موسكو في الوقت الراهن”. فمثل هذه الضربة من شأنها أن تسفر في ظروف المدينة عن “ضحايا كثيرة وسط السكان المدنيين وردة فعل غاضبة لدى السكان السنة في المنطقة بأسرها”.
أما من وجهة النظر السياسية، فإن من شأن مثل هذه الضربة، بحسب الصحيفة، أن تشجع “الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على اختيار صقورٍ في إدارته، اكثر من اختيار الأشخاص الذين يميلون إلى التسوية في سوريا”. لكن مع ذلك ترى الصحيفة أن موسكو”تعتبرو أن الضربات المكثفة على إدلب وحمص تترك أثرها على الأحداث في حلب”.
وتنقل الصحيفة عن نائب رئيس مجلس الإتحاد لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينتسايفتش، قوله إن “الضربات الجوية، بمساعدة الأسطول البحري الروسي، لأهداف المقاتلين في محافظتي إدلب وحمص سوف يكون لها أيضاُ تأثير نفسي شديد يجعل تنظيف حلب، الذي لن يكون دون المشاركة الحاسمة من جانب القوات الجوية الروسية، يتم بنجاح أكبر”.
المدن
كيف سيتعامل ترامب مع تحديات إيران؟/ هدى الحسيني
كثير من الأميركيين، ولأسباب كثيرة، كانوا مشمئزين من مقولة: «السياسة كما جرت العادة»، وأظهروا ذلك عن طريق التصويت لدونالد ترامب أو عدم التصويت إطلاقًا. بعد «البريكست» في المملكة المتحدة، وفوز ترامب في الولايات المتحدة الأميركية، انتهت الفترة الطويلة والمجحفة المؤيدة للعولمة التي تحكم بها سياسيون تقليديون أغفلوا تنامي معارضة المهمشين، ويمكن القول اليوم إن التأييد للعولمة، أو الرفض لها، صار بدل اليسار مقابل اليمين في العالم. لقد بدأنا فصلاً جديدًا، لكن اللوم لا يقع على الديمقراطية، بل على فشل المؤسسات الحاكمة التي انفصلت بعيدًا عن الواقع، ولم تدرك غضب الشعب.
بالنسبة إلينا، قال الرئيس الأميركي المنتخَب إن لديه خطة طموحة لوقف توسع تنظيم داعش، واحتواء الإسلام الراديكالي: «يجب أن يكون هذا أهم أهداف السياسة الخارجية الأميركية، وكذلك سياسة العالم، وهذا يتطلب اللجوء إلى القوة العسكرية، إنما أيضًا مواجهة عقائدية كمواجهتنا الطويلة أثناء الحرب الباردة، لهذا سنعمل معًا، وعن كثب، مع حلفائنا في العالم الإسلامي الذي يتعرض هو الآخر لخطر عنف الإسلام الراديكالي».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول المهنئين لترامب. علاقة مصر الحالية مع الولايات المتحدة صعبة، وكذلك حال كثير من الدول العربية، إذ كانت إدارة باراك أوباما تركز على انتقاد هذه الدول، ولا تعترف بالجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب.
قد يكون الرئيس السيسي ارتاح لفوز ترامب، لكن ما يريده من واشنطن دعمًا اقتصاديًا ضخمًا، وسبق لترامب أن قال إنه يعارض المساعدات الاقتصادية لأي دولة خارجية. هو أشار إلى استعداده لتقديم الدعم المالي «حيث يجب ذلك»، وذكر الأكراد «الذين بحاجة، كي يكونوا مجهزين لقتال (داعش)»، لكن إذا اكتفى ترامب بدعم معنوي لمصر، فهناك خطر اهتزاز الاستقرار فيها، إذا ما استمر اقتصادها في التدهور.
بالنسبة إلى سوريا، اقترح ترامب أن تقاتل روسيا «داعش»، وقد يطرب الرئيس السوري بشار الأسد لهذا الاقتراح، لكن إذا سمح ترامب لروسيا بأن تفعل ما تريد في سوريا، فهذا يعني السماح لها بتقوية وجودها في الشرق الأوسط، مع كل ما في ذلك من تبعات.
أكثر المترقبين لسياسة الرئيس الأميركي المنتَخَب هي إيران، رغم كل عنجهية التصريحات، ستبدأ إدارة ترامب في التهديد باللجوء إلى القوة، وتفرض على إيران الخيار بين عقوبات صارمة، أو عمل عسكري، أو العودة إلى طاولة المفاوضات.
يوم الجمعة الماضي، وأثناء وجوده في براغ، قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تطبق الشقَّ الخاص بها من الاتفاق النووي، وأَسِف لأن الإدارة الأميركية الحالية لم تفعل ذلك.
الاتفاق يلزم إيران بالحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم وتخزينه والقبول بالمفتشين الدوليين. الأسبوع الماضي، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لانتهاكها الاتفاق، بحيث أنتجت 130 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب.
خلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بـ«الكارثة»، وقال إن الأولوية عنده العمل على تفكيكه، متهمًا إيران بخرقه. بعد فوزه، قال أحد مستشاريه للشؤون الخارجية، إن ترامب سيعيد النظر في الاتفاق، ويرسله إلى الكونغرس ليطالب الإيرانيين ببعض التغييرات.
السؤال هو: هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة التراجع عن اتفاق بمفرده؟! فالاتفاق النووي لم يُناقَش فقط بين أميركا وإيران، وإن كانت إدارة أوباما هي الرائدة، بل ناقشته الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (بما فيها أميركا) بالإضافة إلى ألمانيا، ثم صادق عليه مجلس الأمن. لهذا على ترامب أن يذهب بعد الكونغرس إلى مجلس الأمن الدولي ليرى إن كان باستطاعته إقناع الأعضاء الآخرين بالتوافق على التغييرات التي يراها. هنا يأتي دور جون بولتون السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، على زمن الرئيس جورج دبليو بوش، الذي لا يرى تبريرًا لكل الأمم المتحدة وأدوارها.
من ناحية أخرى، يستطيع الرئيس فرض عقوبات أميركية يمكن لها أن تطيح بالاتفاق، والمعروف أن الولايات المتحدة هي الأقوى في النظام العالمي، وهي الأهم عندما يتعلق الأمر بالعقوبات. ثم إن القيود الأقوى التي ستواجهه في تطبيق نظرته تعود إلى عدم استعداده، وعدم استعداد الحزب الجمهوري لخطوة كهذه. يمكنهم القول إنهم يريدون تمزيق الاتفاق، وتستطيع أميركا الخروج منه بفرض عقوبات أحادية، لكن أوروبا لن توافق، ولن تفرض عقوبات جديدة. الصين أيضًا لن توافق، وبالتالي سيحمّل الكل ترامب مسؤولية تدمير الاتفاق، وخلال شهر أو شهرين سيكون أمام خيارين؛ إما قصف إيران أو عدم قصفها. فهل يريد إشعال حرب في بداية عهده؟
أعضاء في مجلس الشيوخ، وبينهم بوب كروكر (جمهوري من تنيسي وأحد المرشحين لمنصب وزير الخارجية) ينتقدون بشدة الاتفاق، ويريدون التفاوض مجددًا بشأنه، أو التخلي عنه واللجوء إلى القوة. الآن أمامهم الفرصة، إنما لا فكرة واضحة لديهم عما يجب عمله، وستكشف لنا الأيام كيف سيتعاملون معه، قد تكون لديهم مفاجأة، لأنهم يرون أنه كافأ إيران فعمدت إلى سجن أميركيين من أصل إيراني، وزادت من عدوانيتها وتدخلها في سوريا والعراق واليمن. وإدارة أوباما تريد من ترامب احترام الاتفاق والالتزامات الأميركية، تمامًا كما طلبت إيران التي تشعر بأنها قد تكون الخاسر الأكبر، ولأن السياسة الأميركية المواتية الآن لها، يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب في الأشهر المقبلة.
المهم أنه إذا بقي الاتفاق، حتى إلى وقت محدد، يجب التفكير بجدية عما سيليه، كوضع استراتيجية تحد من اندفاع إيران إقليميًا، وهذا يتطلب موارد عسكرية، وإرادة سياسية، وموقفًا حازمًا. ولن ينفع إيران تهليلها بأنها وقّعت على مناورات عسكرية مشتركة مع الصين، يوم الاثنين الماضي، لأنه إذا كانت هناك دولة كبرى تريد استقرار الشرق الأوسط، فإنها الصين.
وقبل أن يصوغ ترامب سياسته تجاه إيران، يجب معرفة ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه إقليميًا. هل تريد الاحتواء أم الردع، خصوصًا مع وجود اللاعب الروسي على المسرح الإقليمي؟! الإيرانيون متداخلون جدًا مع الروس في سوريا. وعاد الحديث عن احتمال عودة روسيا إلى استخدام قاعدة همدان الجوية لعملياتها في سوريا.
من الواضح أن ترامب يريد تخفيف التوتر مع روسيا. كيف سيُترجم ذلك.. هل بإعطائها اليد العليا في سوريا، أو في كيفية معاملته إيران؟! هذا ليس معروفًا حتى الآن. لكن بناء على ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، فإن النظام الإيراني يخشى من أن تفرض إدارة ترامب وبقوة تطبيق الاتفاق، ثم إن النظام الإيراني قلق لأن بعض الفوائد الاقتصادية التي كان يأمل بها مع الصفقة، لن تؤتي ثمارها. وعلى سبيل المثال، فإن إدارة ترامب قد لا توافق على بيع طائرات «بوينغ» لإيران.
المهم التأكد من أن تهديد إيران للمصالح الأميركية ولحلفاء أميركا في الشرق الأوسط سيتم احتواؤه مع وقف مغامراتها الإرهابية في الدول المجاورة. الأسبوع الماضي، قال ديفيد فريدمان كبير مستشاري ترامب، إن إدارة ترامب ستعود للتعاون مع الأطراف العالمية بطريقة تسعى لإعادة الضغط على إيران، لأن إيران نووية بعد 9 سنوات غير مقبولة. قد تبدو الـ9 سنوات فترة طويلة لكنها تمر في غمضة عين.
هناك عوامل كثيرة تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، من بينها النظام الإيراني. صحيح أن نظرة الرئيس المنتخَب إلى العالم ليست جيوسياسية بقدر ما هي اقتصادية، ولهذا فهو ليس مهتمًا بالشرق الأوسط كثيرًا، لكن يبقى الشرق الأوسط مهمًا من ناحية النفط، والممرات، ثم إن شركات ترامب نفسها عملت في الخليج، هو يعتقد أن كل شيء قابل للتفاوض، وسيأتي الوقت الذي يشعر فيه بأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية.
وهنا يجب تحذيره: إن رجل الأعمال ترامب غير معتاد على البيروقراطية، لكن الرئيس ترامب سيكون تحديه الأكبر البيروقراطية، إن كان في أميركا أو في الشرق الأوسط!
الشرق الأوسط
عهد ترامب.. هل يطاله الركود؟/ بول كروجمان
سياسة ترامب ستكون لها تأثيرات وخيمة، ولكنها تأثيرات ستحتاج بعض الوقت حتى تصبح ظاهرة وواضحة. لا بل علينا ألا نتفاجأ إذا ما تسارع النمو الاقتصادي لبضع سنوات في الواقع.
لماذا أنا متفائل نسبياً بشأن التأثيرات قصيرة المدى لوضع مثل هذا الرجل السيئ، الذي يستعين بمثل هذا الفريق السيئ، في السلطة؟ الجواب هو خليط من المبادئ العامة وخصائص وضعنا الاقتصادي الحالي.
أولاً، المبادئ العامة: فهناك دائماً فرق بين ما هو جيد للمجتمع، أو حتى للاقتصاد، على المدى الطويل، وما هو جيد للأداء الاقتصادي خلال الشهور القليلة المقبلة. وعلى سبيل المثال، فإن عدم اتخاذ تدابير بشأن تغير المناخ قد يعني الحكم على الحضارة بالزوال، إلا أنه حتماً لن يؤدي إلى تراجع إنفاق المستهلك العام القادم.
أو لنأخذ، مثلاً، السياسة التجارية، التي تعتبر موضوع ترامب الأبرز، فالعودة إلى الحمائية والحروب التجارية ستجعل الاقتصاد العالمي أكثر فقراً مع مرور الوقت، وستؤدي بالخصوص إلى شل الدول الأكثر فقراً، التي هي في أمس الحاجة إلى أسواق مفتوحة لمنتجاتها، ولكن التوقعات التي تذهب إلى أن تعرفات ترامب الجمركية ستتسبب في ركود اقتصادي لم تكن منطقية أبداً: صحيح أننا سنصدِّر أقل، ولكننا سنستورد أقل أيضاً، وبالتالي فالتأثيرات الإجمالية لذلك على الوظائف ستكون متعادلة عموماً.
وإضافة إلى هذه المبادئ العامة، هناك خصائص وضعنا الاقتصادي التي تعني أن إدارة ترامب قد ينتهي بها المطاف، لبعض الوقت على الأقل، إلى القيام بالشيء الصحيح للأسباب الخاطئة.
فقبل ثماني سنوات، وبينما كان العالم قد أخذ يغرق في أزمة مالية، كنت قد حاججتُ بأننا دخلنا مرحلة اقتصادية باتت فيه «الفضيلة رذيلة، والحذر خطراً، والاحتراز جنوناً». كنا قد أصبحنا في وضع صار فيه ازدياد العجز وارتفاع التضخم شيئين جيدين، وليسا سيئين. والواقع أننا ما زلنا في ذلك الوضع – ليس بالشدة التي كنا عليها، صحيح، ولكننا ما زلنا نستطيع استخدام مزيد من العجز.
والحقيقة أن خبراء اقتصاديين عديدين كانوا يدركون هذا الأمر من البداية ولكن تم تجاهلهم، جزئياً لأن معظم المؤسسة السياسية كان قد أصبح مهووساً بمخاطر الديون، وجزئياً لأن الجمهوريين كانوا ضد أي شيء تقترحه إدارة أوباما.
غير أن السلطة الآن أصبحت في يدي رجل لا يعاني قطعاً من فرط الفضيلة أو الاحتراز. فدونالد ترامب لا يقترح خفضاً كبيراً جداً للضرائب لفائدة الأغنياء والشركات لأنه يفهم الاقتصاد الكلي، ولكن خفض الضرائب ذاك سيضيف 4.5 تريليون دولار إلى الديون الأميركية خلال العقد المقبل – أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف ما كلّفته سياسة التحفيز خلال السنوات الأولى لأوباما.
صحيح أن تقديم مكاسب مالية للأغنياء والشركات التي ربما ستجلس على أموال طائلة يمثل طريقة سيئة لدعم الاقتصاد وتقويته، كما أن لديَّ شكوكي بخصوص ما إن كانت الزيادة الموعودة في الإنفاق على البنى التحتية ستحدث بالفعل. غير أن تحفيزاً عرضياً ومصمَّما على نحو سيئ سيكون مع ذلك أفضل، على المدى القصير، من لا شيء.
باختصار، علينا ألا نتوقع أزمة اقتصادية فورية في عهد ترامب.
إن سياسة ترامب تمثل أمراً سيئاً للغاية بالنسبة للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، بطريقتين: ذلك أنه حتى إذا لم نواجه ركوداً اقتصادياً في الوقت الراهن، فإن الأمور السيئة تحدث، والكثير يتوقف على فعالية الرد ونجاعته. والحال أننا على وشك رؤية تدهور كبير في كل من نوعية واستقلالية الموظفين العامين. وإذا حدث وواجهنا أزمة اقتصادية جديدة – ربما نتيجة تفكيك الإصلاح المالي – فإن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا مستعدين للتعامل معها.
وعلاوة على ذلك، فإن سياسات ترامب ستؤدي على الخصوص إلى إيذاء الطبقة العاملة الأميركية، وليس مساعدتها. وسيتضح في نهاية المطاف أن وعوده بإعادة «الأيام القديمة الجميلة» – جعل أميركا عظيمة مجددا – كانت مجرد مزحة قاسية.
ولكن كل هذه الأشياء ستستغرق وقتاً على الأرجح. ذلك أن عواقب سياسة النظام الجديد السيئة لن تظهر على الفور. وعلى خصوم ذلك النظام أن يستعدوا للإمكانية الحقيقية المتمثلة في أن أشياء جيدة ستحدث لأشخاص سيئين – لبعض الوقت على الأقل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
الاتحاد
ترامب.. على خطى «نيكسون» و«ريجان»
قابل قطاع عريض من المجتمع الأميركي انتخاب دونالد ترامب بحالة من الذعر. ووصفت مجموعات كبيرة من المعلقين انتصاره بأنه كارثة محتملة تواجهها الدولة، معتبرين أن «عنصرياً يعاني من رهاب الأجانب»، وقال أحد أنصار هيلاري خارج فندقها في «نيويورك» في الصباح التالي للانتخابات: «أشعر بألم في بدني.. إنني مصدوم وحزين». وانتشرت مقالات بعناوين مثل «يوم الحزن» و«مأساة أميركية» على شبكة الإنترنت، ومثلما كتب «ديفيد ريمنيك» في مجلة «نيويوركر»، «هذه بالتأكيد الطريقة التي تبدأ بها الفاشية».
وفي أوقات مثل هذه، من المفيد أن نطلع على التاريخ الأميركي بحثاً عن وجهة نظر، والحقيقة أننا تعرضنا لمواقف مماثلة مرات كثيرة، طوال القرن التاسع عشر، بل وهناك مواقف لا يزال يذكرها الناس.
وفي انتخابات عامي 1968 و1980 أعربت نفس شرائح المجتمع من الليبراليين والمثقفين عن مشاعر خوف وإحباط مماثلة بشأن النتيجة، والشعور بأن الدولة التي عرفوها لا يمكنها النجاة، وعلى رغم من ذلك، لا نزال هنا بعد عقود مضت، مفتونون بهذه الدولة التي كنا نعتقد أنها انتهت.
وعندما تم انتخاب «ريتشارد نيكسون» في عام 1968، كان يتقلد مناصب عامة منذ أكثر من 20 عاماً، واشتهر بأنه أحد مؤيدي الحرب الباردة المتعصبين والمؤدلجين، وبأنه لا يكن لليبراليين والنخب شيئاً سوى الازدراء، ودافع «نيكسون» عن «الأغلبية الصامتة» ويكاد لم يكن لديه أي اهتمام بالأقليات. وعندما كان عضواً في الكونجرس في أربعينيات القرن الماضي، قاد «لجنة الأنشطة غير الأميركية في مجلس النواب» لاستئصال الأشخاص المشتبه في أنهم شيوعيون، وأصبح نائب الرئيس «أيزنهاور» بسبب صفاته المحافظة. وعلى رغم من أن «نيكسون» اكتسب في بعض الأحيان احترام الشعب وخصومه وحتى حلفائه، فإنه لم ينل أبداً حبهم.
وعشية انتخابه في 1968، كانت الولايات المتحدة منقسمة انقساماً شديداً وعلى شفا السقوط في براثن العنف. ووقعت أعمال شغب خارج مقر «المؤتمر الوطني الديموقراطي». وعندما فاز «نيكسون» بالمنصب بفارق ضئيل، شعر الليبراليون وتيار اليسار باليأس والإحباط. ومثلما ذكر الليبرالي الراحل عضو مجلس الشيوخ «باول ويلستون» في مذكراته، كان رد فعل أسرته بسيطاً: «إن نيكسون فاشي». وبعد أن أعيد انتخاب «نيكسون» في 1972، توقع الليبراليون سنوات طويلة من التيه، ولم يدركوا أن فضيحة «ووترجيت» ورحيل «نيكسون» قاب قوسين أو أدنى.
وأما انتخاب «رونالد ريجان» في عام 1980 فلم يقابل بألم وخوف أقل. ومثل «نيكسون» خاض «ريجان» سباق الرئاسة بصفته أحد داعمي الحرب الباردة، ومعنى ذلك أيضاً أنه ترشح ضد النخب الذين اعتبرهم ضعفاء جداً إزاء المخاطر الخارجية وفي مواجهة الجريمة والفساد الأخلاقي في الداخل.
وتحدث أحد النشطاء من المؤيدين للرئيس الديموقراطي «جيمي كارتر» المرشح لإعادة انتخابه، أمام الملايين، قائلاً في الخامس من نوفمبر 1980: «إن انتخاب دونالد ريجان كارثة تواجه الدولة لأنه فاشي، وهو شخص خطير». ولا أزال أتذكر مدرس التاريخ في مدرستي الثانوية وتبدو عليه علامات الصدمة والدوار بينما كان يمشي في رواق المدرسة لأنه كان مقتنعاً أن نهاية أميركا باتت قريبة، وهي عبارة كررها خلال الأيام التالية بجدية لا تضاهى.
وعزا «ريجان» انتصاره إلى وعده بأن «يعيد الأميركيين إلى العمل»، وأن يجعل الدولة بعزة وفخر على الساحة العالمية بعد الإذلال الذي تعرضت له بسبب الغزو السوفييتي لأفغانستان وأزمة الرهائن الإيرانية، وعندما سئل عن سبب فوزه أكد قائلاً: «إن عندما نظر الناس إليه، رأوا أنفسهم، واعتبروا أنه واحد منهم». وينطبق قدر كبير من ذلك على ترامب.
زخاري كارابيل: رئيس قسم الاستراتيجية العالمية لدى مؤسسة «إنفستنت» للخدمات المالية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
الاتحاد
الاتفاقيات التجارية ووعود ترامب
فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون يعزى إلى حد كبير إلى أصوات الأميركيين من الطبقة العاملة، وخاصة البيض، الذين يبدو أنهم أُعجبوا واقتنعوا برسالته الاقتصادية الشعبوية. رسالة تقوم بالأساس على انتقاد ما وصفه الرئيس المنتخب بـ«الاتفاقيات التجارية الكارثية» التي وقّعها «ديمقراطيون» مثل الرئيس بيل كلينتون (اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»)، ويدعمها الرئيس باراك أوباما («الشراكة عبر المحيط الهادي»).
الآن يتعين على ناخبي ترامب أن يتساءلوا حول كيف يعتزم رئيسهم الجديد بالضبط «التفاوض حول اتفاقيات تجارية منصفة تخلق وظائف أميركية، وترفع الأجور الأميركية، وتقلّص عجز أميركا التجاري». والواقع أن هذه فرصة مبكرة لكي يُظهر لنا الرئيس المنتخب ما إن كان ينوي حقاً السعي لمساعدة الأميركيين العاملين أو ما إن كان وعده بذلك مجرد جزء من خطاب حملة انتخابية.
مخطط ترامب بخصوص التجارة هو الانسحاب من «الشراكة عبر المحيط الهادي»، وتعيين «مفاوضين حازمين وأذكياء»، وتوجيه تعليمات للوكالات الفيدرالية باستعمال «كل أداة» في حوزتها لوقف «التجاوزات»، وإعادة التفاوض حول اتفاقية «نافتا»، واتهام الصين صراحة بالتلاعب بالعملة. ولئن كانت هذه المقترحات لا تخلو من أفكار جيدة، إلا أنني أشك في أن أياً منها يمكن أن تحسّن كثيراً من الأوضاع الاقتصادية لبعض الأشخاص الذين ساهموا في انتخاب ترامب.
يبدو أن «الشراكة عبر المحيط الهادي» قد انتهت، بالنظر إلى أن البيت الأبيض لم يعد يرى أي إمكانية للدفع بالاتفاقية إلى الأمام. ولكن نظراً لأن الاتفاقية لم تُسن، فإن إلغاءها لا يغيّر من الوضع القائم شيئاً. وفضلا عن ذلك، فإن الاتفاقيات التجارية لها علاقة أقل بالوظائف مما يعتقد كثير من الناس: إذ لا يجب أن نخلط بين الاتفاقيات التجارية والتجارة. فهذه الاتفاقيات التجارية لديها علاقة أقل بحجم التجارة وعلاقة أكثر بـ«قواعد الطريق» التي تحدّد الفائز والخاسر من التجارة. وفي ما عدا استثناءات قليلة، فإنني لا أرى أشياء كثيرة في أجندة ترامب التجارية تتعامل مع «قواعد الطريق» على نحو يمكن أن يُحدث فرقاً بالنسبة للأميركيين العاملين.
والحال أن ما يهم ناخبي ترامب في المقام الأول، أقصد أولئك الذين حفّزتهم وعودُه بخصوص موضوع التجارة، هو العجز التجاري، وهو أمر يعتمد على تنافسية مصنّعينا – التي تُعتبر سبب عجزنا التجاري – وقدرتهم على التصدير إلى الأسواق العالمية.
إلى ذلك، يقول ترامب إنه سيصف الصين بأنها «متلاعبة بالعملة»، ولكني لا أفهم كيف يمكن أن يكون ذلك مفيداً إطلاقاً. ذلك أنه إذا كان التلاعب بقيمة العملة الصينية مضراً للغاية بالصناعة الأميركية في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، فإن «اليوان» يُنظر إليه حالياً على أنه مقيَّم بشكل نزيه اليوم. وعلاوة على ذلك، فإن نعت الصينيين أو أي بلد آخر بأنهم متلاعبون بالعملة يرقى إلى سب وشتم دولي. والحال أن المشكلة الحقيقية هنا هي أن أياً من اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك «نافتا» أو «الشراكة عبر المحيط الهادي»، ليست لديها قواعد وقوانين قابلة للتنفيذ بخصوص حالات التلاعب بقيمة العملة، ثم إنه حتى لو كانت لديها مثل هذه القواعد، فإن الولايات المتحدة لا تربطها بالصين مثل هذه الاتفاقية التجارية.
ترامب تحدث خلال الانتخابات أيضاً عن فرض تعرفات جمركية مرتفعة للغاية على الصين والمكسيك. غير أنه وفق تحليل لباحثين في مؤسسة «جولدمان ساكس»، فإذا حصل على دعم الكونجرس لهذه الخطوة، فإن متوسط التعرفات الجمركية سيتضاعف عشر مرات تقريباً، من نحو 1.5 في المئة إلى نحو 13 في المئة، وهو «مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية». والواقع أنه من الممكن أن تؤدي مثل هذه التعرفات المرتفعة، في مرحلة أولى، إلى تعويض المنتجات الداخلية للواردات، ولكنها ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار، ما سيلغي أي مكاسب حقيقية بخصوص الأجور ويضر على نحو غير متناسب بالأسر التي تعتمد على الواردات الرخيصة من أجل دعم استهلاكها. وعلاوة على ذلك، فإن رداً انتقامياً من قبل الشركاء التجاريين سيُضعف الصادرات، وفي النهاية، ستؤدي مثل هذه التعرفات المرتفعة إلى ارتفاع التضخم، وتراجع الاستثمار، وتباطؤ النمو، ما سيُقوض أي مكاسب حققتها الطبقة العاملة.
لا تقلقوا، إنني لم أفقد صوابي وأدركُ أن فريق ترامب الانتقالي لا يصغي إلى أمثالي. ولكن ما أتحدثُ عنه هنا هو من دون شك أجندة شعب، وهو ما يجعل من هذه اللحظة لحظة كاشفة لرئيس منتخب أعلن عن نيته إعادة التفاوض حول اتفاقياتنا التجارية. ولا شك أن هذه هي فرصته الأولى ليُظهر لنا دفاعاً عن مصلحة من سيتفاوض.
جارد برنشتاين: مستشار اقتصادي سابق لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
الاتحاد
فوز «ترامب» يشعل «صراع قيم» داخليا وخارجيا/ عبد الوهاب بدرخان
هناك الكثير مما يجب أن نتعلمه من الحدث الأمريكي. لا لأنه نموذج يحتذى بل لأن تأثير الدولة العظمى الوحيدة لا مناص منه. ينطبق ذلك على الأفراد كما على الحكومات والدول، وعلى العربي كما على الإيراني والصيني والهندي والروسي والإفريقي، طالما أن أمريكا منخرطة في النزاعات كما في التسويات أو في إفساد السلم العالمي، ومهيمنة على الاقتصاد والتجارة والمال كما على التسليح والتنمية والقروض. ومن هنا أن أي تغيير في أمريكا يستثير الترقب في العالم، فكيف إذا كان تغييرا يوحي بأنه عميق وخطير. وعلى رغم أنه داخلي الأسباب في جله فإنه سيكون خارجي الانعكاسات في كله.
يقال الآن إنه يجب ألا يحكم على الأشياء في ظاهرها، وأن ما قيل في الحملة الانتخابية لن يبقى منه سوى القليل في البيت الأبيض. أي أن قرارات دونالد ترامب الرئيس لن تعبر عن تصريحات دونالد ترامب المرشح. ويفترض ذلك أن يتقبل الداخل والخارج «قواعد اللعبة» التي تبرر للمرشح بأن يصرح بما لا يعتقده وبأن يمعن في الكذب والتشهير والتجريح وبث الكراهية وإهانة هذا الدولة وتلك، لأن الهدف هو كسب المعركة!
ومع ظهور النتائج يتبين أنها لم تكن مبررة فعلا، فها هم خصوم ترامب يقولون إن خطابه هشم «القيم الأمريكية» وقسم المجتمع وأثار غرائز العنصرية واستنهض قوى التطرف. وها هم أنصار ترامب يسألون كيف مس القيم وقد حظي بتأييد الصانعين الحقيقيين لتلك القيم من بيض أنجلوساكسونيين مسيحيين، ثم إنه في خطاب الفوز غير نبرته، ودعا إلى وحدة المجتمع. ولكن تظاهرات الغضب على فوزه، وتظاهرات كانت متوقعة في حال فشله، عبرت عن أمريكا مختلفة وغير مألوفة، والبعض يقول إنها أمريكا الحقيقية.
بين «البيض الغاضبين» و«السود الناقمين» قد لا تكون هناك مبالغة في فهم صعود ترامب على أنه رد فعل مختزن على صعود باراك أوباما، وبمنظور عنصري ساهم في تأجيجه أن أوباما لم ينجح في مهمته على رغم أنه بذل كل ما في وسعه ليكون شديد البياض في سياساته، إلى حد إغضاب غالبية السود التي كتمت خيبة أملها إزاءه بسبب تغول البيض في معاداته واستثمار أخطائه.
فحتى إرثه الداخلي الذي كان «خبراء واشنطن» يعتبرونه معقولا بل جيدا تبين أن تقويمه مختلف شعبيا، بدليل انتقال الأصوات التي حصدها مرتين في الولايات الشرقية إلى ترامب، وليس إلى مرشحة حزبه. كان التصويت ضد أوباما ونهجه أكثر مما كان ضد الخيار الذي تقدمه هيلاري كلينتون.
تلقائيا انتقل جدل القيم إلى أوروبا التي تابعت حملة ترامب بقلق شديد من توجهاته، وكانت المستشارة الألمانية الأكثر تعبيرا عن ذلك بإدراجها لائحة مخاوفها في تهنئتها له، قائلة إن «ألمانيا وأمريكا مرتبطتان من خلال قيم الديموقراطية والحرية واحترام حكم القانون وكرامة الناس بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو ديانتهم أو نوعهم أو ميولهم الجنسية أو آرائهم السياسية». وتستشعر أوروبا عداء ترامبيا لم يخفه صاحبه، سواء في انتقاداته المبكرة للاتحاد الأوروبي أو تحمسه لنتيجة الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد، بل خصوصا في إصراره على تغيير جذري في قواعد إدارة حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وإلى مخاوف سياسية واقتصادية ودفاعية، يضاف أخيرا وليس آخرا أن فوزه أنعش آمال قوى اليمين المتطرف في الوصول إلى السلطة. فالتأثير المتبادل من سمات الارتباط التاريخي بين ضفتي الأطلسي، ولاشك أن مواقف ترامب من المسلمين والمهاجرين، معطوفة على مسائل الإرهاب وهواجس الأمن، لقيت صدى في كثير من البيئات الأوروبية التي رصدت في خطابه صراحة وشفافية لا تجدهما في خطاب الأوساط السياسية لديها.
يمكن أن يقرأ بروز صوت برلين بحساسية الموقع والموقف الألمانيين في هذه المرحلة، فخلافا لعواصم أخرى أخذت برلين ظاهرة ترامب وخطابه وأفكاره على محمل الجد، تماما كما فعل ناخبوه. وإذ كانت ناقمة على سلبية أوباما وزئبقيته في أزمتي سوريا وأوكرانيا، فإنها متخوفة الآن من احتمالات تهور لدى ترامب، فهي تشتبه بأنه يميل إلى توافق مع روسيا قد يودي إلى تهميش أوروبا.
ولذا نبهت وزيرة الدفاع الألمانية إلى احتمال «موت الناتو» إذا رفض أحد أعضائه الدفاع عن الآخرين، بل كانت الصوت الأول الذي يقول لترامب «لا تنس القرم وحلب»، فهي لا تزال تدافع عن قيم ربما كان الرئيس الجديد يرى مصلحة أمريكا في التخلي عنها.
* عبد الوهاب بدرخان – كاتب صحفي لبناني
المصدر | الاتحاد الظبيانية
ترمب “الشرق أوسطي”/ عبد الحسين شعبان
كانت انشغالات الشرق الأوسط بالمرشحَين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات الأميركية (دونالد ترمب وهيلاري كلينتون) تتفاوت بين التأييد والتنديد، إضافة إلى عدم الاكتراث أحيانا، خصوصا وأن هناك اعتقاد سائد إلى حدود غير قليلة، بأن السياسة الخارجية الأميركية، ولا سيما إزاء الشرق الأوسط، لن تتغير ولن تطرأ عليها تبدلات جوهرية، لأن أميركا بلد مؤسسات، وبالتالي فإن ذهاب هذا الرئيس ومجيء آخر، سوف لا يغير من المسألة شيئا كثيرا.
وإذا كان مثل هذا الرأي يحمل قدرا من الصواب، فإنه ليس مطلقا ودائما، فثمة متغيرات وتراكمات يمكن أن تُحدث تغييرا في وجهة السياسة أو في بعض حيثياتها تبعا لمواقف الرؤساء، فما بالك برئيس مثير للجدل والالتباس والاستثنائية مثل ترمب؟
يمكن للمراقب أن يضع أمامه بعض المعطيات الأساسية لكي يستطيع أن يحلل مآلات السياسة الخارجية الأميركية إزاء الشرق الأوسط، مما ترشح من آراء وخطب خلال الحملة الانتخابية وحتى قبلها، الأمر الذي خلق نوعا من الترقب والحذر، بعدما قام به الإعلام ومؤسسات قياس الرأي العام والاستطلاع من ضخ كمية من المعلومات، رجحت فوز هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي، بل إن البعض رتب العلاقات معها باعتبارها الفائزة المحتملة أو الأكثر حظا.
وما أن أعلن عن الفوز غير المتوقع والمدوي لدونالد ترمب حتى أصيب الجميع بالدهشة، سواء الفريق المعادي له والكاره لسلوكه وتصريحاته وتوجهاته ذات الطابع العدواني والعنصري، أو الفريق المؤيد له، لأنه محبط بسبب سياسة آل كلينتون وآل بوش، والتي تمثل المرشحة الديمقراطية، استمرارا لها، خصوصا في موضوع استخدام القوة والتدخل العسكري، ولا سيما في ليبيا، إضافة إلى الموقف من عموم قضايا الشرق الأوسط، وبشكل خاص القضية الفلسطينية.
فعلى مدى العقد الماضي كله شنت “إسرائيل” حروبا متتالية ضد الفلسطينيين وضد لبنان ونكثت حتى بتعهداتها التي لا تمثل الحد الأدنى لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، والمقصود بذلك اتفاقيات مدريد أوسلو العام 1993، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت “إسرائيل” منذ العام 1999 ورفضها المضي في ما سمي بـ”مرحلة الحل النهائي”.
وحتى الفريق الذي تمنى فوز ترمب، ليس حبا به، بل كرها بكلينتون، خصوصا بتصريحاته النارية بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة وتنديده بالراديكالية الإسلامية، والمقصود بها ليس تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وجبهة النصرة وسواهم من المنظمات الإرهابية، بل إن التوصيف يكاد يشمل الإسلام كدين، والمسلمين كأتباع للديانة الإسلامية.
لكن أول تصريح لاترمب بعد أن فاز بالانتخابات قال فيه: إنه لا يريد أن تستغرق الولايات المتحدة في حروب المنطقة “وعلينا التركيز على “داعش” مشيرا أن للتدخل عواقب وخيمة، لأن الأمر قد يفضي إلى حرب عالمية حيث ستكون الولايات المتحدة في مواجهة مع روسيا وإيران وسوريا، مشيرا إلى أن وروسيا بلد نووي. وخفف من المشكلة مع الرئيس السوري، لتأكيده أن مشكلتنا هي مع داعش.
وبالعودة إلى لب قضية الشرق الأوسط (القضية الفلسطينية) فقد كتب ترمب عشية الانتخابات (أكتوبر/تشرين الأول 2016) على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك): إنه سيعترف بأن القدس هي العاصمة الوحيدة والحقيقية لـ”إسرائيل”، وجاء مثل هذا التأكيد في حملته الانتخابية بأن “القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي منذ أكثر من ثلاث آلاف عام”.
وقال ترمب خلال لقائه مع بنيامين نتنياهو (في سبتمبر /أيلول 2016) بنيويورك: إن “إسرائيل” ومواطنيها عانوا منذ وقت طويل، وأضاف أن السلام لن يكون إلا حين يتخلى الفلسطينيون عن الكره والعنف ويقبلون بأن “إسرائيل” دولة يهودية.
وسبق له أن صرح قائلا: إنه إذا أصبح رئيسا سيقيم تحالفا قويا بين بلاده و”إسرائيل” متهما الأمم المتحدة بأنها ليست صديقة “لإسرائيل”، (مارس/آذار/ 2016) وذلك في حديث خاص إلى منظمة أيباك (المؤتمر السنوي للمنظمة الأميركية “الإسرائيلية”). وبعد لحظات من فوزه لاحظنا استبشارا وفرحا في “إسرائيل”، ويتبين ذلك من العدد الهائل من التعليقات المرحبة بفوزه، والمهنئة بعهده والمتمنية علاقات متميزة “إسرائيلية” أميركية.
إن فوز ترمب، حسب “الإسرائيليين” يعني “موت خيار الدولتين” الذي قد تبناه الرئيس بيل كلينتون في آخر عهده، وواصله بفتور الرئيس جورج دبليو بوش، وتحدث عنه باراك أوباما في أول عهده العام 2009، ولكن هذا الخيار تم وضعه في الأدراج، خصوصا منذ فرض الحصار على غزة في العام 2007، والعدوان على لبنان الذي دام 33 يوما في العام 2006، ومن ثم شن ثلاثة حروب عدوانية على غزة الأول، دام الأول منها 22 يوما في أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009 وأطلق عليه اسم عمود السحاب.
وكانت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية السابقة قد بشرت بقيام “شرق أوسط جديد”، ولم يكفها الحديث عن شرق أوسط كبير، ولكن صمود الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني فوت على واشنطن وحليفتها فرصة استكمال مخططاتها العدوانية.
أما العدان الثاني فكان عملية الرصاص المصبوب في العام 2012، أما الثالث فهو عملية الجرف الصامد في العام 2014.
ودعت “إسرائيل” ترمب إلى الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لها، كما طالبته بنقل السفارة الأميركية إليها، وهذا يعني التجاوز على جميع القرارات الدولية بما فيها قرار عدم شرعية ضم القدس الذي اتخذه الكنيست “الإسرائيلي” العام 1980.
لقد انتظرت “إسرائيل” هذا اليوم للرد بقوة على قرار اليونيسكو، ببطلان نظرية الهيكل التي اعترفت أن المزاعم “الإسرائيلية” بشأن الأماكن المقدسة في القدس لا أساس لها من الصحة، وأن هذه الأماكن هي من تراث الشعب الفلسطيني.
وفي رد على الدعوة للمفاوضات المباشرة الفلسطينية “الإسرائيلية”، قال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وبحضور رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف: “نحن نريد من بنيامين نتنياهو أن ينطق بعبارة واحدة هي قبوله بخيار الدولتين وبحدود العام 1967”.
ترمب أصبح رئيسا، والأمر الواقع واقعا، فكيف سيبني العرب إستراتيجياتهم وسياساتهم معه؟ أعتقد أن هناك ثلاث قضايا ينبغي وضعها في حساب أصحاب القرار:
القضية الأولى: لا ينبغي التوقف عند الخطاب الشعبوي الذي تبناه ترمب عندما كان مرشحا، بل عليهم مراقبة الخطاب النخبوي عندما أصبح رئيسا، والذي يمكن أن يتغير خارج نطاق الوعود الانتخابية، خصوصا إذا ما عرفنا أن مجمع العقول (تروست الأدمغة) سيلعب دورا غير قليل في صياغة توجهات السياسة الخارجية الأميركية، ويقدم الآراء والمقترحات للرئيس، وهي سياسة معتمدة بشكل خاص منذ عهد الرئيس كينيدي وحتى الآن، وقد برز عدد من العاملين في تروست الأدمغة وغالبيتهم الساحقة جاؤوا من خلفيات أكاديمية، مثل هنري كيسينجر وزبغينيو بريجنسكي ومادلين أولبرايت وكونداليزا رايس وستيفن هادلي، وغيرهم.
القضية الثانية: الحاجة إلى حوار على نحو جديد، تشارك فيه حكومات وبرلمانات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، وهو حوار ذو شقين: أحدهما معرفي وثقافي، بيننا وبين أنفسنا من جهة، وبيننا وبين الآخر جهة ثانية. والهدف منه هو محاولة المواءمة بين مصالحنا ومتطلبات المجتمع الدولي والقوى الكبرى والبحث في السبل الكفيلة بوضع أولوياتنا موضع التطبيق، ثم تشخيص عناصر القوة التي نملكها، وكذلك عناصر الضعف التي نعاني منها، ويعتمد ذلك على التنسيق والتعاون بين دولنا ومؤسساتنا. والشق الثاني له علاقة بالحوار السياسي، وهذا يحتاج أيضا إلى حوار داخلي وخارجي مع النفس ومع الآخر، لا سيما الأميركي.
القضية الثالثة: بين الثابت والإستراتيجي، ثمة تكتيكي وظرفي، فينبغي إخضاع الثاني للأول، وبقدر ما يمكن إبداء مرونة وتواصل في الثاني، يمكن التمسك بالثاني، إلى الحد الذي لا يقبل التنازل، فحقوق الشعب العربي الفلسطيني والحقوق العربية بشكل عام غير قابلة للتصرف.
وبهذا المعنى ينبغي عدم بناء إستراتيجيتنا على ردود الفعل، وخصوصا لترمب المرشح، وعلينا انتظار سياسة ترمب الرئيس، علما بأن الاختلاف، بل الافتراق بدا واضحا وجليا منذ خطابه الأول بعد الفوز، فضلا عن أنه سارع لرفع دعوات منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، من موقعه الإلكتروني بعد فوزه مباشرة (قبل أن تعود ثانية)، والأمر لا يقتصر على هذه القضية، وإنما قد يشمل عددا من المواقف الشعبوية التي اتخذها والتي كانت “ملحا” في مواجهة غريمته كلينتون، وكان يمكن للمواجهة أن تكون “بلا طعم” يُذكر، انظلاقا من بعض خصائص شخصيته الاستعراضية.
السؤال بقدر ما سيواجه الرئيس، فإنه سيواجهنا أيضا.. وماذا بعد؟
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
ترويض ترامب/ نورييل روبيني
الآن وبعد أن فاز دونالد ترامب على نحو غير متوقع برئاسة الولايات المتحدة، بات السؤال المفتوح هو ما إذا كان سيحكم وفقا للمبادئ الشعبوية المتطرفة التي اتسمت بها حملته أو يتبنى نهجا وسطيا عمليا.
إذا حكم ترامب بما يتفق مع الحملة التي انتهت إلى انتخابه، فبوسعنا أن نتوقع إصابة الأسواق بالذعر في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، فضلا عن أضرار اقتصادية من المحتمل أن تكون كبيرة. ولكن هناك من الأسباب الوجيهة ما يجعلنا نتوقع أن يحكم ترامب بطريقة مختلفة تماما.
فمن المتوقع أن يعمل ترامب الشعبوي المتطرف على إلغاء الشراكة عبر المحيط الهادي، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية. وسوف يبني أيضا الجدار الحدودي الموعود بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ ويرحل الملايين من العمال غير الشرعيين؛ ويقيد تأشيرات العمالة المؤقتة للعمال المهرة المطلوبين في قطاع التكنولوجيا؛ ويلغي بالكامل قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير)، وهو ما من شأنه أن يحرم الملايين من الناس من التأمين الصحي.
في مجمل الأمر، سوف يزيد ترامب المتطرف عجز ميزانية الولايات المتحدة بشكل كبير. وسوف يخفض بشكل حاد ضرائب الدخل على الشركات والأفراد الأثرياء. ورغم أنه سيعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الضريبة على الأرباح المكتسبة، وتشجيع الشركات على تحويل الأرباح الأجنبية، فإن خطته لن تكون محايدة في ما يتصل بالإيرادات. فهو يعتزم زيادة الإنفاق العسكري والإنفاق على القطاع العام في مجالات مثل البنية الأساسية، وسوف تعمل تخفيضاته الضريبية لصالح الأغنياء على خفض إيرادات الحكومة بنحو 9 تريليون دولار على مدار عشر سنوات.
وسوف يغير ترامب المتطرف النهج الحالي في التعامل مع السياسة النقدية جذريا أيضا؛ أولا عن طريق وضع أحد الصقور النقديين في محل رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي جانيت يلين، ثم بشغل المناصب الشاغرة حاليا ومستقبلا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من الصقور. وعلاوة على ذلك، سوف يلغي قدر ما يمكنه إلغاؤه من إصلاحات دود فرانك المالية لعام 2010؛ ويغلق مكتب الحماية المالية للمستهلك؛ ويخفض إعانات دعم الطاقة البديلة والتنظيمات البيئية؛ ويخفض بشكل كبير أي قواعد تنظيمية أخرى يُفتَرَض أنها تلحق الأذى بالشركات التجارية الكبرى.
وأخيرا، من شأن السياسة الخارجية التي سينتهجها ترامب المتطرف أن تُفضي إلى زعزعة استقرار تحالفات أميركا وتصاعد التوترات مع الخصوم. وقد يستحث موقفه المعزز لتدابير الحماية حربا تجارية عالمية، ومن المحتمل أن يؤدي إصراره على أن يتحمل الحلفاء تكاليف الدفاع عن أنفسهم إلى انتشار نووي خطير، في حين يحط من قيمة الزعامة الأميركية على الساحة العالمية.
ولكن الأرجح في واقع الأمر هو أن يسعى ترامب إلى تنفيذ سياسات واقعية وسطية. فبادئ ذي بدء، ترامب رجل أعمال يستمتع بفن عقد الصفقات، أي أنه بحكم التعريف أقرب إلى البرغماتية الواقعية من كونه إيديولوجيا ضيق الأفق. وكان اختياره خوض الانتخابات كمرشح شعبوي مجرد تكتيك انتهازي ولا يعكس بالضرورة معتقدات راسخة.
الواقع أن ترامب قطب ثري من أقطاب العقارات عاش كل حياته بين غيره من رجال الأعمال الأثرياء. وهو داهية من دهاة التسويق نجح في استغلال روح العصر السياسية من خلال استرضاء الجمهوريين من الطبقة العاملة ومن يطلق عليهم مسمى “ديمقراطيو ريغان”، الذين ربما دعم بعضهم سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي. وقد سمح له هذا بالبروز في ميدان مزدحم بالساسة التقليديين من أنصار العمل التجاري، وأنصار وال ستريت، وأنصار العولمة.
ومن المنتظر بمجرد شغله للمنصب أن يُلقي ترامب ببعض المزايا الرمزية لأنصاره في حين يرتد عائدا إلى السياسات الاقتصادية التقليدية على جانب العرض والتي فضلها الجمهوريون لعقود من الزمن. والمعروف أن مايك بنس، الرجل الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس، سياسي جمهوري مؤيد للمؤسسة، وكان المستشارون الاقتصاديون للحملة الانتخابية من رجال الأعمال الأثرياء، والممولين، ومطوري العقارات، وخبراء الاقتصاد من منظري جانب العرض. بل ويُقال إنه يفكر بالفعل في اختيار جمهوريين من التيار الرئيسي لحكومته، بما في ذلك رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش، وسيناتور تينيسي بوب كوركر، وسيناتور ألاباما جوس سيشنز، والرئيس التنفيذي السابق لغولدمان ساكس ستيفن منوتشين (الذي كان أيضا مستشارا لحملته).
سوف يتولى الجمهوريون التقليديون وكبار رجال الأعمال الذين من المرجح أن يعينهم ترامب صياغة سياساته. وتلتزم السطلة التنفيذية بعملية اتخاذ القرار التي بموجبها تحدد الوزارات والهيئات المعنية المخاطر والمكافآت المترتبة على السيناريوهات المختلفة، ثم تعمل على تزويد الرئيس بقائمة محدودة من الخيارات السياسية يختار من بينها. ونظرا لنقص خبرة ترامب فإنه سوف يكون أكثر اعتمادا على مستشاريه، تماما كما كان الرئيسان السابقان رونالد ريغان وجورج دبليو بوش.
وسوف يُدفَع ترامب بشكل أكبر باتجاه الوسط بفعل الكونجرس، الذي سيضطر إلى التعامل معه لتمرير أي تشريع. وسوف يكون رئيس مجلس النواب بول ريان وقيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ أكثر ميلا إلى وجهات نظر الحزب الجمهوري الأقرب إلى التيار السائد من ترامب بشأن التجارة والهجرة وعجز الموازنة. من ناحية أخرى، سوف تكون الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قادرة على تعطيل أي إصلاحات جذرية يقترحها ترامب، وخاصة إذا مست صميم السياسة الأميركية: الأمن الاجتماعي ونظام الرعاية الصحية.
وسوف تكون تصرفات ترامب مكبوحة أيضا بفِعل الفصل بين السلطات بموجب النظام السياسي الأميركي، والهيئات الحكومية المستقلة نسبيا مثل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، والصحافة الحرة النابضة بالنشاط.
ولكن السوق ذاتها سوف تكون القيد الأكبر المفروض على ترامب. فإذا حاول ملاحقة سياسات شعبوية متطرفة، فسوف يأتي الرد سريعا وقاسيا: هبوط أسعار الأسهم، وانخفاض قيمة الدولار، وهروب المستثمرين إلى سندات الخزانة الأميركية، وارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد، وما إلى ذلك. ولكن إذا مزج ترامب سياسات شعبوية أكثر اعتدالا مع سياسات التيار السائد الداعمة للأعمال، فلن يواجه تداعيات السوق. فالآن بعد أن فاز في الانتخابات، لا يوجد من الأسباب ما قد يدفعه إلى اختيار الشعبوية بدلا من السلامة.
الواقع أن الآثار المترتبة على رئاسة ترامب الواقعية البرغماتية ستكون أكثر محدودية من السيناريو الراديكالي. فأولا، سوف يتخلص ترامب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي على أية حال؛ ولكن هيلاري كلينتون كانت ستفعل نفس الشيء أيضا. وقد ادعى أنه يعتزم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ولكنه سوف يلجأ في الأرجح إلى تعديلها على النحو الذي يُرضي العمال الأميركيين المتوسطين.
وحتى إذا كان ترامب البرغماتي راغبا في الحد من الواردات من الصين، فإن خياراته ستكون محدودة بفعل الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية مؤخرا ضد تعريفات “الإغراق الموجهة” على السلع الصينية. كثيرا ما يلجأ المرشحون من خارج المؤسسة إلى تقريع الصين خلال حملاتهم الانتخابية، ولكنهم سرعان ما يدركون بمجرد شغلهم للمنصب أن التعاون يصب في مصلحتهم.
ربما يبني ترامب جداره على الحدود المكسيكية، برغم انخفاض أعداد المهاجرين الجدد مقارنة بالماضي. ولكنه لن يضيق الخناق في الأرجح إلا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون جرائم عنف، بدلا من محاولة ترحيل خمسة إلى عشرة ملايين شخص. وفي الوقت نفسه، ربما يحد من تأشيرات الدخول للعمال من ذوي المهارة العالية، وهو ما من شأنه أن يستنزف بعض ديناميكية قطاع التكنولوجيا.
ورغم أن ترامب البرغماتي سوف يولد المزيد من العجز المالي، فإن هذا العجز سيكون أصغر مقارنة بالسيناريو المتطرف. وإذا تبنى الخطة الضريبية التي اقترحها الجمهوريون في الكونغرس، على سبيل المثال، فسوف تنخفض الإيرادات بنحو 2 تريليون دولار فقط على مدى عشر سنوات.
من المؤكد أن مزيج السياسات في ظل إدارة ترامب البرغماتية سيكون غير مترابط إيديولوجيا وضارا بالنمو بشكل معتدل. ولكنه سيكون مقبولا بشكل أكبر كثيرا بين المستثمرين ــ والعالَم ــ مقارنة بالأجندة المتطرفة التي وعد بها ناخبيه.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
ثورة ساندرز/ بدر الراشد
كان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية صادماً، لكنه لم يكن “ثورةً” من أي نوع، بل عودة إلى الوراء، إلى ما قبل انتخاب باراك أوباما أول رئيس أسود، أو ما قبل إقرار قوانين التأمين الصحي، أو ما قبل السماح للمثليين بالزواج، أو بنظرةٍ متطرّفة، ما قبل حركة الحقوق المدنية التي حاولت رسم ملامح مختلفة لأميركا، تحفل بالتعدّدية والتنوع، قبل قرابة خمسة عقود.
كانت الثورة في أميركا في مكان آخر، ولا يبدو أنها أًجهضت بعد. وهنا الحديث عن حملة السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، والتي تحولت إلى تيار، يبدو أنه بدأ مسيرةً ستكون حافلةً لمعارضة سياسات ترامب، بقيادة السيناتور العجوز (75 عاماً) الذي أعلن أنه سيكون “أسوأ كوابيس” الرئيس المنتخب، إذا حاول انتهاك حقوق الأقليات العرقية والدينية في أميركا.
بأثرٍ رجعي، يتّضح أن حملة هيلاري كلينتون، والتي كانت قائمة على الاحتفاء بالتعدّدية، تساوى تأثيرها تقريباً مع حملة ترامب التي قامت على خطاب شعبويٍّ متعصب (فازت هيلاري على مستوى التصويت الشعبي بفارق مليوني صوت، أما ترامب فحصد العدد الكافي من المندوبين للفوز بالرئاسة). بدا خطاب هيلاري كأنه امتداد لخطاب أوباما، ومع هذا لم تستطع أن تُقنع الناخبين من الأقليات والنساء الذين خرجوا في العامين 2008 و2012 للتصويت لأوباما، بدعمها ضد ترامب، كما تظهر أرقام ما بعد الانتخابات.
لكن الثورة في أميركا جاءت من مكان آخر، من حركة السيناتور العجوز، بيرني ساندرز، والذي أدار حركةً شعبيةً حقيقية، ومؤثرة، كادت أن تتفوق على حملة عائلة كلينتون التي كانت انتخابات 2016 الرابعة في تاريخهم. وتكسب حملة ساندرز أهميتها اليوم، لأنها في طور التحول إلى حركةٍ تقود تياراً عريضاً مناوئا لترامب وسياساته.
في كتابه “ثورتنا: مستقبل لنؤمن به”، الصادر قبل يومين، يتحدّث بيرني ساندرز عن حملته الانتخابية التاريخية، والمبادئ التي قامت عليها، والمستقبل الذي يراه للجيل الأميركي الجديد، الذي التف حوله. يصف حملته الانتخابية بأنها “كانت بلا مال، أو منظمة سياسية داعمة، وكنا نواجه كل مؤسسة الحزب الديمقراطي (الإستبلشمنت)”. وعلى الرغم من هذا، استطاعت هذه الحملة أن تحقق غير المتوقع. حصد ساندرز في الانتخابات التمهيدية 13 مليون صوت، وفاز في 22 ولاية أميركة، ونال دعم 1846 أي 46% من المندوبين. وكان بحاجة لدعم 2383 مندوبا، ليمثل الحزب الديمقراطي في الانتخابات.
يصف ساندرز حملته بقوله “صنعنا التاريخ، وأدرنا واحدةً من أكثر الحملات الانتخابية المهمة، والمؤثرة في التاريخ الحديث، الحملة التي، بصورةٍ عميقة، غيّرت أميركا”. ويصف أحد الأكاديميين الأميركيين الحملة بأنها أثّرت في جيل أميركي كامل، كان غير مهتم بالسياسة، فساندرز “لم يجعل الحزب الديمقراطي يتجه إلى اليسار، بل جعل جيلاً كاملاً يتّجه إلى اليسار”.
جذبت حملة ساندرز الأميركيين من كل الأعراق والخلفيات الثقافية، وتفوّقت من خلال تبني أجندةٍ لا يتم تناولها عادة في الانتخابات الأميركية، ترتكز على الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر اشتراكية، تراجع خطط التأمين الصحي، والتعليم، واتفاقيات التجارة العالمية.
يؤمن ساندرز بأن التغيير “لا يأتي من القمة إلى القاعدة، بل من القاعدة إلى القمة”. لذا، يرى التغيير يبدأ بـ “استعداد الناس العاديين، بالملايين، للصمود والنضال من أجل العدل” أولئك الذين حشدهم في حملته الانتخابية، ويحشدهم اليوم ضد سياسات ترامب العنصرية والمتعصبة.
أن يفوز ملياردير أبيض وشعبوي ومتعصب، من مدينة نيويورك، بالانتخابات، أمرٌ صادم، لكنه لا يخبرنا شيئاً مختلفاً عن أميركا. الثورة الأميركية الحقيقية، في أن يحصل سيناتور عجوز، ويهودي، يعلن أنه اشتراكي، من ولاية صغيرة ومهمشة (فيرمونت) على كل هذا الدعم، وينجح في تسييس جيلٍ أميركي جديد، لم يسيّس من قبل، ويمثل السواد الأعظم من الأميركيين، ليشارك هذا الجيل في السياسة على تعدّد مستوياتها، من انتخاب المسؤولين عن التعليم في المقاطعات المحلية إلى الانتخابات الرئاسية.
العربي الجديد
سياسة ترامب الخارجية موضع جدل وقلق دولي/ راغدة درغام
مستقبل علاقة إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع كل من روسيا وإيران، يُشغل بال أركان الحزب الجمهوري الذي رشح ترامب لمنصب الرئاسة وأعمدة الحلفاء التقليديين الأوروبيين للولايات المتحدة. عنوان القلق من تقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنتخب دونالد ترامب يصب في سورية وأوكرانيا، لكنه يطاول أيضاً الحذر من انعدام التوازن بين خبرة بوتين وحنكته ومكره وبين افتقاد ترامب التجربة السياسية وعمق المعرفة بالعلاقات الدولية. التجاذب في شأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران يقع في اتجاهين معاكسين بين القيادات الأوروبية الداعية إلى التمسك بالاتفاق وبين قيادات في الحزب الجمهوري تشدد على ضرورة تشديد مراقبة تنفيذ طهران الاتفاق وأخذ الاستعدادات لإعادة فرض العقوبات عليها وإنذارها بجدية عبر إعادة الخيار العسكري إلى الطاولة، في حال إخلال إيران بالتعهدات أو التلاعب بتطبيقه بحذافيره. بل إن هناك مَن بدأ بالمطالبة باتخاذ خطوات تمهيدية، عبر تعيينات رئيسية في إدارة ترامب، تهيئة لموعد نفاذ الاتفاق بعد 9 سنوات، تكون استباقية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. الجميع في انتظار تشكيل الحكومة الأميركية في مواقع وزير الخارجية، ووزير الدفاع، والمدعي العام، ومستشار الأمن القومي، ووزير إحدى أهم الوزارات، بل هي أم الوزارات، وزارة أمن البلاد homeland Security. كثر يتموضعون وقلة تعرف هوية أقطاب إدارة ترامب التي – على الأرجح – ستكون مزيجاً من التقليديين في المؤسسة الحاكمة (إيستابلشمانت) ومن المتطرفين اليمينيين إرضاءً للقاعدة الشعبية التي دعمته. الواضح أن ترامب بدأ التأقلم مع متطلبات المنصب لكنه ليس في طلاق مع المرشح ترامب الذي خاض الحملة الانتخابية أو «دونالد» الذي تغلّب على المطبّات في مسيرته كرجل أعمال ووعد نفسه بالوصول إلى البيت الأبيض، ووصل بانفرادية القرار وانفرادية العزم. وهذا هو تماماً موضع قلق الذين يخشون أن تأتي هذه الخامة غير التقليدية إلى الرئاسة الأميركية من دون خبرة حكم أو تجربة سياسية لتتخذ القرارات المصيرية باعتباطية الانفرادية. الذين يدعون إلى التريّث للتعرف إلى دونالد ترامب الرئيس يطلبون الانتظار قبل إطلاق الأحكام، أقله إلى حين تسلمه السلطة في 20 كانون الثاني (يناير). إنما كل خطوة من الآن إلى ذلك الموعد تُرصَد، إن أتت من روسيا في سورية أو إيران في العراق، ذلك لأن الإدارة المقبلة ستتميّز بصورة ما عن سابقتها.
الرئيس باراك أوباما نفّذ بعض وعود دونالد ترامب فعلياً أثناء ولايتيه من 8 سنوات بالذات في مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تصنيفهم مجرمين وخارجين على القانون. أوباما اكتسب سمعة «القائد الأعلى للترحيل»، لأنه رحّل أكثر من 2.5 مليون شخص ما بين 2009 و2015. دونالد ترامب بدأ التسلق هبوطاً بقوله أن الفوج الأول من الترحيل سيكون لحوالى 2 مليون مجرم وخارج على القانون وليس لكامل الـ11 مليون مهاجر غير شرعي.
كذلك في مسألة الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي تم بناء ثلثه حتى الآن. ترامب يتحدث الآن عن أجزاء من الحائط الموعود تكون سياجاً لا جداراً. يقول أنه خبير بناء ويعرف كيف يوفّق بين السياج والجدار.
أثناء الحملة الانتخابية، تحدث ترامب بلغة عدائية وتهديدية مع الصين. أما عندما أصبح رئيساً منتخباً، فقد بدأ لغة التواصل والبراغماتية مع القيادة الصينية.
عندما اجتمع مع أوباما في البيت الأبيض لنحو ساعة بعدما كان قد تم تخصيص 15 دقيقة للقاء، خرج أوباما ليصف ترامب بأنه ليس عقائدياً وإنما هو براغماتي ويجب إعطاؤه فرصة قيادة الولايات المتحدة. دونالد ترامب خرج أيضاً من اللقاء مادحاً الرجل الذي تبادل معه أقسى الأوصاف. وعندما سئل عمّا تحدثا ذكر أول ما ذكر منطقة الشرق الأوسط – تلك المنطقة التي كان وضعها في أسفل الأولويات وقزّمها إلى محاربة الإرهاب.
لغته عن السعودية تغيّرت منذ انتخابه رئيساً. مواقفه من النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي أفادت بأنه لن ينفذ ذلك الوعد الانتخابي لكل مرشح للرئاسة الأميركية بنقل السفارة إلى القدس. وأفادت بأنه لن يكون «محايداً» بمعنى الابتعاد عن تناول الملف والعمل نحو حل سياسي، بل إنه راغب في إخراج المسألة من الجمود التام والسعي نحو إحياء العملية التفاوضية. أما إذا قرر أن يكون وسيطاً أميركياً يتسم بالحياد، فهذه ستكون نقلة نوعية مهمة – مستبعدة تماماً إذا كانت الأسماء المطروحة لوزير الخارجية على نسق رودي جولياني أو جون بولتون.
جولياني، عمدة نيويورك السابق، يريد منصب وزير الخارجية وهو سيكون من أسوأ الخيارات لو حصل على المنصب. جون بولتون أذكى وأكثر خبرة في الشؤون الخارجية، لكن تفكيره أقرب إلى المحافظين الجدد ومبدأ التدخل العسكري، ما يتناقض مع وعود ترامب الانتخابية باللامبالاة بحروب الآخرين وعدم الرغبة في التورط في أماكن النزاع ورفض مبدأ التدخل العسكري الأميركي.
المستبعد تماماً هو أن يختار ترامب وزير خارجية من الحزب الديموقراطي، إنما هذا لا يعني أنه لن يختار شخصية تهادنية تشبه باراك أوباما عند التعاطي مع روسيا، أو حتى مع إيران إلى درجة أقل، والتفاصيل مهمة.
بالنسبة إلى إيران، لن يكون دونالد ترامب نسخة عن باراك أوباما في درجة التهادنية، ولا في مدى الاستعداد للرضوخ للاتفاق النووي كالمحرك الأساسي للعلاقات الأميركية – الإيرانية. ستقع طهران تحت مراقبة أعمق وأوسع مما هي في عهد أوباما، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تفاصيل الاتفاق النووي. ستكون إدارة ترامب أكثر تأهباً لإعادة فرض العقوبات لدى أي محاولة إيرانية للتحايل على القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق. ستسعى إدارة ترامب وراء استفسار الوكالة الدولية للطاقة الذرية عما تفعله في كل شاردة وواردة بدلاً من ترك الأمر كاملاً لحرية مراقبتها. ستعيد إدارة ترامب طرح جميع الخيارات على الطاولة في تعاطيها مع إيران، بما في ذلك الخيار العسكري.
هذا لا يعني أن إدارة ترامب ستنحاز ضد إيران في معاركها الإقليمية، أو أنها ستتبنى الدول الخليجية كحليف في العلاقات الأميركية – الخليجية – الإيرانية. في أقصى الحالات قد توافق إدارة ترامب على إعادة طرح العلاقات مع إيران من ناحية مشاريعها الإقليمية التوسعية – فقط إذا أجبرتها التطورات في سورية والعراق واليمن ولبنان على ذلك، وليس في إطار العلاقات الأميركية – الخليجية. فإيران تبقى مشروع شراكة الأمر الواقع في الأولوية الأميركية في عهد ترامب، وهي محاربة «داعش». فإرهاب 11/9 ما زال محركاً أساسياً في سياسة أميركا في الشرق الأوسط، ما يفيد العلاقة الأميركية مع إيران التي تزعم قيادة الحرب على الإرهاب. ولكن، إذا أتى إلى مناصب القيادات الرئيسية في الإدارة الأميركية مَنْ يربط بين الاتفاق النووي الذي يعارضه ترامب وبين مشاريع إيران للهيمنة الإقليمية، فسيكون الحديث مختلفاً وربما أيضاً سياسات الإدارة المقبلة.
روسيا موضوع آخر. الدول الأوروبية تعي عواقب تقارب دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على حساب سياسات رئيسية بين الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي وبين الولايات المتحدة. بريطانيا في طليعة الدول التي تتخذ مواقف ناقدة ومحذّرة من السياسة الروسية في سورية وفي أوكرانيا وعلى صعيد مبادئ العلاقات الدولية والقيم التي تتحكم بضرورة المحاسبة على تجاوزات تدخل في خانة ارتكاب جرائم حرب أو غض النظر عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
تحسباً لما قد تأتي به المودة الشخصية أو التلميحات بنقلة نوعية في العلاقة الأميركية – الروسية في عهد ترامب وبوتين، بدأ الاتحاد الأوروبي إعداد خطة تتحدى روسيا ليس بمعنى «الخطة باء» العسكرية وإنما من منطلق استراتيجية «الوخز بالدبوس» لزيادة الضغوط على الحكومة الروسية وكذلك على الحكومة السورية. هذه الاستراتيجية تشمل فرض العقوبات الاقتصادية وإجراءات العزل الديبلوماسية والاستعداد للمحاسبة والعقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا أو سورية.
روسيا أيضاً لا تسترخي في افتراض علاقات نوعية بمجرد تسلم ترامب السلطة. ربما البعض في موسكو يعتقد أن ترامب مدين لها بسبب وضوح المشاعر الروسية ضد هيلاري كلينتون. إنما هناك واقعية تفرض التفكير في أبعاد احتفاظ الحزب الجمهوري بالكونغرس، وربما اعتزامه مساعدة ترامب على القيادة الأميركية في الساحة الدولية.
روسيا في حاجة دائماً إلى تغذية فكرة العداء مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة. وهي ليست جاهزة للتخلي عن اعتزامها حسم المعركة عسكرياً في حلب – وهذا الأمر لن يغيّر طموح بدء العلاقة مع إدارة ترامب بتهادنية. والفسحة الضائعة، كما تسمى، من الآن إلى 20 كانون الثاني قد تفرض معطيات جديدة على تصور دونالد ترامب للعلاقة الأميركية – الروسية.
ما زال باكراً التنبؤ بما ستحدثه رئاسة دونالد ترامب على صعيد السياسة الخارجية. فالرجل يتأقلم مع المنصب، والمنصب قد يعيد صوغ الرجل، والثابت دوماً هو أن هناك سياسة خارجية أميركية بعيدة المدى تتعدى الاعتبارات الشخصية.
الحياة
القصير وحلب وترامب والحكومة اللبنانيّة/ وليد شقير
لا يمر يوم من دون أن يقتحم الوضع الإقليمي في تقلباته وأحداثه الخطيرة، المشهد السياسي اللبناني، على رغم أن التسوية التي قضت بإنهاء الشغور الرئاسي استندت، بين أمور عدة، إلى السعي «لإبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية»، وفق ما قال الرئيس ميشال عون في خطاب القسم في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
أحدث مظاهر الاقتحام الإقليمي للسياسة الداخلية اللبنانية، كان العرض العسكري بالآليات المدرعة لـ»حزب الله» في مدينة القصير السورية آخر الأسبوع الماضي، والذي لقي ردود فعل محلية وخارجية ما زالت تفاعلاتها مستمرة.
فهذه التسوية التي قال مريدو الرئيس عون في سدة الرئاسة أنها صُنعت في لبنان، لا بد من أن تمر في اختبارات شبه يومية لمدى قدرة أصحابها على تحييد لبنان عن حروب المنطقة وانخراط «حزب الله» فيها بصفته جسماً إقليمياً تعلو هويته وأدواره على هويته المحلية، كقوة راجحة في طائفته التي تشكل أحد المكونات الرئيسة للنسيج اللبناني المعقد.
يرمز العرض العسكري للحزب في القصير إلى الكثير، ويكرس تفوّق علاقته بالإقليم على وزنه الداخلي. وإذا كان البعض ما زال يشكك في رسم جديد لخرائط المنطقة وتحديداً لسورية المدمرة، بحجة أن ما يجري في بلاد الشام هو مناطق نفوذ موقتة، فإن استعراض القوة الذي تخللته مسيرة المدرعات التابعة للحزب، يثبت أن الحزب كرس اقتطاعه منطقة نفوذ تمتد من البقاع اللبناني الشرقي إلى الغرب السوري يتيح له حرية الحركة نحو الغرب الجنوبي لسورية، ونحو غربها الشمالي عبر حمص المدمرة، وصولاً إلى حلب، التي يعد التحالف الروسي- الإيراني – الأسدي بالسيطرة عليها قريباً لتعمل فيها أيضاً سكين التغيير الديموغرافي مثل غيرها. لكن المنطقة الغربية السورية المحاذية للبنان، باتت مساحة نفوذ واحدة مع المساحة اللبنانية الشرقية لـ «حزب الله»، تلغي الحدود بين البلدين لتبقى ممرات العبور لقوات الحزب متاحة من دون أي عائق. إنها نسخة طبق الأصل عن إلغاء الحدود بين العراق وسورية من جانب «داعش» عام 2014، ولعملية الإلغاء هذه حين سيدخل «الحشد الشعبي» العراقي الأراضي السورية، تحت عنوان المساهمة في معركة تطهير محافظة الرقة من «دولة الخلافة» بعد الانتهاء من معركة الموصل.
الحال هذه، هل يمكن تصور إقدام السلطات اللبنانية على إقفال الحدود الشرقية خلافاً لمقتضيات تكريس منطقة نفوذ «حزب الله»، (وهو نفوذ إيراني بالتعريف النهائي)، على الأرض السورية، إذا افترضنا أن البعض يصدّق أن هناك إمكانية لـ «تحييد» لبنان عن الصراعات الخارجية؟
قيل الكثير عن الرسائل المتوخاة، إقليمياً ودولياً، من استعراض القوة في القصير. أما لبنانياً، فإن تزامنه مع جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة واعتراض الحزب على إيكال وزارة الدفاع الى حزب «القوات اللبنانية»، يؤشر إلى رفض الدور السياسي لفريق قد لا يسلم بما يمليه غض الطرف عن الموجبات اللبنانية لدور الحزب الإقليمي. فوزير الدفاع هو الذي يقترح إسم قائد الجيش الجديد الذي تقع عليه مهمة غض الطرف، إذا لم يكن أكثر من ذلك، والذي يفترض تعيينه من الحكومة الجديدة. ومع أن الحزب ليس في حاجة إلى إذن الجيش ليواصل دوره الإقليمي، فإنه يفضل أن يأمن إلى توجهات مؤسسة عسكرية أكثر مساعداتها من الجيش الأميركي، الذي له رأيه هو الآخر بالقائد الجديد.
ومع أن الاندفاع الروسي- الأسدي – الإيراني (و»حزب الله») نحو احتلال المزيد من الأراضي السورية، لا سيما حلب، يراهن على توجه دونالد ترامب نحو التساهل مع رغبات موسكو بتحول سورية إلى قاعدة نفوذ لها تحت ستار محاربة «داعش»، وعلى استمرار غض الطرف الأميركي عن دور الحزب في سورية، فإن ضمانة هذا الدور الأولى تبقى في التأثير في قرار السلطة المركزية اللبنانية. والركون إلى إدارة ترامب مجازفة يتحتم الاحتياط لها، خصوصاً أن الشعارات التي طرحها الأخير، ومنها رغبته في التفاهم مع فلاديمير بوتين، قد تصطدم بواقع أكثر تعقيداً من مواقف أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية. والرئيس الآتي من خلفية جاهلة بالسياسة الخارجية، قد تدفع حزبه الجمهوري إلى إحاطته بفريق أكثر إدراكاً منه بتعقيداتها.
تحوّل تعايش الطوائف اللبنانية وتقاسمها النفوذ والسلطة، في توازن داخلي رعته على الدوام القوى الدولية والإقليمية، إلى تعايش مع التحالفات الخارجية لبعضها في مراحل سابقة، لكنه مع «حزب الله» تحول تعايشاً مع أدوار فاعلة للحزب في الحروب الإقليمية، التي توجب القبول بالتسهيلات المطلوبة لبنانياً كي يستمر في لعبها. وهو تعايش غير مسبوق في التاريخ اللبناني.
الحياة
ترامب والحلفاء الأوروبيون/ راجح الخوري
بعد أيام من قول فلاديمير بوتين إن دونالد ترامب “رجل لامع وموهوب لانه مستعد لاستعادة العلاقات الروسية – الاميركية كاملة”، حذّر جان – كلود يونكر من العواقب الوخيمة لتصريحات ترامب عن السياسة الامنية الاطلسية، وقال إن إنتخابه يشكل خطراً على العلاقات الأوروبية – الأميركية “لأنه جاهل بالإتحاد الأوروبي وطرق عمله” !
قبل ان تتمكن فيديريكا موغيريني من ترتيب لقاء مع ترامب، كان فلاديمير بوتين يجري أول من أمس إتصالاً معه على الهاتف إنتهى بالإتفاق على العمل المشترك بينهما بهدف “إقامة علاقات قوية ودائمة مع روسيا والشعب الروسي”، كما أفاد فريق ترامب، في حين أشار بيان الكرملين الى انهما إتفقا على تحسن العلاقات المتبادلة بين البلدين، وعلى التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف وناقشا تسوية الأزمة السورية!
من المبكر القول إن هذه مؤشرات زلزالية تضرب في عمق العلاقات الاميركية – الاوروبية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ترامب، عن انه يمكن ان يفرض شروطاً على الإلتزام الأميركي في “حلف شمال الاطلسي” الذي تتحمل أميركا ثلثي نفقاته العسكرية، خصوصاً ان الريبة في بروكسل خلال اليومين الاخيرين تزامنت مع الإعلانات الاميركية الدافئة عن المحادثة بين ترامب وبوتين الذي يواجه عقوبات أوروبية على خلفية سياسته في القرم وأوكرانيا.
بعد فوز ترامب سارعت وزيرة الدفاع الإلمانية أورسولا فون در ليين الى القول تعليقاً على تصريحاته، التي أشاد فيها ببوتين، إن عليه ان يحدد بوضوح في أي جانب هو، في جانب القانون والسلام والديموقراطية أم أنه لا يعبأ بكل هذا ويتطلع الى بوتين كصديق وثيق؟
يأتي هذا في وقت ترتفع مرارة الأوروبيين مما يبدو لهم قفزاً اميركياً فوق القارة الحليفة لإقامة تعاون وثيق مع روسيا، بما يناقض الروح الاطلسية التي مثّلت قبضة الغرب العسكرية وجداره القوي الذي انهارت امامه روح حلف فرصوفيا كما هو معروف، لهذا لم يكن مستغرباً ان يقول يونكر، وهو من أكثر الشخصيات نفوذاً في اوروبا، إن على الرئيس المنتخب ان يتعلّم ما هي أوروبا وكيف تعمل، وأعتقد أننا سنضيع سنتين الى حين انتهاء ترامب من التجول في العالم الذي لا يعرفه، خصوصاً انه يعتقد ان بلجيكا التي تضم مقرّي الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هي مدينة وليست دولة!
ما يزعج حلفاء اميركا الأوروبيين هو حديث ترامب عن ان عليهم ان يدفعوا أكثر في موازنة حلف شمال الأطلسي، لهذا ردّت فون در ليين بالقول إن على ترامب ان يفهم ان تعامل اميركا مع الحلف يقوم على القيم المشتركة وانه ليس مشروعاً تجارياً.
باراك أوباما لمح لترامب بأن تكامل اميركا مع أوروبا هو اعظم إنجازات العصر، ولكن يبقى من المبكّر الافتراض ان ترامب سيهدم الشركة الاطلسية.
النهار
هل تصنّف إدارة ترامب “الإخوان” منظمة إرهابية؟/ أسامة أبو ارشيد
بعد انتصار دونالد ترامب المفاجئ في الانتخابات الرئاسية، تقف أميركا، والعالم معها، على أبواب مرحلةٍ مفصليةٍ، لا يستطيع أحد تكهّن كنهها، في حين يبدو أن أحداً لم يعدّ العدّة للتعامل مع أميركا ترامب، فالسواد الأعظم افترض أن أميركا لا يمكن أن تسمح لشخصٍ مثله بتبوؤ سدة الرئاسة.
لا تخوض هذه المقالة في هواجس الحلفاء قبل الأعداء، فلا أحد يعلم تماماً ما يمكن أن تكون عليه السياسة الخارجية لرجلٍ يعدم الخبرة، ولا يمكن التنبؤ بسياساته، كما أبانت حملته الانتخابية للرئاسة. من بين هؤلاء، ينبغي أن يكون العرب والمسلمون الأكثر قلقاً، لا لضعفهم وتشرذمهم وانعدام وزنهم فحسب، بل لأن الرجل جعل منهم هدفاً رئيساً للشيطنة والاستخفاف، بما في ذلك “الحلفاء” منهم، خلال حملته للانتخابات. وها نحن اليوم، نرى بعض بوادر إيفاء الرجل بوعوده، حتى قبل استلامه الحكم رسميا. فمن ينظر في قائمة مرشحيه لوزارة الخارجية، وتحديداً عمدة نيويورك الأسبق، رودي جولياني، وممثل الولايات المتحدة الأسبق في مجلس الأمن الدولي، جون بولتون، أو حتى الرئيس الأسبق لمجلس النواب، نيوت غينغريتش، فإنه لا شك يترقب الأسوأ. أيضا، من يتابع المستشارين اليمينيين المتطرفين الذين أحاط ترامب نفسه بهم، كستيفين بانون رئيس تحرير موقع “بريت بارت” اليميني العنصري، وفرانك غافني، رئيس “مركز سياسات الأمن” اليميني المتطرف، ووليد فارس، أحد الذين تدور حولهم شبهات جرائم حرب في لبنان، عندما كان عضوا في “القوات اللبنانية” خلال الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، فإنه لا شك يدرك أن هؤلاء سيدفعون باتجاه أجندةٍ متطرفةٍ نحو العرب والمسلمين، بما في ذلك نحو المسلمين الأميركيين. الشخصيات الثلاثة سالفة الذكر، وغيرهم مثلهم حول ترامب، وعلى قائمة مرشحيه للوزارات المختلفة، بما في ذلك وزارتا العدل والأمن القومي، معروفون بعنصريتهم وكراهيتهم العرب والمسلمين. بل إن بانون متهم بأكثر من ذلك، فهو معادٍ حتى لليهود والسود واللاتينيين الأميركيين، وغيرهم من الأقليات. ويؤيد كلٌّ من بانون وغافني، بل يدفعان، باتجاه تنفيذ وعد ترامب في الانتخابات بأن يصمم نظام تسجيل خاص بالمسلمين، وفرض بطاقات هويةٍ خاصة بهم.
هذا في السياق العام لما قد تكون عليه سياسة إدارة ترامب نحو العرب والمسلمين عموما، لكن الأيام القليلة الماضية حملت تركيزا أكبر على ما إذا كانت إدارة ترامب ستسارع إلى تصنيف
“إدارة جورج بوش الابن، وفي ذروة “الحرب على الإرهاب” لم تضع “الإخوان المسلمين” على قائمة “المنظمات الأجنبية الإرهابية” جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، ويبدو أن مستشارين ومؤيدين له من المراكز والشخصيات اليمينية المتطرفة يدفعون باتجاه ذلك علناً، بل ويصرحون بفظاظة حوله، كما فعل فارس وغافني. وبالمناسبة، تذهب مطالبهم بتصنيف “الإخوان” إلى أبعد من استهداف الجماعة في الخارج إلى استهداف منظمات إسلامية أميركية مرموقة، يزعمون أنها امتداد لها.
كتبت في “العربي الجديد”، في 10 مارس/ آذار الماضي، مقالاً بعنوان (“الإخوان” والنقاش الأميركي لتصنيفها “منظمة إرهابية”)، كما كان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قد نشر دراستي في مايو/ أيار 2014 “الولايات المتحدة الأميركية والإخوان المسلمون في مصر”. ناقش المقال مشروع قانون قدّم في مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، أواخر عام 2015، يدعو وزارة الخارجية إلى تصنيف الإخوان المسلمين “منظمةً إرهابية”، غير أن إدارة أوباما رفضت. من قدّموا مشروع القانون، وفي مقدمتهم السناتور تيد كروز، لا يزالون يضغطون لتمريره. وكنت أشرت، حينها، إلى أن إدارة جمهورية قادمة، قد تمضي في قرار التصنيف، فالأمر لا يحتاج إلى أكثر من قرار رئاسي تنفيذي، أو عبر وزارة الخارجية. كتبت ذلك قبل أن يعلم أحد أن ترامب سيكون رئيساً، فقد كان ثمّة قناعة سائدة حينها أنه، حتى تحت إدارة جمهورية قادمة من داخل “مؤسسة الحكم التقليدية” Establishment، بعيداً عن ترامب وكروز، فإن ذلك مستبعد الوقوع، فإدارة جورج بوش الابن، وفي ذروة “الحرب على الإرهاب” لم تضع “الإخوان المسلمين” على قائمة “المنظمات الأجنبية الإرهابية”، على الرغم من وجود تيارات من داخل الإدارة وحولها كانت تدفع في ذلك الاتجاه.
بناء على ما سبق، واهمٌ من يزعم أنه يعلم أين ستتجه الأمور. فمن يجادل، من دون نظر في المعطيات والسياقات، بأن أميركا دولة مؤسسات عريقة، وبأن حسابات المؤسسة فيها أكبر من حسابات الفرد، حتى ولو كان رئيساً، لا يفهم حقيقة النظام السياسي الأميركي وتفاعلاته، كما أنه لم يستوعب بعد مغازي انتخاب ترامب أميركيا. هذا لا يعني أن أميركا ليست دولة مؤسسات عريقة، وبأنها أكبر من الأفراد، لكننا أيضاً رأينا، في محطاتٍ مفصليةٍ في تاريخ أميركا، كيف أن رؤساء استطاعوا أن يحدثوا انعطافاتٍ جذريةً في مسار البلاد، في ظل معطيات خاصة. فعلها إبراهام لينكولن في قراره تحريره العبيد، وبسبب ذلك، خاضت أميركا حرباً أهليةً ضروساً بين الشمال والجنوب، انتهت باغتياله. وفعلها ليندون جونسون بإقراره قوانين الحقوق المدنية، والتي بسببها خسر الحزب الديمقراطي الجنوب. كما فعلها جورج بوش الابن، بفرض قوانين أمنيّة صارمة جعلت من الولايات المتحدة أقرب إلى الدول البوليسية، مستغلا هستيريا الخوف بعد هجمات “11سبتمبر” في 2001.
اليوم، نحن أمام مفصل تاريخي آخر في الولايات المتحدة، أي قد نرى صداماً بين أعراف
“قد نرى صداماً بين أعراف “المؤسسة الحاكمة” وشخص الرئيس وإدارته والحركة الشعبوية اليمينية التي حملته إلى الحكم” “المؤسسة الحاكمة” وشخص الرئيس وإدارته والحركة الشعبوية اليمينية التي حملته إلى الحكم. وهنا تأتي أهمية الدراسة التي نشرتها عبر المركز العربي، فقد شرحت التأسيس الفلسفي للمؤسسة الأميركية الحاكمة لمقاربة العلاقة مع “الإسلام السياسي”، والتي جاءت في خطابٍ ألقاه، في يونيو/ حزيران عام 1992 في واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حينها، إدوارد بي. جيرجيان بعنوان “الولايات المتحدة والشرق الأوسط في عالم متغير”. وباختصار، يحدد جيرجيان المعايير التي ستقبل الولايات المتحدة التعامل على أساسها مع حركات “الإسلام السياسي”، مثل القبول بمرجعية صناديق الانتخاب، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الأقليات، والحريات، ونبذ “الإرهاب”.. إلخ، غير أن الخطاب كان واضحا في أنه يتحدث عن القبول بـ”مشاركة” سياسية لـ”حركات الإسلام السياسي” لا عن تسلم الحكم. وقد شرحت حينها معطيات السياق الموضوعي لذلك الخطاب، وأهمها أن الولايات المتحدة التي فوجئت بالثورة الإسلامية في إيران عام 1979 اعتبرت أن جزءاً من عنصر المفاجأة ترتب على إهمالها الاتصال مع حركة الخميني في مدينة قم الإيرانية، وذلك بسبب ضغوط الشاه على السفارة الأميركية في طهران، حينئذ، للامتناع عن ذلك. ومنذ ذلك الحين، في أواخر رئاسة جيمي كارتر، ومروراً برئاسات رونالد ريغان، جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وبوش الابن، وصولاً إلى باراك أوباما، والولايات المتحدة تحافظ على اتصالاتٍ مع الإسلاميين، وتحديداً الإخوان، تزداد وتيرتها حيناً، وتخفت حيناً آخر، حسب الظروف. أيضا، فإن جُلَّ الخبراء في “المؤسسة الحاكمة”، أو القريبين منها، دائماً ما جادلوا بأن حركات الإسلام السياسي، وخصوصا “الإخوان المسلمين” هم جزء من معادلة الاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب حجمهم وتأثيرهم، من دون أن يعني ذلك القبول بهم خارج الاشتراطات التي أشير إلى بعضها سابقا.
باختصار، سيكون العشرون من شهر يناير/ كانون الثاني 2017، يوم تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، المحطة الزمنية الفاصلة لمعرفة هل ستنتصر التقاليد العريقة للمؤسسية الأميركية، في السياستين الداخلية والخارجية، بما في ذلك في التعامل مع العرب والمسلمين، ومن ضمنهم الإخوان المسلمون، أم أن الحركة الشعبوية التي حملت ترامب، وكثيرين من الإيديولوجيين المتعصبين من حوله، سيُحدثون خرقاً في تلك المؤسّسة. سؤالٌ لا يملك أحد الإجابة عليه الآن، وإن كنا نرى بعض الكتابة على الحيطان.
العربي الجديد
العائلة الحاكمة في أميركا/ خليل العناني
لم تتوقف مفارقات الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، عند حدود فوزه المفاجئ في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من كل ما صاحب ذلك من صخبٍ وجدل. ولا تزال الأخبار والمفاجآت تتدفق بشأن مداولات اختيار فريقه الرئاسي، والتي يقوم بها فريق عمل انتقالي، يتكون من مقرّبين لترامب، بيد أن الخبر الأكثر إثارة هو مشاركة أفراد عائلة ترامب في عملية اختيار المسؤولين الجدد في الإدارة الأميركية، المفترض أن تبدأ عملها بعد حلف الرئيس الجديد اليمين في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ الرؤساء الأميركيين. حيث تضم اللجنة التنفيذية في الفريق الانتقالي الذي يرأسه مايك بينس، نائب ترامب، ثلاثةً من أبناء الأخير: ابنته إيفانكا (35 عاماً)، وابنيه إريك (32 عاماً)، ودونالد ترامب جونيور (38 عاماً)، بالإضافة إلى صهر ترامب وزوج ابنته إيفانكا، جارد كوشنير (35 عاماً).
تلعب العائلة الحاكمة الجديدة الآن دوراً حاسماً في اختيار أعضاء إدارة والدهم، ويبدو الأمر وكأنهم يديرون إحدى شركاته الخاصة، وليس دولةً بحجم أميركا. وقد تناقلت وسائل الإعلام الأميركية مدى النفوذ الذي تتمتع به إيفانكا وزوجها كوشنير في عملية اختيار أعضاء الإدارة الأميركية الجديدة، والذي وصل إلى حد التخلص من شخصياتٍ كبيرةٍ ومؤثرةٍ في حملة ترامب، منهم، على سبيل المثال، كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي، والمرشح الرئاسي السابق الذي انضم لحملة ترامب الرئاسية، ولعب دوراً مهماً فيها. فقد تمت إطاحة كريستي من رئاسة الفريق الانتقالي قبل أيام في مفاجأة مدوّية. ويُقال إن جارد كوشنير لعب دوراً مهماً في هذا الموضوع، نظراً لوجود خلافات بينه وبين كريستي الذي حبس تشارلز كوشنير (والد جارد)، عندما كان مدّعياً عاماً يحقق في أحد قضاياه المتعلقة بالضرائب، وتلقي تبرعاتٍ غير مشروعة، فضلاً عن بعض القضايا المخلّة بالشرف، وذلك عام 2005. كذلك يُشاع أن موري كوشنير، (أخ تشارلز وعم جارد) كان يدعم كريستي ضد أخيه، بسبب خلافات مالية بينهما، ما أثار حفيظة جارد ضد عمه وضد كريستي، لذا عمل على تهميشه منذ انضمام الأخير لحملة ترامب، أوائل الصيف الماضي، إلى الدرجة التي حرمه فيها من أن يتولي منصب نائب الرئيس. كذلك لعب كوشنير دوراً مهما في استبعاد رئيس لجنة الاستخبارات السابق في مجلس النواب، مايك روجرز، والمحسوب على كريستي، من تولي منصب مستشار الأمن القومي الذي كان مرشحاً له بقوة.
ومن المفارقات أن الشاب جارد كوشنير، وهو رجل أعمال ناجح خريج جامعة هارفارد، وتتجاوز ثروته خمسة مليارات دولار ومن أصول يهودية، أنه لا يتولي أي منصب رسمي في فريق ترامب. ولكنه على علاقة وطيدة بعالم المال والأعمال في “وول ستريت”. كما أنه لعب دوراً محورياً في فوز ترامب بالرئاسة، وكان مسؤولاً بشكل غير مباشر عن ترويج ترامب على “السوشيال ميديا”. وهو الآن يلعب دوراً مهماً في الفريق الانتقالي لترامب. وما يفعله الشاب كوشنير، ومعه بقية عائلة ترامب، يذكّرنا بالمسلسل الأميركي الشهير “هاوس أوف كاردس”. ولن نفاجأ أيضا إذا علمنا أنه قد يلعب دوراً في إعادة هيكلة الحزب الجمهوري الذي يعاني الانقسام والتفسخ، بعد فوز ترامب، لكي يتجه به يميناً.
يكشف انخراط عائلة ترامب في إدارة عملية الانتقال، واختيار مسؤولي الإدارة الأميركية الجديدة، مدى التغير الذي تمر به السياسة في أميركا، والتي لم تعد تُدار بالطرق التقليدية. ويبدو أن الأميركيين سوف يكون لديهم، للمرة الأولي في تاريخهم، عائلةً حاكمةً تدير شؤون الدولة من خلف الستار، كما لو كانت إحدى جمهوريات الموز، وليست واحدةً من أعرق الديمقراطيات الراسخة في العصر الحديث.
العربي الجديد
عن ترامب وبقية شعبويّي الغرب…/ حازم صاغية
إذا استعدنا، بقدر من التصرّف، عبارة لليون تروتسكي عن الفاشيّة، أمكن القول إنّ الحداثة المعولمة ابتلعت في العقود الثلاثة الماضية الشيء الكثير، وهي ابتلعته بسرعة، وعلى نحو غير عادل. ولأنّ الأمر هكذا، فإنّها لم تهضم هذا الكثير الذي ابتلعته، بل تقيّأتْ بعضه. والقيء هو اليوم دونالد ترامب وأشباهه في أوروبا.
ما وصفه تروتسكي في الثلاثينات يشبه، ولا يشبه، ما يعاش اليوم ممّا لا يزال تعريفه ينجم عن المقارنة بالفاشيّات الكلاسيكيّة أكثر ممّا يقوم بذاته كحالة مستقلّة.
فليس ثمّة، بين شعبويّي يومنا، تيّار عريض ومتماسك يرفض الديموقراطيّة وتقنيّتها الانتخابيّة، أو يعد بإلغائها حال الوصول إلى السلطة. صحيح أنّ ثمّة أفراداً محيطين بترامب يشكّكون بـ «عداليّة الديموقراطيّة» ويتّهمونها بـ «تحكيم الأغبياء والجهلة»، إلاّ أنّ أصوات هؤلاء لا تُسمع قياساً بأصوات الذين يعلنون التمسّك بها والحكم باسمها. وهذا من دون استبعاد المحاولات التي قد تؤول إلى التحكّم بالعمليّة الديموقراطيّة والمبالغة في ضبطها سلطويّاً. ويُخشى هنا خصوصاً تضخّم الميل الدارج اليوم إلى هجاء «المؤسّسة»، بوصفه تذكيراً بهجاء «فساد الأحزاب» الذي شكّل في العقود الماضية تمهيداً ضروريّاً لإلغاء السياسة. ولا يُنسى أنّ دونالد ترامب نفسه سبق له، قبل الانتخابات، أن حذّر من احتمال تزويرها. وهو المنطق الذي يفضي، في حال شيوعه، إلى إضعاف الثقة بالمؤسّسات كمصدر تحكيم أخير، والتشكيك تالياً بأحد أبرز روابط المواطنيّة وأهّمها.
كذلك توجد في الولايات المتّحدة ميليشيات متفرّقة تزعم التفوّق الأبيض، إلاّ أنّ الشعبويّة الراهنة تفتقر إلى تنظيمات شبه عسكريّة موازية للسلطة وجيشها على نطاق وطنيّ، كـ «قوّات العاصفة» النازيّة وسواها. ولئن وُجد لاساميّون في البيئات الشعبويّة الناهضة اليوم، في الولايات المتّحدة وأوروبا، فمن المستحيل تصوّر محرقة على غرار ما عرفته الأربعينات.
وعلى صعيد آخر فإنّ الذي يفكّر بـ «عبادة الدولة» وفقاً لتعاليم الفاشيّة الإيطاليّة، يواجهه راهناً، أقلّه في الشعبويّة الأميركيّة، عداءٌ حادّ للدولة ورغبة في محاصرتها والحدّ من دورها. وغنيّ عن القول إنّ أثر الليبيرتاريّة في تشكيل «اليمين البديل» في أميركا أقوى من أثر التيّارات الفكريّة الأخرى.
طبعاً يتكرّر في زمننا لقاء الأزمة الاقتصاديّة والفكر الرجعيّ، كما يتكرّر استحضار الفائض القوميّ الهائج، وإن بات عنصره الثقافيّ يغلب على عنصره العرقيّ المحض. لكنْ من دون أن تختفي جيوبٌ عنصريّة الهوى والعقيدة، ورموز سيقيم بعضها في البيت الأبيض، قريباً من الرئيس، لا يزال الكلام عن «إيديولوجيا عنصريّة» متماسكة مستبعداً جدّاً، كما هو مستبعد شيوع أدبيّاتها التي لا تزال في بعض البلدان موضع تجريم.
كذلك تتشخّص الحركات الراهنة في زعيم معصوم، وإن كانت المؤسّسات الحاليّة أشدّ تقييداً لعلاقته المباشرة بـ «الشعب» و «الجماهير». أمّا استبعاد المحرقة فلا يلغي عذابات مهولة قد يعانيها اللاجئون والمهاجرون والمهمّشون والأقلّيّات الإيروسيّة، فضلاً عن انتكاسات تشريعيّة تطاول المرأة وقضايا الاختلاف تكون المحكمة العليا في أميركا رافعتها وحاملتها. ودائماً ستتغذّى الوجهة هذه على رفض مبدأ «حقوق الإنسان»، بل على رفض وجود «الإنسان» نفسه بوصفه قيمة كونيّة عابرة للانتماءات والهويّات الجزئيّة.
وما من شكّ في أنّ جوّاً لاعقلانيّاً سينتعش حاولت اللغة أن تواكبه بتعبير «ما بعد الحقيقة» المستجدّ. بيد أنّ وسائط التواصل الاجتماعيّ، التي اضطلعت بدور سلبيّ كثر تناوله مؤخّراً، قابلة أيضاً أن تضطلع بدور رقابيّ وفاضح لم يكن متاحاً من قبل.
لكنْ من دون أن يقع المرء في التقليل من الأخطار والمصاعب التي تداهم عالمنا، تبعاً للصعود الشعبويّ هذا، يُرجّح أن لا ترتسم الثورات والحروب أفقاً للتغيير، بل أن يأتي الأمر، إذا أتى، نتيجة لمقاومات ديموقراطيّة ومدنيّة لا يملك أصحابها إلاّ أن يقاوموا.
الحياة
هل يحوّل ترامب العالمَ نحو اتجاه آخر؟/ سيّار الجميل
دونالد جون ترامب رجل أعمال أميركي، دخل المعترك السياسي أخيراً، ليغدو فجأة رئيساً منتخباً للولايات المتحدة الأميركية عن الجمهوريين بعد معركةٍ انتخابية مثيرة للجدل ضد هيلاري كلينتون عن الديمقراطيين، إذ كان ترامب يتقلد عدة إداراتٍ لشركات قابضة ومشروعات ومصالح تجارية. ويتبادل أتباعه نيته لإخلاء نفسه لمنصب الرئاسة. وكان ناجحاً في بناء امبراطويته المالية التي نشر اسمه عليها في كلّ العالم. ما يهمنّا قوة تحوّلاته التي يخطّط لها بينه وبين نفسه، ويحاول تحقيقها بأيّ ثمن. ولم يكن غامضاً، بل صريحاً لا يخشى من الآخرين، ويعتزّ بنفسه كثيراً، ويفتخر باسمه، وقد تزوج ثلاث مرات، مكرّساً حياته للأفكار التي يؤمن بها، وقد بلغ السبعين عاماً.
لم تمرّ أيّة انتخابات أميركية سابقة بمثل هذا الماراثون العاصف الذي كان بطله ترامب بلا منازع، وقد صدم العالم كله بفوزه، وسجّل الصندوق الانتخابي كلمته الفاصلة، لكي يعد فوزه المثير علامة فارقة في التاريخ الأميركي. ولكي نشهد تاريخاً جديداً، يعبّر حقيقةً عن كلّ ما يجري في العالم من تفاقم للتناقضات وضياع للقيم وانهيار في أساليب الحياة والتفكير، مقارنة بما كان سائداً في القرن العشرين.
النظام الليبرالي الغربي برمته في خطر، بعد أن نضج منذ مائة سنة، إثر الحرب العالمية الأولى. ولم تهزّه الحرب الباردة مع المنظومة الاشتراكية، ولكنه بدأ يهتز من دواخله، منذ أعلن هانتينغتون عن صدمة الحضارات قبل 25 عاماً، لكي تعلن قوى جديدة غاضبة ومحتدمة على نتاج الغرب من قيم ليبرالية وانفتاح، لتقول بالتغيير نحو اتجاهات أخرى، كما ندرك ذلك من تعابير قالها ترامب، ليس كما يفسرها بعضهم إنها مجرد دعايات انتخابية، بل إنها تعلن عمّا يدور في أعماق تفكيره المخالف لكل الراهن، وهو يتمتع بصراحة، ومن دون وجل. وعليه، أخالف كلّ الذين خرجوا علينا، وقالوا إنّ الرجل لا خبرة سياسية له، ولم يحسن قوله، إذ وجدته، منذ صعوده على المسرح السياسي منافساً، يتمتع بقوة الذئب، ليس في المخاتلة، بل في الوثوب، وليس في الانصياع بل في الهجوم، وليس في التباكي، بل في الوقاحة، وليس في الجهالة، بل في السفاهة الذكية .. ناهيكم عن تجربته في إدارة المال والأعمال، فكيف سيتمكن من صنع القرار المناسب؟
يأتي ترامب اليوم معبّراً عن إرادة جيل مهني جديد، فاقد للعمالة، يختلف تفكيره عمّا ساد سابقاً من أجيال القرن العشرين، ولكن الخطأ ليس فيه أو في السياسات الأميركية العقيمة التي ارتكبت أخطاء غبية، صنعها رؤساء سابقون، بحيث نشروا ظواهر مميتة صادمة للحياة، بصناعتهم
“على زعمائنا في المنطقة أن يكونوا أذكياء جداً في تعاملهم مع التنين القادم” المستبدين والفوضى والإرهاب والحروب، وأحدثوا في العالم قوميّاتٍ، لها نرجسيتها، وأماتوا حريّة الشعوب، وباركوا الحركات الدينية والطائفية العنيفة، وأشعلوا صراعات الأعراق والمذاهب، وفتحوا أبوابهم لجحيم المهاجرين الذين يلوذون بالفرار نحوهم، ساحبين معهم كلّ أوبئتهم وثقافاتهم الرثة وأساليبهم غير الشرعية، ليأتي ترامب اليوم في لحظةٍ تاريخيةٍ حاسمةٍ رافضاً ما حدث رفضاً قاطعاً، فيشكل ظاهرة جديدة برزت فجأة لتخيف دولاً وزعماء وقوميات ومنظمات، عندما قال مردّداً “سأعيد لأميركا مكانتها”، فكان ذكياً في سحب البساط من تحت أرجل ليس الديمقراطيين وحسب، بل في سحب من كان يقف فوق ذلك البساط المهترئ، ويتركه بعيدًا، وأغلبهم من فئات العمال والقوى الفاعلة التي عانت من تراجع المشروعات الصناعية الكبرى، جرّاء سياسات الديمقراطيين البلهاء. ربما يختلف المرء معه أو يقف ضده بسبب رعونته أو مجابهته، لكنه، في الحقيقة، جواب تاريخي للسياسات البليدة التي مارستها أميركا منذ سقوط المنظومة الاشتراكية، وهو أيضاً ظاهرة عبرت عن نتائج أفرزها احتدام أجيال جديدة خابت آمالها، وهي تتطلع إلى استعادة قوة أميركا ثانية في العالم. ومع غيبوبة النخب والفئات المخملية في المدن، تتبلور القوى الشعبوية في الطبقات الوسطى والعاملة في أصقاع متنوعة، تطالب بزعامات مشاكسة، تنادي بثورات التحدّي ضدّ كلّ الاهتراءات في العالم، مع شعور الأميركان بغيبوبة زعاماتهم القوية إزاء غيرها في العالم، مثل بوتين روسيا، وأردوغان تركيا، وأوربان هنغاريا، وترودو كندا. ويبرز فجأةً ترامب أميركا، عندما اختفت فرص العمل والوظائف واعتمدت الشركات على عمالات أخرى، بسبب تقليل الإنفاقات وضعف الإنتاج الأميركي في السوق العالمي، كالذي أحدثته العولمة التي جنت منها الشركات والمؤسسات التجارية الأميركية وحلفاؤها أرباحاً غير متخيلة، ومنها مؤسسة ترامب نفسه الذي خبر الألعوبة، فزجّ نفسه ليكون جمهورياً، فنزل إلى الحلبة بأمواله، ليعبّر عن هشاشة الديمقراطيين الذين بقوا لسنوات طوال، وهم يشهدون مأساة الإرهاب في العالم وحروب الأهالي وقصف المدن الآهلة وهشاشة صنع القرار وميوعة حسم تداعيات السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.
لم يكن للديمقراطيين، كعادتهم، إلا التنظير في الهوية والبيئة والتباكي على المثليين، ومكوكية وزير الخارجية الفارغة، والكذب في إطلاق الوعود من دون تنفيذها. ومن الفجيعة أن يذوي كلّ اليسار إثر اختفاء المنظومة الاشتراكية، وانساقت القوى الثورية القديمة في ركاب الديمقراطيين والوسطيين والليبراليين، ووصل الأمر إلى أن يكونوا من الليبراليين الجدد. فما المتوقع من ترامب؟
ثمّة مفاجآت قوّية وصاعقة، في مقبل الأيام، كجزء من ثورة التحدّي وطور الاحتدام،
“لم يكن للديمقراطيين، كعادتهم، إلا التنظير في الهوية والبيئة والتباكي على المثليين” وخصوصاً مع أوروبا، ومع الشرق الأوسط ، وستجري تحولات قوية بتحجيم دور إيران في المنطقة، وستجري متغيرات قوية في السياسات الاقتصادية، وستهتز منظومة الأمن في العالم، وسيجري كلّ شيء بأثمان، ربما تكون باهظة، ناهيكم عن إعادة التفاوض في الاتفاقيات التجارية الحالية، وكيفية التعامل مع كندا التي يحكمها الليبراليون، وربما الخروج عن الاتفاقيات السابقة إن لم ينصع الآخر لمطالب ترامب. المتوقع أن يقوم بتحجيم أدوار المتحالفين مع الولايات المتحدة، إذ سيحول حلبة السياسة إلى سوق بضاعة يديرها بنفسه. وهنا سيلعب ترامب بالنار إذا ما غامر بذلك، إذ سيمرّ اقتصاد العالم بمخاطر كبرى. وإذا كان ترامب يفكر بأن لكل شيء ثمنه، فربما سيخضع الميديا والاتصالات وثورة المعلومات وشبكات التواصل لسيطرته الأميركية، وربما فرض قيوداً عليها، أو طالب ببيعها بأعلى الأثمان. كما أن سياسات أميركا الخارجية ستختلف كلياً عما كانت عليه، ولا ندري من سيكون مسؤولاً عن هذا الميدان الحيوي، ومن هم الصقور الذين سيعتمد عليهم ترامب، في ترتيب العلاقات الخارجية بالنسبة لروسيا والصين وأوروبا، وبالنسبة لمشكلات الشرق الأوسط الصعبة القديمة والجديدة.
لم تعد أميركا كما كانت عليه في بدايات القرن العشرين، تحمل مبادئ ولسن في الحريات وتقرير المصير، ولم تعد الشفافية تنفع، ولا القوة الناعمة، بل سنسمع سياسة الإهانة واستعراض القوة الخشنة. وعليه، هل باستطاعة ترامب مسك العصا الغليظة التي يتوعّد بها هذا وذاك؟ هل سيمتلك طاقماً من الخبراء الذين يمكنهم ترجمة أفكاره في الواقع؟ هل سينجح في استعادة أميركا دورها القوي، لا المستعرض؟ هل ستكون سياسته متوحشةً وصريحة، أم تكون ناعمة وخبيثة؟ هل سيترجم أفكاره الصاخبة بصدد المهاجرين؟ هل سينجح في إيجاد فرص العمل للأميركيين؟ ما سياسته إزاء جيرانه الكنديين على عهد الليبراليين؟ ما سياساته إزاء أوروبا التي يريد أن تحمي نفسها بنفسها؟ هل ستبقى سياسات أميركا السابقة التي اتبعت في الشرق الأوسط؟ هل سيبقى صناعة الفوضى والميوعة البليدة والتمويه على الإرهاب والتمتع بما يجري من تفكيك وانقسامات؟ هل سيلغي الاتفاق النووي مع إيران؟ هل سيتبع سياسات مغايرة في العراق وسورية؟ ما سياسته إزاء إسرائيل والفلسطينيين؟ وهل يستطيع البقاء في الحكم إن نجح في تغيير اتجاه العالم؟ وهل يستطيع أن يبقي على حياته، وهو في السلطة، إن بدأ تطبيق أفكاره نحو الاتجاه الآخر. إلى غير هذه الأسئلة التي لا يجد أغلب الناس أجوبة عليها إلا بعد حين. وأخيراً، أقول إن على زعمائنا في المنطقة أن يكونوا أذكياء جداً في تعاملهم مع التنين القادم.
العربي الجديد
النزاع السوري: الاختبار الأول بين ترامب وبوتين/ د. خطار أبودياب
تفرض روسيا إيقاعها على الساحة السورية التي تعتبر أكثر ساحة خارجية تأثرا بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية. بعد أقل من أسبوع على انتخاب دونالد ترامب، تطلق موسكو العنان لتصعيد عسكري وكأن فلاديمير بوتين يسابق الزمن قبل بدء عمل الإدارة الأميركية الجديدة. الانتظار أو المهادنة لا يندرجان في قاموس الواقعية السياسية عند “القيصر الجديد” الذي لا يعول على رسائل طمأنة وصلته من “الدونالد” صديقه المفترض، ويريد التفاوض معه حسب شروطه وأجندته. مقابل التصميم الروسي على الإمساك بالورقة السورية وعلى انتزاع موقع قوي في الإقليم، ترتكز أولوية دونالد ترامب على مقارعة تنظيم داعش والظاهرة الجهادية. لكن الاندفاعة الروسية نحو ما يشبه الحسم في الوقت المستقطع قبل 20 يناير المقبل، يمكن أن تدفع بسيد البيت الأبيض الجديد إلى صوغ رؤية مغايرة للعلاقة مع موسكو، ومن الواضح أن النزاع السوري سيكون الاختبار الأول الذي يضع علاقة بوتين وترامب على المحك.
بعد 9 أسابيع يتسلم الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة مهامه، وسيكون الشرق الأوسط بمثابة الضيف الثقيل الذي يحل عليه في بداية ولايته. إبان الاجتماع مع باراك أوباما، كان لملفي العراق وسوريا حصة كبيرة من التداول، وبما أنه توجد قوات أميركية هناك، سيهتم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية بتطورات هذه المنطقة، بالرغم من اختزالها سابقا في سياق الحرب ضد الإرهاب، وليس كأحد أبرز مسارح السياسة الخارجية الأميركية منذ عقود.
هكذا سيكون الشرق الأوسط بمثابة المعمودية الدبلوماسية لملياردير مانهاتن الذي يتبع خط مدرسة انعزالية تاريخية (أميركا أولا)، ولكنه يريد في نفس الوقت إعادة قوة أميركا مما يلزمه السعي لوقف التراجع الأميركي حول العالم. أما التناقض الإقليمي في سياسة ترامب فيتمثل في كيفية التوفيق بين التنسيق المباشر أو غير المباشر مع إيران وحلفها في سوريا من جهة، والعمل على التنبه للاتفاق النووي ولمدى دورها الإقليمي من جهة أخرى. لا يمكن اختصار الوضع في سوريا على هزيمة داعش وعدم اعتماد مقاربة شاملة للحل السياسي ومستقبل منظومة الأسد والتوازنات الإقليمية.
احتمال بلورة ترامب لحلف مع روسيا في سوريا سيمثل انقلابا في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، لأن ذلك لن يعني استمرارية مقنعة لسياسة إدارة أوباما فحسب، بل تسليما بوقائع جديدة وإعادة رسم تحالفات. لكن ترامب لا يملك الحرية المطلقة في تحديد خياراته ويمكن أن تقيده لعبة المؤسسات، إذ أن مجلس النواب الأميركي فاجأنا وأقر هذا الأسبوع وبالأغلبية المطلقة، قانون “حماية المدنيين”، المعروف اختصارا بـ“سيزر” (الاسم الكامل هو “قانون قيصر للحماية المدنية بسوريا”، نسبة للمصور العسكري السوري السابق، الذي قام بالتقاط 55 ألف صورة لضحايا مدنيين قضوا تحت التعذيب على يد القوات الحكومية قبل أن يهرّبها خارج سوريا، والمعروف باسم “قيصر”، وأدلى بشهادته أمام لجنة مجلس النواب الأميركي للشؤون الخارجية عام 2014) حول تعذيب نظام الأسد للمدنيين السوريين، والذي ينص على معاقبة كل من يدعم النظام السوري، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله وبعض الجماعات المسلحة.
ويعد هذا القرار لغزا جديدا بشأن التوقيت، لأن إدارة أوباما عملت سابقا على عدم إقراره لمراعاة روسيا وتمرير اتفاق جون كيري – سيرجي لافروف (9 سبتمبر الماضي) ولأن أغلبية الكونغرس تنبثق من الجمهوريين الداعمين للرئيس الجديد دونالد ترامب الذي لم يصوب يوما على نظام الأسد، ولم نسمع له آراء عن الترويج لقيم حقوق الإنسان من قبل زعيمة “العالم الحر”.
ربما يزيد هذا القرار من التوتر مع روسيا في حال مروره في مجلس الشيوخ وعدم فرض أوباما الفيتو عليه، لكنه يمثل نوعا من الرسالة المشفرة للرئيس الجديد حول ضرورة احترام بعض الثوابت في سياسة أميركا في الشرق الأوسط، إزاء تطور الوضع الميداني والسعي المحموم للحسم في شمال سوريا، لا يمكن لإدارة ترامب الاعتصام بالصمت أو تجاهل محرقة حلب وكأنها لا تحصل، ولذا من المحتمل ألاّ يذهب بوتين بعيدا في اجتياح شرق حلب وجعل مصير المدينة السورية موضع تفاوض.
في هذه الحالة، لا يستبعد أن تستمر سياسة إدارة أوباما (مع بعض التعديلات) خلال العام الأول من إدارة ترامب. من خلال بعض إطلالات الرئيس الجديد الإعلامية ومداخلات بعض المقربين منه من أمثال المرشح المحتمل لمنصب مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل تي فلاين (الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية بين 2012 و2014، وكان قد اعتبر أن عدم التدخل الأميركي في سوريا أواخر 2013 بعد استخدام الكيميائي قد قوض مصداقية واشنطن) يمكن أن يتم التسليم لروسيا بإدارة منطقة نفوذها، مقابل اهتمام واشنطن بترتيب أوضاع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة. وهذا يعني استمرار حالة التفكك مع إمكانية إنشاء منطقة آمنة على الحدود مع تركيا، لكن ذلك ينطوي على تساؤلات حول ردود فعل القوى الإقليمية المنخرطة في الحرب السورية.
نتيجة تداخل معركتيْ الموصل والرقة، وتهديد الحشد الشعبي العراقي بالدخول إلى سوريا، ستجد واشنطن نفسها في موقع حرج للتوفيق بين تناقضات تحالفاتها مع الحكومتين التركية والعراقية وجماعات الأكراد وغيرها من الجماعات في سوريا، وسيعقّد ذلك الحوار أو التجاذب مع موسكو التي أعطت الأولوية في عام تدخلها الأول لدعم النظام وليس لضرب داعش، وتحاول الآن عبر إنزالها البحري تبيان إسهامها في ضرب الإرهاب قبل بدء عهد ترامب.
من الواضح أنه من دون بلورة مقاربة إقليمية شاملة، ومن دون نجاح اختبار القوة مع روسيا (مع ما يعنيه من إنهاء أو تخفيف للتوتر في ملفات أخرى) لا يمكن لواشنطن ترامب أن تكون أكثر فعالية من إدارة أوباما في حل النزاع السوري.
أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك – باريس
العرب
ترامب: انتهازي أم إيديولوجي؟/ حازم صاغية
ما إن أُعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حتى انفرزت الآراء التي كانت متحفظة على ترامب أو معارضة له إلى ثلاثة:
– رأي يمكن وصفه بالانتهازي، كان من أبرز وجوهه رايان بول، رئيس مجلس النواب والشخصية البارزة في الحزب الجمهوري. فالانتهازيون سارعوا بين عشية وضحاها إلى اكتشاف فضائل دونالد ترامب التي كانت خافية عنهم، وتبدّت لهم قدرته الفائقة، بل الخارقة، على القيادة وعلى توحيد الأميركيين ممن عصفت بهم انقساماتهم.
– ورأي يمكن وصفه بالراديكالي، عبرت عنه قلة من أصحاب الأسماء البارزة، بمن فيهم بعض الذين أعلنوا مؤخراً عن رغبتهم في الهجرة إلى كندا كي لا يعيشوا في ظل ترامب! ولكن هذا الرأي تجسد خصوصاً في التظاهرات الشبابية التي شهدتها مدن أميركية كثيرة، وتحول بعضها إلى مناسبات عنفية. وهؤلاء بدورهم انقسموا بين من يعلن عدم الاستعداد لقبول رئاسة ترامب، وأولئك الذين يوجهون تحذيراً استباقياً ضد سياسات تفرّدية أو انعزالية قد يسلكها المقيم الجديد في البيت الأبيض.
– أمّا الرأي الثالث فاتجه إلى توكيد البعد الانتهازي في شخص ترامب والتخفيف من البعد الإيديولوجي. وتنهض الحجة هنا على ما يلي: لقد اكتشف ترامب وجود قطاعات شعبية واسعة تناهض المؤسسة والنخبة فركب موجتها، كما اكتشف أن ثمة تقليداً سياسياً سابقاً عليه، في معارضة هاتين المؤسسة والنخبة، فاعتنق هذا التقليد الجاهز. وفي هذا المعنى فإنه ما إن يطّلع على تعقيدات صناعة القرار، وعلى أن وعوده الضخمة والخارقة غير قابلة للتحقق، حتى ينكفئ إلى مواقع المحافظين المألوفين في التاريخ السياسي الأميركي.
وأصحاب هذا الرأي الأخير إذ يقولون ما يقولونه، فإنهم يبدون حرصهم على الحياة الديمقراطية وسلاسة اشتغالها، على ما فعل أوباما في واشنطن ثمّ في أوروبا، بقدر ما يحاولون عدم استفزاز ترامب، بحيث لا ينتقل، فعلاً وليس لفظاً فحسب، إلى المواقع الأشد تطرفاً وخطورة. وفي هذا السياق بدا لافتاً أن يعلن بيرني ساندرز، المرشح «الاشتراكي» عن الحزب الديمقراطي الذي هزمته هيلاري كلينتون، استعداده للتعاون مع ترامب شريطة ألا يتبع سياسات شوفينية ومعادية للنساء.
على أية حال، يبقى السؤال الأشد إلحاحاً اليوم هو هذا بالضبط: هل ترامب مجرد انتهازي أم أنه إيديولوجي متعصب لأفكار متطرفة؟ أغلب الظن، وتبعاً لما بات معروفاً عنه، أنه شيء من هذا وشيء من ذاك. وما هو واضح، حتى إشعار آخر، أن الوجوه التي ستتصدر إدارته تضم انتهازيين عاديين مثل كريس كريستي، كما تضم بعض سياسيي الحزب الجمهوري المعروفين بهوى إيديولوجي بالغ اليمينية، كنيوت غينغريتش ورودي جولياني وجون بولتون وسارة بالين والجنرال المتقاعد مايكل فلين.
فهل يعمل ترامب في ظل هؤلاء على تنفيذ وعوده الخارقة، وكان آخرها إعلانه عن طرد وسجن ثلاثة ملايين شخص، أم أن الواقعية ستدفع به، وبهم، إلى تدوير بعض الزوايا الحادة؟
قد يكون من المبكر تقديم جواب شافٍ، إلا أن حذف الدعوة إلى منع المسلمين من دخول أميركا من موقع ترامب ثمّ إعادتها يوحيان بارتباك، والشيء نفسه يوحي به الإعلان أنّ ترامب سيتمسّك ببعض فقرات برنامج أوباما للرعاية الصحية، فضلاً عما لحظه غينغريتش من أن بناء الجدار مع المكسيك أقرب إلى خطّة انتخابيّة، أو ابتلاع المطالبة بتسليح اليابان وكوريا الجنوبية ذرياً لمواجهة الخطر الكوري الشمالي. وغني عن القول إن الانتهازية الممزوجة بحس الواقع هي دائماً أقل سوءاً من النزعة الإيديولوجية المحلقة في الخيال، والتي تقود إلى خطوات تدميرية تتعدى الولايات المتحدة إلى العالم كله! لكنّ كلّ شيء، بما في ذلك التعيينات التي أعلن عنها مؤخّراً، يلحّ على ضرورة المضيّ في ممارسة الضغط الشعبيّ والديمقراطيّ على ترامب وإدارته الجديدة.
* محلل سياسي- لندن
الاتحاد
دونالد ترمب وتحديات السياسة الخارجية/ جوزيف س. ناي الابن
خلال حملته الانتخابية شكك رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترمب في التحالفات والمؤسسات التي تشكل الأساس الذي قام عليه النظام العالمي الليبرالي، ولكنه لم يعرض بالتفصيل سوى القليل من السياسات المحددة. ولعل السؤال الأكثر أهمية الذي أثاره فوز ترمب هو ما إذا كانت المرحلة الطويلة من العولمة التي بدأت في نهاية الحرب العالمية الثانية انتهت فعليا.
ليس بالضرورة؛ فحتى لو فشلت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي واتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، وتباطأت العولمة الاقتصادية، تعمل التكنولوجيا على تعزيز العولمة البيئية والسياسية والاجتماعية في أشكال مثل تغير المناخ، والإرهاب العابر للحدود الوطنية، والهجرة، سواء شاء ترمب أم أبى. فالنظام العالمي ليس الاقتصاد فحسب، وتظل الولايات المتحدة تحتل مركز القلب من هذا النظام.
كثيرا ما يسيء الأميركيون فهم مكانهم في العالم، فنحن نتأرجح بين تصورات التفوق والانحدار. بعد إطلاق الاتحاد السوفياتي للقمر الصناعي سبوتنيك في عام 1957، كنا نعتقد أننا في انحدار. وفي ثمانينيات القرن العشرين، كنا نظن أن اليابانيين عمالقة. وفي أعقاب الركود الأعظم في عام 2008، اعتقد كثيرون من الأميركيين مخطئين أن الصين أصبحت أكثر قوة من الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من اللغة التي استخدمها ترمب في حملته، فإن الولايات المتحدة ليست في انحدار؛ فبفضل الهجرة، تُعد الدولة المتقدمة الكبيرة الوحيدة التي لن تعاني من انحدار ديموغرافي (سكاني) بحلول منتصف القرن؛ ولا يتزايد اعتمادها على الواردات من الطاقة بل يتجه نحو الانحسار؛ وهي في طليعة التكنولوجيات الرئيسية (التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، والمعلومات) التي ستشكل هيئة هذا القرن؛ كما تهيمن جامعاتها على جداول التصنيف العالمية.
سوف تزاحم قضايا مهمة عديدة أجندة ترمب في السياسة الخارجية ولكن القليل من القضايا الرئيسية من المرجح أن تهيمن على الساحة، على وجه التحديد علاقات القوة مع الصين وروسيا والاضطرابات في الشرق الأوسط. وتظل المؤسسة العسكرية الأميركية القوية ضرورية ولكنها ليست كافية لمعالجة القضايا الثلاث. لا شك أن الحفاظ على التوازن العسكري في أوروبا وشرق آسيا من المصادر المهمة للنفوذ الأميركي، ولكن ترمب محق عندما يقول إن محاولة السيطرة على السياسة الداخلية للشعوب القومية في الشرق الأوسط وصفة أكيدة للفشل.
تشهد منطقة الشرق الأوسط مجموعة مقعدة من الثورات النابعة من الحدود المصطنعة التي رسمها الاستعمار، والصراع الطائفي الديني، والحداثة المتأخرة كما وصفتها تقارير التنمية البشرية العربية الصادرة عن الأمم المتحدة. وقد تدوم الاضطرابات الناتجة لعقود من الزمن، وسوف تستمر في تغذية الإرهاب الجهادي المتطرف. فقد ظلت حالة عدم الاستقرار في أوروبا قائمة طوال خمسة وعشرين عاما بعد الثورة الفرنسية، وكانت التدخلات العسكرية من قبل قوى خارجية سببا في تفاقم الأمور سوءا.
” ولكن حتى مع تراجع الواردات من الطاقة من الشرق الأوسط، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تدير ظهرها للمنطقة، نظرا لمصالحها في إسرائيل، وعدم الانتشار النووي، وحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى. والحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا ليست مجرد كارثة إنسانية؛ فهي تعمل أيضا على زعزعة استقرار المنطقة وأوروبا أيضا. ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تتجاهل مثل هذه الأحداث، ولكن ينبغي لسياستها أن تركز على الاحتواء، والتأثير على النتائج من خلال دفع وتعزيز الحلفاء، بدلا من محاولة فرض السيطرة العسكرية المباشرة التي ستكون باهظة التكلفة وهدّامة.
وفي المقابل، يجعل ميزان القوى الإقليمية في آسيا تواجد الولايات المتحدة موضع ترحيب هناك. فقد أثار صعود الصين المخاوف في الهند، واليابان، وفيتنام، ودول أخرى. ومن الواضح أن إدارة صعود الصين عالميا من تحديات السياسة الخارجية الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة هذا القرن، وتظل الإستراتيجية الأميركية الثنائية الحزبية والمزدوجة المسار القائمة على “التكامل ولكن مع تأمين الذات”- والتي بموجبها وجهت الولايات المتحدة الدعوة إلى الصين للانضمام إلى النظام العالمي الليبرالي، في حين أكَّدَت على معاهدتها الأمنية مع اليابان ــ هي النهج الصحيح.
على النقيض من الحال قبل قرن من الزمن، عندما تسببت ألمانيا الصاعدة (التي تفوقت على بريطانيا بحلول عام 1900) في تغذية المخاوف التي ساعدت في التعجيل بكارثة 1914، فإن الصين لا تقترب حتى من التفوق على الولايات المتحدة في القوة الشاملة. وحتى إذا تفوق اقتصادها على الاقتصاد الأميركي في الحجم الإجمالي بحلول عام 2030 أو 2040، فإن نصيب الفرد في الدخل هناك (المقياس الأفضل للتقدم الاقتصادي) سوف يتأخر. وعلاوة على ذلك، لن تتعادل الصين مع القوة العسكرية الأميركية الصارمة أو قوتها الناعمة الجاذبة. وكما قال مؤسِّس سنغافورة الراحل لي كوان يو ذات مرة، ما دامت الولايات المتحدة منفتحة وجاذبة للمواهب من العالم، فسوف تعطيكم الصين “منافسة قوية”، ولكنها لن تحل محل الولايات المتحدة.
لهذه الأسباب، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة احتواء للصين، فالدولة الوحيدة القادرة على احتواء الصين هي الصين. فعندما تدفع الصين صراعاتها الإقليمية مع جيرانها، تحتوي ذاتها. ولابد أن تبادر الولايات المتحدة إلى إطلاق مبادرات اقتصادية في جنوب شرق آسيا، والتأكيد على تحالفها مع اليابان وكوريا، والاستمرار في تحسين العلاقات مع الهند.
” وأخيرا، هناك روسيا الدولة التي تشهد انحدارا، ولكنها تمتلك ترسانة نووية كافية لتدمير الولايات المتحدة، وبالتالي تظل تشكل تهديدا محتملا لأميركا وغيرها. وتدير روسيا، التي تعتمد بشكل كامل تقريبا على العائدات من موارد الطاقة، “اقتصاد المحصول الواحد” في ظل الفساد المؤسسي ومشاكل ديموغرافية وصحية يتعذر التغلب عليها.
والواقع أن تدخلات الرئيس فلاديمير بوتين في الدول المجاورة والشرق الأوسط، وهجماته السيبرانية على الولايات المتحدة وغيرها، برغم أن الهدف منها جعل روسيا تبدو عظيمة مرة أخرى، لن تُفضي إلا إلى زيادة آفاق البلاد في الأمد البعيد سوءا. ولكن في الأجل القصير، تخوض الدول المنحدرة غالبا المجازفات فتصبح بالتالي أشد خطورة، ولنتذكر هنا حال الإمبراطورية النمساوية المجرية في عام 1914.
وقد خلق هذا مأزقا سياسا؛ فمن ناحية، من المهم أن نقاوم تحدي بوتين الذي قد يغير قواعد اللعبة فيما يتصل بحظر النظام الليبرالي بعد عام 1945 لاستخدام الدول للقوة للاستيلاء على أراضي الجيران.
ومن ناحية أخرى، كان ترمب مصيبا عندما تحدث عن ضرورة تجنب العزل الكامل لدولة تربطها بنا مصالح متداخلة عندما يتعلق الأمر بالأمن النووي، ومنع الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، والقطب الشمالي، والقضايا الإقليمية مثل إيران وأفغانستان. وتمثل العقوبات المالية والعقوبات في مجال الطاقة ضرورة أساسية للردع؛ ولكننا لدينا أيضا مصالح حقيقية لن تتحقق على النحو الأفضل إلا من خلال التعامل مع روسيا. فلن يكسب أحد من حرب باردة جديدة.
إن الولايات المتحدة ليست في انحدار. وتتلخص مهمة ترمب المباشرة في السياسة الخارجية في ضبط خطابه وطمأنة الحلفاء وغيرهم إلى استمرار أميركا في الاضطلاع بدورها في النظام العالمي الليبرالي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
ثلاثة أرقام لانتخاب واحد/ سامر فرنجيّة
ثلاثة أرقام تلخّص نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدّة. الرقم الأول والأسهل هو إجمالي عدد الأصوات التي حصدها كل من المرشحين. فعلى رغم مفاجأة انتصاره، لم يقنع الرئيس المنتخب أكثرية المقترعين، بل حصد عدد أصوات تقل بعض الشيء عن المرشحين الجمهوريين السابقين. بيد أنّ استقرار نسبة الناخبين في الجانب الجمهوري واجهه انهيار عند الديموقراطيين الذين خسروا ما يوازي الخمسة ملايين صوت، مقارنة بالنتائج التي حقّقها الرئيس أوباما في الدورتين الأخيرتين.
الخلاصة سهلة، فـ «المركز» لم يعد يقنع وقد دخل طور «أزمة الشرعية». تجاهل الحزب الديموقراطي هذه الأزمة وكابر عليها، وبنى حملة مرشحته على سلبيات انفجرت في وجهها: سلبية تجاه المنافس الديموقراطي، وسلبية في مواجهة الخصم الجمهوري، وسلبية انتخابية قامت على اعتبار التحوّلات الديموغرافية كفيلة للنجاح في السباق الرئاسي. فشلت هذه التطمينات، وبقيت الحقيقة أنّ المركز لن ينجو بشكله الحالي من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسبب بها أو التي لم يستطع حلها.
إذا كانت خلاصة الرقم الأول سهلة، فالرقم الثاني أكثر تعقيداً. فقد حصد ترامب أكثرية أصوات الناخبين البيض، وبالأخصّ الرجال منهم، وهذا على رغم خطابه العنصري، أو، وما هو أخطر، بسبب خطابه العنصري هذا. وكالعادة مع نتائج كهذه، يتصارع تفسيران لضبطها، الأول منهما ينطلق من دوافع الفعل والثاني من خطابه. فتفسرّ المقولة الأولى النتائج كانعكاس لآثار السياسيات النيو-ليبرالية، والتي «دفعت» بقايا الطبقة العاملة البيضاء إلى حضن اليمين المتطرف. أما التفسير الثاني، فيبدأ من هذا الحضن، ليعتبره ردّ فعل على ثماني سنوات من حكم رئيس أسود، قد تليه أربع سنوات من حكم امرأة.
ومع هذه المواجهة، نعود إلى دوامة الاقتصاد في وجه الثقافة، والتي باتت تواكب أي حدث، من ظهور «داعش» إلى عملية إرهابية في الغرب وصولاً إلى انتخاب ترامب.
على تقاطع هذه التفسيرين، برزت ظاهرة «الرجل الأبيض الضحية»، وهي الضحية الاقتصادية الفاقدة لخطاب يحميها بسبب عرقها «المنتصر»، أي الأكثرية الصامتة. وليست هناك بالضرورة أسس انتخابية لهذه الظاهرة، فالفقراء البيض صوتوا بأكثريتهم للمرشحة الديموقراطية. لكنّها قدّمت الغطاء الثقافي لخطاب ترامب وداعميه من «اليمين البديل». فشبكات اليمين المتطرف التي واكبت صعود الرئيس الجديد تختلف عن اليمين التقليدي الجمهوري أو المسيحيين الجدد. فهذا «اليمين البديل»، والذي بات اليوم في البيت الأبيض، يقطع مع تركيز خلفه التقليدي على مسألتي الاقتصاد والسياسة الخارجية. في وجه حرية السوق، يقدّم ترامب ومناصروه تلفيقة تجمع بين داروينية اقتصادية مطلقة وتحذير من مفاعيل المنافسة والسوق على المجتمعات الأهلية. أما في ما يخض السياسة الخارجية، فيقطع هذا اليمين مع السياسات التوسعية باسم انعزالية عنصرية، لا ترى دوراً للولايات المتحدة غير الدفاع عن مصالحها.
بيد أنّ الجديد في هذا اليمين هو انقطاعه عن الهموم الثقافية التقليدية لليمين المحافظ. فـ «عصب» خطاب ترامب ليس في تجديد محافظة تقليدية، بل في الدفاع عن «حق» الرجل الأبيض في التعبير عن رغباته والدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاحتفاء بما يعتبره طريقة عيشه، والدفاع عن الذين، وفق مناصري ترامب، يتعرضون للقمع باسم التعددية والاندماج. فانتخابه هو لحظة تحوّل «الرجل الأبيض» من المعيار الخفي للمجتمع، الذي هيمن من خلال تجريد نفسه من أي ميزة عرقية، إلى مجموعة كسائر المجموعات تتنافس على موقعها في المجتمع الأميركي الذي هو قيد تحوّل.
انتصار أوباما، بهذا المعنى، شكّل اختباراً لفرضية التجريد هذه، أمّا انتصار ترامب، فهو استبدال للهيمنة المجرّدة للرجل الأبيض بسيطرة مجموعة «الرجل الأبيض الضحية» على بقية الفئات العرقية والجنسية.
أما الرقم الأخير، فقد يكون الأكثر تعقيداً، وهو النسبة المتدنية للتصويت، على رغم وجود مرشح استفزازي كترامب. فالسؤال هنا ليس عن كيفية تأقلم ناخبيه مع تصاريحه المتناقضة وعلاقته المتوترة مع الوقائع، بل عن قدرة من لم ينتخب أياً من المرشحين على تجاهل الفارق الشاسع بينهما والكارثة التي يشكّلها انتخاب ترامب. وتتعدى المسألة شخصية المرشحة الديموقراطية لتطاول حالة الكلبية (السينيكية) المعممة والواعية، والتي باتت المدخل لتطبيع حدث انتخاب ترامب أو لتفسير امتناع الملايين عن الانتخاب ضده.
تعود حالة الكلبية المعممة إلى تطورات عدة، أفقدت ثقة الناخب بالتمثيل السياسي والإعلامي والثقافي لواقعه. من بينها، مثلاً، نقد الأحزاب السياسية التي تحوّلت إلى نوادٍ مغلقة لمحترفي السياسة وطموحاتهم الشخصية، أو نقد مقولة انتهاء السياسة بعد وفاة البديل الواقعي، أو تزايد الفضائح المالية للطبقة الحاكمة. فالنقد المصيب لهذه التطورات لم يترجم ببديل سياسي عن الواقع الفاسد، بل بتشكيك عام في عملية التمثيل السياسي.
وقد يكون التطور الأبرز في هذا الإطار انهيار الإعلام المؤسساتي، الذي بات يعاني أزمة صدقية، كما ظهر مع الانتخابات الأخيرة حيث لم ينجح الدعم شبه الكامل لأبرز وسائل الإعلام الأميركية في تأمين فوز المرشحة الديموقراطية. ونقد الإعلام، والذي هو محق، لم ينجح في ابتكار إعلام أفضل، بل ساهم في توسيع حالة الكلبية هذه.
ومَثَل «ويكيليكس» قد يكون معبراً هنا، حيث اتبعت استراتيجية تعميم الكلبية إلى حدودها القصوى، بالتزامن مع سيطرة الأجهزة الروسية عليها.
لقد حذرت هنه أرنت في أحد نصوصها من أخطار تحويل الحقيقة إلى مجرد آراء تتنافس في سوق الأفكار، وإن اعترفت بالعلاقة المتوترة بين الحقيقة والسياسة. وقد لا تكون ثمة عودة إلى مفهوم «الحقيقة» الذي ساد قبل النقد، والذي شكّل إحدى طرق الهيمنة في المجتمعات السياسية. ولكن لم يمكن في حالة الكلبية التي قضت على المناعة الأخلاقية والمعرفية، والتي تشكّل أحد خطوط الدفاع أمام احتمال استغلال الديموقراطية، خيار كهذا. ليس من خلاصة واضحة لآخر رقم عن هذه الانتخابات غير الالتفات لحالة النقد في مجتمعاتنا وإعادة تسييسها، هذا إذا كنا لا نريد أن نتحوّل إلى مجرّد بيئة حاضنة ليمين متطرف.
الحياة
الترامبيون العرب» وملامحهم العشرة/ وحيد عبدالمجيد
قوبل فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، بكثير من البهجة من سياسيين وإعلاميين وغيرهم في بعض البلدان العربية، بعدما تفاعلوا مع حملته الانتخابية التي أثارت فجاجتها حماستهم.
يختلف هؤلاء الذين يمكن أن نسميهم مجازاً «ترامبيين عرباً»، عن أنصار ترامب في الولايات المتحدة، على رغم وجود بعض أوجه التشابه. فالأميركيون المؤيدون لترامب غاضبون على نظام ديموقراطي أصابه الجمود، ونخبة سياسية انغلقت على نفسها، وفقدت التواصل معهم، فيما «الترامبيون العرب» يساندون نظماً غير ديموقراطية أشد جموداً وانغلاقاً بكثير، اعتقاداً بأن هذا هو السبيل إلى أمن بلدانهم واستقرارها.
لكن الترامبيين، أميركيين وعرباً، يمثّلون ظاهرة تُعبّر عن نوعين من الشعبوية، وليس عن تيار سياسي أو فكري. فالشعبوية بأنواعها كلها تفتقر إلى محتوى، وتعادي السياسة، وتستهين بالفكر حيناً وتزدريه أحياناً. وقد نجد فيها خليطاً عشوائياً وسطحياً من أفكار مختلفة، وربما متناقضة. لذلك، يصعب البحث عن أرضية سياسية مشتركة تربط أنصار ترامب العرب به. غير أنهم وجدوا في حملته الانتخابية شيئاً من الملامح التي تُميّزهم راهناً عن غيرهم في بلدهم.
أول هذه الملامح، الإتجار بشعارات وطنية أو قومية فارغة المحتوى، وادعاء القدرة على جعل بلدهم الأعظم أو الأفضل، على نحو ما ردَّد ترامب لأنصاره في كثير من مؤتمراته الانتخابية: «فلنجعل أميركا عظيمة مُجدَّداً».
وإذ يثير هؤلاء صخباً لا يهدأ عبر نفخ متواصل في نزعة وطنية خارج أي سياق موضوعي، فهم يُحقّرون بلدهم من حيث لا يقصدون، ويحطون من شأن شعوبهم ويُحمّلونها صراحة أو ضمناً مسؤولية انحدار يزعمون في خطابهم أنهم قادرون على تحويله صعوداً صاروخياً، فيما يأخذون هذه الشعوب إلى هاوية سحيقة.
ويبدو الملمح الثاني امتداداً للأول، وهو ترويج الكراهية والبغضاء، وصنع فزّاعات لتخويف الناس واللعب على أوتار الغرائز التي يُحرّكها خوفهم، لكي يُدخل في روعهم أن لا أمن ولا أمان إلا بالتخلي عن حريتهم وكرامتهم الإنسانية، ثم عن بعض حاجاتهم الأساسية أو الكثير منها، لأن النصر على «العدو» يفرض الاصطفاف وراء قيادة قوية حازمة تتخذ ما يُسمى «القرارات الصعبة».
ويرتبط هذان الملمحان أحياناً بثالث ذي شكل بونابرتي بدا في حملة ترامب الانتخابية عبر ترويج ما يعني أنه المُنقذ أو المُخلّص من الطبقة السياسية التقليدية Establishment التي تجمدت وانغلقت، ولم تدرك أن فتح الأبواب أمام الجديد ضروري لتجديد شرعية أي نظام سياسي، فيبحث قطاع كبير من الناخبين عن سبيل آخر الى هذا التجديد، لكن بالأدوات الانتخابية الديموقراطية. غير أن «الترامبيين العرب» يتجاهلون في احتفائهم بـ»المُخلّص» الأميركي، أنه صعد إلى السلطة بهذه الأدوات التي لا يؤمنون بها ولا يسمحون بوجودها إلا لإضفاء مشروعية شكلية على من يُعدّونهم «مُخلّصين» في بلدانهم.
أما الملمح الرابع، فالولع بالتفكير التآمري في أكثر صوره بساطة وسذاجة وابتعاداً من الواقع أو إنكاراً له، واللجوء الى تلفيق روايات للإساءة للمختلفين وتشويههم. وقد وجدوا ترامب «أستاذاً» في هذا، لأسباب ربما كان بينها شغفه بما يُسمى «تلفزيون الواقع» وعمله فيه لبعض الوقت.
ويقودنا ذلك إلى ملمح خامس هو التأثر ببرامج «تلفزيون الواقع» هذا، خصوصاً أكثرها ميلاً إلى الضحالة والشطط والعدوانية واللغة الفظة، واعتماداً على أداء استعراضي صادم، وخطابة فالتة صارخة تنضح بالتبسيط والتسطيح والتجهيل، وتُعبّر في المحصلة عن غثاء لغوي مضطرب بلا منطق أو معقولية.
وثمة ملمح سادس هو الذهاب إلى أبعد مدى في إرهاب المختلفين والخصوم، اعتماداً على قذائف من شتائم وبذاءات تُطلق من دون رادع أخلاقي، ما يدفع من لا يستطيعون الهبوط إلى هذا المستوى الى الانسحاب كما فعل مثلاً تيد كروز، أحد منافسي ترامب في السباق التمهيدي داخل الحزب الجمهوري، قائلاً أن «الحوار بلغ أدنى درجات الإسفاف والمهانة».
ونجد ملمحاً سابعاً لـ»الترامبيين العرب» في ميلهم إلى استئصال، أو أقله إقصاء، من يختلف أو يعارض، إذ يُعد التخلص من أصحاب الآراء والاتجاهات الأخرى أسمى أمانيهم. وقد عبر ترامب عن بعضهم عندما قال في أحد مؤتمراته الانتخابية، أنه لا يريد قتل المختلفين معه، لكنه هدد بسجن إحداهن على الأقل (منافسته فى الانتخابات الأخيرة هيلاري كلينتون). غير أن الكثير من «الترامبيين العرب» يذهبون أبعد بكثير، لأن إخراج من يختلف معهم من المجال العام يُمثّل الحد الأدنى في موقفهم الإقصائي. كما يجهر بعضهم بالتحريض على قتل المختلفين إن بإطلاق النار عليهم في الشارع إذا أقدموا على أي احتجاج، أو بإحالتهم إلى محاكمات يريدونها صورية تقضي بإعدامهم فوراً، ويتبرمون من الإجراءات القضائية المعتادة.
أما الملمح الثامن، فالبراعة في تحويل التـــنافس السياسي إلى معارك عرقية ودينية ومذهبية، وشيطنة الآخر في غمار هذه المعارك وتسويغ افتراسه، واللجوء إلى البلطجة والتشبيح. وربما وجد «ترامبيون عرب» في دعوة ترامـــب أنصــاره خلال الحملة الانتخابية إلى التصدي لما ادعى أنه «تزوير» سيحدث في الانتخابات، دعماً لطريقتهم في التعاطي مع المجال العام في مجمله.
وهناك ملمح تاسع هو احتراف التضليل والخداع، والاعتقاد بأن الكذب يُعد أعلى مراتب المهارة الانتخابية والسياسية، وأن في الإمكان خداع الناس لأطول وقت عبر وعود والتزامات يصعب الوفاء بها، وقد يستحيل تحقيقها. ولا غرابة في أن يحدث ذلك في أميركا أيضاً. فليس ممكناً تجنب استخدام آليات الديموقراطية في الخداع وتزييف الوعي، الأمر الذي يثير جدلاً منذ الثلاثينات حول مدى ديموقراطية حظر نشاط القوى المعادية للحرية لحرمانها من التلاعب بهذه الآليات للقضاء على الديموقراطية.
ويبقى ملمح عاشر ظاهر بما يكفي في الحالة «الترامبية» أميركياً وعربياً على السواء، هو النزعة المحافظة التي لا تطيق أي ميل تحرري، وتنزع إلى تحقير المرأة والحط من شأنها، وتضيق بحضورها في المجال العام، باستثناء حشد النساء لاستغلال أصواتهن في الانتخابات، أو في مناسبات تتطلب تصفيقاً وتطبيلاً.
وإذ يجد «الترامبيون العرب» في وصول ترامب إلى رئاسة أكبر دولة في عالمنا، وأحد أكثر بلدانه ديموقراطية، ما يُبهجهم ويُنعشهم، إذ يعتقدون أن فوزه يؤكد سلامة خياراتهم المنافية للعقل والحرية والمساواة والعدل والتقدم.
الحياة
نحن والعالم وعنصرية ترامب/ الياس حرفوش
لم يخدع دونالد ترامب أحداً ولم يتراجع عن أي وعد من وعوده الانتخابية. ها هو رئيس أميركا المنتخب كما هو وكما كنا نتوقعه، عنصرية فاضحة ضد الأعراق والأديان والجنسيات الأخرى، جهل عميق ومن دون أي خجل بما يجري في العالم بعيداً من الشواطئ الأميركية، واحتقار لكل القيم التي أرسى العالم الغربي قواعد علاقاته على أساسها بعد الحرب العالمية الثانية، بما يضمن تقارب الشعوب والحضارات، ومواجهة النزعات الفاشية والقومية المتعصبة التي قادت العالم الى الكوارث التي شهدها النصف الأول من القرن الماضي.
التعيينات الأولى التي أعلنها ترامب في أكثر مواقع إدارته حساسية، على رأس وزارة العدل، ووكالة الاستخبارات المركزية، فضلاً عن الرجل الذي سيكون مستشاره للأمن القومي، وقبل ذلك تعيين السياسي اليميني المتطرف ستيفن بانون مسؤولاً عن استراتيجية الإدارة الجديدة، تؤكد أن ترامب كان صادقاً خلال حملته الانتخابية، ولم يكن خطابه العنصري الموجه ضد الأقليات التي تعيش في الولايات المتحدة، ومن بينها المسلمون، أو ضد التزامات اميركا على الساحة الدولية، من باب الدعاية الانتخابية التي تهدف فقط الى كسب الأصوات. وعلى هذا، فعلى الذين راهنوا، من عرب ومسلمين وغيرهم، أن ترامب سيتغير عندما يواجه مسؤوليات المنصب، وأن ترامب الرئيس سيكون مختلفاً عن ترامب المرشح، عليهم الآن أن يعيدوا النظر في مواقفهم، وأن يستعدوا لأربع سنوات صعبة من التعامل مع هذه الإدارة الجديدة.
لم يكن ممكناً أن يقع اختيار دونالد ترامب على من هم أقل تطرفاً في عنصريتهم من الرجال الثلاثة الذين تتناقل الأخبار أسماءهم وصورهم. جيف سيشنز، الذي اختاره وزيراً للعدل، سبق أن رفض الكونغرس تعيينه كقاض فيديرالي في ظل ولاية رونالد ريغان بسبب مواقفه العنصرية. من المدافعين عن جماعة «كو كلوكس كلان»، أكثر الجماعات العنصرية المعادية لأصحاب البشرة غير البيضاء في الولايات المتحدة. يمكن المرء أن يتخيل طبيعة «العدل» الذي سترعاه إدارة ترامب في ظل رجل مثل سيشنز يرى أن من يدافعون عن الحقوق المدنية يضرون بالمصالح القومية للولايات المتحدة.
بعده هناك مايك بومبيو عضو الكونغرس والمرشح لادارة الـ «سي آي إي» وأحد قادة «حزب الشاي» الذي يقف الى يمين الحزب الجمهوري، ومن الداعين إلى التشدد في مراقبة المهاجرين وطالبي اللجوء. بومبيو هو أيضاً من الداعين إلى عدم إغلاق معسكر غوانتانامو، معتبراً أن السجناء هم في وضع جيد، على عكس روايات التعذيب، بل «زاد وزنهم بعد اعتقالهم».
غير أن الفضيحة الكبرى في تعيينات ترامب هي تعيين مايكل فلين مستشاراً للأمن القومي، وهو منصب لا يحتاج الى مصادقة الكونغرس. فلين هذا لا يخجل من عنصريته ولا من عدائه للإسلام كدين، وليس فقط للمسلمين. جنرال سابق في الجيش، عمل في وكالة الاستخبارات الدفاعية في إدارة أوباما وطرد منها عام 2014 بسبب مواقفه المتطرفة. يعتبر أن على الولايات المتحدة أن تخاف من الدين الإسلامي الذي يصفه بـ «السرطان». ويعتقد أن الغرب، وخصوصاً أميركا، هي «أكثر تحضراً وأخلاقاً من النظام الذي يحاول أعداؤنا فرضه علينا». ولا يرى أنه يصح أن توضع كل الثقافات والأديان والحضارات على قدم المساواة، لأن الثقافة الغربية المسيحية أكثر تحضراً من الثقافات الأخرى.
هذه باختصار لمحة سريعة عما تحضره إدارة ترامب لنا وللعالم، وما علينا أن ننتظره ونستعد لمواجهته. في تعليق لمجلة «الإيكونوميست» اليمينية الرصينة، وضعت انتخاب ترامب والسياسات التي يُنتظر أن تتخذها إدارته في إطار النزعات الشوفينية التي تسود العالم اليوم، وتسميها «القومية الإثنية»، التي تقوم على استغلال الرئيس أو القائد المشاعر الوطنية لأبناء بلده للتحريض على البلدان أو الشعوب الأخرى. هذه النزعات يمكن العثور على نماذج منها في روسيا وتركيا وحتى في الصين، وفي عدد من البلدان الأوروبية، حيث يتم استغلالها للوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها، كما في حالة مارين لوبن في فرنسا أو فيكتور أوربان في هنغاريا أو غيرت فيلدرز في هولندا، وأمثلة أخرى في النمسا وألمانيا وسواهما.
وتخلص «الإيكونوميست» إلى أن هذه التيارات التي تتوخى الشعبوية طريقاً الى السلطة تؤسس لعالم أكثر خطراً، لأن هذه الأفكار هي التي قادت العالم إلى الحروب والدمار في النصف الأول من القرن العشرين.
ترامب حلقة في سلسلة من القادة يتحكم بهم الجهل والغرور والعنصرية واستعداء «من لا يشبهنا». كلهم يصلون أو يطمحون للوصول عن طريق صناديق الاقتراع. هذه الصناديق ذاتها التي حملت أدولف هتلر إلى السلطة ذات يوم.
والسؤال إذا كان الرضوخ لهذه الصناديق هو الخيار الوحيد المتاح أمام الأصوات الليبرالية التي ترى الخطر قادماً ولا تملك وسيلة لردّه.
الحياة
قراءة في سياسة «ترامب» في الشرق الأوسط
ترجمة وتحرير فتحي التريكي – الخليج الجديد
تسابق زعماء الشرق الأوسط في تهنئة «دونالد ترامب» على فوزه المفاجئ في الانتخابات. ونظرًا لخطاب ترامب العدائي ضد المسلمين، ربما يبدو ذلك مفاجئًا. لكن ينبغي ألا يكون كذلك، وخاصةً مع التكهنات حول استمرار «هيلاري كلينتون» على خطى إدارة «أوباما» تجاه إيران وسوريا في حال نجاحها. وفي الوقت نفسه، لا يزال زعماء المنطقة غير أكيدين حول توجهات ترامب في الشرق الأوسط، وما إذا كان سيغير من السياسة الحالية للإدارة الأمريكية أم سيستمر بها.
ويأمل العرب المحافظون والإسرائيليون على حد سواء أن تسير حكومة «ترامب» القادمة على عكس سياسة فترة «أوباما» التي اعتمدت على القيادة من الخلف. وبالأخص، يريدون إشارات واضحة على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين. أمّا إذا بدأ «ترامب» بالتركيز على الداخل الأمريكي لتنفيذ وعده بجل أمريكا «عظيمة مرة أخرى»، سيضطر الأصدقاء الإقليميون للبحث من جديد عن شركاء آخرين لحماية مصالحهم.
التحوط .. أسلوب الشرق الأوسط
من الصعب قراءة تفضيلات سياسة «ترامب» في الشرق الأوسط، نظرًا لحديثه المحدود عن السياسة الخارجية أثناء حملته الانتخابية، باستثناء انتقاد سياسات «أوباما» و«هيلاري كلينتون» في سوريا والعراق وليبيا وإيران وغيرها. ويخشى الزعماء العرب أن يفضل فريق سياسة «ترامب» المضي قدمًا في تقليل الدور الدبلوماسي والعسكري للولايات المتحدة في المنطقة. وربما يبدأ العديد من رؤساء هذه الدول بتشجيع لاعبين من خارج المنطقة العربية للعب دور أكبر مثل الصين أو الهند أو روسيا أو تركيا، للعب دور أكبر، وبالتالي زيادة زعزعة توازن القوى حول العالم.
ومنذ أواخر الأربعينات من القرن الماضي، دأبت أنظمة الشرق الأوسط المحافظة والموالية للغرب، مثل الأردن والسعودية على سبيل المثال، على النظر إلى الولايات المتحدة كركيزة دفاعية جديرة بالثقة. ولكن بدأت تلك الثقة في الاهتزاز خلال سنوات فترة «أوباما»، بعد أن تراجع عن تهديده للنظام السوري عام 2012 إذا ما تخطى «الخطوط الحمراء» باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. ومع غياب عدالة الولايات المتحدة، بدأ حكام العرب البحث عن بديل للدعم السياسي والدبلوماسي، عند موسكو بشكل أساسي.
خلال العام الماضي، دخل الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» إلى الحرب الأهلية في سوريا، وشرع في هجوم كبير في الشرق الأوسط. ويهدف الكرملين لبسط سيطرته ونفوذه الدبلوماسي والعسكري في المنطقة الاستراتيجية شرق المتوسط، في الوقت الذي يعمل فيه على إضعاف الكتلة الداعمة للولايات المتحدة. وبفضل تواجده وغياب الولايات المتحدة، فتحت دول مثل مصر و (إسرائيل) والسعودية وباقي دول الخليج العربي اتصالات مع موسكو. وسيكون على إدارة «ترامب» الجديدة العمل لاسترجاع الثقة والتعاون مع تلك الدول، وممارسة ضغط أكبر على إيران.
في الوقت نفسه، تظهر رغبة «ترامب» في تحسين العلاقات مع روسيا. وفي عالم غير مثالي، ما زالت دول الشرق الأوسط تفضل التعامل مع واشنطن، ويفضلون مما لا شك فيه تراجع الولايات المتحدة عن التعاون مع روسيا. ويشجع «ترامب» روسيا على المضي قدمًا في حربها ضد «الدولة الإسلامية»، والتي يعتبرها أساس عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لكن لم يتضح بالنسبة لـ«ترامب» ما هي الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة في حالت رفض روسيا لعب هذا الدور.
مخاوف العرب
لا يزال زعماء العرب يشعرون بالقلق بسبب خطاب ترامب المعادي للمسلمين خلال حملته الانتخابية ووعوده بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. ولكن من المعروف أنّ خطابات المرشحين عادةً ما تحمل سياسات تختلف بعد الفوز. ويتوقع المحللون أن يختلف خطاب الرئيس «ترامب» عن خطاب المرشح «ترامب». ولكن سيتعين عليه العمل بجد لتخفيف حساسية العرب والمسلمين.
ربما ترى الدول العربية السنية فائدة من فوز «ترامب»، فبعد تخوفهم الشديد من اتفاق إيران النووي، تأمل هذه الدول في أن تكون الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة أكثر حزمًا تجاه إيران.
وعلى الرغم من توقع المحللين أن يكون الاتفاق النووي مع إيران هو أول ضحايا «ترامب»، إلّا أنّه من الصعوبة بمكان أن ينسحب «ترامب» من اتفاق متعدد الأطراف، وسيؤثر ذلك على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها في أوروبا. وفي الوقت نفسه، سيحاول «ترامب» ترضية الحلفاء التقليديين. ومع ذلك، ظهر «ترامب» متناقضًا باتجاه قضايا أخرى مثل قضية «الدولة الفلسطينية، فمن جانب، قال أنّه سيكون محايدًا نحو عملية السلام، وبعد ذلك صرّح أنّه لن يضغط على (إسرائيل).
وهذا يترك (إسرائيل) تعدّ خططها الخاصة لما بعد 20 يناير/ كانون الثاني. ويرى سياسيون يمينيون في (إسرائيل) نعمة كبيرة في فوز «ترامب»، حيث لن تمثل العملية الدبلوماسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين جزءً هامًا من أجندته. ولكن في دوائر حكومية أخرى، ترى أنّ هناك شكوك حول قدرة «ترامب» على تجاوز سياسات واشنطن، وخاصةً في تنفيذ وعده بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
كل الأنظار تتجه ناحية واشنطن
ما تزال معالم السياسة الخارجية لـ«ترامب» غير محددة. وينتظر بعض شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ما ستسفر عنه الأمور. ويستعد البعض الآخر لاستمرار الولايات المتحدة في الابتعاد عن دورها في الشرق الأوسط بالاعتماد على النفس، مثل تركيا بطول حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق وإيران، والسعودية في اليمن. بينما سعت دول أخرى مثل مصر لتعزيز أمنها بتحسين علاقاتها مع الصين وروسيا في تحدٍ واضح للولايات المتحدة.
ومن الرجح أن يستمر ذلك، رغم أنّ «التحوط» ليس الخيار المفضل لدى غالبية الدول والزعماء. وسيستمرون في تفضيل تقوية العلاقة مع الولايات المتحدة، مع حساسية أكبر تجاه مصالحهم. فهم يرون «ترامب» شخصية قوية قادرة على عقد صفقات مع شخصيات قوية مثلهم. وعلى سبيل المثال، فقد أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بيانًا هنأ فيه «ترامب» بالفوز وقال أنّه يثق في أنّ ترامب سيضخ «حياة جديدة» في العلاقات المصرية الأمريكية. ومن جانب «السيسي»، فحياة جديدة تعني تجريف كامل لإرث «أوباما» و«كلينتون»، حيث يرى أنّهما قد دعما جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع.
ويوجد أيضًا هؤلاء الذين يعتقدون أنّ رغبة ترامب في إبعاد نفسه عن الشرق الأوسط قوية لدرجة لا يمكن تجاهلها. وقد أثبت الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط قدرتها على الاعتماد على نفسها. ولكن ستظل مشاكل مثل منع انتشار السلاح ومحاربة الإرهاب قضايا جوهرية في الشرق الأوسط. ومن الممكن أن تنتشر عدوى السلاح والإرهاب من الشرق الأوسط لبقية العالم خلال فترة من 4 إلى 8 سنوات. وستجبر هذه القضايا الرئيس على توجيه الدفة قليلًا ناحية الشرق الأوسط وإن كان ذلك ضد رغبته وأولوياته التي تقول «أمريكا أولًا».
ويعدّ الشرق الأوسط من بين أقل المناطق استقرارًا في العالم. ولن يؤدي غياب الولايات المتحدة لمزيد من الاستقرار، وأي تغير كبير في التزامات تحالفات الولايات المتحدة، سيكون له على المدى الطويل تبعاته السلبية على الحلفاء الإقليميين وعلى الولايات المتحدة وعلى النظام العالمي. ومع تفكك العالم العربي، وأطماع روسيا والصين، واشتعال 4 حروب في وقت واحد في المنطقة، يواجه الرئيس الـ 45 بالفعل مجموعة رهيبة من القرارات المصيرية في مواجهة اختلال الشرق الأوسط.
المصدر | فورين أفيرز





