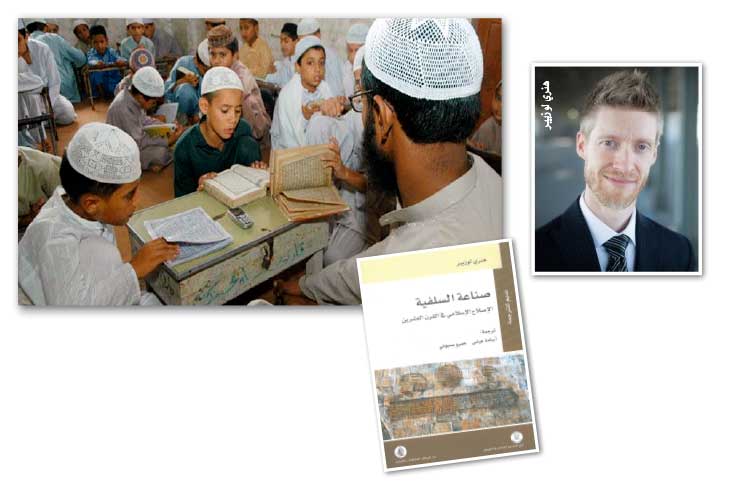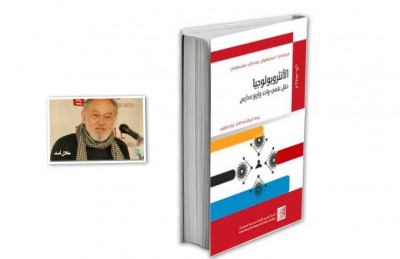“ايلين” لأوتسا موشفيغ: أقذر العقول تملك أنظف الأصابع/ جنى الحسن

في معرض حديثها عن روايتها “أيلين” (بنغوين: 2015)، التي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر البريطانية لعام 2016، قالت الكاتبة الأميركية، من أصل إيراني، أوتيسا موشفيغ، إنّها أرادت أن تكتب روايةً تمتلك المقومات الكافية لتندرج ضمن لائحة الأفضل مبيعاً. قالت أيضاً إنّها كانت مفلسة وبحاجة إلى المال، ممّا قد يخلّف انطباعاً بأنّها ذهبت باتجاه الكتابة التجارية وظهرت كأنّها متغطرسة نوعاً ما إذ اعتبرت أنّه يمكنها القيام بذلك بسهولة.
لكن الكاتبة الشابّة (35 عاماً) عادت وأوضحت في مقابلة أخرى أنّها لم تكتب فقط بسبب الحاجة إلى المال، وأنّها تأخذ الكتابة على محمل الجد، وهي تعرف أنّها ليست مهمة سهلة. وأشارت إلى أنّها أرادت أن تكتب حول كيفية أن تكون إنساناً وسط النظام وكيف تبقى إنساناً حقيقياً وأنت مقموع من قبل كل القوانين والأنظمة التي تفرض عليك من كل صوب وفي أيّ بقعة من العالم.
بحسب ما ترى موشفيغ، فإن القواعد الاجتماعية والأنظمة وضعت لكي تقيّد الإنسان وتسيطر عليه. ولذلك لكي تعكس هذا النظام، كتبت ببناء تقليدي من ثلاثة أجزاء، ووضعت بطلة روايتها الشخصية القاتمة أيلين وسط هذا القالب الكلاسيكي.
الروايات الأكثر مبيعاً
أيلين هي باكورة أعمال موشفيغ الروائية الطويلة، وقالت المؤلفة إنّ كتابها المقبل سيجعل هذه الرواية تبدو من صنف حكايات الأطفال، كونها بصدد التحضير لعمل أكثر تعقيداً. ولكن سبق للروائية أن اكتسبت شهرة من خلال كتابة القصص القصيرة ومشاركتها لأكثر من مرة في دورية “باريس ريفيو” الأدبية ومن خلال كتابتها نوفيلا (رواية قصيرة) عام 2014 تحت عنوان “ماك غلو”.
يسلّط تصريح موشفيغ الضوء على مصطلح “الروايات الأكثر مبيعاً” أو بالأحرى معاييرها وما قد يتطلبه المحتوى الروائي ليصل إلى الذائقة الشعبية ويصبح جذّاباً إلى أكبر نسبة من القرّاء. وهل يبدو أمراً غير أخلاقي أو غير “أدبي” أن يطمح الكاتب لأن يسجّل عائدات من أعماله سواء كانت الشهرة أم المال؟ وهل يجب أن يتمّ ذلك عبر التبخيس بالقيمة الأدبية للرواية أو للكتابة بشكل عام أو بمجرد إيجاد التوازن عبر أن يتمكّن الكاتب من الوصول إلى الناس والحفاظ على القصة واللّغة؟ هذه الأسئلة تبدو في صلب رحلة موشفيغ الأدبية التي تبدو كأنّها تحاول أن تجد نقطة توازن بين الأديب كشخص متعالٍ عن عائدات الكتابة والأديب الذي يجب أيضاً أن يحوّل الكتابة إلى مهنة وليس فقط لمجرد الكتابة.
أدب الجريمة
الرواية التي صنّفت من نوع أدب الجريمة لا تملك بالضرورة كل العناصر التقليدية لذلك، وإذ يبدأ التشويق في نهاية الفصل الأول حيث تقول إيلين إنّها اختفت من منزلها لكي لا تعود أبداً، لا تحلّ لغز اختفائها حتّى الفصل الأخير وهناك تبدأ الجريمة فعلياً بالظهور. وبهذا المعنى، البينة الروائية ليست مبنية على أحداث الجريمة أو محاولة حلّها، بل هي جزء من عالم الفتاة القاتم.
في منزلها القاتم ببلدة أسمتها الكاتبة “أكس” في ضواحي مدينة بوسطن الأميركية عام 1946، تعيش أيلين (24 عاماً) مع والدها السكّير في أجواء بائسة بعد وفاة والدتها. لكن المنزل لم يكن يوماً جميلاً، وتجيد الكاتبة وصف التفاصيل المزرية للمكان المغبر والمتّسخ والمحشور بالأشياء في كل زاوية. كانت أيلين تنام في القبو لتتجنب صوت والدتها التي كانت تصرخ في الليل حين كانت لا تزال على قيد الحياة. والد الفتاة يراها مثيرة للشفقة وهي تضطر إلى خدمته. تفاصيل المنزل تعكس شخصية أيلين المنغمسة في كراهية الذات وانعدام الثقة بالنفس والغرق في السوداوية، فالفتاة حتى في القراءة، ترفض أن تقرأ عن الأزهار أو الأمور المبهجة وتستغرق في القراءة عن المرض والألم والجرائم.
نظرة سوداوية
تقدّم موشفيغ صورة مزعجة عن العالم من خلال حياة الفتاة، فهو ليس مكاناً وردياً بأيّ شكل. بل يبدو بارداً ومظلماً، كسجن الأحداث الذي تعمل فيه أيلين وتغوص في حيوات المساجين من الفتيان. صورة أيلين الابنة في جميع الأحوال تبقى الأقسى، فهي تكره والدها، لكنّها مدفوعة بواجبها تجاهه، تخدمه. تمثّل اضطرابات الفتاة تلك التي تنتج عن البيئة المنزلية الممزّقة، حيث لا يعطي الآباء والأمهات الاهتمام الكافي لأولادهم وبناتهم. وهي بذلك تشبه الشخصيات المضطربة التي تقدم على الجرائم في عمرٍ صغير وتنتهي في السجن.
والعالم الذي تفضّله أيلين أو تعتبره حقيقياً هو الواضح في قبحه وبشاعته، أي أن عالم المجرمين بالنسبة لها هو بمثابة اعتراض على العالم. وهناك عالم آخر نظيف من الخارج، لكنه ليس بريئا من التحكم بعقول الناس، وتقول الشابة “من السهل أن تستدل على أقذر العقول – انظر فقط إلى أنظف الأصابع”.
سرد اجتماعي
وفي هذا السياق، تقترب موشفيغ في سردها إلى الأدب الاجتماعي وليس فعلياً إلى أدب الجريمة. فتبدو الجريمة التي سنكتشف ألغازها لاحقاً أشبه بمحاولة خلق أجواء “ثريلر” لكي تحقق ربما الانتشار الجماهيري والشعبي وتحقق موشفيغ الرواية التجارية التي قالت إنها أرادتها. هذه المحاولة لم تضرّ بالمضمون أي بالمحتوى الأدبي من جهة اللغة وتشكيل الشخصيات، لكن بدت الحبكة في بعض الأحيان مفتعلة ومبالغاً بها.
القتل والصداقة
تتلمّس أيلين الدفء حتى داخل السجن لدى العاملين معها، لكنها تقابل بالجفاء. حين تأتي سيّدة جميلة تدعى ريبيكا للعمل معهم، تنبهر بها أيلين وتصبح صديقتها. تمثل ربيكا الأمل بالنسبة لأيلين التي رغم القتامة التي تعيش فيها، تحلم بالرحيل إلى نيويورك والعيش في المدينة الكبيرة. وفي النهاية، نكتشف أن الجريمة التي ارتكبتها الفتاة كانت نتاج الصداقة. فريبيكا، مدفوعة ربما بالدفاع عن العدالة، تحتجز والدة أحد المساجين الذي قتل أباه الذي كان يسيء معاملته بتواطؤ مع الأم.
تزور أيلين ريبيكا لتناول طعام العشاء، وكانت المرة الأولى التي تدخل فيها منزلها. وريبيكا هنا تشبه أيلين في الانعزال، لكنها تفوقها جرأة وشجاعة وقوة. تعترف ريبيكا لأيلين بأنها تحتجز والدة الشاب وبأنّها تريد أن تحصل منها على اعتراف حول جريمة قتل الابن لوالده. لكن ينتهي الاستجواب بقتل المرأة، ولا تنتهي الجريمة التي ارتكبتها أيلين بمسدس والدها هنا، بل تصطحب الجثة إلى منزله وتترك له المسدس ليبدو كأنّه هو القاتل.
قتل الأب
يتمثّل قتل الأب في الرواية بتحميله وزر الجريمة والفرار إلى مكانٍ آخر. أيلين الراوية الآن في السبعين من عمرها وهي تسترجع الذاكرة وقد نجحت في الزواج والوصول إلى نيويورك والعيش من دون قيود المكان القاتم الذي تتحدّر منه. وبحديثها عن قدرة المرء على الحفاظ على ذاته وسط النظام الاجتماعي المفروض عليه والتي تصفه موشفيغ بالاعتباطي، تبدو الجريمة أشبه بنوع من الانتقام للتحرّر. والأمر سيان لريبيكا وأيلين بظروفهما المختلفة.
يقول عالم النفس السويسري كارك يونغ “ينبغي عليك أحياناً أن تقوم بأمور لا تغتفر فقط لكي تواصل العيش”. وهذا ما يبدو أنّ أيلين اقترفته. فالفتاة التي كانت تعيش على هامش المجتمع ترسم لدينا ملامح الآلاف من الأشخاص، نساءً ورجالا، الذين يعيشون في الظلام، في ظروف صعبة. يأتون من القاع، من منازل تبدو مكتظة بالخيبات، وبأعمالٍ شاقة. وكما تقول أيلين في الرواية “الأشخاص المنغمسون حقا في الحياة يعيشون في منازل تعمّها الفوضى” وربما هذه المنازل هي فقط صورة مصغّرة للعالم الأوسع.
ضفة ثالثة