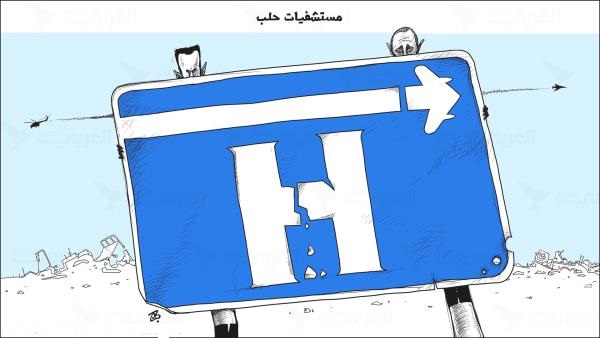بابُ الطريق/ بشير البكر

حين شاهدتُها في هذا المقهى كانت قادمةً من الطرف الآخر، ناحية شارع المقدّسي،عابرةً في اتجاه الحمراء، بدت معروفةً من قبل الفتيات العاملات وبعض الزبائن المداومين في المقهى. ولكنّها لم تجلس في ذلك الصباح، الذي كانت ترتدي فيه فستانًا ورديًا يكشف عن قسطٍ عزيزٍ من صدرها. لها نظراتٌ رصينةٌ حالمةٌ تحمي من اليأس. تسيرُ بخطى امرأة ذات رؤية، في النصف الثاني من الثلاثينات فيها تردّد وعجالة، وذات مسحةٍ من الجمال الشرقي الودود، جمالٍ المدنٍ العتيقةٍ المفتوحة الأبواب على ضفاف بعيدة، الذي يحفر مجراه الخاص. كان الانطباع الأوّل الذي توّلد لدي هو أنها ليست من بيروت لكنّها صارت بيروتيةً. هي من مدينةٍ أخرى، ربما لم تولد في أرضها، اعتقدت أنها من مكانٍ آخر وحطّت هنا قرب أوّل البحر، وحدستُ بذلك لأنّها بدتْ تحمل جرحًا داخليًا، يظهر في نظراتِها الحائرة التي تشبهُ هديلَ الحمام.
ظللتُ أفكّر بها كلّما قصدت المقهى، مضى أكثر من أسبوع ولم تعدْ تمرّ من هناك. وبينما كنتُ أنتظر قبالة أحد المحلات في شارع الكومودور، شاردًا في البعيد أنضحُ عرقًا، وإذ بعطرٍ خاصّ يعبرني خفيفًا ناعمًا. حطّت وطارت. مرّت كالظلّ، ولم يخطر في بالي أنها هي، إلا حينما صارت على الرصيف الآخر. كانتْ هذه المرّة قد تركت شعرَها الكستنائي على سجيتِه، فراح يختالُ كالقمح في وهجِ القيظ، يسحبُ نفسه من حباتِ العرقِ التي كانت تلمعُ على عنقها، الذي أخذت تلوّحه شمسَ البحر.
تيّقنتُ أنها في بيروت بعد أن خامرني شعورٌ بأنها قد تكون غادرت، وأن حساباتي وتحاليلي حول تجذّرها في بيروت، محضَ تهويمات وأوهام رجلٍ وحيدٍ يضيقُ به الوقت في مدينةٍ مغلقةٍ، يدورُ فيها من الصباح حتى المساء، مثل ثورٍ منسيٍ ووحيدٍ في حلبةِ مصارعةِ الثيران.
وذات ما بعد ظهيرة حانتْ الفرصة لكي أحدّثها عدّة كلمات. كنتُ جالسًا قبالة كومبيوتري النقّال، فجاءتْ لتجلسَ إلى الطاولة المجاورة في المقهى برفقة فتاةٍ أجنبيةٍ تصطحب معها كلبًا صغيرًا من “فصيلة الذئبيّات”، التي يأنس لها الغربيون كثيرًا ويثنون على لطفها. لكن الشيطان الصغير لم يكن كذلك، بل إنه لم يهدأ للحظة، ولم يكفّ عن القفز، وشدّ الحبل في جميعِ الاتجاهات، ولم يدعْ صاحبَته تَهنئ بتناولِ عصير التوت.
سرعان ما اكتشفتُ أن سبب هيجان الكلب هو قطّة المقهى، التي كانت مستلقيةً بعدمِ اكتراثٍ قرب الطاولة التي أجلس إليها، بينما ينطّ الكلب ويولول. يكاد يبكي وهو يعوي بصوتٍ مخنوق، يتفلّت من حبِله الذي أمسكتْ به صاحبته بعنايةٍ شديدة. لكن القطّة ظلّت هادئةً باسطةً رجليها الاماميتين، في وضعيةِ توجّس، لا بدّ أنها قلقت من كثرةِ حراكِ هذا الكلبِ الصغير، وذلك على غير عادتها، فقد عرفتُها وراقبتُ سلوكَها في لحظاتِ ضجري التي لا تنتهي. تتحرّك في المقهى من أوّله إلى آخره. هادئةً، وحكيمةً، لا تضايق الزبائن، لا تتطفّل على أحد، وبالكاد يشعرُ الزبائن بوجودها. تختار ركنًا خاصّا، وتسلتقي هناك تراقبُ من بعيد. وحين تتحرّك، فإنما تذهبً مباشرة نحو زبونٍ محدّد لتنبطحَ على أحد جنبيها، ولا تترك المكان إلا إذا ضايقها أو بارحَ المقهى. وقد حاول بعضُ أطفالِ الزبائن اللعب معها، أوحتى ضربها بسببِ برودتِها، فكانت تديرُ ظهرها، ولا تردّ على الاستفزازات أو الاغراءات. وعلى العموم هي وحيدة في هذه المملكة الصغيرة. وكلّما شاهدتها ذكّرتني بقطط الفراعنة التي كانت رمزًا للقداسة. رغم أن القطّة لم تعره اهتمامًا كبيرًا، كانت درجةُ غليان الكلبِ الصغيرِ ترتفعُ بوتيرةٍ متسارعةٍ، الأمر الذي دفع صاحبته للقيام بحركةٍ غريبةٍ؛ أمسكت به من أرجله الأربعه، وطوتهم كما لو أنها تثني كلبًا آليًا، وبسطته أرضًا وأصدرت إليه أمرًا بعدم الاتيان بأي حركة. وقد رضخ المسكين واستكان من دون جدال، لكنّ طلبَ استغاثةٍ ظلّ يشعّ من عينيه. فوجدت نفسي أطلبُ منها أن تطلق سراح أقدامه، وتتركه يعبّر عن مشاعره بحرية. قلتُ لها لو كنتِ في بلدٍ غربيٍ لجرى اعتقالك وتجريدك من هذا الحيوان. شرحتُ لها سبب استنفار كلبَها؛ إنه يرى القطّة، التي انتبهت مع صديقتها إلى وجودها لأوّل مرّة. التفتتْ نحوي وكانت المرّة الأولى التي أرى الوردة عن كثبٍ، فصرختُ من الداخل: يإلهي اغفر لي قلّة الحيلة أمام هذه الخيالات السعيدة. لبرهةٍ خفضتْ نظرها نحوي، وابتسمتْ ثم أشاحتْ. الابتسامةُ والِنظرة الخاطفتان جعلاني أسافر على الفور نحو حقولِ القمح. وهجم عليّ ربيعُ الصحراء بإقحوانِه الذي لا ينقطع. ياإلهي ما هذه الإقحوانة؟. وأنا في الطريق الذي لا ينتهي، حطّت يمامةٌ على الطاولةِ المجاورةِ. اقتربتْ منها، صارتْ الصورة واحدةً بالنسبة لي.
رأتني شاردًا فقالت لي، غريبٌ هذا الكلب، هو هائجٌ رغم أن القطّة لا تتحرّش به. فأجبتُ باقتضاب، ربّما يكمن السرّ هنا، أنه لا يستطيع أن يحتملَ خفّتها هذه. هي هادئة وهو يعوي، يضربُ الأرضَ، يبكي بحرقةٍ، يتوسلها أن تعيره أي اهتمام. لكنّها جامدة كالقطط الفرعونية في المقابر. تسلّط عليه ضوءَ اليقظة، تستلذّ بتعذيبه، أمّا هو فهو يتلمّس دربَه خبطَ عشواء.عاجزٌ فوق هذا، حتّى في خياله، النظر بتأملٍ إلى هذه المخلوقة الفريدة المتمدّدة إلى جواره.
حاولت صاحبة الكلب نهرَ القطّة لكي تبتعد، لكنّها لم تتجاوب، صرخت بها، وهوّمت بيدها نحوها، فلم ترتعشْ أو يرفْ جفنُها أو تتحرّك من مكانها. حدّقت في عينيها مليًا، كانت هناك مسحةٌ قوّيةٌ من السخرية الممزوجة بحسّ النصر. مسّدت على ظهرها، وطلبت منها المغادرة، لكي يتمكّن الكلب من أن يستعيدَ روعَه. تحرّكت وذهبت نحو الطرف الآخر من المقهى، وحين تأكّد الكلب أنها لم تعدْ في مرمى نظره، تمدّد على ظهره وصار يلعب بولدنةِ ومرحِ طفلٍ انزاح عن ظهرِه شبح الخوف.
حين غادرتْ وهي وصديقتها في ذلك المساء ألقتا عليذ تحية الوداع. بقيتُ وحدي، وهما لاتعرفان بالتأكيد ما بي من شجنٍ وانكسار. لا تدريان كم هطلَ في داخلي من ليلكٍ، وكم نما من العشب. شعرتُ أنها جاءت من مكانٍ قصي، وعليّ في تجوالي العظيم أن أمشي مغمضَ العينين، لكي أراها مرّة أخرى في رفوف اليمام الذي يحلّق في سماوات بيروت.
عليّ أن أسير نحو نهايات هذا الممرّ الطويل، واقفٌ عند كلّ غروب على حافّة المدى، بانتظار ضمّةَ قمحٍ يأتي بها السراب البعيد.
العربي الجديد