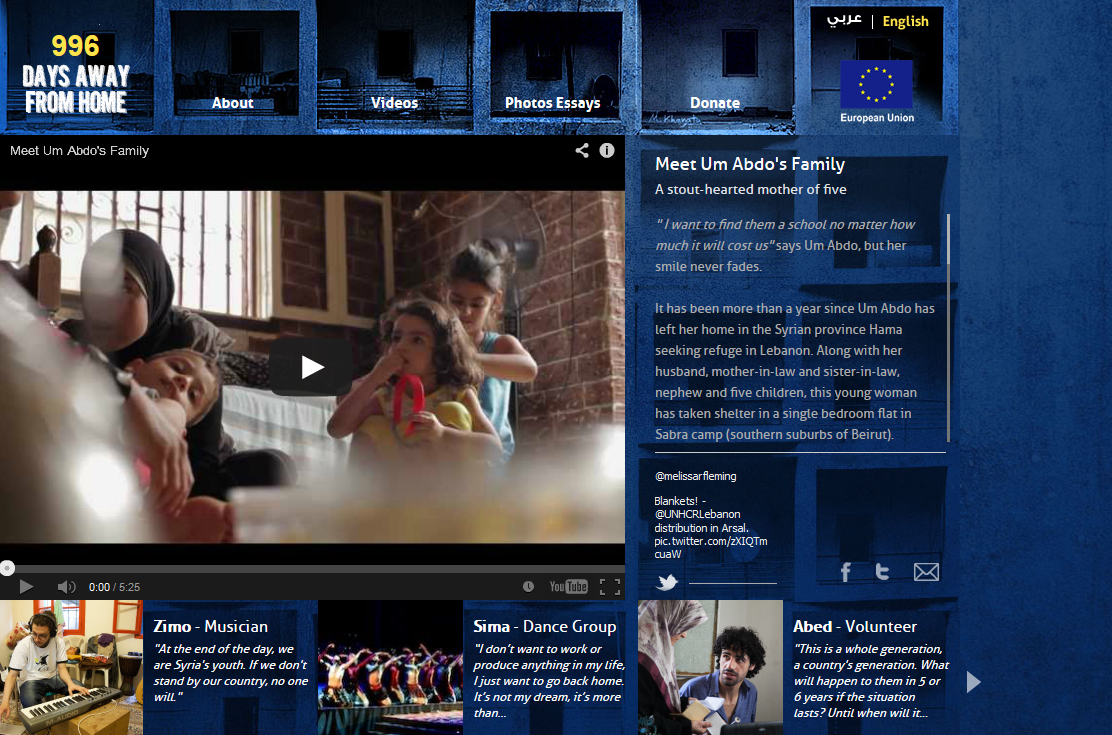بانتظار الموت في حلب: حفّارو أنفاق شرسون ومتقاعدون سئموا الحياة/ كريستوف رويتر

ترجمه عن الإنكليزية طارق أبي سمرا
بعد عبور أحياء المدينة الخارجية، تمتد أرضُ خرابٍ تسكنها الأشباح. الشوارع والأبنية السكنية خالية نصف مدمرة. لا صوت سوى صرير لافتات معدنية مهشمة تلهو بها الريح، ودوي مدفعية بعيدة ترعد متقطعة.
شرق حلب صار مهجوراً فعليا،ً كحال معظم الأحياء السكنية البعيدة عن الجبهة. من بقوا هناك يفضلون أن يأووا إلى مساكن ملاصقة، غير بعيدة من خطوط الاشتباك شبه الثابتة منذ سنتين. المفارقة هي أن الناس يشعرون بأمان أكثر لدى سكنهم في مرمى الدبابات ونيران القناصة. تلك هي سُنَّة الحياة في حلب.
للوضع هذا أسباب عملية، أحدها أن الطبقات السفلى من المباني، على طول خط الجبهة، توفر شيئاً من الحماية من قذائف المدفعية. لكن السبب الرئيسي هو عدم إلقاء المروحيات براميلها المتفجرة، التي تزن نصف طن، على هذه المناطق. القنابل هذه فعالة وفتاكة، لكن دقة تصويبها متدنية جداً إلى حد امتناع سلاح جو النظام السوري عن استخدامها على مقربة من قواته.
في ما عدا خطوط الجبهة، كل شيء متاح في شرق حلب. باستطاعة البراميل المتفجرة، المحشوة بالمتفجرات والشظايا، هدم مبانٍ بأكملها. لقد قام النظام بتجريب أنواع مختلفة منها على المدينة: بعض منها تُرْبَط بها خزانات وقود لتشعل حرائق لدى انفجارها. أخرى، بالغة الثقل، تُدَحرج من المروحية بواسطة دواليب مدفع صغير.
تظهر المروحيات في الصباح وبعد الظهر، في الأوقات نفسها من كل يوم تقريبا. تدور في الفضاء لحين، على ارتفاع 4000 أو 5000 متر، فتبدو في السماء كنقاط صغيرة. ترمي قنابلها التي لا يسمع لها صوت، إلا ثوان قبل الاصطدام: وقت كافٍ لتدرك أنك على وشك الموت، وغير كافٍ للهرب.
حتى لو كان الوقت كافياً، فإن الملاجئ الفعلية نادرة جداً. لا أحد يطلق النار على المروحيات من الأرض، فذلك عديم الجدوى: هي تحلق على ارتفاع بالغ، فلا تبلغها رصاصات المدافع المضادة للطائرات، الروسية العتيقة، التي بحوزة الثوار.
الموت يهطل من السماء
قواعد العيش في حلب واضحة مقلقة، كأن من وضعها يقوم بتجربة علمية دموية: كيف يتصرف الناس عندما يمكن للموت أن يهطل من السماء في أي لحظة؟ فرَّ ما يقرب من تسعين في المئة من سكان شرق حلب منذ أواخر عام 2013، وقتما ابتدأ القصف الممنهّج الذي أودى بحياة 2500 شخص حتى الآن. بالرغم من ذلك لايزال 200 ألف إلى 300 ألف شخص يعيشون في القسم الشرقي من المدينة.
يقول البعض أنهم لا يريدون المغادرة، والبعض الآخر أنهم لا يستطيعون. هنالك أيضاً من يؤكد أن محاولة الهرب لا طائل منها: سيجدهم الموت إن كان من نصيبهم. وإن لم يكن، فلن يفعل. لذلك يمكثون منتظرين.
المدينة، بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على بدء الانتفاضة على عائلة الأسد، وسنتين على اندلاع القتال في محيط حلب، منقسمة إلى جزأين. النظام يفرض سيطرته على الأحياء الأكثر ازدهاراً في القسم الغربي، حيث مقرات المخابرات والجيش. هناك، يحتشد ما يقارب المليوني شخص، كُثُرٌ منهم اتوا من شرق حلب، هلعين هاربين من الموت الذي يهطل من السماء.
أما في شرق حلب، فمن الأصعب تحديد من يسيطر على ما تبقى من احياء الطبقات الوسطى والفقيرة، إضافة إلى قسم كبير من وسط المدينة التاريخي. بدايةً، كان هنالك بضع كتائب من الثوار فقط. تكاثروا، فوصل عدد المجموعات الصغيرة إلى أربعمائة. أما الآن، فتوجد ست كتائب كبيرة. أتت أيضاً المجموعة المتطرفة المعروفة بـ«داعش»، لكنها طردت لاحقاً. لا حكومة مركزية في شرق حلب، لكن هنالك مجلس بلدية ووحدات للشرطة ومتطوعون في الدفاع المدني يلبون، بعد القصف، نداءات الاستغاثة، فيجلون الجثث والأحياء المدفونين تحت الأنقاض.
لقد أوقف الثوار، خلال شهر سبتمبر/ ايلول من هذا العام (2014)، تقدم مقاتلي «داعش» قبل قليل من بلوغهم مدينة مارع، الواقعة على بعد أربعين كيلومتراً شمال حلب. قوات الأسد من جانبها، لا ينقصها سوى التقدم بضعة كيلومترات، لصد الثوار، فيكتمل حصارها حلب، ويصبح بمقدورها تجويع سكان الطرف الشرقي من المدينة. الوضع مأسوي إذاً، لكنه على هذه الحال منذ أشهر. أنباء متواصلة عن معارك، عن تقدم وانسحابات، تصل إلى المدينة المسكونة بالأشباح، لكن خافتة وبعيدة. في أوقات توقف إطلاق النار، يخيم على كل شيء سكون مريب، وينصرف السكان، بصمت تام، إلى تدبير أمور حياتهم اليومية. الأصوات العادية منعدمة: ما من حركة مرور، ما من موسيقى أو أصوات بشر أو طير.
امرأة الجسر
في صباح نهار من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ ايلول. لا يزال الجميع على قيد الحياة: أبو عبدو زكريا صاحب المتجر، جارته الشابة سمر حجازي، محسن الكهربائي، امرأة عجوز ترتدي الأسود، واثنا عشر عاملاً مياوماً من حي الطبقة العاملة في الحيدرية. 16 شخصاً من أمكنة مختلفة من المدينة، لا يجمعهم، في صباح هذا اليوم، سوى بقائهم في حلب.
بعد ظهر يوم الإثنين هذا، راحت أجهزة اللاسلكي التابعة للدفاع المدني وشرطة الثوار توشوش. هاتان المؤسستان هما اللتان تحافظان على نوع من النظام البدائي في هذا الجحيم. هنالك امرأة تمشي على جسر صاخور، الطريق السريع المهجور: «يا إلهي، ما الذي تفعله هناك؟!»، قال صوت عبر اللاسلكي. «لا بد أنها مجنونة!»
المكان تحت الجسر لا يزال آمناً. الجدران الإسمنتية السميكة توفر ملاذاً لأحد أكبر مواقف سيارات الأجرة المتبقية في المدينة، ولباعة الفاكهة كذلك. لكن القسم الأعلى بأكمله في مرمى نيران القناصة. لقد نُصِبت حواجز من الركام والحافلات المتفَحِّمة لردع الناس عن محاولة سلوك هذه الطريق، لكن المرأة التي ترتدي الأسود تتجنب الحواجز والركام وتسير على الجسر.
الرصاصة الأولى تخترق الجو بعد بضع ثوان. مع تتابع الطلقات، يتزايد تدريجاً توتُّر الأصوات الطالعة من اللاسلكي. «ماذا يجب أن نفعل؟ إطلاق النار؟ كلا، ذلك لن يؤدي سوى إلى استفزازهم. يا إلهي…». تنحني المرأة وتتابع سيرها. طلقة سابعة فثامنة، فتسقط المرأة ذات الثياب السوداء أرضاً.
لا أحد يدري ماذا كانت تفعل على الجسر. هل كانت تقوم بجمع أكياس بلاستيكية مستعملة بهدف بيعها؟ أم كانت ربما تحاول إنهاء حياتها؟ أم بكل بساطة فقدت عقلها؟ هزَّ الناس بأكتافهم. لا أحد يعرف اسمها. انتشلوا جثتها في الظلام، فلم يعد لها من اثر هناك.
«لا نزال احياء، لكن إلى متى؟ ليوم واحد أم لأسبوع؟ نحن أموات أحياء، كمخلوقات الزومبي في الأفلام!»، يقول متطوع في الدفاع المدني اثناء نوبة حراسته. «أجل، مخلوقات زومبي! هل تشرب قهوتك مع سكر أو من دون سكر؟»، يسأل. شرق حلب مكان أنهكه اليأس، مدينة مخلوقات زومبي دمثة.
كان زكريا، في يوم الإثنين هذا، يشرب قهوته في الحديقة، كعادته في كل صباح. هو خياط هرم، ستيني، يسكن منفردا في منزل مرَّت عليه قرون من الدهر. يملك متجراً أجّره، لكن المستأجر توفيَ. يعتني بمزروعات حول بئر في الباحة الداخلية، ويزور عادة، في الصباحات، صديقه القديم أوهانس ، مُحْضِراً له، من البراد، إبريق ماء بارد.
سمر، أوهانس، وزكريا
مجدداً، يشرب زكريا القهوة في حديقته، في تمام الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء. يسمع فجأة صفير قنبلة، فيهرع نحو غرفته، آملاً في أن يكون في مأمن هناك. كان اتجاهه خاطئاً: على الرغم من صغر حجمها، أصابت القنبلة الرجل الستيني ودمرت نصف منزله، ومنزل سمر حجازي، أرملة موظف البورصة، البالغة الثمانية والثلاثين من العمر. توفي زوجها قبل خمسة أعوام، يقول الجيران، ويضيفون: «وفاةٌ طبيعية»، وكأنها طريقة غير اعتيادية للموت.
لو فعل زكريا كجاره وقفز إلى داخل القبو في الطرف الآخَر من الباحة، لكان من الممكن أن ينجو. متطوعو الدفاع المدني، الذين وصلوا مع مولد كهربائي وآلة لثقب الصخور وقاطعة للمعادن، سريعا وجدوا جثته. لكنهم احتاجوا إلى ساعتين من النشر في جبل الركام، لانتشال جثة سمر حجازي. لقد اخترقت كرتان فولاذيتان ما تبقى من جمجمتها: كرة بحجم حبة كرز، وأخرى كبيرة كحبة جوز. كانت القنبلة محشوة بكرات مماثلة لمضاعفة قوتها التدميرية.
ظهر أوهانس، صديق زكريا القديم، بينما كان رجال الدفاع المدني يتابعون الحفر. أطلعه أحد عما حدث. أومأ برأسه. لا صراخ، لا عينين مذهولتين، ولا مفتوحتين جامدتين رعباً. لا شيء سوى إيماءة. اشترى الخبز ،عاد إلى مأواه، مأوى العجزة الكاثوليكي الوحيد الذي تبقّى في شرق حلب: دار القديس إيليا.
«يجب أن أكنس الباحة»، قال مبتعدا، وبنبرة الصوت الرخيم الرقيق أياها، أضاف انه كان قد خَمَّن ما جرى: في بادئ الأمر حصل انفجار. زكريا لم يظهر مع إبريق الماء، ففكر أوهانس: «لقد قُتِل زكريا أيضا».
مأوى القديس إيليا
لا يزال هناك سبعة مقيمين في دار القديس إيليا. غادر الباقون أو توفوا. أوهانس، ذو الخمسة والسبعين عاماً، من بين أصغر إثنين سناً. ماغي أناستوس، الجالسة في ظل الأشجار في الباحة، قبالة تمثال يسوع الأزرق السماوي، تبلغ الثمانين. ظنَّ سكان المأوى – بعضهم لا زالوا يمكثون فيه منذ عشرين سنة أو أكثر – أن آخر سني حياتهم ستكون هادئة.
يبذلون قصارى جهدهم للتشبث بهذا الأمل، لكنه ليس بالأمر اليسير. مبنى المأوى، وباحته الشاعرية الهادئة، التي يزيل أوهانس منها كل ورقة شجر شاردة، يقعان على خط الجبهة مباشرة. في الخلف تماماً، تمتد المنطقة المحرمة. «لا أحد يُكِنُّ لنا أي ضغينة»، يقول جوزيف شدياق البالغ، هو الآخر، خمسة وسبعين عاماً. في ما مضى دَرَسَ لسنتين علم اللاهوت، ويترأس حاليا القداس المرتجل في كل نهار أحد، ويعتني بنزلاء المأوى طريحي الفراش. «لكن القناص في الطرف الآخر، لدى صعودي إلى السطح لإصلاح خزان المياه في فصل الشتاء، راح يطلق النار في اتجاهي فوراً. صرخت له أن يتوقف. تحسَّنت علاقتنا بعد هذه الحادثة. صرنا نعلم أنه يدعى أبو جعفر». نزلاء المأوى قلقين حالياً، «فأبو جعفر أصيب بطلق ناري ونحن لم نتعرف على بديله بعد».
أول قتيل من نزلاء المأوى، ربطه أوهانس وجوزيف بعربة صغيرة دفعوا بها، عبر خطوط التماس، نحو الطرف الآخر من حلب حيث عائلته. «لم يعد حالياً مثل هذا الأمر ممكنا». من يموت الآن من نزلاء المأوى، يدفن في باحة الحديقة الداخلية.
«هناك متسع لدفننا جميعاً. لكننا نتضرع إلى الله أن يرحمنا ويهبنا مزيداً من الوقت»، يقول جوزيف. أبناؤه، كحال معظم المسيحيين، يسكنون في القسم الغربي من حلب. هناك، يعيشون كوالدهم، على مقربة من خط التماس. فادي، أصغرهم سناً، قتلته هناك، قبل شهرين، قذيفة هاون أطلقها من هنا الثوارُ الذين يجلبون الخبز والشاي لنزلاء دار القديس إيليا بين حين وآخر. «ماذا يمكنني أن أقول؟»، يتنهد جوزيف متطلعاً إلى السماء.
ينهض أوهانس لجمع بضعة أغصان سقطت على البلاط اللامع. حدث انفجار على مقربة. ما من أحد يتطلع إلى الأعلى. يفتح جوزيف باب غرفة المعيشة ويشير بسبابته إلى ثقب في السقف، أحدثته قذيفة هاون في فصل الشتاء. «كنا جالسين هنا قبل نصف ساعة من سقوط القذيفة. لا نقوم بتدفئة غرفة المعيشة، حيث نشرب قهوة ما بعد الظهر، إلا في الشتاء».
القذيفة أخطأتهم، وهذه إشارة من الله، يقول جوزيف. كمعظم الباقين في هذه المدينة، الذين نجوا بالكاد من انفجار ما، يرى جوزيف تدخلاً إلهياً في أحداث تلك الفوارق الضئيلة، التي تقاس بالدقائق، وانقذت حياته.
الآن، في فصل الصيف، جوزيف وأوهانس وماغي يجلسون كل مساء في الباحة المُكَنَّسة بعناية فائقة. يستمعون إلى الهتافات التي يرددها الطرفان من فوق رؤوسهم. «الله أكبر!»، يصرخ الثوار. «بشار أكبر!»، يَرُّد عليهم جنود النظام. كأنه جدل بيزنطي حول من الأقوى: الله أم بشار الأسد.
شرفة مائلة
صار هؤلاء الرجال الخمسة الطاعنين، بارعين في التعرف على لهجات المقاتلين من الطرف الآخر. «منذ حوالى شهر، كنا نسمع دائما، من هناك، عراقيين يتكلمون»، يقول أوهانس. «أجل، لكنهم رحلوا الآن»، تقول ماغي، «واللبنانيون كذلك»، يضيف جوزيف.
من التضليل القول ان وتيرة القتال في محيط حلب قد خفتت بعد مرور عامين. لكن عدد المقاتلين على الجبهة قد انخفض. كان لدى النظام، منذ بضعة أشهر، ألف محارب عراقي، إضافة إلى مقاتلي «حزب الله» اللبنانيين الشرسين، ومرتزقة أفغان. هذا التحالف الشيعي اختفى تماما في الآونة الأخيرة. عاد العراقيون إلى ديارهم بعد أن صارت بغداد مهددة من تنظيم «الدولة الإسلامية»، وأمر «حزب الله» مقاتليه بالتوجه نحو دمشق. في المقابل، أرسل الثوار، خلال أغسطس/ آب 2014، آلاف المحاربين من حلب إلى الشمال، لوقف تقدم مقاتلي «الدولة الإسلامية». حالياً، الخطوط الأمامية جامدة، فكلا الطرفين لا يحرز أي تقدم. انها «جبهة باردة»، يقول السكان المحليون.
الأربعاء، بعد التاسعة صباحاً، سُمِع صوت مروحية أعقبه دوي انفجار. ارتجت الجدران على امتداد مئات الأمتار. رياح خفيفة أخذت معها سحابة غبار عملاقة في اتجاه السماء. امرأة تحمل كيسين من البلاستيك، تمشي بتروٍ في الشارع الخالي، متجهة إلى موقع الانفجار، فلا تبطئ سيرها أبداً.
الانفجار ليس ببعيد. يكفي النزول نحو شارع عكجول، ثم التوجه يساراً. معظم المباني مدروزة بثقوب الشظايا. الستائر ترفرف في النوافذ المحطمة في مبانٍ لا زالت قائمة، لكنها خالية تماما. فقط هنالك رجل عجوز على شرفة مائلة يسقي الزريعة. ينظر إلى أسفل ولا يتفوه بكلمة.
غشاء رقيق من الغبار غطى المنطقة. بعد دقائق معدودة، خرج رجل يكسوه الغبار لجلب الماء. أخذ يغني بهدوء فيما يغسل دراجته النارية التي نجت بأعجوبة. «لقد سمعته!»، قال الرجل، وهو كهربائي اسمه محسن، التحق بصفوف الثوار. كان يتكلم عن الصفير الوجيز الذي سبق الانفجار. في اللحظة الأخيرة قفز إلى داخل مبنى اسمنتي. كان محظوظاً، فالقنبلة سقطت وانفجرت في حفرة حفرتها قنبلة سابقة، ما أضعف من قوتها التفجيرية. إتَّجَه محسن نحو الحطام، انعطف يميناً وراح يعدّ الجثث في الباحة المتاخمة. بدا عليه الأسى وقال «قَتَلَتْ ثلاثة».
الأنفاق والكهرباء
تكلم محسن عن الدجاجات – معظمها نجت من الانفجار. انتهى من غسل دراجته النارية وجلس في الدور السفلي مع بقية مقاتلي الثوار لكي يتقاسموا نوبات عملهم. يتمركز بعضهم داخل مباني تعرضت لقصف عنيف على طول الجبهة. الآخرون، على الرغم من الحرّ، يرتدون سترات ذات أكمام طويلة ويباشرون حفر الأنفاق. بأزاميل، بمطارق، بملاعق، وبقضبان فولاذية يحفرون رويداً رويداً لإزالة الصخور الكبيرة. والأهم أنهم بهدوء يحفرون لتجنب الانكشاف. هدفهم الالتفاف على مواقع جيش النظام أو تفجيرها. كما انهم يحفرون أنفاقهم لمنع الطرف الآخر عن حفر أنفاقه.
تعامُل الثوار مع مباني حلب التاريخية التي لا تثمَّن، ليس مغايراً لتَعامُل قوات الأسد معها. لكنهم يحتاجون وقتاً طويلاً لما يفعله جيش النظام السوري بدقائق معدودة. «فجرنا مبنى واستولينا على آخر ولم نخسر أي من مبانينا خلال الأشهر الأربعة الماضية. صحيح أن مروحيات الأسد تسيطر على الجو، لكننا نسيطر على ما تحت الأرض»، يقول القائد أبو عرب الذي كان صاحب متجر. منذ استقرَّت رصاصة في عنقه وشظية صغيرة فوق عينه، سماه رجاله الشهيد الحيّ.
يشعر مقاتلو النظام بتوتر متصاعد خلال استماعهم إلى الأصوات القادمة من تحتهم. كلٌّ من الطرفين ركّب كاميرات على طول خط جبهته. «لكن جماعة الأسد لديهم كهرباء لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً. أما نحن، فلأربعة وعشرين ساعة»، يقول أبو عرب، ويتابع: «عليهم إذاً تشغيل مولداتهم لكي تعمل الكاميرات. لكنهم لن يتمكنوا اذ ذاك من سماع ما يحدث تحتهم».
بإمكان الثوار الانتقام جزئياً على الأقل، للإخلاء السكاني المستمر والممنهج لشرق حلب الذي يمارسه النظام، عبر قطع التيار الكهربائي. خط الإمداد الرئيسي بالكهرباء للمدينة كلها يأتي من حماة في الجنوب، وفي طريقه إلى أحياء حلب الغربية، يمر في أحيائها الشرقية. يستطيع الثوار، إذاً، قطع التيار الكهربائي عن كامل القسم الغربي من المدينة. لكن لن يبقى إذ ذاك ما يردع النظام عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة بأسرها.
كلُّ طرف يستطيع ابتزاز الآخر. توصل وسطاء إلى التسوية التالية: يتلقى كل طرف تقريباً الكمية نفسها من الطاقة الكهربائية. لكن عدد السكان في القسم الغربي 2.2 مليون نسمة. أي ما يعادل عشرة أضعاف عدد سكان القسم الشرقي. التزود بالطاقة الكهربائية يختلف جذريا، إذا، بين القسمين. فمنذ ان أصلح مهندسو بلدية شرق حلب محطات التوزيع في اوائل سبتمبر/ أيلول 2014، صارت الكهرباء تصل على مدار الساعة إلى بعض احياء الثوار.
لا تفروا من الموت إذاً
لدى عودتنا كان لا يزال العجوز ينظر إلى الأسفل من شرفة منزله المائلة. رحمة حسين عبد الله، صانع الورق البالغ السابعة والسبعين، هو آخر من تبقى في الشارع. يمكن ان تبقى الأمور على حالها، فلا ينزعج. مكتبته تملأ غرفة كاملة. «اتركوني وحيداً مع كتبي! فأُمضي أيامي في القراءة والاعتناء بالمبنى»، يقول. أليس الأعقل ان يعتني بنفسه ويهرب قبل أن يقتله برميل متفجر؟
«كلا، لماذا؟ لقد سقط برميل هنا منذ ثلاثة أشهر، أمام المبنى تماماً»، يقول. هنا، حيث كان الفرن، عشرات كانوا ينتظرون في الصف عندما ظهرت فوقهم المروحية. لم يشاؤوا خسارة أماكنهم في الصف، أو أن فرصتهم في النجاة كانت معدومة على أي حال، فلم يتزحزحوا. عبد الله لم يكن واقفاً في الصف. كان مسمّراً أمام كتاب، ولم يكن جائعاً. أخلَّت القنبلة من توازن الشرفة، وفتحت ثقباً في حائط غرفة المعيشة. سدّ عبد الله الثقب بالحجارة لاحقاً. ذلك لم يكن حظاً، يقول مُصِرّاً: «ساعتي لم تكن قد حانت بعد».
بعد مقتل آخر جارٍ له، اشترى عصفور زيبرا ليخفف عنه وطأة الوحدة. من مسجلة كاسيت عتيقة لقّنه أغانٍ قديمة. إحدى غرائب حلب، هي متاجر الحيوانات الأليفة التي ما زالت أبوابها مشرعة، على الرغم من إقفال المحال الأخرى، أو زوالها مع الأبنية التي كانت فيها.
تُسْمَع طلقات قريبة، لكن عبدالله لا يرف له جفن. بدلاً من ذلك، يروي لنا من كتبه حكايات عن سليمان والملك نمرود وإسحاق ويوسف، ويخبرنا عن عنجهية من يصبو إلى أن يكون سيداً على الحياة والموت. يخبرنا أيضاً عن قصاص الله، عن البعوضة التي ارسلها الله لقتل نمرود عقاباً له على غطرسته: «فلا تَفرُّوا من الموت!»، إذاً، يقول عبد الله.
لكن الله لا يرسل بعوضاً إلى حلب: جيش الأسد يُسقط براميل ضخمة متفجرة. «هذا غير مُهِم – يقول – فالقنابل ليست المشكلة، بل ساعة الموت التي حُدّدت مسبقاً». هل من الجنون التفكير بهذه الطريقة؟ أم أنها مجرد محاولة لجعل الجنون الذي يحاصره يبدو طبيعياً؟
رحلة المحجبات والفودكا
حفارو أنفاق شرسون، ومتقاعدون سئموا الحياة: انهما مجموعتان متباينتان رُميتا معاً في شرق حلب. الأولى تعتقد ان مصيرها لا يزال ملك أيديها، وإن كان ثمن ذلك باهظاً. الثانية تؤمن أن ما من أحد يتخذ أي قرار على الإطلاق. صار الفريقان رفاق جحيم.
أسباب بقائهم قد تختلف من شخص إلى آخر ، لكنهم ما زالوا جميعهم هنا. هنالك أمر قوي يوحدهم إذن.
نادراً ما يعبر أحد عن عداوة تجاه الطرف الآخر من المدينة. «رجالي وأنا نقاتل النظام، لا الأشخاص المقيمين هناك»، يقول القائد أبو عرب. بالطبع هذا لا يمنع الثوار عن إطلاق القذائف وعبوات الغاز المتفجرة على الطرف الآخر. هي متفجرات وقذائف قصيرة المدى، لكنها تقتل عشوائياً.
للجميع، عموماً، أقارب أو معارف في الطرف الآخر. في صلاح الدين، على الجبهة تماماً، هنالك مكاتب وكالات سفر، تعرض رحلات «من حلب إلى حلب». المسافة، مستقيمة، هي 600 متر فقط، لكن الرحلة تستغرق اثنتي عشرة ساعة، إذ يشق الباص طريقه في قسم كبير من شمال سوريا. فقط من ليس اسمه على لوائح المطلوبين لدى مخابرات الأسد الجبارة، يجرؤ على القيام بهذه الرحلة. على الرغم من ذلك، يشتد الطلب على مقاعد الباصات.
أحصى أحد من قاموا بهذه الرحلة 46 حاجزاً. «لم يكترث الثوار لأماكن جلوسنا في الباص، رجالا ونساء. لكننا حين عبرنا لاحقاً إمارة «داعش»، تحجبت النساء كلياً وجلسن في الخلف، أما الرجال فجلسوا في مقدمة الباص. صار يتوجب على كل امرأة أن تكون برفقة زوجها أو والدها أو شقيقها وإلا تمنع من السفر! لذا اخذ السائق، لحل هذه المعضلة، يخترع زيجات وهمية: أنتما الاثنان، أنتما الاثنان، أنتما الاثنان!».
وصلوا إلى المنطقة التي يسيطر عليها النظام: «من جديد، صار على الرجال والنساء ان يجلسوا معاً. اختفى فجأة كل حجاب. كان من المستحسن أن تمسك بيدك زجاجة فودكا». يصعب تخيل أن أحد ساكني شرق حلب – الذي يحاول جيش الأسد تدميره – قد يذهب إلى غرب حلب، حيث يسيطر جيش الأسد، ثم يعود من هناك إلى هنا، إلى هذا الجحيم، لكن هذا ما يحدث.
في يوم الجمعة، على عادتهم كل صباح، تجمع العمال المياومون من حيّ الحيدرية شبه المهجور، قرب المستديرة الوحيدة في المنطقة. من يحتاج حرفياً أو عاملاً لبضع ساعات، يأتي إلى هذه المستديرة. هي في الحيدرية المكان الوحيد الذي لا يزال الناس يحتشدون فيه. أما الشوارع، فمقفرة، والجامع مهجور، حتى في أيام الجمعة. في الثامنة من صباح اليوم، خمسة عشر رجلاً ينتظرون قرب الدوار. يجلس بضع سائقين داخل شاحناتهم المركونة على طرف الطريق، وقد تركوا محركاتها تشتغل. لاحقاً سيقول أحد الناجين انهم لم يسمعوا أي شيء. مقاتل مفجوع من سكان الحي سيهمس قائلاً انه كان دوماً يحذرهم من التجمع هناك، كل يوم، وفي الوقت نفسه. وسيقول أحد المصابين أن الخوف كان بالطبع لا يفارقه، لكن: «علي أن أطعم عائلتي»، قال أيضاً.
في تمام الساعة الثامنة وثلاث دقائق، برميل متفجر مَزَّق إرباً ثلاثة مبانٍ، وكذلك الشاحنات الصغيرة و11 من رجال المستديرة. لدى وصولهم إلى الموقع، وجد المسعفون أشلاء على سطوح المباني المهدمة. الضحية الثانية عشرة توفيت في المستشفى. طَلَب منا الأطباء عدم ذكر اسم وموقع المستشفى ، «وإلا سيقصفوننا بوتيرة مضاعفة».
من الأشخاص الـ16، وحده محسن بقيَ على قيد الحياة، الكهربائي الذي راح يغني بينما كان يغسل دراجته النارية.
في المستشفى ثلاثة من جرحى الحيدرية. واحدٌ بتر الأطباء ساقه، الثاني يَئِنُّ بهدوء، والثالث صارت يده كتلة متورمة مضمدة، ويقول: «أين أنا؟». مجدداً، عبثاً، ومن دون أمل، يردد: «أين أنا؟».
( مراسل من الشرق الأوسط لمجلة دير شبيغل الألمانية.(
[نشر هذا التحقيق بالألمانية، وفي 24 سبتمبر/ أيلول 2014 نُشر بالإنكليزية على الموقع الالكتروني لمجلة دير شبيغل:
www.spiegel.de
المستقبل