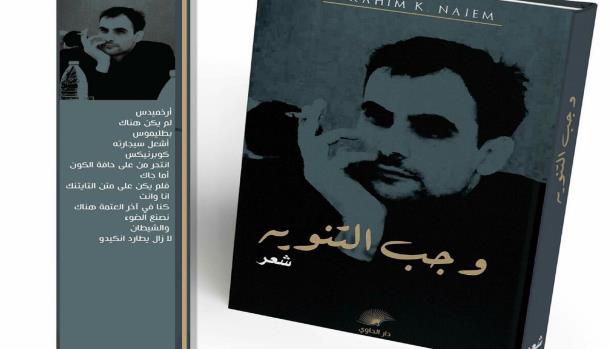بلاترس القبرصية… من هنا مرَّ سيفيرس/ أمجد ناصر

العنادلُ لن تدعك تنام في بلاترس
أيها العندليب الخجول، في تنفّس أوراق الشجر،
يا من تُضفي برودة موسيقى الغابة على الأجساد الممزقة،
على أرواح أولئك الذين يعرفون أنهم لن يعودوا.
أيها الصوت الأعمى الذي يتلمَّس طريقه في ظلام الذاكرة
وراء الخطى والإيماءات – ولن أجرؤ على قول: القبلات –
والغضبة المهتاجة للمرأة الأسيرة.
بلاترس: أين بلاترس؟
وهذه الجزيرة: من يعرفها؟
لقد عشت حياتي أسمع أسماء لم أسمع بها من قبل:
بلداناً جديدة، حماقات جديدة لأناس أو آلهة.
قدري الذي يتأرّجح بين السيف الأخير لـ “إياكس” ما و”سلامي” أخرى
جاء بي إلى هنا،
إلى هذا الشاطئ.
هذا مقطع من قصيدة لجورج سيفيرس (1900- 1971)، أول شاعر يوناني ينال جائزة نوبل للآداب عام 1963، يتحدث فيها عن بلدة بلاترس القبرصية، الجبلية، التي كان يتردَّد إليها في السنين الأخيرة من حياته. يخطر في بال من يذهب إلى بلاترس أسماء بعض زوارها الكبار، إن كان يعرف، طبعاً، طرفاً من تاريخها. لا اسم يتقدَّم، في المدوَّنة الأدبية، على اسم سيفيرس، أما في الأرشيف الحكومي فيتقدَّم الزوارَ الدائمين الملكُ فاروق، آخر ملوك سلالة محمد علي التي حكمت مصر حتى مجيء الضباط الأحرار في تموز / يوليو 1952. هناك أميرات يونانيات، أيام الملكية، وحكام بريطانيون سابقون للجزيرة، أيام “الانتداب” البريطاني، وكتاب إنكليز، لكنهم أقلُّ شأناً من سيفيرس، وفاروق الذي صُنِعَ له فيها شراب من البراندي صار يعرف باسمه. أعدَّت هذه البلدة، التي تقع في سفح جبل ترودس الضخم، نفسها، باكراً، لكي تكون منتجعاً للباحثين عن الهدوء والعزلة والهواء العابق برائحة الصنوبر على بعد 25 كيلومتراً من مدينة ليماسول الساحلية، ونحو 45 كيلومتراً من العاصمة نيقوسيا التي لا تطلُّ على بحر. هكذا كانت منذ مطلع القرن العشرين، وهكذا لا تزال إلى اليوم رغم الأزمة الاقتصادية التي تمسك بتلابيب الجزيرة.. والعالم إلى حد ما.
عبقر سيفيرس
يمكن القول إن بلاترس شكَّلت نوعاً من “عبقر”، وادي الإلهام الشعري العربي الأسطوري، لسفيرس. فعندما جاءها في أوائل خمسينيات القرن الماضي كان قد توقف عن كتابة الشعر نحو سبع سنين. ربما هذا ما جعله يعود إلى البلدة القبرصية الصغيرة مرة فأخرى. في المقطع الذي ترجمته، آنفاً، تردُ بلاترس بالاسم في قصيدته “هيلين”. وهذه القصيدة لها علاقة، كما هو واضح، بالبلدة، بيد أنها ليست الوحيدة المستوحاة منها أو المكتوبة فيها، فهناك أكثر من عمل شعري له في هذا الصدد. مهما كانت واقعية الشعر يظل غير واقعي، أي أنه ليس نقلاً للواقع ولا نسخاً له. هذا هو الشعر في عمومه والشعر الحديث تحديداً. وهكذا تتراءى بلدة بلاترس القبرصية، في مدونة سيفيرس الشعرية، بين الواقعي: البلدة الجبلية التي تنام في كتف جبل ترودس، محاطة بالسفوح والوديان ذات الانحدار الشديد، المكللة بأشجار الصنوبر، والأسطوري الذي يستدعي أصوات أبطال الملاحم اليونانية والآلهة التي هجرها البشر.
قد لا تتراءى بلاترس على هذا النحو لشاعر إنكليزي مثلاً. ربما يرى فيها، فقط، صور الطبيعة الباهرة، الوديان العميقة، السفوح التي تهرول في اتجاه البحر، روائح الشواء التي تتصاعد من المطاعم وبرودة كأس البيرة في درجة حرارة ثلاثين في الظل. هذا الأخير شاعر محايد حيال التاريخ. لا تعيش فيه أرواح أسلاف قدماء، ولا تتردَّد في ذهنه أصداء الملاحم وصيحات الأبطال. وليس هذا حال سيفيرس، ابن جيل الثلاثينيات، الذي قامت على أكتافه نهضة الشعر اليوناني الحديث. كان الماضي مهماً لسيفيرس، مثلما كان مهماً لسلفه المباشر كافافيس، فاليونان الحاضرة، المهزومة في الحرب التركية، لا تملك صناعة ولا اقتصاداً ولا شوكة عسكرية في عالم كان يخرج من حرب كبرى طاحنة ليدخل في حرب كبرى طاحنة. كان لديها خزانتها الذهبية: الماضي العريق. الفلسفة، المنطق، العلوم، الشعر والملاحم المسرحية والأبطال والآلهة والفتوحات الهائلة. فهذا، قبل كل شيء، هو الجذر الذي تستمد منه الحضارة “الغربية” نسغها. هذا هو الاسم الذي تنتسب إليه عندما تبحث الأمم عن آباء وأسلاف.
كان سيفيرس، ومعظم أبناء جيله، أوروبياً بقدر ما كان يونانياً، بل لعل “خلطته” كانت أكثر تعقيداً من غيره، فهو يوناني من أزمير “التركية”، و”أوروبي” من آسيا الصغرى. شاب غادر مرابع طفولته في مدينة تغير اسمها ونسبها وصارت في جهة العدو، يدرس الأدب والحقوق في باريس، ويعيش هناك فترة انفجار التيارات الأدبية والفنية والسياسية التي لم تعرف أوروبا، وربما العالم، أهم منها: الدادائية، السوريالية، الماركسية، بعد التكعيبية والتعبيرية والرمزية التي كانت لا تزال تتلكأ في الأدب والفن. وبين شعراء جيله يملك جورج سيفيرس إحساساً عميقاً بالمنفى، فأثينا التي تستقر فيها عائلته الإزميرية، لم تكن موطنه ومرابع طفولته، بل تلك المدينة الإيجية الآسيوية التي يختلط فيها الأتراك باليونانيين والأرمن وكانت تسمى باليونانية سميرناه، ولم يبق فيها يونانيون مسيحيون بعدما تبادل الأتراك، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، والحكومة اليونانية، السكان على أساس ديني.
خفَّة الهواء
سأعود إلى سيفيرس مرة أخرى. أما الآن فأنا في الطريق الى بلاترس. وكان ينبغي أن أبدأ مقالي بوصفها وتقديمها للقارىء، غير أن الشعر غلبني، كما يفعل دائماً حتى وأنا في قلب نثر النثر. أتساءل مثل سيفيرس : أين بلاترس؟ وهذا سؤال له علاقة بالطريق الفعلي إليها وليس الفكري، أو الوجودي، الذي قصده سيفيرس. ها هي الشواخص تدلني إليها. من ليماسول تصعد سيارتي الكورية المستأجرة، غير المعدَّة لصعود طرقات وعرة بصعوبة. أفتح شباك السيارة. فلا ضرورة لمكيِّفٍ تحتاجه، أكيداً، في الساحل. الهواء يخفُّ. حتى من دون أن ترى صعودك شبه العمودي، ستعرف أنك انتقلت من ثقل هواء الساحل ورطوبته إلى خفّة هواء الجبل المتلاعبة. الهواء معبأ برائحة الصنوبر. لا تتمكن، إن كنت تقود السيارة، من التلفّت إلى السفوح والوديان التي تزداد عمقاً وتشعّباً وأنت تعبر. عليك أن تركِّز على الطريق، جيدة التعبيد، ولكن الضيّقة. من “كوع” إلى “كوع” تستمر الطريق. كأنك تقود سيارتك في “زكزاك” لا يتوقف. والسيارة الكورية الصغيرة المستأجرة تئن على الغيار الأول والثاني ونادراً ما تصل إلى الثالث.
ها هي الشاخصة تشير إلى بلاترس. انعطف، يساراً، من الشارع الوحيد الصاعد إلى جبل ترودس، الذي تبلغ أعلى قممه، أولومبوس، نحو ألفي متر. من بيوتها ومرافقها تعرف أنك تدخل بلدة عريقة. يبدو الماضي وقد ترك أكثر من أثر فيها. وهي آثار يحافظ عليها الأهلون لأنها صارت مصدر رزقهم. لا أتحدث عن آثار (آركيولوجية، أوابد) بل عن بيوت ومرافق وفنادق من الماضي الحديث: بداية القرن العشرين.
براندي لفاروق
تعلّقُ سيفيرس بقبرص، وبلدة بلاترس، له جذر نوستالجي. فهي تذكّره بمدينة طفولته، وبحر طفولته، والمزيج اليوناني التركي لعالم طفولته، المفقود إلى الأبد. سيعود سيفيرس إلى تركيا مرة أخرى ولكن سفيراً لليونان هذه المرة في “بلاده” الأولى.
في البلدة أكثر من مَعْلَمٍ يذكّر زائرها بالشاعر والدبلوماسي اليوناني منها قاعة كبيرة مسماة باسمه في مبنى البلدية القديم، أُعيد ترميمها وجَعْلها مرفقاً للمعارض والاحتفالات. وفيها “فندق الغابة” الذي سيقولون لك إنه كان المكان المفضَّل للملك فاروق، وفيه صنعوا له شراباً مخصوصاً من البراندي، فبلاترس كانت، يومها، معروفة بزراعة العنب وصناعة النبيذ. لا منبسط في البلدة سوى ساحة صغيرة تتوزع على جوانبها مطاعم على الطراز القبرصي. هناك مطعم ستعرف أنه مشهور، على مستوى الجزيرة، بهذه الحلوى التي عندما ينطقونها سيرنَّ جِرْسٌ عربي في الجو: لوقماتوس. كانت “العوامة” كما نسميها في بلاد الشام، أو لقمة القاضي كما تسمى في مصر، أو اللقيمات في تسمية مشرقية أخرى. لا تستغرب إن سمعت أسماء مأكولات، حلوى، أدوات، تذكَّرك بالعربية، فهي، على الأغلب، كذلك غير أنها هاجرت إلى التركية ومنها إلى اليونانية القبرصية، وهذا لا يدعو إلى الفخر.. أو الأسف.
هذا وتؤكد الأبحاث الأثرية في جزيرة قبرص أن أول موجة استيطان بشرية للجزيرة جاءت من المشرق (لافانت) في نحو الألفية العاشرة قبل الميلاد، وكانوا مزارعين جلبوا معهم أنواعاً من الحيوانات لم تكن تعرفها الجزيرة، مثل الأغنام، والكلاب، والماعز والخنازير.
سيظل التواجد والتأثير المشرقيان مستمرين في الجزيرة من خلال الفينيقيين، ثم العرب المسلمين الذين استولوا على قبرص أيام معاوية بن أبي سفيان في معركة ذات الصواري مع البيزنطيين. في أيام عبد الملك بن مروان تم إبرام اتفاق مع الإمبراطور البيزنطي، جوستينيان الثاني، لحكم الجزيرة سوية واستمر هذا الاتفاق نحو ثلاثمائة سنة.
العربي الجديد