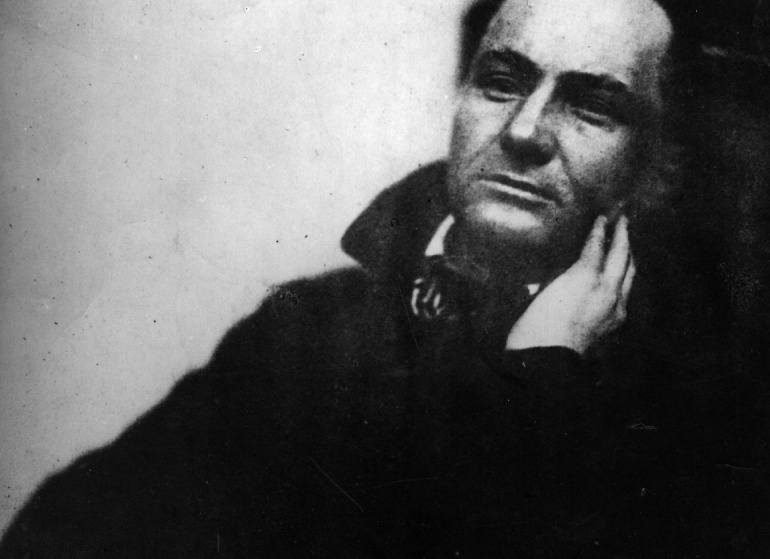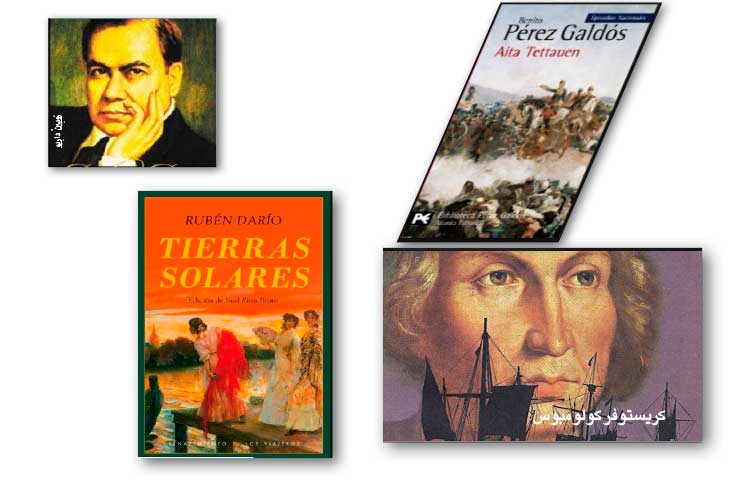بوّابة الرجاء/ محمود الزيباوي
تحولت غوطة دمشق في السنتين الأخيرتين ساحةً لحرب ضروس تزداد حدّة يوماً بعد يوم، وتردّد اسم هذه البقعة السورية في سائر أنحاء العالم اثر الهجوم الكيميائي الذي قضى أخيراً على المئات من سكانها. بات اسم الغوطة مرادفاً لهذا الهجوم الرهيب، وهي في كتب التراث “أنزه بلاد الله وأحسنها منظراً”، و”إحدى جنان الأرض الأربع”.
في “العقد الفريد”، تحدث ابن عبد ربّه الأندلسي عن بلاد الشام، وقال: “أول حد الشام من طريق مصر أمج، ثم يليها غزة، ثم الرملة رملة فلسطين، ومدينتها العظمى فلسطين وعسقلان، وبها بيت المقدس. وفلسطين هي الشام الأولى. ثم الشام الثانية، هي الأردن، ومدينتها العظمى طبرية، وهي التي على شاطئ البحيرة، والغور واليرموك، وبيسان فيما بين فلسطين والأردن. ثم الشام الثالثة الغوطة، ومدينتها العظمى دمشق، ومن سواحلها طرابلس. ثم الشام الرابعة وهي أرض حمص. ثم الشام الخامسة وهي قنسرين، ومدينتها العظمى حلب”.
من العهد العباسي إلى العهد المملوكي، استفاض أهل الأدب والأخبار في وصف الشام الثالثة، وتباروا في تعظيمها وإجلالها. كلّما ذُكر اسم الغوطة ذُكر اسم دمشق، وكلّما ذُكر اسم دمشق، ذُكر اسم الغوطة، وكأنهما توأمان. في القرن العاشر، ذكر الإصطخري في “المسالك والممالك” جند دمشق، وأكّد أن قصبتها مدينة دمشق، “وهي أجمل مدينة بالشام كلها، وهي في أرض واسعة بين جبال تحيط بها مياه كثيرة وأشجار وزروع متصلة، وتُسمى تلك البقعة الغوطة، عرضها مرحلة في مرحلتين، ليس بالمغرب مكان أنزه منه”. في القرن الثاني عشر، حدّد الإدريسي موقع دمشق الجغرافي في “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق”، وأضاف معلّقاً: “ومدينة دمشق من أجمل بلاد الشام، وأحسنها مكاناً، وأعدلها هواء، وأطيبها ثرىً، وأكثرها مياهاً، وأغزرها فواكه، وأعمّها خصباً، وأوفرها مالاً، وأكثرها جنداً، وأشمخها بناءً، ولها جبال ومزارع تعرف بالغوطة، وطول الغوطة مرحلتان في عرض مرحلة، وبها ضياع كالمدن، مثل المزة وداريا وبرزة وحرسة وكوكبا وبلاس وكفرسوسية وبيت الأهواء، وبها جامع قريب الشبه بجامع دمشق”. في الختام، رأى الجغرافي المغربي أن دمشق هي “أنزه بلاد الله”، وقال إن “مياه الغوطة الجارية بها تخرج من عين الفيجة، وهذه العين في أعلى جبل، وينصبّ ماؤها من أعلى هذا الجبل كالنهر العظيم له صوت هائل ودوي عظيم يُسمع على بعد، ويُرى نزول الماء من أعلى الجبل على قرية ابل حتى ينتهي إلى المدينة فتتفرع منه الأنهار المعروفة بها”.
كأنّها الجنة
في نهاية العهد العباسي، قدّم ياقوت الحموي في “معجم البلدان” تعريفاً بالغوطة، ونصّه: “الغوطة بالضم ثم السكون وطاء مهملة وهو من الغائط وهو المطمئن من الأرض، وجمعه غيطان وأغواط. وقال ابن الأعرابي: الغوطة مجتمع النبات. وقال ابن شميل: الغوطة الوهدة في الأرض المطمئنة. والغوطة هي الكورة التي منها دمشق، استدارتها ثمانية عشر ميلا، يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها، ولا سيما من شماليها، فإن جبالها عالية جدا، ومياهها خارجة من تلك الجبال، وتمد في الغوطة في عدة أنهر فتسقي بساتينها وزروعها، ويصبّ باقيها في أجمة هناك وبحيرة. والغوطة كلها أشجار وأنهار متصلة قلّ أن يكون بها مزارع للمستغلات إلا في مواضع كثيرة، وهي بالإجماع أنزه بلاد الله وأحسنها منظراً، وهي إحدى جنان الأرض الأربع وهي الصغد والأبلة وشِعب بوان والغوطة، وهي أجلّها”.
تتكرّر مقولة “جنان الأرض الأربع” وتتردّد في العديد من امهات الكتب، وهذه الجنان هي صغد سمرقند، والأبلة الواقعة على شط العرب في البصرة، وشِعبُ بوان في أرض فارس بين ارجان والنوبندجان، وغوطة دمشق. ويرى الكثيرون من الكتاب أن أجمل هذه الجنان الأربعة وأبهاها هي الغوطة. في “آثار البلاد وأخبار العباد”، استعاد القزويني هذا الوصف، ونقل عن أبي بكر الخوارزمي قوله: “جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق، وصغد سمرقند، وشعب بوان، وجزيرة الأبلة، وقد رأيتها كلها فأحسنها غوطة دمشق”. في “ربيع الأبرار”، نقل الزمخشري قول أبي بكر الخوارزمي في صيغة مغايرة تتميّز ببلاغتها الرفيعة، ونصّها: “قد رأيتها كلها، فكان فضل الغوطة على الثلاث كفضل الأربع على غيرهن، كأنّها الجنة صُوّرت على وجه الأرض”.
تكرّست هذه الصورة للغوطة في أدبيات العصر المملوكي، كما يُستدلّ من النصوص العديدة التي تعود إلى تلك الحقبة. في القرن الرابع عشر، تحدّث ابن الوردي عن “أرض الشام” في “خريدة العجائب وفريدة الغرائب”، وهي بحسب الكاتب “إقليم عظيم كثير الخيرات، جسيم البركات، ذو بساتين وجنات وغياض وروضات وفرج ومنتزهات وفواكه مختلفة”. “ومن مدن الشام الشهيرة دمشق المحروسة، وهي أجمل بلاد الشام مكاناً، وأحسنها بنياناً، وأعدلها هواء، وأغزرها ماء. وهي دار مملكة الشام، ولها الغوطة التي لم يكن على وجه الأرض مثلها، بها أنهار جارية مخترقة وعيون سارحة متدفقة وأشجار باسقة وثمار يانعة وفواكه مختلفة وقصور شاهقة، ولها ضياع كالمدن”. في “نهاية الأرب في فنون الأدب”، استعاد النويري من جديد مقولة “منتزهات الدنيا الأربعة”، وأكّد ان الغوطة هي أجلّها، فهي “شركُ العقول وقيدُ الخواطر، وعِقالُ النفوس ونزهةُ النواظر، خلخلت الأنهار أسواق أشجارها، وجاست المياهُ خلال ديارها، وصافحت أيدي النسيم أكفّ غُدرانها، ومُثلت في باطنها موائسُ أغصانها، يخال سالكها أن الشمس قد نثرت على أثوابه دنانير لا يستطيع أن يقبضها ببنان، ويتوهم المتأمّل لثمراتها أنها أشربةٌ قد وقفتْ بغير أوانٍ في كل أوان، فيا لها من رياضٍ من لم يطفْ بزهرها من قبل أن يحلق فقد قصر، ومن غياضٍ من لم يشاهدها في إبانها فقد من عمره الأكثر”.
لا يتغير المشهد في القرن الخامس عشر. في “الروض المعطار في خبر الأقطار”، اختزل الحِميري كتابات من سبقه من الرواة، وكتب في وصف الغوطة: “قيل هي قصبة دمشق، وقيل هو موضع متصل بدمشق من جهة باب الفراديس، جبال ومزارع. وطول الغوطة مرحلتان في عرض مرحلة، وبها ضياع كالمدن وجامع قريب الشبه بجامع دمشق. والغوطة أشجار وأنهار ومياه محدقة تشقّ البساتين، وبها من أنواع الفواكه ما لا يحيط به تحصيل خصباً وطيباً”، “ويخرج ماء الغوطة من عين تنحط من أعلى الجبل كالنهر العظيم، لها صوت هائل ودوي عظيم يسمع على بعد”.
بستان واسع ريّان
تتقاطع هذه الكتابات العربية مع نصوص عدد من الرحّالة الفرنسيين الذين قدموا من الغرب إلى الشرق لأغراض مختلفة بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. تحت عنوان “دمشق في نصوص الرحّالة الفرنسيين”، جمعت الباحثة اللبنانية كارين صادر طائفة من هذه النصوص ونقلتها إلى العربية، وأشارت في تقديمها لهذه الكتابات إلى ثبات صورة دمشق في المخيلة الأوروبية: “إنها نقلة من الصحراء إلى الخضرة، ومن الجفاف إلى الماء، ومن الحزن إلى السرور، وصلة وصل بين حضارتين قديمتين هما مصر وما بين النهرين، وهي موطن المعابد والقصور والمغاور والكهوف والمقامات والمقاهي والبساتين، ومنحة الغوطة رئتها، وهبة بردى صديقها القديم قدم المدينة التي يدفق الحياة في أوردتها”.
أقدم النصوص المنشورة يعود إلى عام 1413، وهو لبرتراندون دو لابروكير، صاحب “رحلة إلى ما وراء البحار”. يقول الكاتب في وصف دمشق: “مدينة كبيرة واسعة، وفيها حدائق جميلة جداً هي من أكبر ما رأيت، وفيها أفضل الفواكه ووفرة المياه، لأنه من النادر، كما يقال، أن تجد بيتاً ليس فيه نبعة ماء”. يتكرر هذا الوصف في نص يعود إلى 1581، وهو من كتاب “من الإسكندرية إلى اسطنبول” للأب جان باليرن. يبدو الكاتب منبهراً بموقع المدينة الطبيعي، ويبرز هذا الانبهار في قوله: “لا يمكن لمن يرى دمشق إلا وأن يعترف من تلقاء نفسه بأنها في الموقع الأجمل في العالم”، فهي “وسط سهل جميل مغروس بأشجار متنوعة دائمة الخضرة”، تحدّها الجبال العالية من جهة، والصحراء من جهة أخرى، وفيها “كل أنواع الفواكه الموجودة في أوروبا”. في القرن التاسع عشر، يتحدث العالم قسطنطين فرنسوا فولني متعجباً عن ثمار المدينة ويقول: “في دمشق أثمار نواحينا جميعا، فتربتها تصلح لتفاح نورماندي وخوخ لاتورين ودراق باريس، وفيها من المشمش عشرون نوعاً، واللوزي منه يرغبه الناس في كل تركيا”. في المعنى نفسه، يذكر الطبيب لويس داموازو كيف قصد دمشق، ووجد نفسه وسط “بستان واسع ريّان”.
بوّابة الرجاء
هنا وهناك، تتجلى الغوطة في أبهى صورها ومشاهدها، وتبقى “بالإجماع أنزه بلاد الله وأحسنها منظراً”، كما كتب ياقوت الحموي في القرن الثالث عشر. ورث شعراء القرن العشرين هذه الرؤيا، ومنهم أدونيس الذي خاطب دمشق في “تحولات الصقر”، وقال: “رسمت عينيك على كتابي/ حلمت ميراثك في شبابي/ في الغوطة الخضراء في سفوح قاسيون”، “أمس/ أنا والشعر والنهار/ جئنا إلى الغوطة واقتحمنا/ بوابة الرجاء/ نستصرخ الحقول والمياه/ ننسج منها راية وجيشاً/ نغزو به سماءك السوداء/ ولم نزل ننسج يا دمشق/ لا الموت يلهينا ولا سواه/ أنّى لنا الموت أو الراحة يا دمشق؟”.
في منتصف الستينات، غنّت فيروز من شعر سعيد عقل: “ويحهُ ذاتَ تلاقينا على سُندس الغوطة والدنيا غروبُ/ قال لي أشياءَ لا أعرفها كالعصافير تُنائي وتـؤوبُ”. في منتصف السبعينات، عادت وغنّت من نظم الشاعر نفسه: “دمشق بغوطتك الوادعة/ حنين إلى الحب لا ينتهي/ كأنك حلمي الذي أشتهي/ هوى ملء قصتك الدامعة/ تمايل سكرى به/ دمشق كشمس الضحى الطالعة”. ردّد الكثيرون من بعد فيروز هذه الأبيات، وباتت الغوطة في مخيّلة من زارها ومن لم يزرها، هذه البلاد السكرى التي “لها تربةٌ نايٌ ونهرٌ عندليبُ”. هي هذه الغوطة التي تتدمّر وتحترق اليوم في حرب مسعورة لا تعرف هدنة. وها نحن نشهد دمارها عاجزين ولا نملك سوى أن نرثيها بحسرة.
النهار