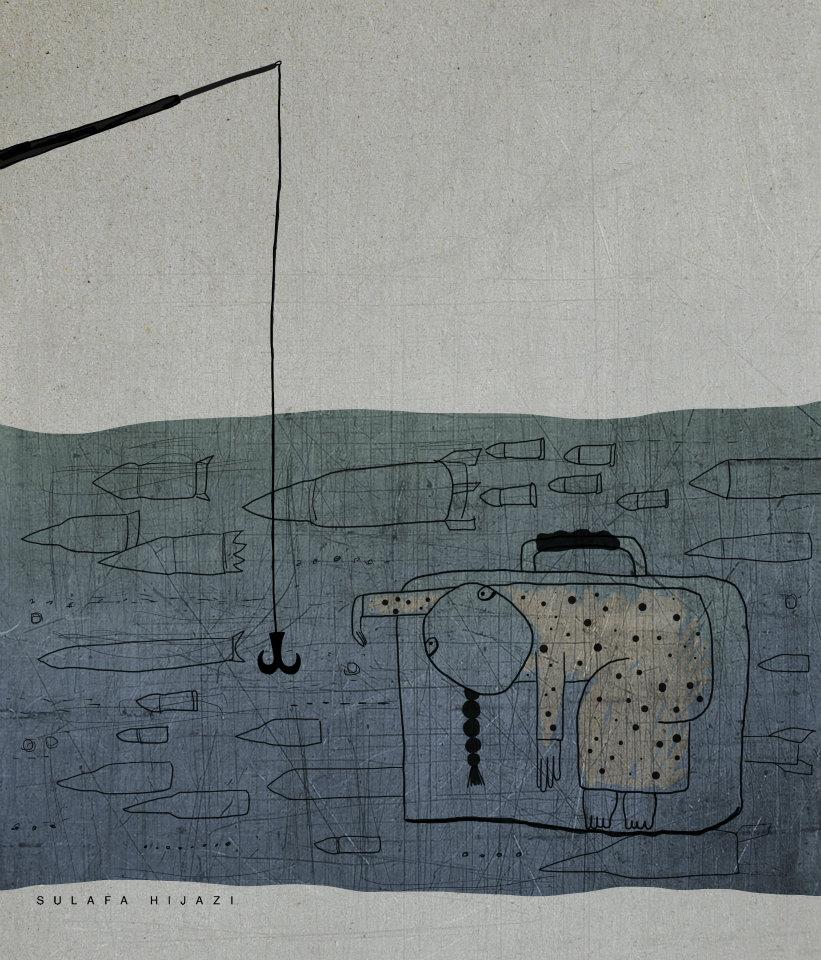تركيا والانتفاضة السورية: الخيار الاطلسي ام الخلافة العثمانية؟
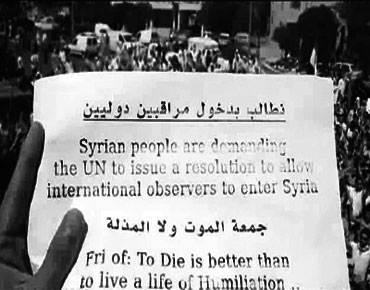
صبحي حديدي
ليست مصادفة محضة، كما أنها لا تُعزى إلى مرونة القوانين الناظمة لحرّية التعبير وحدها، أنّ تركيا استضافت غالبية المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة السورية في الخارج، من جهة أولى؛ وأنّ مقرّ قيادة جماعة الإخوان المسلمين السورية قد انتقل من عمّان ولندن إلى اسطنبول، من جهة ثانية؛ وأنّ رجال أعمال سوريين معارضين للنظام لأنهم تضرّروا من سياساته، من أمثال آل سنقر، صاروا يجدون راحة أكبر في إطلاق المبادرات من أنقرة، بدل القاهرة أو طرابلس (لبنان)، من جانب ثالث. وهكذا، في ملاحظة الشكل الأولى، ليس صحيحاً أنّ المنابر التركية (وهي، في نهاية المطاف، ليست حكومية أو رسمية البتة) لا تشرع أبوابها إلا للإسلاميين، كما تردّد مراراً؛ إذْ شهدت المؤتمرات واللقاءات ولجان العمل حضور سوريين من مشارب شتى، من أهل اليمين واليسار والوسط، المتديّن فيهم مثل العلماني، والماركسي مثل الليبرالي، فضلاً عن التنويعات الإثنية والدينية والمذهبية كافة.
هذا من حيث الشكل، الذي يعكس في واقع الأمر بعض علائم المحتوى أيضاً، في أنه يسبغ على تحركات المعارضة السورية صفة سياسية، وربما إيديولوجية، ليس من السهل التهرّب منها: أنّ الحاضنة الأولى لهذه المؤتمرات، بالمعنى القانوني والإجرائي على الأقلّ، هي في عهدة شخصيات أو مؤسسات تابعة لـ’حزب العدالة والتنمية’ التركي الحاكم؛ وأنّ هذه الحاضنة تشكّل، بدورها، ميداناً عملياً لرأب الصدع الظاهري بين موقف الحكومة التركية من الإنتفاضة السورية، وموقف الحزب الحاكم. في عبارة أخرى، ما يجد المسؤول التركي حرجاً في التصريح به، لا يتردد المسؤول الحزبي التركي في الإعراب عنه من خلال رعاية هذا أو ذاك من لقاءات السوريين على الأرض التركية؛ فلا تقع الحكومة التركية في محذور قد يحمّلها أعباء دبلوماسية وسياسية في غير أوانها، ولا يفوت المسؤول الحزبي أن يشبع تطلّع جماهير الحزب إلى مواقف أكثر صلابة في تأييد الشعب السوري، الجار في الجغرافيا، والشريك في التاريخ، والأخ في الإسلام.
وثمة سلسلة من الاعتبارات التي حكمت وتحكم العلاقة بين النظام السوري وتركيا المعاصرة، في عهد ‘حزب العدالة والتنمية’ بصفة خاصة، ترقى من الجانب التركي إلى مستوى المزايا الكبرى الجيو ـ سياسية والاقتصادية والإيديولوجية، على مستوى تركي محلّي، وآخر إقليمي وإسلامي، وثالث أوروبي وأطلسي. بيد أنّ الحال تغيّرت، وكان لا بدّ لها من أن تتغيّر، بعد انطلاق الإنتفاضة السورية، ولجوء النظام الفوري إلى الحلّ الأمني وأعمال العنف الوحشية ضدّ المدنيين العزّل والتظاهرات السلمية، سيّما تلك التي وقعت في جسر الشغور والقرى المحاذية للحدود، وأجبرت آلاف السوريين على اللجوء إلى تركيا. وهكذا، كانت العلاقات التركية مع النظام السوري في أبهى أزمنتها، فأخذت تتدهور يوماً بعد آخر، وكلما حنث بشار الأسد بما قطعه من وعود لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شخصياً؛ وتوجّب أن تنقلب اعتبارات الجوار من مزايا إلى تحدّيات، ومن مغانم إلى مخاطر.
فعلى الصعيد الجيو ـ سياسي، كان على تركيا أن تتخلى عن ركائز كبرى في فلسفة وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو، وهي الناظمة للسياسة الخارجية التركية منذ نجاح ‘حزب العدالة والتنمية’ في حيازة أغلبية برلمانية مريحة. بين تلك الركائز مبدأ تطوير علاقات متعددة المحاور مع القوقاز، والبلقان، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأسود، وكامل حوض المتوسط؛ وليس الإقتصار على علاقات أنقرة التقليدية مع أوروبا والولايات المتحدة، أو البقاء في أسر التلهف على عضوية الإتحاد الأوروبي.
ركيزة ثانية هي خيار ‘الدرجة صفر في النزاع’ مع الجوار، من منطلق أنه أياً كانت الخلافات بين الدول المتجاورة، فإنّ العلاقات يمكن تحسينها عن طريق تقوية الصلات الاقتصادية. وفي الماضي كانت تركيا تحاول ضمان أمنها القومي عن طريق استخدام ‘القوّة الخشنة’، واليوم ‘نعرف أنّ الدول التي تمارس النفوذ العابر لحدودها، عن طريق استخدام القوة الناعمة هي التي تفلح حقاً في حماية نفسها’، كما ساجل داود أوغلو في كتابه الشهير ‘العمق الستراتيجي: موقع تركيا الدولي’.
وتدهور العلاقات مع النظام السوري يعني، أيضاً، هذا المقدار أو ذاك من تدهور العلاقات مع إيران، ومع حكومة نوري المالكي في العراق، و’حزب الله’ في لبنان…
كذلك، على الصعيد الاقتصادي، ظلّت تركيا حريصة على إدامة ميزان تجاري رابح تماماً بالنسبة إلى أنقرة، وخاسر على نحو فاضح من الجانب السوري، بلغ 2,5 مليار دولار في سنة 1010، بزيادة تقارب 43 بالمئة، وكان يُنتظر له أن يبلغ خمسة مليارات في السنتين القادمتين. الصادرات التركية تشمل المعدّات الكهربائية، والوقود المعدني، والزيوت النباتية والحيوانية، والبلاستيك، ومنتجات الصناعات التحويلية والمؤتمتة، ومشتقات البترول المصنعة، والمنتجات الكيماوية، والإسمنت، ومنتجات الحديد والصلب، وصناعة القرميد والبلاط، والمنتجات الجلدية، والأخشاب، والقمح، والدقيق، والسمن النباتي، والملابس الجاهزة… الإستثمارات التركية في سورية تبلغ أكثر من 260 مليون دولار، وتحتلّ الشركات التركية المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التابعة لجهات أجنبية… ولقد اتضح، طيلة أسابيع الإنتفاضة، أنّ كبار التجار الأتراك تكاتفوا مع كبار التجّار السوريين، في حلب ودمشق بصفة خاصة، لإبقاء العاملين في مؤسساتهم بمنأى عن الحراك الشعبي، حتى إذا كلّفهم ذلك سداد تعويضات إضافية ومغريات مادية مجزية.
ومن جانب آخر، تغاضى النظام السوري عن شحّ مياه نهر الفرات بسبب تغذية السدود التركية المتزايدة، وتعاونت الأجهزة الأمنية السورية مع الأجهزة الأمنية التركية في تعقّب أنصار ‘حزب العمال الكردستاني’، الـ PKK، الذين كانت دمشق تزوّدهم بالسلاح ومعسكرات التدريب حتى عام 1998، بل وحدث مراراً أنها سهّلت قيام الأتراك بعمليات إغارة على القرى السورية المحاذية للحدود مع تركيا، بهدف اعتقال أولئك الأنصار.
الأهمّ من هذه الاعتبارات الاقتصادية، الجيو ـ سياسية بامتياز ايضاً، أنّ النظام السوري أقرّ، ضمنياً، بالسيادة التركية التامة على لواء الإسكندرون، وهو منطقة سورية واسعة قامت تركيا بغزوها سنة 1938، قبل أن تسلخها سلطات الإنتداب الفرنسية عن الجسم السوري، وتضمّها إلى تركيا.
في المستوى الإيديولوجي، لم يكن ‘حزب العدالة والتنمية’ يملك الكثير من هوامش المناورة في ضبط مشاعر جماهيره وناخبيه، وغالبيتهم الساحقة من المسلمين السنّة، إزاء ما يرتكبه النظام السوري من مجازر وأعمال وحشية، وخاصة في مواقع ذات قيمة عاطفية ورمزية عالية مثل مدينة حماة، فضلاً عن دمشق التي تظلّ ‘الشام الشريفة’ في ناظر الجمهور التركي العريض. وكيف للفريق التركي الحاكم أن يسكت عن جرائم النظام السوري، فيضحّي بما اكتسبته تركيا من شعبية واسعة في الضمير العربي العريض، بسبب الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزّة، وانسحاب أردوغان من سجال مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في ملتقى دافوس، ومأثرة ‘أسطول الحرية’، وسواها؟
وفي الجانب الذي يخصّ المقارنة بين نظامين في الحكم، لا مناص للجارة تركيا من أن تشكّل مثالاً نقيضاً، وبالتالي قدوة حسنة، لمواطن سوري عانى طيلة ثلاثة عقود من نظام الإستبداد والفساد الذي ترأسه حافظ الأسد، ويعيش منذ 11 سنة في ظلّ النظام ذاته بعد أن ازداد سوءاً وصار وراثياً وأقرب إلى حكم العصابات والشبيحة. صحيح أنّ الديمقراطية التركية لم تكن أبهى نماذج الديمقراطية في العالم، ولكنها في الحساب الأخير تقوم على انتخابات حرّة، وتداول سلمي للسلطة، وحرّيات مدنية أساسية؛ كما أنها، وهنا الأخطر ربما، ديمقراطية لا يغيب عنها العسكر والجنرالات، وهي إسلامية المنشأ، آسيوية شرق ـ أوسطية؛ واقتصادها مزدهر متطّور، ينتقل من نجاح إلى نجاح!
غير أن تركيا، بمعزل عن تطورات ما بعد انطلاق الإنتفاضة السورية، كانت تسير حثيثاً نحو احتلال موقع أبعد نفوذاً من ذاك الذي تتولاه قوّة أقليمية، لأنها ـ في فلسفة داود أوغلو، التي يتبناها أردوغان بالحرف تقريباً ـ قوّة دولية أوّلاً وقبلئذ، ويتوجب عليها أن تتصرّف على هذا الأساس، فتعمل على خلق منطقة تأثير تركية ستراتيجية، سياسية واقتصادية وثقافية. ولم يكن غريباً أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون ثمّنت عالياً، ومراراً، هذه المرونة التركية في التعامل مع محاور مسلمة ومسيحية ويهودية، في العالم العربي والإسلامي، وفي أوروبا وإسرائيل، فأطلقت على تركيا لقب ‘القوّة الكونية الصاعدة’.
البعض، ليس خارج تركيا فحسب، بل في داخلها أيضاً، يفضّل استخدام تعبير نظير، أكثر تعبيراً عن واقع الحال ربما: إمبراطورية عثمانية جديدة، وليدة، ناهضة من رماد ذلك ‘الرجل المريض’ الذي ساد، ثمّ تفكك، دون أن تبيده العقود تماماً!
وهنا، في تراث العلاقات السورية ـ التركية، لا تُنسى تلك الواقعة المفصلية التي شهدها صيف العام 1998، حين أبلغت تركيا الأسد الأب هذه الرسالة الوجيزة القاطعة التالية: إمّا أن يرفع النظام الغطاء عن عبد الله أوجلان، زعيم ‘حزب العمال الكردستاني’، فتطرده من سورية ومن البقاع اللبناني، وتغلق معسكراته، وتوقف أيّ دعم لوجستي وعسكري واستخباراتي كانت تقدّمه له؛ ثمّ تفعل الشيء ذاته مع ‘الجيش السرّي لتحرير أرمينيا’ ASALA، الذي يحظى برعاية أمنية سورية في لبنان؛ وإمّا… الحرب العسكرية المباشرة الشاملة، بوضوح وبساطة وبلا تأتأة! قبل تسليم الرسالة كانت تركيا قد استنفرت فرقة عسكرية كاملة، نشرتها مع قوّات مختلفة التسليح على طول الحدود مع سورية، فقلّب الأسد الأب الرسالة التركية على كلّ وجه ممكن، وتأكد أنّ أنقرة لا تمزح، فانحنى. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته، غادر أوجلان الأراضي السورية واللبنانية إلى غير رجعة، أو بالأحرى غادرها إلى حيث سيقيم اليوم: في المعتقل التركي!
وتركيا، إلى هذا، عضو في الحلف الأطلسي، يستمدّ من هذه العضوية سلسلة منافع، ويتكىء عليها لجني المزيد، أو لتعزيز أمن تركيا القومي والجيو ـ سياسي الستراتيجي؛ الأمر الذي يحفظه جنرالات تركيا عن ظهر قلب، وعلى نحو يدغدغ ذلك المزيج من التربية الإنكشارية العثمانية، والغطرسة الكمالية المتقنعة بالعلمانية. فإذا بلغ النظام السوري في حلّه الأمني مرحلة قصوى ختامية، وانتحارية، تبرّر للحلف الأطلسي اختراع تدخّل عسكري من نوع ما، كما في إقامة منطقة آمنة على سبيل المثال، أو فرض حصارات جوية وبحرية، فإنّ لعاب الجنرالات الأتراك لن يكون وحده الذي سوف يسيل، وسيلحق بهم الساسة المدنيون لا محالة، بذرائع قد تبدأ من خطر عودة الـPKK، ولا تنتهي عند زعم انهيار الحدود جرّاء تدفّق اللاجئين.
فإذا امتزجت فلسفة الإحياء العثمانية لدى ساسة ‘حزب العدالة والتنمية’، بنزوعات الإحياء الإنكشارية والأطلسية لدى الجنرالات الأتراك، وطُولب أصحاب المزيج باتخاذ موقف ‘إنساني’ من مأساة الشعب السوري ومجازر جلاديه من آل الأسد، فإنّ مؤتمرات اسطنبول وأنقرة لن تذهب سدى… لصالح الحاضنة التركية، غنيّ عن القول، وليس لمشاريع المجالس السورية ‘الإنقاذية’ و’الوطنية’ و’الإنتقالية’؛ فهذه ستواصل سجالاتها على الفضائيات وحدها، أغلب الظنّ، حيث الجعجعة بلا طحن!
‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس