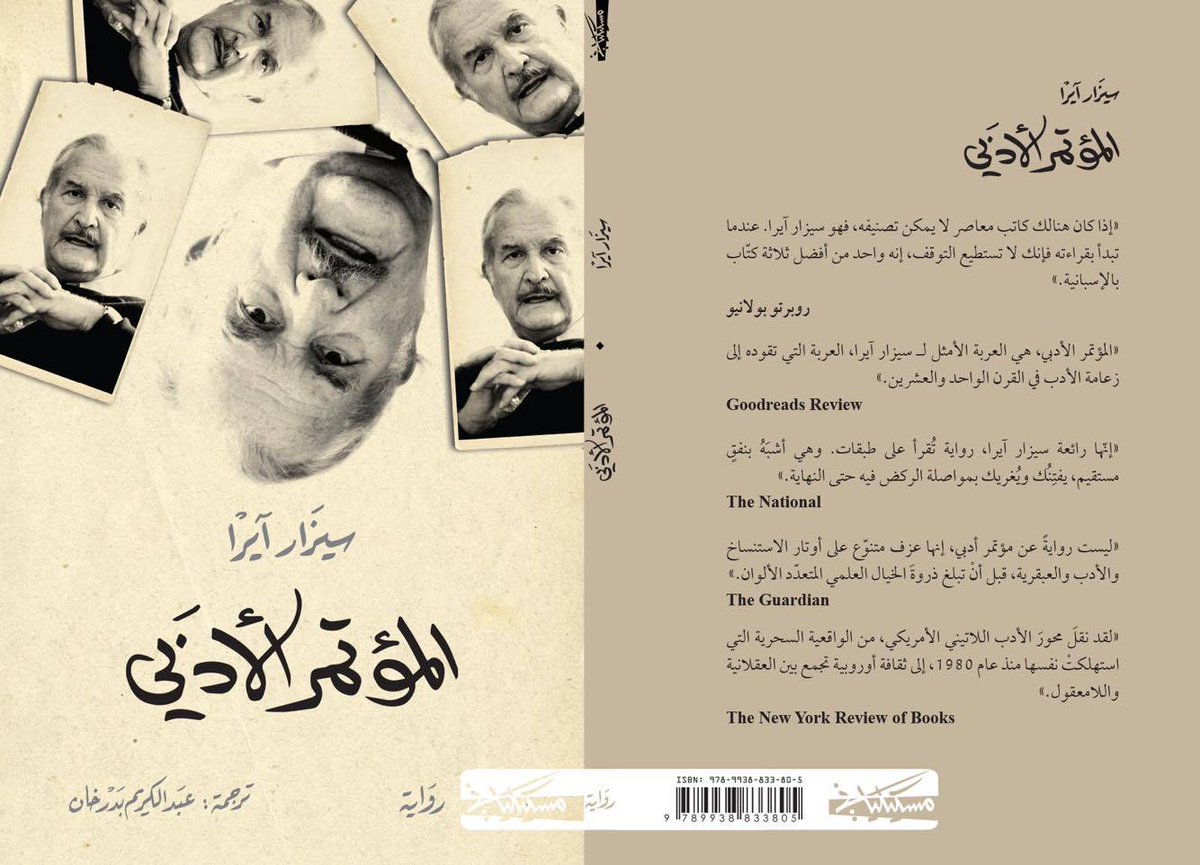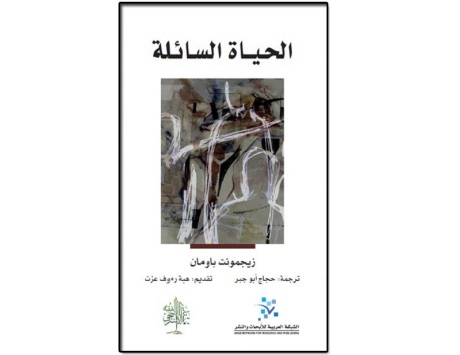ثقافة الطائفية/ أسامة المقدسي

ثقافة الطائفية
اسامة مقدسي ترجمة ثائر اديب – دار الاداب – بيروت لبنان
العدد 250
إعداد: زينب الطحان
ثقافة الطائفية: الطائفة والتاريخ والعنف في لبنان تحت الحكم العثماني
* الطائفية ليست دهرية
تتبدّى أهمية المراجعة التاريخية
للطائفية في لبنان عبر نظرة موجزة إلى الكتابات المتعددة عن «مشكلة الطائفية»في لبنان. ومن الرّؤى المميّزة في هذه الإشكالية رؤية المؤرّخ أسامة مقدسي في كتابه «ثقافة الطّائفية: الطائفة والتاريخ والعنف في لبنان القرن التاسع عشر تحت الحكم العثماني»، وهو من ترجمة «ثائر ديب» وإصدار «دار الآداب».
مقدسي هو أستاذ مشارك في دائرة التاريخ في جامعة رايس (هيوستن)، في الولايات المتحدة، وأول حاصل على كرسي الصندوق العربي ـ الأميركي التربوي للدراسات العربية فيها. في كتابه «ثقافة الطائفية» يبين «المقدسي» أن الطائفية في لبنان ليست دهرية، بل انبثقت بشكل واضح جداً في القرن التاسع عشر. وعليه، فإنها ليست مؤامرة عثمانية، ولا اختراعاً أوروبياً، ولا «طبيعة» لبنانية، وإنّما تعكس تحلّل النّظام الاجتماعي اللّبناني التّقليدي وسط وجود أوروبي متنامٍ وإصلاحات عثمانيّة كبرى في الشرق الأوسط. كما أنّ العنف الديني بين الموارنة والدروز، والّذي توّج بمجازر العام 1860، كان تعبيراً مركباً ومتعدد الطبقات عن التحديث Modernization لا ردّ فعل بدائياً له.
* دراسة مقدسي: الطائفية جزء حيوي من حداثتنا المعقدة
شهدت فترة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بروز دراسات جديدة لظاهرة الطائفية، دمجت التحليل النقدي لأصول الطائفية ومسار تطورها التاريخي، آخذةً بالاعتبار المسالك الثقافية، الخطابية والمؤسساتية التي أنتجت الطائفية وتستمر في إعادة إنتاجها إلى يومنا هذا. ويرى ماكس فايس – وهو أحد المنظِّرين للطائفية – أنّ هذه الدراسات النقدية «سعت إلى إيجاد أرضية وسطية في المشهد التأريخي للطائفية عبر تحديد العوامل المادية والثقافية التي أسهمت في إدامة النظم الطائفية والمجتمع الطائفي». ومن أبرز المساهمين في هذا «التيار النقدي» أسامة مقدسي، الذي يُظهر على نحو مقنع، عبر دراسة للعنف الطائفي بين الموارنة والدروز في جبل لبنان في منتصف القرن التاسع عشر، كيف أنّ الطائفية نبعت من تقاطع الإصلاحات العثمانية (المعروفة بـ«التنظيمات») والتدخل الأوروبي في المنطقة في القرن التاسع عشر. ففي القرن المذكور، «جرت»، بحسب مقدسي، «إعادة ابتكار جبل لبنان بحسب طوائفه، بمعنى أنّ هوية طائفية عامة وسياسية حلّت محل سياسات الوجاهة غير الطائفية التي كانت السمة المميزة لمجتمع ما قبل الإصلاح». لذلك يشدد مقدسي على عدم جدّية معاملة الطائفية «كنزوع قبليّ، وكتديّن بدائيّ معادٍ للحداثة»، مشيراً إلى أنّه لا بدّ من الاعتراف «بأنّ الطائفية جزء حيوي من حداثتنا المعقدة»، ويرى أنّ تأثيرها «كان في محصّلته سلبياً»، إذ إنّها «منعت ـ ولا تزال تمنع ـ تبلور مفهوم وطني شامل قادر على توحيد اللبنانيين».
ليس النظام الطائفي في لبنان أقدم نظام حكم عربي فحسب، بل لعله أيضاً أكثرها قوةً ورسوخاً، وخصوصاً على المستوى الاجتماعي. ذلك أنّه قام، على امتداد عقود من الحرب والسلم، بابتلاع أية مساحة عامة قد تمثّل إطاراً لتلاقي المصالح والتطلّعات المشتركة بين اللبنانيين، على تنوّع انتماءاتهم الاجتماعيّة والطائفيّة والمناطقيّة، لكن بالرغم من كلّ ذلك، فإنّ الطائفية في لبنان، متى نُظر إليها في سياقها التاريخي، ليست غريزة ولا حتميّة، بل هي، كما يشير أسامة مقدسي، «تعبّر عن ترجمة وتحوير لفكرة جديدة للمساواة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في مجتمع متعدد الطوائف وخاضع لضغوط خارجية ويفتقر على جميع المستويات إلى رؤية قادرة على تخيّل مستقبل أفضل».
كتاب مقدسي عن تكوين الهوية الطائفية في جبل لبنان بين 1839 وأحداث 1860 كان يجب أن يكون ثوريّاً بالنسبة إلى اللبنانيّين، وأن يفتح نقاشاً متجدّداً عن الهوية اللبنانية، لكن العمل – مع الأسف – لم ينل الاهتمام الذي يستحقّه، على الرغم من توافر ترجمة جيّدة له بالعربيّة. وتعود قلّة النقاش حول كتاب مقدسي لأنّ نتائجه تزعج الجميع في لبنان، الطائفيين وأعداءهم. فهو من ناحية يعامل الطوائف (بمعنى الهوية والسياسة) كتكوينات تاريخيّة، حديثة وعرضيّة، لكنّه، من المنطلق ذاته، يحلّلها كـ «قوميّات» و«محاولات أمم»، لا تختلف جوهرياً عن غيرها من الحركات القومية التي نشأت في القرنين الأخيرين، فحاز بعضها على دول وكيانات، وفشل كثيرها.
وما يشدد عليه أسامة مقدسي هو أن الطائفية ليست «مؤامرة» حاكتها القوى الخارجية في الماضي أو تحوكها الآن، فحسب، بل الأحرى أنها تعكس خيارات واعية لدى جماعات متعددة في وضع تاريخي محدد، فمع أن لكل أمة انقساماتها، إلا أننا لا نجد شكل الحكم الطائفي في كل أمة. ومن المؤكد أن بين العوامل الحاسمة في تطور الحكم الطائفي (في العراق اليوم كما في لبنان القرن التاسع عشر) ذلك التدخل المفرط الذي تمارسه القوى الغربية التي تقرأ الشرق قراءة استشراقية وطائفية، فطرية أو مطبوعة، وتفرض «حلولاً»تستند إلى قراءاتها الخاصة المغرضة. فثمة سبب في النهاية، لما يزجيه كولن باول وزير الخارجية في إدارة بوش الابن، من الثناء على نموذج السياسة الطائفية اللبناني وحض العراق على تبنيه.
في قراءة متأنية لهذا الكتاب تصل إلى نتيجة أوردها الباحث في ثنايا الصفحات، أن الطائفية بزغت في لبنان كممارسة حين نشب الصراع بين النخب المارونية والدرزية، وبين الأوروبيين والعثمانيين، حول تحديد علاقة عادلة ومنصفة لـ«القبيلتين» و«الأمتين» الدرزية والمارونية بدولة عثمانية تستهدف التحديث. بزغت الطائفية حين نزعت الثقة في منتصف القرن التاسع عشر عن النظام القديم في جبل لبنان، وهو نظام كان محكوماً بتراتب نخبوي تحدد فيه السياسة المنزلة في الدنيا لا الانتماء في الدين. فلقد فتح انهيار النظامِ القديمِ الفضاءَ لتشكلٍ جديدٍ من السياسة والتمثيل قائمٍ على لغة المساواة الدينية، ولقد أعلى هذا التحول من شأن الطائفة بدلاً من المكانة النخبوية، وجعلها الأساس لأي مشروع من مشروعات التحديث والمواطنة والتحضر.
* الإرساليات التبشيرية وإغفال دورها في «الطائفية»
ولقد أغفل الكاتب، ربما عن غير قصد منه، وأستغرب هذا الإغفال، دور الإرساليات التبشيرية، إذ إنه في ظل فضاءات دولية، في القرن التاسع عشر، نجحت النخبة الشامية، ومنها جبل لبنان، بتوليد أنماط من التفكير المعاصر تَميَّز بنوع من الخصوصية الثقافية. وشكلت هذه الخصوصية مدارس متنوعة خلطت الكثير من المناهج البحثية بانتماءات محلية متوارثة. وذلك بفضل الدور الذي أدته الإرساليات التبشيرية الغربية، التي كانت مدارسها موزعة في أقاليم الإمبراطورية العثمانية، وهذا الخلط بين وعي يعتمد على فلسفات أوروبية وتاريخ متسلسل من الطوائف والمذاهب والمناطق أسهم في تشكيل نواة أيديولوجية «حديثة» آنذاك في لغتها ومفرداتها ومصطلحاتها ومناهجها و«معقدة» في أهدافها وغاياتها. وشكل هذا التعارض بين الفكرة والواقع أزمة سياسية للنخب اللبنانية. وتشكل في بلاد الشام، وتحديداً في جبل لبنان، ذاك المثقف العضوي الذي يحمل الأفكار التقدمية ولكنه محكوم بذاك الرابط مع طائفته أو مذهبه أو منطقته. فتأسست النخبة وفق مناهج مختلفة تحكمت في برامجها الإرساليات الأجنبية.
كتاب أسامة المقدسي حول الثقافة الطائفية: إعادة النظر بهالة طانيوس شاهين-1
اصدر المؤرخ اسامة المقدسي في العام 2000، ولم يكن قد تجاوز الثانية والثلاثين من عمره، كتابه(1) حول الاحداث الطائفية لعام 1860. يقدم الكتاب احاطة شاملة بتلك الاحداث، ويوفر امكان مقارنتها مع تلك التي حصلت بعد ذلك التاريخ بـ 115 عاماً، أي في العام 1975. بل هو يتيح الاضاءة على بعض خصائص نظامنا الفريد التي لا يمكن فهمها من دون العودة الى امور نشأت في القرن التاسع عشر وتكرّست منذ ذلك التاريخ.
-1 الوقائع
يقول الكاتب ان كل النصوص حول احداث 1860 حملت هماً مشتركاً، هو معرفة لماذا تحولت انتفاضة وصفت بانها اجتماعية الطابع الى صدام طائفي ومذابح طائفية، في ما اعتبر انحطاطاً لها (degeneration) (ص 119). أي ان غالبية الكتابات اعطت مقاماً لثورة طانيوس شاهين بصفتها انتفاضة او ثورة اجتماعية. قاد الاخير حركة “الاهالي” في كسروان ضد تسلّط وعسف آل الخازن. وقد رفض هؤلاء الالتزام بما نصّت عليه الاصلاحات العثمانية، أي التنظيمات، متمثلة بمرسوم “كلخانة” للعام 1839، و”خطي همايون” للعام 1859، واللذين ارست بهما السلطنة دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع رعاياها. سرد الكاتب لائحة طويلة من الوقائع التي تظهر تسلّط المشايخ على الاهالي (ص 100). والارجح ان حركة هؤلاء كانت اولاً رد فعل على الامتهان الذي يتعرّضون له، قبل ان تكون حركة مطلبية. وقد تسلّحوا بالحقوق الجديدة التي منحتهم اياها السلطنة للثورة على مشايخهم وطردهم من بيوتهم. ما حصل بعد ذلك هو تمدد الانتفاضة الى مناطق المتن وجبيل وغيرهما. لكن اخطر ما في الانتفاضة كان شروع طانيوس شاهين باستخدام خطاب طائفي، وذهابه في ما بعد الى تنفيذ مشروع تحرير مسيحيي المناطق المختلطة من “ظلم” الدروز (ص 120).
لماذا تحوّلت حركة محلية محدودة الى كارثة بالحجم الذي اتخذته احداث 1860، والتي نجم عنها تدمير واحراق مئيتي قرية، ومقتل آلاف الاشخاص في المذابح التي حصلت (ص 118)؟ هنا يدخل دور اطراف ثلاثة، هي السلطة المركزية والكنيسة والقوى العظمى الاوروبية آنذاك ممثلة بقناصلها، بالاضافة طبعاً الى دور المنتفضين انفسهم.
أ. في دور السلطة المركزية
انتقد الكاتب ارتكاز كل الكتابات الغربية حول الاحداث الى مصادر “اولية”، مثلتها كتب مشاقة وابكاريوس والحتوني والعقيقي، الخ. (ص 212)، انطلقت كلها من انه كان ثمة مؤامرة شيطانية عثمانية لافتعال تلك الاحداث. لكن السلطة المركزية بدت من جهة اخرى، ممثلة بخورشيد باشا والي صيدا العثماني، ضعيفة ومتلكئة وغير متوفرة على الامكانات التي تتيح لها التدخل لاطفاء الحريق في بدايته. يذكر الكاتب ايضاً ان خورشيد باشا استقال من منصبه احتجاجاً على نقص الامكانات الموضوعة بين يديه، وانه حذّر اسطنبول من مغبة الاستمرار في تخفيض عديد جيش عربستان لاستخدامه في امكنة اخرى، لما يترتب على ذلك من اشعار للمنتفضين انهم سيتمكنون من الافلات من العقاب ( ص 142).
ب. في دور القناصل
بدت تدخلات القناصل، وان كانت متباينة في ما رمت اليه، شديدة التأثير. فها هو قنصل فرنسا دو بونتيفوغليو يتدخل لمنع العسكر من الدخول الى كسروان بحجة ان الاخير يفترض ان يبقى “معقلاً مسيحياً لا ينبغي انتهاك حرمته” (ص 121). تحت هذه الحجة ترك المنتفضون يعممون “الفوضى”، بحيث تجمعت الشروط لاحداث الكارثة الكبرى في شهر حزيران 1860.
ج. في دور الكنيسة
بدت الكنيسة المارونية، ممثلة خصوصاً ببطريركها بولس مسعد والنائب البطريركي في بيروت المطران طوبيا عون، عاجزة عن ضبط المنتفضين او التأثير عليهم (ص 122)، وعاجزة عن الذهاب الى ابعد من المناشدات لالتزام الهدوء. أي ان الكنيسة نفسها لم تتوفر على موقف او مشروع واضح، في ما يخص مآل الانتفاضة واهدافها.
د. في تكوين الانتفاضة
بدت حركة طانيوس شاهين على الدوام، لغير المتخصصين، شيئاً ايجابياً. فهي كانت “انتفاضة شعبية”. ساهمت باعطاء هذه الصورة كتابات المؤرخين الغربيين، والكتابات الماركسية الكثيرة في هذا المجال، والتي جعلت دأبها الاحتفال بـ”الشعب” واعطاءه ما ليس له. يتيح كتاب مقدسي تصحيح هذه الصورة في اذهان الناس.
يظهر الكتاب ان الضالعين مباشرة في الاحداث والمتنطحين لتحقيق اهداف لم تكن واضحة لديهم، كانوا بضع مئات تجمعوا على الطريق الساحلية وقطعوها. يرى القارئ ان قطع الطريق الساحلية لم يكن اختراعاً لحقبة 1975-1990، وانه كان مبرراً رئيسياً لشكوى السلطة المركزية آنذاك.
تسقط لدى القارئ هالة كانت تحاط بها حركة طانيوس شاهين. هذا ما تتيحه الوقائع التي يسردها الكاتب، وليس موقفه هو نفسه منها. وهو لا يقدم الكثير في سوسيولوجيا المنتفضين، أي لا يوضح من كان هؤلاء. وتظهر الوقائع التي يعرضها، ان الناس رأوا الحركة بصفتها “فوضى” (ص121)، وانها حوت “جهالاً” و”مجانين” (ص 214). وقد دعا المجتمعون في مار الياس-انطلياس طانيوس شاهين الى موافاتهم هناك، واخبروه انهم احرقوا منازل للدروز (ص 124). يذكر الكاتب ايضاً كيف ذهب المنتفضون الى سلب الناس بحجة تمويل نصرة مسيحيي المناطق المختلطة. أي ان البعد الآخر للانتفاضة، هو انها مثلت عدوانية وتطاولاً على الناس وتعدياً عليهم وعلى ممتلكاتهم، كاحراق منازل الدروز، او سلب تجار انطلياس (ص 136)، او فرض خوات باسم المساهمة في نجدة مسيحيي مناطق الاختلاط. عرفت احداث 1975-1990 كل هذه الامور على نطاق واسع، وما هو اكثر منها بكثير. وكان المنخرطون فيها لا يقفون عند حد.
كانت الحركة في البداية رد فعل من الاهالي ضد تعسّف النخب المحلية. وتحولت في ما بعد الى مشروع تحرر طائفي غير واضح الاهداف. لكن اهالي المناطق التي انطلقت منها الانتفاضة رفضوا الالتحاق بالاربعمئة مقاتل الذين قادهم طانيوس شاهين. بل اظهرت تجربة 1975-1990 انه اقتضى سنوات من تراكم الاحباطات والتخريب لكي يتكوّن مجدداً لدى الناس وعي طائفي حاد.
تبرر بنية الانتفاضة ومسلكيتها طرح اسئلة مشروعة : لماذا اقتضى ان يكون تحركها عنفياً؟ لماذا حملت السلاح ولماذا عمدت الى ضخ المشاعر السلبية تجاه الآخرين؟ ألم يكن النضال من اجل الحقوق ذاتها ممكناً بدون اللجوء الى العنف؟
لماذا قرر المنتفضون الذهاب الى الشوف، وإلام كانوا يرمون؟ لا يوضح الكتاب هذه النقطة. وقد رفض مسيحيو المناطق المختلطة استقبال هؤلاء. وجعل سوء تنظيمهم وسوء ادارتهم، مبادرتهم كارثة بالنسبة لمسيحيي تلك المناطق.
وفي الصفحات التي كرسها الكاتب لايام ايار وحزيران التي شهدت حصول المذابح وتدمير القرى واحراقها، عزا الكاتب عملية اقتلاع الوجود المسيحي من مناطق الاختلاط التي عمل المشاركون الدروز في المذابح على اتمامها، الى الاقتناع الذي تكوّن لديهم بوجود وعي ماروني نابذ لهم يهدد طريقة حياتهم وامساكهم بالارض (ص 140). لكن الكاتب كان قد اظهر كما سبقت الاشارة، انعدام التعبئة في صفوف الموارنة ورفضهم الالتفاف حول المنتفضين. ولا يقع القارئ على معلومات او وقائع في الكتاب تظهر انه كان ثمة مشروع طائفي محدد لدى الموارنة.
لا يظهر الكتاب ايضاً نوع العلاقة التي كانت قائمة بين مكوني الجبل الطائفيين قبل الاحداث. وليس فيه ثبت بما كان يعاني منه الاهالي المسيحيون من الزعماء في المناطق المختلطة، على شاكلة ما تم عرضه بالنسبة للاحتجاجات ضد آل الخازن.
يمكن ان يستنتج القارئ، ان الاعمال التي ارتكبها المشاركون في الاحداث من الدروز عكست حالة احتقان متفاقمة منذ بداية عهد القائممقاميتين، نتيجة الضخ المستمر للمشاعر السلبية. قدم الكاتب ايضاً تفسيراً لعمليات جرف القرى المسيحية التي ارتكبها المسلحون الدروز، بربطها بالنزاعات على الاراضي التي كانت قائمة في السابق (ص 139). لكنه لم يقدم وقائع هنا ايضاً. هل قتل الشيوخ في بيوتهم لانهم بقوا فيها؟ وهل عادت العائلات الى بيوتها لتجد اشجارها المعمّرة قد قطعت، لابقائها على فكرة انها طارئة وبلا جذور؟
واظهر الكتاب محاولات رجال دين موارنة تفسير اسباب “النكبة” التي ألمّت بابناء طائفتهم. وقد رأوا انه كان ثمة تمايزات شتى قائمة بين هؤلاء اعاقت توحيد كلمتهم (ص 140). ويمكن ان تعزز الاحداث التي حصلت بعد 115 عاماً من ذلك التاريخ الرأي القائل بأن التمايز الاهم بين هؤلاء، ربما كان بين من خرجوا على القانون واستباحوا المحرمات، والآخرين الذين لم تنل الاحداث من انسانيتهم، ولم ينخرطوا في ممارسات تمثل خروجاً على القانون.
وحين أخذت الاحداث بعدها الدرامي الاعلى في المذابح التي حصلت، أخذ القنصل الفرنسي يكرر ان فرنسا هي على مسافة واحدة من الكل (ص 138). بل ان كثيراً من التصريحات تبدو في وقتنا الحاضر، كما لو كان اصحابها يعودون الى الدرج نفسه الذي حفظت فيه تقارير دوبونتيفوغليو.
هـ. في دور الجريمة المغفلة
رأى الكاتب ان اعمال القتل والتشويه للافراد التي حصلت هدفت الى تحقيق فرز طائفي، واعادة تكوين المجتمع على قاعدة هذا الفرز (ص 128). وذكر ان ثمة قوى خفية تحرّكت في احداث 1860، وكانت تعيد اشعال الحريق من خلال عمليات القتل التي كانت تحصل. بقي مرتكبو تلك الجرائم مجهولين في احداث 1860. والامر نفسه تكرر في احداث 1975-1990. أي ان اللجوء الى الجرائم المغفلة كان ثابتة في التجربتين. والارجح ان هذا الامر مرشح ان يتكرر في المقبل من التجارب، كما لو كان ثابتة تعصى على الفهم في تاريخ شعب لبنان المنكوب، او قدراً مأسوياً لهذا الشعب.
(1) – أنظر: Ussama Makdisi, The culture of sectarianism: community, history, and violence in nineteenth-century Ottoman Lebanon, Berkeley, CA: University
of California Press, 2000.
( استاذ في الجامعة اللبنانية)
كتاب أسامة المقدسي حول ثقافة الطائفية [2]
الحلقة الثانية من قراءة الدكتور ألبر داغر لكتاب اسامة المقدسي حول أحداث 1860 في لبنان:
د- في التأسيس للبنان كساحة
يظهر كتاب المقدسي ان حقبة السلطنة جعلت النخب المحلية قادرة على اقامة علاقات مع القناصل، أي بكلام آخر، الانفراد بادارة علاقات خارجية خاصة بها، في حين ان ادارة العلاقات الخارجية هي ركن اول من اركان ممارسة الدولة لسيادتها. ولم ينفك مشايخ آل الخازن يطرقون ابواب القناصل لكي يجدوا مساعدة تعيد لهم سلطتهم المفقودة (ص 121). ويقول الكاتب من جهة اخرى انه كان قد تم آنذاك احتواء منطقة الهلال الخصيب باكملها، اقتصادياً وثقافياً وحتى عسكرياً تحت السيطرة الاوروبية (ص 147). أي ان ممارسة الدولة العثمانية سيادتها على المنطقة كانت آنذاك في ادنى مستوى لها.
وقد جعل النظام الذي نشأ بعد تلك الاحداث، نخبة كل طائفة قادرة ان تنفرد بادارة للعلاقات الخارجية خاصة بها، ومتمايزة عن ادارة الدولة لها. أي ان الطائفة اصبحت منذ ذلك التاريخ ليس فقط هوية، وانما ايضاً ممارسة وصلاحيات، وهما بعدان للطائفة لا يحتّم احدهما وجود الآخر. ولم يذهب كيانا المتصرفية ثم لبنان الكبير، خصوصاً في حقبة الاستقلال، الى تجريم هذه الممارسة. أليس هذا ما جعل لبنان يستمر تحت تسميات مختلفة منذ 150 عاماً كساحة.
2- الجريمة
انتقد الكاتب طريقة معالجة غالبية النصوص السابقة للعنف الذي يختصر تلك الاحداث بكاملها. وقال انها اقتصرت على وصفه بانه كان فجائياً مدمراً وغير عقلاني (ص 119). نأى الكاتب هو ايضاً عن محاولة تفسير العنف الذي حصل، تاركاً الامر ربما الى ورشة فكرية لاحقة. واكتفى بالعودة الى مصادر محدودة حول تعريف العنف المدني (ص 213)، لا تبدو انها جسدت ما هو مطلوب لدراسة احداث 1860.
ليس ثمة ايضاً في الكتاب وقائع حول العنف المرتكب واستعادة له إلا من خلال صورتين او ثلاث، اخذت من كتاب مراقب اوروبي لتلك الاحداث هو تشرشل. نفهم ان لا يحب الكاتب وصف الجرائم المرتكبة، وهو ما تقوم به الضابطة العدلية حين تعمد الى اعادة تمثيل الجريمة.
يبدو التعسف الذي يمارس على نطاق واسع الارضية الاساسية للعنف آنذاك وفي كل وقت. ويكون التعسف هو القاعدة حين يحوّل الاعيان مواقعهم الى سلطة سلطانية، بمعنى عدم خضوعها الى رادع او وقوفها عند حدود، وحين يسطو الناس على مواقع لا يستحقونها، وحين يعمد كل ذي سلطة من أي نوع للحط من قيمة الآخرين. ولا يؤدي التعسف الى النتائج الكارثية التي تحصل إلا حين تغيب السلطة المركزية وتنتفي قدرتها على فرض سلطة القانون او فرض النظام. ويلعب الاستفزاز، أي الخروج على الاصول في التعاطي والتخاطب دوراً مركزياً في تصعيد حالة الشحن التي تورث عنفاً. تنقل الكاتبة اليزابيت بيكار(2) بحبور ظاهر تأكيد باحثين غربيين واقعة خضوع اهل الشرق للعسف، واختلافهم في ذلك عن الغربيين الذين تخضع علاقاتهم للحدود التي يرسمها القانون.
لا يبدو ممكناً تفسير العنف الذي حصل من دون اللجوء الى الانتروبولوجيا التي تعنى بمناطقنا والبحر المتوسط بشكل عام، والى انتروبولوجيا العنف. ولا يمكن تفسير امور كثيرة بدون مفهوم “المكانة” (Honour) وترجمته في الحقل السياسي عبر مفهوم “الناس الذين يفرضون انفسهم بالقوة” (Men of Honour) لتعريف سلطة المشايخ والامراء آنذاك، والزعماء بعد ذلك التاريخ. بل ان الناس العاديين هم ايضاً “اناس ينشدون الاحترام” وفق ما يصفهم مايكل جونسون. وهم يصفون حياتهم بانها “توازن هش بين الاحترام والمهانة”(3). ويجعلهم التعرّض للتعسف، بمعنى تعريضهم للاهانة، يلعنون الساعة التي ولدوا فيها.
3- التعاطي مع الجريمة
لا يستطيع القارئ إلا ان يستغرب كيف نحا الكاتب الى اعتبار المسؤولين عن المجازر الطائفية آنذاك ” اكباش محرقة” (ص 156-157). واول سؤال يتبادر الى ذهنه هو هل تلاحق الخشية من الزعماء المثقفين الى مهاجرهم؟ وبالكاد يحافظ الكاتب، حين يندفع الى المرافعة عن المسؤولين عن المجازر، على صدقية راكمها على امتداد الصفحات والفصول السابقة. وهو كان قد صدّر كتابه بفقرة مستعارة من كتاب تشرشل، يصف فيها احدى الاميرات وهي تثني على من ارتكبوا المجازر، وقد كدست امامها جثث الضحايا الذين سبق ان قصف هؤلاء اعمارهم.
يعالج الكاتب بكثير من السلبية والشك عملية الاقتصاص من مرتكبي المذابح التي تولاها فؤاد باشا، البيروقراطي العثماني التحديثي المسكون بالرغبة باثبات ان السلطنة هي كأمم الغرب تمتلك مؤسسات دولة القانون ومسلكيتها. بل بدت الصفحات التي كرّسها الكاتب لفؤاد باشا وكأنها محاكمة للاخير. وقد انتزعت محاكمة ممثلي السلطنة والزعماء التي اعقبت احداث العام 1860 حق الثأر من ايدي الناس ووضعته بين ايدي الحكومة. ينتقد المقدسي رفع فؤاد باشا مرجعية القانون فوق كل مرجعية، علماً ان مرجعية القانون هذه، هي التي سمحت بالتعاطي مع الجرائم المرتكبة بصفتها جرائم، واتاحت عدم التعامل مع الناس المقتولين كأنهم مجرد ضحايا.
وهي كانت المرة الاولى التي يتم فيها تحميل النخب مسؤولية ما حصل. فقد تكيّف افراد هذه النخب مع نظام القائممقاميتين المعتمد منذ عشرين عاماً، معتقدين انهم سينأون بانفسهم عن دفع ثمن سوء أداء ذلك النظام. ومثلت مقاربة فؤاد باشا لدوره، بدعم من اسطنبول، قطيعة مع ما كان يحصل سابقاً لانهاء النزاعات، حيث كان شكيب افندي قد اعتمد في العام 1841 وخورشيد باشا بعد ذلك، مبدأ “مضى ما مضى” لانهائها. وهو المبدأ الذي اصبح اسمه في القرن العشرين “لا غالب ولا مغلوب”، واتاح افلات المرتكب من العقاب.
لا تبدو محاولات السلطنة العثمانية ونخبها العسكرية والادارية للتحديث والاقتداء بالمتروبولات الغربية مقنعة بنظر الكاتب. لا يحب ان تكون النخب العثمانية آنذاك قد امتلكت الوعي الذي حملته النخب الغربية وبنت به الدولة الحديثة. وهو بدا في هذا الامر بالذات كما لو كان متأثراً ببعض الكتابات التي تناولت بالنقد الاستشراق ومؤسسته ونتاجه. ذلك انه اذا كانت هذه النخب عاجزة، فلأنها تنتمي الى جوهر “شرقي” يمنعها من ذلك. هذا ما يسميه صادق جلال العظم “الاستشراق معكوساً(4). لكن احداث القرن العشرين اثبتت ان التحديث بقي هاجساً لدى النخب العثمانية الى ان تحقق في التجربة التي انطلقت مع اتاتورك.
أنشئت محكمتان بعد احداث العام 1860، محكمة عرفية عثمانية اصدرت الاحكام ومحكمة دولية تولت التحقيق في الاحداث. وصدرت احكام “ثقيلة” بالذين تورطوا بالاحداث والذين تحملوا مسؤولية مباشرة او معنوية فيها، خصوصاً بعدما تبعت مذابح جبل لبنان مذابح اخرى في دمشق في الشهر التالي، أي في تموز 1860. الامر المستغرب هو ان طانيوس شاهين لم يحاكم على شاكلة مرتكبي المجازر. يظهر الكتاب على أي حال، ان التدخل الاجنبي هو الذي حماه (ص 159).
لم تجرِ الامور على النحو ذاته في التجربة التي اعقبت احداث 1860 بـ115 عاماً. تبوأ مسؤولون مباشرون او معنويون عن تلك الاحداث مسؤوليات رسمية رفيعة خلال الحرب وبعدها، واصبحوا اصحاب الحل والربط. ومنحت النخبة السياسية نفسها عفواً بقرار ذاتي (self amnesty). وعرف المتذابحون السابقون انهم لا يستعيدون او يوطدون سلطة كاملة على المنتمين الى طوائفهم إلا بحلف عابر للطوائف بينهم. واعطت مصالحات صفحاً كاملاً وغير مشروط عن جرائم ارتكبت، وأكدت ان لا قيمة لمرجعيات محلية في احقاق حق او رفع ظلامة. بل اظهرت ان ملاحقة المرتكبين قد لا يقدّر لها ان تتم، إلا بتدخل سلطة خارجية، كما في القرن التاسع عشر.
ان يكون التسبب بالمآسي هو المدخل الى حياة سياسية مديدة، ذلكم نموذج قائم. لكن كتاب المقدسي ينطوي في جزء منه على موقف مناهض للنموذج النقيض.
(•) – أنظر: Ussama Makdisi, The culture of sectarianism: community history, and violence in nineteenth-century Ottoman Lebanon, Berkeley
CA: University of California Press, 2000.
(2) – أنظر: Elizabeth Picard, ” Une sociologie historique du Za’îm libanais”, in Charles Chartouni (dir.), Histoire, sociétés et pouvoirs au Proche et Moyen Orients, Tome 1, Paris, Geuthner, 2001, pp. 157-172, p. 162.
(3) أنظر: Michael Johnson, “The Neo-Patrimonial Lebanese State before 1975”, Contribution to the L.C.P.S. Workshop on: “the Developemental State Model and the Challenges to Lebanon”, February, 15-16, 2002, Beirut, p. 15.
(4) – أنظر: صادق جلال العظم، الاستشراق والاستشراق معكوساً، بيروت، دار الحداثة، 1981، ص. 8-9.
لتحميل الكتاب من الرالط التالي
صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت
كتب عربية، روايات عربية، تنزيل كتب، تحميل كتب، تحميل كتب عربية.