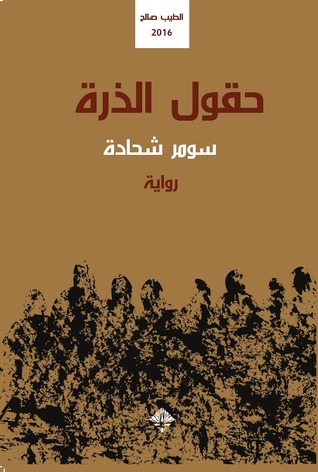“ثورة حقيقية ـ منظور ماركسي للثورة السورية” لسلامة كيلة: لماذا يقف الشيوعيون والممانعون ضد ثورة الفقراء والمضطَهدين؟
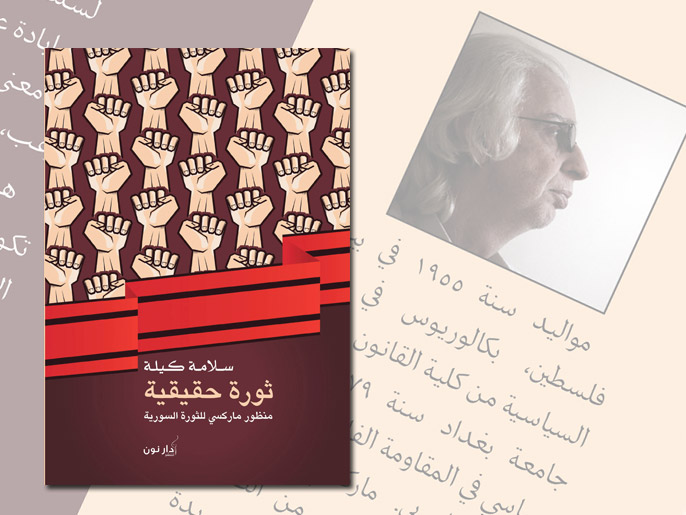
تهامة الجندي
لماذا يقف الشيوعيون ضد ثورة شعب، مثل الثورة السورية؟ سوادها الأعظم من الفقراء والمضطَهدين، يطالبون بالخبز والحرية والكرامة، ويبذلون أقصى البطولة، لإسقاط سلطة مافيوية عائلية ريعية مسيطرة منذ عقود، تواجههم بأقسى وحشية ممكنة، تفوق أسوأ أفلام الرعب في العالم؟ سؤال محير بالفعل. يحاول الباحث اليساري، الفلسطيني، سلامة كيلة الإجابة عنه عبر ستة فصول، يضمها كتابه الجديد «ثورة حقيقية – منظور ماركسي للثورة السورية». ومنذ المقدمة يرى أن هذا الموقف الملغوم، يكشف لاماركسية اليسار العربي، ويعكس إفلاس الحركة الشيوعية العالمية بكل انشقاقاتها وتفرعاتها، التي تأسست على تبعية المنظور الستاليني والماوي، والسوفياتي، وبعض الاتجاهات التروتسكية.
يعتبر كيلة أن كل المواقف التي ترفض تأييد الثورة السورية، سواء تلك الصادرة عن اليساريين، أم عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للنظام السوري، بما فيها تلك التي تدعي الممانعة والعداء للإمبريالية الأميركية، هي مواقف لا مبدئية، تعوزها القيم الأخلاقية، لأنها قائمة إما على المصالح المتبادلة مع النظام الحاكم، أو على سوء فهم وخلل معرفي. ومن ثمة يمضي في تحليل وتقويم ذرائع الرافضين.
يلاحظ المؤلف أن ثمة من يعتقد أن الثورة يجب أن يكون وراءها حزب وبرنامج ورؤية، تؤدي إلى تغيير النظام، وتأسيس نمط اقتصادي مختلف، وفي الحقيقة أن هذه الشروط النظرية، لم تُحقق إلا في عدد قليل من الثورات عبر التاريخ، وفي المنطقة العربية ليس هناك وضع يشير إلى هذا التحقق، كل الثورات العربية انفجرت نتيجة الاحتقان الشعبي، من بينها ثورة يناير في مصر عام 1977 التي فشلت، ونحن لا نستطيع، ولا ينبغي، أن نضع شروطنا المسبقة، لما يجب أن تكون عليه الثورة، كي نؤيدها أو نرفضها.
كذلك ثمة مواقف رافضة للثورة السورية، تحكمها نظرة سياسية تقليدية، قائمة على ترسيمات أوجدها الاتحاد السوفياتي في صراعه مع الإمبريالية، التي هي أميركا المتآمرة على شعوب العالم، وكل من عاداها صديق، وكل من وقف معها عدو. وفي هذا السياق، ظلت سوريا بلد التنمية، بنظام يدعم المقاومة، وفي محور المواجهة مع الإمبريالية، ولم تجرِ مراجعة هذا الموقف المتكلس، الذي ينطلق من انعكاسات البنية الفوقية، ولا يتناول البنية الاقتصادية بوضعها الجديد، لا على المستوى العالمي، ولا في مستواه السوري.
البنية الاقتصادية هي أساس التحولات في النظرية الماركسية. وعليه، يعتقد الباحث أن الامبريالية ليست مقولة سياسية، بقدر ما هي تكوين اقتصادي اجتماعي، له طابع معين، تمثله دول صناعية قوية في المركز، هي أميركا، أوروبا واليابان (الرأسماليات القديمة)، أُضيفت إليها حديثا روسيا والصين (الرأسماليات الجديدة)، ودول أخرى في الأطراف تقوم على نمط اقتصادي غير منتج، يتمحور حول قطاع: الخدمات، العقارات، السياحة، الاستيراد، البنوك، القطاع المالي والريعي، وهذه قطاعات لا تفيد تطور المجتمع، ولا تنتج فائض القيمة.
وفي السياق ذاته، يشير الباحث إلى أن الأزمة المالية التي انفجرت عام 2008، والمديونية الكبيرة التي ترتبت عليها، وأثقلت كاهل الرأسماليات القديمة، أدت إلى تراجع وضع الولايات المتحدة المحلي والعالمي، وإعادة رسم استراتيجيتها العسكرية، بحيث لم يعد الشرق الأوسط أولوية بالنسبة لها، بل منطقة «الباسيفيك«. (المحيط الهادئ)، وبهذا انتهى عصر التفرد الأميركي، ومشروع «الشرق الأوسط الجديد»، وأخذت الرأسماليات القديمة والجديدة تتنازع فيما بينها، وتعيد موضعة موقعها، بحيث يتجه العالم نحو التعددية القطبية. ولذا، فإن التوافق مع الإمبريالية الأميركية أو الاختلاف معها، لم يعد المحدد لطبيعة التكوين السياسي للنظام، سيما السوري، الذي لم يكن معارضا للإمبريالية على الإطلاق، بقدر ما كان يسعى لتحسين شروط الالتحاق بها، والذي عوض عن العلاقة المباشرة بالطغم المالية في المركز، بعلاقته مع الرأسمال الخليجي، الذي هو جزء ملحق بالرأسمال الإمبريالي، ومع الرأسمال التركي والروسي والأوروبي الشرقي، الذي هو رأسمال إمبريالي ومافيوي.
وقبل ذلك كانت سوريا آخر دولة عربية، حُسم فيها الوضع الاقتصادي باتجاه اللبرلة، حيث شهد العقد الأخير خطوات متسارعة لتعميم الخصخصة، وفرض الانفتاح الاقتصادي. وربما كانت سنوات 2005/2007، هي الخاتمة التي فرضت تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي، وتحكم القطاع الخاص و»رجال الأعمال الجدد» بـ 70% من الاقتصاد السوري، خصوصاً تلك الفئة اللصيقة بالسلطة والعائلة الحاكمة وتوابعها، التي هيمنت على «النت« والإتصالات والتقنيات الحديثة، وقسم واسع من قطاع العقارات والسياحة والخدمات، ومركزت الثروات بأيديها، ما أدى إلى انهيار اقتصادي عام، طاول الصناعة والزراعة ومؤسسات القطاع العام، بما فيها التعليمية. وبالتالي، انهار الوضع المعيشي للسوريين، بحيث صار الحد الأدنى للدخل، أقل من ثلث الحد الأدنى للعيش الطبيعي. وارتفعت نسب البطالة إلى ثلث السكان، سيما في أوساط الشباب. وهذه الظروف المتردية هي التي تسببت بحالة الاحتقان الجماهيري، ومهدت لقيام الثورة السورية، التي بدأت بشكل عفوي من الفئات والمدن المهمّشة، وعبرت عن حقيقة الصراع الطبقي بين الطبقات الشعبية والطبقة المافياوية الحاكمة.
بدأت الثورة السورية بتظاهرة صغيرة في سوق الحميدية بدمشق في 15 آذار 2011، لكنها أصبحت حقيقة في 18 آذار، حين فتحت السلطة النار على المعتصمين في درعا، ثم توسعت ببطء إلى حوران فدوما وبانياس واللاذقية، واستمرت بالتوسع لتطال كل سوريا تقريبا، والتوسع البطيء أعطى السلطة فرصة كبيرة لقمع منطقة بعد الأخرى، واللعب على تناقضات المجتمع، من خلال تصوير ما يجري على أنه مؤامرة خارجية، وتحرك سلفي، أصولي وأخواني (سني)، ضد التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والأقليات، وضد دولة علمانية للنيل من مناعتها، ومن مواقفها المبدئية الداعمة للمقاومة.
مرت الثورة بمراحل مفصلية عدة، تبعا لطبيعة الحراك والقوى الفاعلة فيها. الأولى كانت مرحلة التظاهر السلمي، التي بدأت من 15 آذار، وانتهت بنهاية رمضان/ آب، 2011 أو ما عُرف بشهر الحسم، حيث الإضراب العام، والتظاهرات اليومية بعد صلاة التراويح. وخلال هذه المرحلة، كانت مطالب الثوار تتمحور حول إسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديموقراطية. وشهدت سوريا تظاهرات ضخمة في درعا وحمص ودير الزور وحماه، على الرغم من القتل بالرصاص والاعتقالات. كما تبلورت تنسيقيات عملت على تنظيم التظاهر، وضبط الشعارات، والتنسيق بين المدن. وكان الجهد منصبا باتجاه توحيد التنسيقيات، لكي تصبح القيادة الفعلية للثورة، لكن اعتقال أغلب النشطاء فيها، أدى إلى ابتسارها في تشكيل «الهيئة العامة للثورة السورية»، التي تبين فيما بعد، أنها ملحقة بجماعة الإخوان المسلمين، وتنطق بلسانها.
بالتوازي مع هذا أعلنت المعارضة الخارجية تأييدها للحراك الشعبي، وحاولت منذ نهاية أيار تشكيل إطار خارجي معارض، يصبح هو ممثل الثورة (مؤتمر أنطالية نهاية شهر أيار، بروكسل بداية حزيران، ومؤتمر اسطنبول) ورغم الإشارات التي أطلقتها بضرورة تشكيل مجلس انتقالي، وتغيير العلم السوري، فقد كانت حذرة ومتريثة، في حين عملت الأحزاب المعارضة في الداخل على توحيد صفوفها في 25 حزيران 2011 بتشكيل «هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني».
اتضحت معالم المرحلة الثانية مع تأسيس «المجلس الوطني السوري» في 2 تشرين الأول 2011، (من «الإخوان« والأكاديميين وشخصيات إعلان دمشق«) الذي كان هدفه الضغط على الحكومات الغربية، من أجل حماية المدنيين، وطلب الحظر الجوي على طيران النظام الذي بدأ بقصف المدن والأرياف، وبالتالي طلب التدخل العسكري، ولم يكن ذلك توجه الثورة، لكن قطاعات واسعة اندفعت فيه، مؤيدة فكرة التسليح والتدخل الأجنبي، بسبب القمع الدموي الذي مارسته السلطة على الثوار والمناطق الثائرة. وعلى الرغم من استمرارية التظاهر وتوسعه، أخذت الشعارات المدنية تتغير بالاتجاه الديني. وبعد الصورة التي رسمها خطاب المجلس الوطني، وبعض مواقع النت الأصولية، وقناة «الوصال» والشيخ العرعور، ثم «الجزيرة» التي أصبحت تحت سيطرة الإخوان، فيما يخص الشأن السوري منذ أوائل تشرين الأول، بعد ذلك بات خطاب السلطة قابلا للتصديق، لقد أصبحت المجموعات المسلحة موجودة، والخطاب الأصولي موجودا، بما في ذلك أسماء ألوية «الجيش الحر» وأيام الجمع، وأصبحت دعوات التدخل الخارجي معلنة، ما يعني أن سياسة المعارضة، كانت تصب لصالح سياسة النظام الإعلامية في هذه المرحلة التي امتدت حتى أيار 2012.
مع الذكرى الأولى للثورة، كان الحراك قد وصل إلى حلب، وكان ذلك مؤشرا لشمول رقعة الثورة كل سوريا عدا الساحل، في مرحلتها الثالثة التي امتدت حتى أيار 2013، لكن هذه النقلة سُحقت بسيطرة الكتائب المسلحة على المدينة، وإدخالها في عداد المدن المعرضة للقصف والتدمير، بعد أن بدأت السلطة سياسة السيطرة العسكرية على حمص، وتدمير بابا عمرو، والزحف نحو جبل المضيق وجبل الزاوية وإدلب والمناطق الأخرى. وهنا، يلحظ المؤلف ظهور متغيرين على الساحة، تمثل الأول بانسحاب قوات النظام من حمص ودير الزور وبعض مناطق درعا، ليس لقوة الكتائب المسلحة، ولكن لاحتقان عناصر الجيش من الوحشية التي تُمارس على المدن، وتطال بعضا من أهاليهم، فتم حصرهم في المعسكرات، والانسحاب من مناطق واسعة في الشمال والشرق والجنوب، وجرى تسليم المناطق الكردية لحزب (بي واي دي) فرع ال (بي كيه كيه) وتسليم منطقة القصير لحزب الله.
أما المتغير الآخر فقد تمثل بظهور جبهة «النصرة» في المناطق التي انسحبت منها السلطة، خلال الشهرين التاليين. و»النصرة» تنظيم مكون من عناصر قيادية في القاعدة، كانوا معتقلين لدى السلطة، وأُطلق سراحهم في نيسان 2012، انضم إليهم جهاديون، غذت بعض دول الخليج إرسالهم عبر تركيا والأردن، ومجموعات من تنظيم القاعدة تسربوا من العراق.
وفي الختام يرى كيله، أن ما يبدو من اختلاف وصراع على المستوى الدولي لحل الأزمة السورية، إن كان عبر الحوار والمفاوضات، أم عبر الحسم العسكري، إنما يصب في مسار واحد، هدفه إفشال الثورة وليس انتصارها، البعض من خلال الدعم الكبير للسلطة الحاكمة، والبعض من خلال تشويه الثورة، وحرفها عن مسارها، وهو ما يطيل أمد المعركة، ويجعل الشعب السوري، يخوض صراعا ليس ضد النظام فقط، بل كذلك ضد كل التشويهات والأخطار والتدخلات، التي تجري من أجل سحق الثورة، في معركة متعددة الأشكال والمحاور والاتجاهات، يترتب عليها إعادة النظر بكل المنطلقات النظرية، وإعادة الفرز والاصطفاف الدولي من جديد.
[الكتاب: «ثورة حقيقية – منظور ماركسي للثورة السورية»
[دراسة في 191 صفحة، قطع متوسط.
[المؤلف: سلامة كيلة
[الناشر: دار نون، رأس الخيمة
[دولة الإمارات المتحدة 2014
المستقبل