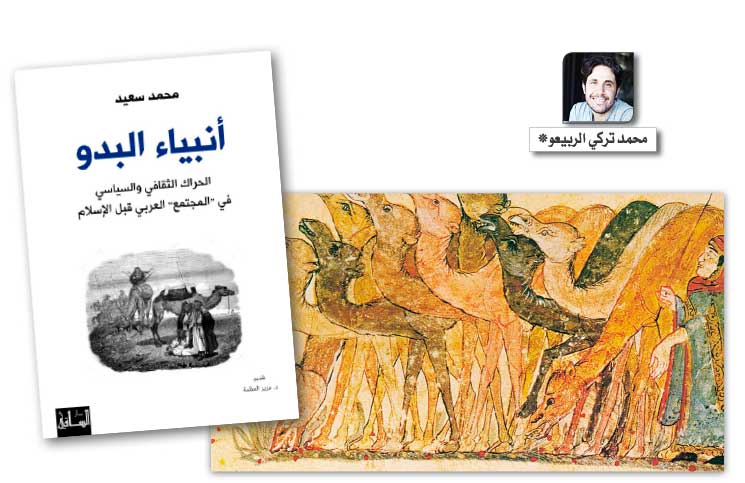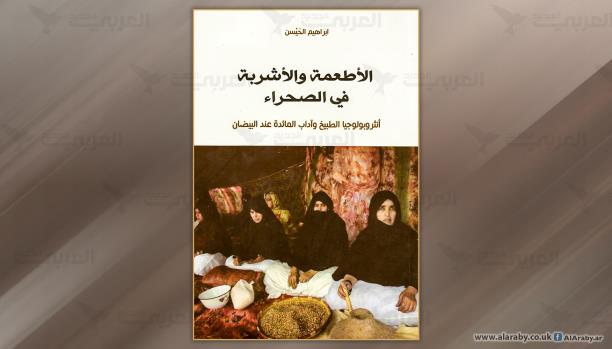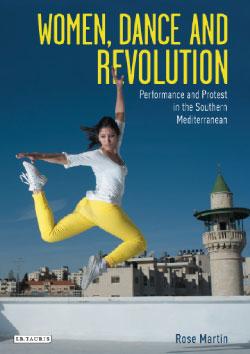جلبير الأشقر وتحليل الظّاهرة: الدّين والاستشراق وماركسية المنظور/ رامي أبو شهاب
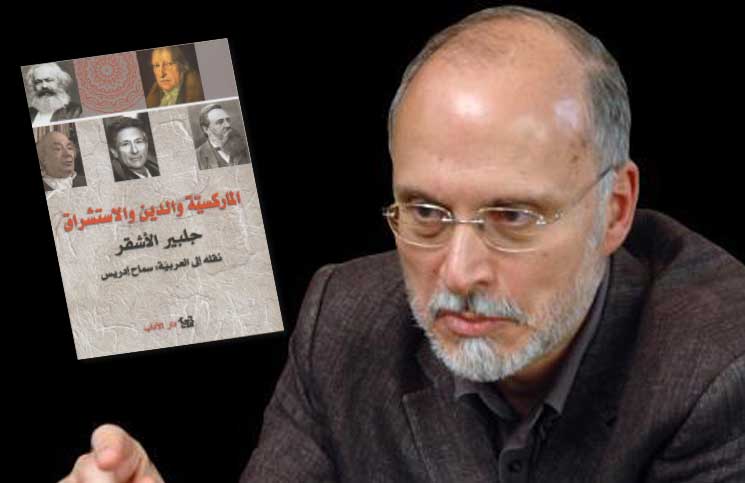
يسعى جلبير الأشقر أستاذ معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن من خلال كتابه الموسوم بـ»الماركسية والدين الاستشراق» الذي ترجمه سماح إدريس، وصدر عن دار الآداب (2015) إلى تقديم أربع دراسات تبدو أقرب إلى مخبر بحثي يكتنه مقولات لطالما اتسمت بجدل غير منجز، فالكتاب يهدف إلى قراءة تموضع الدين من منظور وضعي، ما يعني تقييماً تحليلياً سياقياً ذا بعد دنيوي، يطال وجوداً متعالياً في طبيعته وتوجهاته ونعني الدين، بالتجاور مع قراءة ظاهرة الاستشراق بوصفه خطاباً معكوساً للاستشراق التقليدي، وبوجه خاص نقد أطروحة إدوارد سعيد والشّبهات الاستشراقية التي طالت ماركس.
الكتاب أشبه بتقييم تحليلي نقدي، غير أنه يبدو لتعدد مستويات المنظور والناظر ذا نسق تبادلي حيث يختبر الدارس الظاهرة الدينية، سواء أكانت ممثلة باللاهوت المسيحي أو بالإسلام، ولكن من منظور ماركسي، فهو يبدأ من ظاهرة الامتداد والانتشار كما الثبات والكمون، بالتوازي مع منهج تاريخي يعمد إلى تكريس أفعال من المقايسة، بالتوازي مع تقدير معياري لا يعدم وجهات نظر لتفسير تكوّن الدين وانتشاره.
في الفصل الأول ثمة تفسير لتموضع الدّين في الوعي الإنساني تاريخياً من قبل ماركس، ومن ثم ينتقل الكتاب في ما بعد إلى منهج مقارن، حيث يوضح التكون الإسلامي وامتداده بالتوازي مع تقدم اللاهوت المسيحي، غير أنه يسبق بملحوظة بسيطة تأتي على لسان أحد أساتذة الباحث، وتتلخص بأن تقدم العلم لم يمحُ الدين كما كان يتوقع، بل على العكس من ذلك، فإن هذا النهج الحتمي للتطور المادي أسهم بتفعيل البحث عن الروحانيات، ما يجعل من القرن الواحد والعشرين قرن الدين بامتياز، ولكن جلبير يذهب إلى نفي ذلك أو يشكك بصحة ذلك تحت ضغط نزعته الماركسية، فهو يرى أن العالم بدأ يُفقد الإنسان خياراته القائمة على التعبير وحرية الإيمان، ومن هنا فإن ثمة حاجة ماسة لتفسير هذا التقدم الذي تتميز به الظاهرة الدينية التي تعيد إنتاج ذاتها، بما في ذلك أيديولوجياتها، وهذا يتطلب عودة تاريخية معرفية لتفسير ذلك، ولكن من منظور ماركس الذي يرى أن تقدم الدين بوصفه ظاهرة ترتبط بالقهر، والحاجة للتخلص من البؤس، أي أنه يُحال إلى منطق اقتصادي؛ وهنا يستأنس بمطالبات الفلاحين والمقهورين بالحد من الملكيات في أوروبا. هذا النهج الذي دعمته المسيحية كان ينطوي على مبدأ شيوعي أو اشتراكي كامن، كما أشار من قبل إنجلز الذي نعت هذا النهج بالأيديولوجية الدينية التي سادت في العصور الوسطى، غير أن هذا المسلك يعود مرة أخرى للظهور في العصر الحديث، من خلال الإشارة إلى التجاذب بين المسيحية الأصلية والشيوعية في دول أمريكا اللاتينية، حيث ينتشر الفقر والجوع والاضطهاد.
في محور آخر يبحث جلبير ظاهرة الانتشار الإسلامي المعاصر، وأسباب تقدمه، ومنها علاقته مع الاستعمار الذي لم يسعَ لتحديه أو المواجهة المباشرة معه، قاصداً من ذلك تحييد الدين تجنباً لتحويله إلى نسق من المقاومة، وهذا يأتي مشفوعاً بتراجع الحركة التقدمية التي انتهت بموت جمال عبد الناصر، وهزيمة حزيران 1967. هذه العوامل وغيرها أتاحت تقدم الإسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني، ولاسيما بعد انتصار الثورة الإيرانية، بالإضافة إلى تمكن الدول الإسلامية السنية من إقامة علاقات حسنة مع الغرب، وكلا النهجين –كما يرى جلبير- ارتهنا لمتخيل قروسطي استعادي، على اعتبار أنه النموذج المثالي.
إذن ثمة اتفاق من حيث المبدأ مع النهج المسيحي الذي سعى لتجاوز أزمة الإنسان ضمن معادلة عالم مثالي وعادل، وهنا يستعين الدارس ببراهين تاريخية، ومنها ثورة البدو والفقراء المهمشين في التاريخ الإسلامي على سكان المدن الذين كانوا يتنعمون برغد العيش، ولهذا كان لابد على الدوام من ظهور أو وجود مخلّص، يعيد قيم المساواة والعدل، وهو ما يكنى عنه بظاهرة المهدي، أو من يأتي بالخلاص.
ومن العوامل التي ساعدت على عودة الوهج الديني حديثاً أحداث ظرفية نشأت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، وغير ذلك، ومن هنا يرغب جلبير للوصول إلى نتيجة محددة، تتمثل برفض مقولة مفادها إن لدى الشرقيين وعيا دينيا كامنا، أو طبيعيا، وهذا ما يجعل من هذه المقولة استشراقية بامتياز.
في الفصل الثاني من الكتاب، ثمة تمحور حول ربط الظاهرة الدينية بالمعاناة والقهر، وبوصفها عاملاً للشجب والتذكر، ولكن ثمة إشارات إلى أن الماركسية الكلاسيكية لم تدعُ إلى حجب الدين، ومصادرة وجوده، كما يشير جلبير الذي يرى أن الماركسية ينبغي لها ألّا تلجأ إلى عمليات الإخضاع والاضطهاد في هذا المجال، فكل مسلك بهذا الاتجاه سوف يؤدي إلى ردود فعل عكسية، ومن ذلك على سبيل المثال مسألة الحجاب، غير أن ثمة إشارات مهمة تتمثل بأن العديد من التيارات الدينية تبنت الدفاع عن قضايا تقدمية تتصل بالتحرر، ولاسيما مع وجود فراغ نتج بفعل انحسار اليسار.
في الفصل الثالث تحليل لظاهرة الاستشراق المعكوس، وهذا يمهد له بثلاثة أحداث مهمة تتصل بتحليل تقدم التيارات الدينية، وجميعها تتصل بتاريخ 1979، وأولها سقوط نظام الشاه في إيران، بالتزامن مع انبثاق مقاومة إسلامية ضد اليسارية الديكتاتورية، اليسارية السوفييتية في أفغانستان، وأخيرا صدور كتاب إدوارد سعيد «الاستشراق».
هذه الأحداث أنتجت تحولا في أفعال المثقفين ومسالكهم، حيث اتجهوا لمناقشة هذا التحول أي من اليسار إلى الإسلام، في هذه الأثناء كان إدوارد سعيد ينال من ماركس الذي جعله عقلا استشراقياً، وبذلك أرسله إلى قاعة الخزي والعار كما يقول جلبير.
في هذا الفصل نقرأ للجدل الذي أنتجه كتاب «الاستشراق»، وما صدر من صادق جلال العظم من ردود تنال من أطروحة سعيد من خلال مقولة «الاستشراق معكوساً»، وتتلخص بالإشارة إلى التمايز الجوهراني الذي نقده سعيد في الأصل، علاوة على الرؤية التي ترى أن العقل العربي يتفوق على الغرب، بالإضافة إلى مقولة أخرى، تنهض على أن الخلاص الوطني لن يتحقق إلا من خلال الأصالة الإسلامية، لا عبر نهج آخر سواء أكان يسارياً، أم علمانياً، أم قومياً..الخ.
يحلل جلبير بعض المقولات ذات الطبيعة الجوهرية، ومنها أن الماركسية لا تلائم الشعوب الشرقية، ومن أن انعتاق الشرق ينبغي ألا يُقاس بالمعايير الغربية كالديمقراطية، وغيرها، كما لا يمكن فهم الشرق من خلال العلوم الاجتماعية الغربية، ومن ثم فإن العامل الأساسي الذي يحرك الشرق هو الدين، وبناء عليه فإنه لا خلاص إلا بالإسلام، كما يجب النظر إلى هذه الحركات الدينية لا بوصفها رجعية، إنما هي حركات تقدمية. ولعل هذا النهج في التفكير اتخذ صدى واسعاً، وبوجه خاص حين تعرض لتنظير أو تلميع شديد الانبهار بالنموذج الذي مثلته الثورة الإيرانية على يد ميشيل فوكو، وهذا يقود الكتاب إلى البحث في الاستشراق الفرنسي الذي أظهر توجها مستجدا، أو اهتماماً نحو اكتناه الدين، وبوجه خاص التيارات الإسلامية، فهنالك العديد من علماء الاجتماع الفرنسيين الذين توجهوا إلى الدراسات الإسلامية من منطلقات مختلفة، ولاسيما مع انتشار هذه الظاهرة، علاوة على بحث المثقفين عن مردود مالي من خلال العمل كمستشارين في قسم الشؤون الخارجية والإعلام، بيد أن دورهم المعرفي قام على نزع مفهوم الأصولية عن هذه الحركات، والنظر إليها بوصفها نزعات تقدمية، علاوة على الدمج بين التيارات الدينية والقوى القومية العربية أو القليل من التمايز بينهما، كما بيّن أوليفييه كاريه. وهنا ما زال جلبير يعمل على تحليل تطور التيار الديني، وانتشاره من خلال هذا الاكتناه لسياقات بعينها أسهمت في تشكيل الظاهرة الدينية في الشرق، أو عودتها، كما تميزها بالقدرة على نبذ كافة التيارات الفكرية الأخرى، وهذا ما أكده من قبل العديد من المفكرين الفرنسيين الذين رأوا في التيارات الإسلامية نماذج لقيم التحديث الحتمي، والحقيقي، ومنهم كييل، الذي وقف بين الاستشراق التقليدي والاستشراق المعكوس، كما وصف جلبير، آتيا على العديد من النماذج التي تؤكد التوجه الغربي في التقديم لظاهرة الاستشراق المعكوس، وتبني التقديم للخطاب الإسلامي بوصفها عاملاً للتغيير في العالم العربي والإسلامي، على حد سواء. وهنا يخلص جلبير إلى أن المرتكزين الأساسيين لنموذج الاستشراق المعكوس كما حلله كاريه أو غيره، يتحددان بأن النزعة الإسلامية جاءت عامل تحديث، وأن الدين الإسلامي ما هو غلا اللغة والثقافة الملازمين للشعوب المسلمة، غير أن ما هو أهم من كل ما سبق ما يحلله جلبير في خطابات المثقفين الفرنسيين التي ترى أن النزعة الإسلامية ما هي إلا مجال خطابي، فإذا كان اللغة القومية مستجلبة من الغرب، فإن لغة النزعة الإسلامية محلية بامتياز، أو هي لغة أكثر منها عقيدة، حسب تعبير جلبير الذي يعيد موضعة الاستشراق، وفهمه الفرنسي، ولكن هذا الاستشراق سرعان ما أصيب بنكسة مع اغتيال ميشال سورا في لبنان – أحد الأشخاص الذي عمل معهم كاريه- ما أنتج قطيعة في ما بعد من قبل مجموع المستشرقين الفرنسيين، نظرا لتلك الأحداث دافعاً إياهم إلى العودة لمفاهيم الاستشراق التقليدي، وبهذا فإن ثمة اتفاقاً على النظر للإسلام أو التدين على أنه ظاهرة جوهرية للشعوب المسلمة، وليؤدي هذا الأمر إلى مراجعات من قبل المستشرقين الفرنسيين نحو الدعوة إلى إسلام علماني، والتشكيك بالمشروع الإسلامي برمته، وليستمر الجدل حول الظاهرة مع كل حدث طارئ كأحداث 11 أيلول/سبتمبر، وغيره، بهدف تعديل فهم الإسلام، وتوجهاته وتفسيراته.
في الختام، يأتي الفصل الرابع ليهتم بظاهرة الاستشراق، وتمثّلات ماركس وإنجلز ضمن السياق الاستشراقي الخاص بإدوار سعيد معرجا على مميزات الطرح، ومثالبه، ضمن تكوين منهجي معرفي، طارحاً نماذج أتت على نقد أطروحة الاستشراق لكل من رودنسون، الذي ينص على حصافة ما أتى به سعيد، ولكنه حذر في الوقت عينه من أن مطّ هذا الطرح قد يقود إلى تبني عقيدة دوغمائية، يمكن أن تنسف الكثير من الحقائق. وفي السياق عينه يأتي جلبير على بعض الآراء التي نالت سعيد، خاصة موقفه من المنظور الماركسي، وما ينطوي عليه من نزعات استشراقية، ما دفع بعض هؤلاء النقاد إلى نعت منهج سعيد بالانتقائية، ومنهم بعض الماركسيين العرب كمهدي عامل وغيره، حيث أخذوا على سعيد افتقاده لمعرفة فلسفية معمّقة، ومن ذلك نموذج ماكس فيبر الذي لم يذكره سعيد سوى مرة واحدة.
في جزئية أخيرة، يقدم الكتاب جملة تساؤلات تتمحور حول ماركس وإنجلز وثبوتية نزعتهما المركزية، وهنا يميز جلبير بين نمطين من المركزية، الأول معرفي، والثاني استعلائي، وبينهما ثمة مجالات كبيرة للتأويل والبحث، ولكن ثمة إشارة إلى أن الماركسية تتميز بقدرتها على تعديل نهجها وتصورها، كما يستنتج الكاتب عبر تحليل معمق لهذين البعدين مستأنسا بعدة نماذج، ولكنه يخلص في النهاية إلى أن أطروحة إدوارد سعيد، والطابع الكولونيالي، ونقد الثانية لماركس ينبغي أن يُرحب به، كونه يقود إلى تحفيز النقد الذاتي، أو التصحيح الذاتي اللذين لولاهما لكانت الماركسية قد ماتت من زمن.
نلاحظ بأن جلبير الاشقر يبدو فاعلاً أو ناشطاً في تحفيز المنظورات الماركسية من خلال اختبار متانة وجودها، ولكن هذا يأتي ضمن قضايا أو تيارات أقلقت الفعل الماركسي، وحيّدته إلى حد كبير؛ ولهذا سعى جلبير إلى ممارسة نقدية ذات طبيعة انعكاسية، ونعني اكتناه ظاهرتي التدين، والاستشراق بوصفهما أحدثا ضرراً معرفياً ووجودياً بالغاً في الطرح الماركسي؛ فكان لا بد من إعادة الواجهة الماركسية عبر إدخاله في جدال مع هذين الطرحين، من مبدأ الناظر والمنظور إليه، مما يُعيد حياة الأخيرة «الماركسية» ويجددها، أو ربما يعيد إليها شيئا من حيويتها لكونها تتغذى على مبدأ جدلي في الأساس. كما يشار إلى أن أطروحات جلبير في كتابه هذا، تبدو أقرب إلى محاولة تطويع الظاهرة، وتسويغها عبر البحث عن تفسيرات سياقية، ولكنه مارسها من منظور معرفي خاص، أو ماركسي، وبهذا فإن المأخذ الذي أخذ على الاستشراق باعتباره جانس المعرفة الغربية، عاد كي يظهر مرة أخرى في هذا الكتاب، ولكن بطبيعة معكوسة، أي أن هنالك مبدأ واحداً فقط « الفعل ورد الفعل».
٭ كاتب فلسطيني أردني
القدس العربي