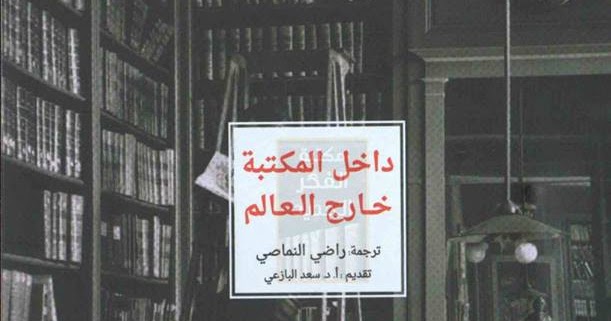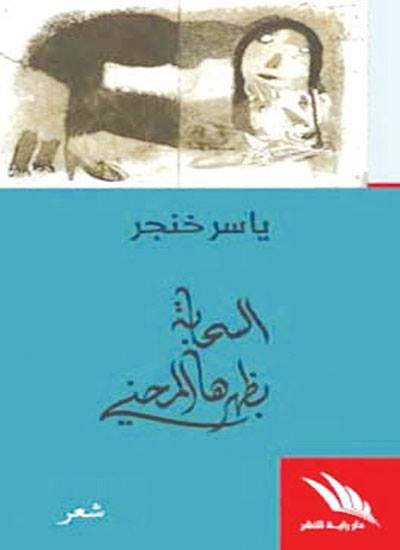“جنة وجحيم” تستعيد “فردوس” ميلتون من الصقيع/ عبده وازن

«جنة وجحيم» هي الرواية الأيسلندية الأولى التي تُترجم الى العربية، وصدرت عن دار المنى في السويد، وتولّت نقلها عن الأيسلندية سكينة ابراهيم. ويشارك مؤلفها الروائي يون كالمان ستيفنسن، في لقاء حول الأدب الأيسلندي في معرض أبو ظبي للكتاب، ويوقع النسخة العربية من روايته. وكالمان من أبرز روائيي الجيل الجديد، في الثانية والخمسين من عمره، أعماله تُرجمت الى لغات عدة، وتمثل الطبيعة الأيسلندية الباردة ركناً رئيساً في عالمه الروائي، بثلجها وبحرها الشمالي وعواصفها ثم بتراثها الفلسفي والوجودي.
< تفاجئ رواية «جنة وجحيم» قارئها العربي الذي يجهل الأدب السكندينافي الأوروبي، الغريب في أجوائه ومعالمه وجغرافيته وتاريخه، وفي أبعاده الفكرية والفلسفية. يجد القارئ نفسه في هذه الرواية الفريدة، أمام عالم يحكمه البرد والثلج كما العزلة والموت والغربة، لا سيما أن الأحداث تجري في القرن التاسع عشر، في مناطق منزوية، بحراً وبلدات لا يغادرها البرد بتاتاً، يعمل رجالها غالباً في صيد سمك القدّ أو المورية حتى ليُقال مجازاً، إن البيوت هناك بنيت من أحساك هذا السمك. لم يختر كالمان هذا القرن ليكتب رواية تاريخية كما قد يخيل للقارئ، بل ليكتب رواية «مسارية» فيها من التراجيديا والواقعية ما فيها من الحلم أو الكابوس والحب والشعر والصداقة والحداد والموت… رواية مناخ وشخصيات وأحداث وقصص تفوق الخيال من شدّة واقعيتها. والأشد طرافة أو فرادة، أنّ من يتولى السرد فيها ليس راوياً أو بطلاً أو كاتباً، بل ضمير الجماعة «هم» أو الموتى كما يوضح السرد واللعبة السردية المتقطّعة. إنهم الموتى الذين لم يغادروا أرض أيسلندا، يهيمون فيها ويراقبون الناس والوقائع، ويواكبون الحياة ليس من فوق بل من قلبها. هذه إحدى أولى خصائص هذه الرواية التي تقارب المدرسة الأليغورية والفانتازيا من غير أن تتخلى عن الواقعية، بطابعيها التاريخي والجغرافي. في مستهل الرواية، يتحدث هؤلاء «الهم» قائلين: «لم يبقَ فينا إلا القليل مما هو نور. نحن نقف أقرب الى الظلام، بل نحن ظلمة تقريباً، كل ما خلفناه لا يتعدى الذكريات والأمل المتخدر…». وفي مقطع آخر، يعرب هؤلاء الرواة الموتى عن مهمتهم الهادفة الى «بعث الحركة في عجلة المصير»، وهي كما يقولون : «أن نخبر عن أولئك الذين عاشوا في أيامنا قبل أكثر من مئة سنة، ويعنون لكم ما هو أكثر قليلاً من مجرد أسماء على صلبان مائلة وشواهد قبور. ننوي أن نحدث تغييراً في أنظمة الزمن القاسية التي محت الحياة والذكريات». وفي مجرى الرواية، كان لا بد لهؤلاء «الهم» أن يقطعوا سياق السرد متحدّثين بلهجة لا تخلو من التأمل والفلسفة والصوفية والحكمة في أحيان. ولعلّهم حاولوا أداء مهمة الراوي «العليم» الذي يوجّه السرد بحرية، لكنهم إنما يؤدون هذا الدور من قبيل الفانتازيا واللعب شبه الغرائبي.
ولئن اقتصرت الرواية على جزئين أو رحلتين، فإنما لرصد مسار الشخص الذي يدعى «الفتى» في انتقاله من عالم البحر، والأمواج العاتية، والرياح الهوجاء، والبرد القاتل، الى عالم البلدة الأيسلندية القائمة خلف الوديان والجبال التي تغطيها الثلوج، والتي تضم أشخاصاً نموذجيين وتعيش حياة وعادات غريبة على رغم واقعيتها. وقد يمكن إسباغ صفة المسارية على الرواية هذه انطلاقاً من رحلة هذا الفتى الذي ظلّ مجهول الإسم، وهي رحلة مزدوجة، رحلة بحرية ورحلة برية، ولكن في حال من الانصهار وكأنهما في الختام رحلة واحدة صوب المجهول الذي هو الموت في الأولى، والذي هو العزلة في الثانية، لكنها العزلة في قلب عالم غريب يحتلّه أناس وأطياف، أحياء كأنهم موتى وموتى كأنهم أحياء.
الفتى والبحر
الرحلة الأولى أو الجزء الأول من الرواية وعنوانه «الفتى والبحر وضياع الفردوس»، يستهلّها الرواة قائلين: «حدث هذا في السنين التي كنا خلالها ما زلنا أحياء نُرزق. نحن في شهر آذار والعالم متدثّر بالثلج الأبيض…». إنه الربيع الأيسلندي البارد إذاً. يتهيأ الفتى وصديقه الصياد باردور والصيادون الأربعة الآخرون، لخوض غمار البحر في هدف صيد سمك القدّ عبر مركبهم السداسي المجاذيف. تبدأ الرحلة بالتوجّه الى الكوخ البحري الذي يأوي إليه الصيادون قبل ولوج البحر، والذي يتاخم الشاطئ الذي «لا يغيب عنه الثلج بتاتاً». هذا الكوخ تشرف عليه أندريا التي يكنّ لها الفتى العشريني مقداراً من الحب غير المعلن، وهو ما يفضحه في ختام الرواية حنينه المستعر إليها. في هذا الكوخ، تقع حادثة نسيان الصياد باردور معطفه المبطن الذي لا يمكن ولوج عمق البحر من دونه، لا سيما عندما تهبّ العواصف الثلجية. أما ما دفع الصياد الى هذا النسيان القاتل، هو انكبابه على قراءة ملحمة «الفردوس المفقود» للشاعر الإنكليزي الكبير ميلتون الذي كان ضريراً. كان باردور مأخوذاً بهذه الملحمة، ويسعى الى حفظ ما أمكنه من أبياتها. والمفارقة أنه كان استعار نسخة الملحمة هذه من القبطان الأعمى كولبين، وهي قديمة طُبعت عام 1828 في ترجمة أيسلندية. ومثلما أن الرواية هي رواية الفتى وباردور والصيادين والبلدة البعيدة، يمكن القول إنها أيضاً رواية ميلتون وملحمته الشهيرة التي تستعيد حكاية التكوين وتعيد صياغتها. فلا هو ولا الملحمة يغيبان عن سرد الأحداث في الجزءين. بل إن الفتى لم يغادر الشاطئ وعالم الصيادين بعدما توفي صديقه باردور في المركب في عرض البحر العاصف ليبدأ رحلته الثانية، إلا بغية إعادة نسخة «الفردوس المفقود» الى صاحبها القبطان الأعمى. وكان الفتى فقد معنى وجوده في فقدان صديقه الذي كان له بمثابة الأب والرفيق والظلّ، على رغم الفرق في العمر بينهما. لم يحتمل الفتى موت باردور الصياد الذي كان يحب القراءة وبخاصة الشعر، وكان يحتفظ حتى في كوخ الصيد ببضعة كتب يعود إليها. هل يمكن الصياد أن يكون قارئاً وقارئاً حقيقياً؟ وهل يمكن أن تضع «قراءة الشعر الصياد في خطر الموت»؟ الرواية هذه تقول: نعم. وهذا ما حصل فعلاً: «قرأ باردورقصيدة وتجمّد حتى الموت بسببها»، يقول الكاتب، أو الرواة. ولا يتمالك الكاتب أو رواته عن مديح الشعر حتى لتبدو الرواية قصيدة روائية في مديح الشعر: «تحملنا بعض القصائد الى أماكن لا تبلغها الكلمات، ولا الأفكار. إنها ترقى بك الى الجوهر نفسه، فتتوقف الحياة للحظة واحدة وتصبح جميلة». كان باردور يقرأ بصوت عال الأبيات التي يودّ حفظها ليرددها في رحلة الصيد، وعلى ضوء القنديل في الكوخ يروح يعيد قراءة الأبيات مرة تلو أخرى بحماسة وحبور: «الآن يقبل المساء/ ثمة قلنسوة بلون الغسق/ مشوبة بالصمت/ تحط على المكان كله/ الوحوش أوت الى الملاجئ/ الطيور في أعشاشها/ هوذا الليل يهجع». ويصف الكاتب باردور خارجاً من الكوخ نحو البحر: «كان باردور يخرج غارقاً في مقطع شعري كتبه رجل إنكليزي أعمى، وأعاد كتابته بالأيسلندية كاهن بسيط. كان يعيد تلاوة المقطع الشعري، يغمض عينيه بسرعة ويخفق قلبه». وعن هذه الترجمة نعلم أنها طبعت في كوبنهاغن عام 1828، والكاهن الذي ترجمها يُدعى يون وكرّس لها خمسة عشر عاماً. ويقول الكاتب هنا: «ملحمة ألّفها في إنكلترا شاعر فاقد البصر، ألّفها للاقتراب من الخالق أكثر، الخالق الذي هو في أي حال، مثل السماء وقوس القزح والجوهر، يتفادانا حتى ونحن نسعى إليه. الفردوس المفقود. أفي الموت فقدان للفردوس؟».
ألا أن الصفحات التي يصف فيها الكاتب الرحلة البحرية وهبوب العاصفة الثلجية وعراك الصياد باردور مع الصقيع وموته، هي من أجمل ما يمكن قراءته في هذا القبيل. ولعلّه يذكر بصفحات بديعة كتبها روائيون كبار عن البحر من أمثال إرنست همنغواي (العجوز والبحر) وفيكتور هيغو (عمال البحر) وهيرمان ميلفيل (موبي ديك) على رغم اختلاف الأجواء والوقائع. لا يصف الكاتب مشاهده وصفاً بل يجعل القارئ يعيشها بحذافيرها وكأنه يبصرها بعينيه. ويخامر القارئ أيضاً ما خامر الفتى وهو يبصر صديقه يحتضر في البرد القارس، من مشاعر خوف ويأس وأسى عميق. ومن المشاهد المؤثرة تلك التي يصف فيها الصياد ميتاً وممدداً على سريره في الكوخ بعدما نقله الصيادون إليه: «زحف الصقيع الى قلبه، دخله، وبدخوله تلاشى كل ما جعل منه ما هو عليه… عيناه مفتوحتان لكنهما فقدتا لونهما وتنظران الى لا شيء». وبينما يجلس الصيادون قرب الميت، يشيح الفتى نظره وينهض الى الخزانة التي خبأ فيها الراحل «الفردوس المفقود»، يحمل الكتاب ويربّت عليه. هذا الكتاب سيكون حافز الفتى للبدء برحلته الثانية.
الفتى والبلدة
مع مغادرة الفتى كوخ الصيادين حاملاً كتاب «الفردوس المفقود»، يبدأ الجزء الثاني من الرواية وعنوانه «الفتى والبلدة والثالوث الدنيوي». يجتاز الوديان والجبال غير آبه للثلج والرياح، همّه أن يوصل الأمانة الى صاحبها ويبحث من ثم عن طريقة ينتحر بها. ويتذكر صخرة الانتحار التي كان حدّثه عنها باردور: «السقوط منها أسلس وأخف من الهواء، والبحر كفيل ببقية التفاصيل». إلا أن الفتى ليس شخصية ذات طباع انتحارية على رغم واقعه التعس ووحدته، ولم يكن الانتحار في نظره، هو المؤمن بل المسيحي، سوى حلّ للتخلّص من الحيرة الشخصية التي كانت تعتريه بعدما فقد صديقه الوحيد ومرجعه. لم تعقه الرحلة الشاقة من الوصول الى البلدة التي يقطنها القبطان الأعمى، وكان كتب له رسالة يخبره فيها مأساة باردور ويتركها له مع الكتاب ويرحل. لكنه ما أن يدخل عالم البلدة حتى يكتشف وجهاً آخر للحياة. هناك يتعرف الى أشخاص جدد والى نمط آخر من العيش والى علاقات غير مألوفة، يمتزج الشر فيها بالخير. وانطلاقاً من لقائه القبطان، يتعرّف الى فتيات ونسوة ورجال ومنهم: غيرترود المرأة اللعوب والغامضة، غوديون العجوز، القس النزق، القاضي لارس، ثورفالدر، هيلغا الثلاثينية الشقراء، راغينهيلد فتاة المتجر ذات العينين الرماديتين والتي لها يقول عندما تسأله عن نفسه: «أنا لا أعرف من أنا. ولست أصلاً واثقاً تماماً من أنني سأُمنح الوقت الكافي لأكتشف من أنا».
في هذا الجزء من الرواية، تتوالى التفاصيل والوقائع والأشخاص والقصص الصغيرة، ويكتشف القارئ عالم هذه البلدة التي تضم نحو 800 نسمة. وفي هذه البلدة، يدرك الفتى مصيراً لم يكن يتوقعه، وهو أن يصبح قارئاً للقبطان الأعمى كولبين الذي جلب له الكتاب. رجل صاحب مزاج متقلّب، يملك مكتبة تحوي 400 كتاب، ويقضي وقته مع القبطان الآخر برينيولفر، وبينهما يعيش الفتى مقدماً لهما العون والقهوة والمشروب. لكنّ الفتى لم يتمكن لحظة من نسيان صديقه باردور، وفي المقاطع الأخيرة من الرواية يتراءى له طيفه في المقهى. يرفع الفتى عينيه فتلتقيان بعيني باردور ويكلمه. وفي المقهى لا يبقى سواهما، «الفتى وباردور، ذاك الذي عاش وذاك الذي مات». يظل الفتى ينظر الى صديقه الذي لا يلبث أن يقول له: أنا وحيد هنا، فيجيبه الفتى متمتماً: وأنا أيضاً، ثم يطلب منه ألاّ يغادر وهو لا يعلم إن كان يعني ذلك أم لا. أما الأسطر الأخيرة، فبديعة حقاً وشفافة وشديدة الاستيهام: «يبدأ الثلج بالتساقط في الخارج ، يتساقط بصمت من وراء النوافذ، ندف كبيرة مثل أجنحة الملائكة. يجلس الفتى ساكناً وأجنحة الملائكة تحوم في الخارج، يجلس ويراقب باردور وهو يتبدد رويداً رويداً ويتحول الى هواء تقشعرّ له الأبدان».
رواية فريدة في مناخها ووقائعها وشخصياتها وفلسفتها ووجوديتها، هي أقرب الى أن تكون حكاية خرافية وأليغورية ولكن واقعية، تستند الى تاريخ هو القرن التاسع عشر، والى أرض وبحر وبشر وعادات تنتمي الى أيسلندا. والرواية هي ثالثة ثلاثية كتبها يون كالمان ستيفنسن، والروايتان الأخريان هما وفق عنوانيهما الفرنسيين «حزن الملائكة» و «قلب الإنسان». وليت دار المنى العريقة في نقل الأدب السكندينافي، تواصل ترجمة هذه الثلاثية الجميلة.
الحياة