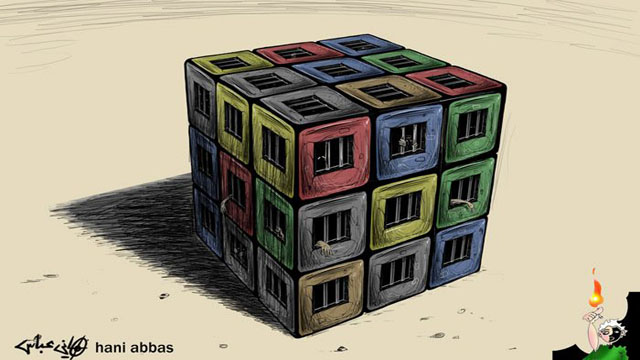جوديث باتلر: أن تتنفس وترغب وتحب وتعيش/ نوال العلي

صدر للفيلسوفة الأميركية، جوديث باتلر، كتاب جديد بعنوان “ملاحظات نحو نظرية أدائية للجماعة” (منشورات هارفرد). إننا أمام كاتبة غزيرة، لذلك فإن كتابة مقال عنها سيكون أشبه بأظافر تخدش السطح فقط. التفكير في منجز باتلر هو تفكير في “حال النقد” اليوم، بكلمات صاحبة “أجساد ذات شأن”، أو “وضع الفلسفة” اليوم، إذا كنا سنستخدم طريقة الفيلسوف التشيكي سلافوي جيجيك، والذي كان سيضيف إليها التحليل النفسي. فتناول تجربتها الفكرية يعني التنقيب في أن نكون ضد النزعة المؤسساتية، وكيف نتعامل مع الذات والقدرة على الفعل والتفكير في عصرنا.
كان اهتمام صاحبة “مواضيع الرغبة” (كتابها الأول 1987) في بدايتها بالهيغيلية، وكان مفهوم الرغبة أساسياً بالنسبة إليها، وبشكل أدق التفاعل بين الرغبة والاعتراف، وهو أمر له مركزيته في فينومينولوجيا هيغل. سيشكّل هذا الاهتمام في ما بعد محور دراساتها الفلسفية عموماً، والنسوية الجندرية بشكل خاص. ومع ظهور كتابها الثاني “مشكلة النوع”، بدا كما لو أن أحدهم أقدم على تغيير أدوات اللعبة في الكتابة النسوية عن الجندر وفي الدراسات “الكويرية”.
كان هذا الكتاب لدى صدوره عام 1990، استفزازياً بالمعنى الإيجابي لدى كثيرين، وصادماً لكثيرين أيضاً، وفيه قدّمت باتلر لأول مرة مفهوم “أدائية النوع”، والذي ترى من خلاله أن الجندر ليس فقط تصنيفاً غير أساسي، بل إنه مرتبط بالأداء والارتجال. آنذاك، لقي هذا المفهوم الترحيب بنفس القدر الذي لقي فيه الانتقاد من قبل نسويات أخريات، رأين في “النسوية الباتلرية” استسهالاً كبيراً في تناول قضايا المرأة والنوع، ولطالما أخذن عليها أنها لم تنخرط مع نسويات أخريات في النشاط الحقوقي للدفاع عن قضايا نسوية.
ليس الأمر أن باتلر متفرّغة للكتابة، بل إنها في الأساس، كانت تنتقد الصيغ المهيمنة على النسوية وقتها، والتي تفترض أن المرأة، ولكي يتم الاعتراف بها كامرأة، لا بد من أن تقع ضمن إطار الهوية الجنسية المنجذبة للرجل، وأن يكون لديها رباط خاص مع الأمومة.
ترى باتلر في الأداء نوعاً من الفعل، فإذا كان الجندر نوعاً من الفعل الذي يقوم به المرء من دون معرفة أو إرادة؛ فهو ارتجالي إذن؛ أي مزيج من اللامتوقع والمحتمل. وتعتبر أن فصل حياة الجندر عن حياة الرغبة أمر مستحيل، لذلك فهويتنا متأثرة بالشغف، وهذا يقود إلى استخدامها لكلمة “القدرة على الفعل” agency بديلاً عن “الذات”، التي تتجنّب استخدامها كي لا تضع نفسها في بارديغما الليبرالية الفردانية، التي انتُقدت من قبل مفكرين من طراز فوكو، كونها الذات الإمبريالية المهيمنة، التي لا يمكنها أن تحيد أو تثور على التأثير الثقافي. إذن فهي لا تتناول الذات، بل القدرة، التي هي ليست ضحية للمعايير وحسب، بل والعاجزة عن إعادة ابتكار الذات طوعاً أو كرهاً.بعد هذا الكتاب، توالت سلسلة مؤلفات اشتغلت فيها صاحبة “الحياة النفسية للسلطة: نظريات في الإخضاع”، على تطوير مفهوم “الأدائية”، في الوقت الذي تتأمل فيه الوسائل التي تتقاطع فيها الهوية والجنسوية والسياسة والأخلاق في العالم المعاصر، الأمر الذي اتضح أكثر في كتابها “حلّ النوع” Défaire le genre، والذي تتطرّق فيه إلى أن عملية تكرار الصياغة الثقافية هي في حقيقتها تثبيط لعملية إعادة صنعها، محاولةً تحليل الكيفية التي تتفاعل فيها العمليتان. تبدو باتلر هنا وكأنها تتبع تقليداً فوكوياً، ينطلق من أن المحظورات تقود إلى صيغ جديدة من الهوية وإعادة صناعتها.
تتوقّف مؤلفة “هل النقد علماني؟”، أيضاً عند النشاط الحقوقي Activism، وترى أنه إن كان ينبغي أن ينبثق من هوية ما، فلا بد ألا يكون محدداً بمحددات تلك الهوية. تقول: “يبدو لي أن مهمة كل الحركات الحقوقية أن تميّز بين المعايير والعهود التي تتيح للناس أن تتنفس وترغب وتحب وتعيش، وتلك التي تقيّد أو تسلب شروط الحياة نفسها”.
من فهمنا للجندر ولمعنى النشاط الحقوقي عند باتلر، نفهم مواقفها السياسية والأخلاقية التي لا تتجزّأ، هي التي تريد أن تحرّر ذلك النشاط من التصنيفات؛ ليس عليك أن تكون مثلياً لتطالب بحقوق المثليين، ليس عليك أن تكون امرأة لتدافع عن حقوق المرأة، ليس عليك أن تكون كاتباً لتطالب بحرية التعبير، ليس عليك أن تكون سورياً لتناضل من أجل السوريين، ويمكنك أن تكون يهودياً وتطالب بحقوق الفلسطينيين، وأن تواجه الصهيونية.
وهذا ما فعلته في كتابها “مفترق طرق.. اليهودية ونقد الصهيونية” (الذي نلحق جزءاً صغيراً مترجماً منه بهذا المقال)، وفيه توظّف لتوضيح موقفها من “إسرائيل” والصهيونية مفهوم اللااندماج أو لنقل التبرّؤ الذي ابتكره جاك رانسيه، للمواطن أو المثقف الفرنسي، الذي اعتبر أن الدولة الفرنسية لا تمثله حين ارتكبت مذبحة ضد 200 جزائري وسط باريس عام 1961. فباتلر كيهودية تعلن أن دولة “إسرائيل” لا تمثل اليهودية كهوية وكدين، وتستعين بشكل أساسي بمقولات إدوارد سعيد في كتابه “فرويد وغير الأوروبيين”، كما تستعين بأفكار حنا آرنت ومانويل ليفيناس وفالتر بنيامين وبريمو ليفي وتجربة محمود درويش في مقال بعنوان “ماذا نفعل من دون منفى؟”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتناول فيها باتلر عنف الدولة، فقد كتبت قبلاً “حياة مضطربة” و”أطر الحرب”، ولكن “مفترق طرق” هو كتابها الوحيد المخصّص لنقد الصهيونية و”إسرائيل”. وفي ظل هذا النقد، كانت تتصوّر المستقبل فيما هي تحاول بناء مفهوم لاهويّاتي لليهودية، مفهوم مبنيّ على فكرة التعايش كما طرحتها حنّة آرنت، فهي ترى أن تاريخ اليهودية يضع الآخر مكوِّناً في صميم الديانة، مقدّمةً برهاناً في تفسير إدوارد سعيد لـ “مصرية موسى”. من هنا لا يمكن فهم اليهودي من دون فهم العربي، فهو في صميم الهوية الأساسية لليهودية كما تقول.
وإن كانت باتلر تحاول تصوّر هذا المستقبل عبر قراءات مختلفة طيلة الكتاب، لكنها تقوله منذ الفقرة الأولى وتعترف بافتقاره إلى الواقعية السياسية في الوقت نفسه: “على الرغم مما يقال عادة من أن حل الدولة الواحدة وثنائية القومية المثالية هما هدفان غير عمليين، حتى من قبل أولئك الذين يلتفتون إلى النية الحسنة لمثل هذه المفاهيم، فمما لا شك فيه بل ومن المحق القول إن العالم الذي لا يدافِع فيه أحد عن حل الدولة الواحدة، ولا يعتقد أحد بعد الآن بالثنائية القومية، سيكون عالماً مفقراً على نحو جذري. أعرف أننا يمكن أن نقول الشيء نفسه عن “السلمية”. فربما تكون قد فقدت مصداقيتها من حيث أنها تفتقر إلى الواقعية السياسية، ولكن هل يريد أي منا أن يعيش في عالم لا وجود فيه لدعاة السلام؟ أي نوع من العالم سيكون هذا؟”.
“مفترق طرق”: مهمّة ملحّة ومستحيلة/ جوديث باتلر
لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة لي، وهدية أيضاً؛ أن أقرأ واحداً من آخر كتب إدوارد سعيد، “فرويد وغير الأوروبيين”، ليس فقط بسبب إعادة الارتباط الحيوية بشخصية موسى التي يحتويها الكتاب، بل لأن موسى يصبح بالنسبة إليه فرصة لتوضيح أطروحتين، أعتقد أنهما تستحقان النظر.
الأولى أن موسى، مصري، هو المؤسس لـ”الشعب اليهودي”، ما يعني أن الديانة اليهودية ليست ممكنة من دون هذا التضمين المعرِّف لما هو عربي. مثل هذه الصيغة تتحدى التعريف الأشكينازي المهيمن للهوية اليهودية Jewishness. لكنها أيضاً تتضمن أصولاً أكثر شتاتاً للديانة اليهودية Judaism، الأمر الذي يدعو إلى افتراض أن الحالة التأسيسية مُنحت ضمن الشرط الذي لا يمكن بوجوده تعريف اليهود من دون علاقتهم بغير اليهود.
ليس فقط في الشتات يجب على اليهود أن يعيشوا – وهم يعيشون بالفعل – مع غير اليهود، ويجب أن يفكّروا بدقة في كيفية عيش الحياة في خضم عدم التجانس الديني والثقافي، بل إن الأمر أنه لا يمكن فصل اليهود تماماً عن سؤال العيش بين من ليسوا يهوداً. من جهة أخرى، تضيف شخصية موسى نقطة توكيدية، بالنسبة للبعض، فاليهود والعرب ليسا فئتين قابلتين للفصل نهائياً، حيث إنهما عاشتا معا وتجسّدتا في حياة العرب اليهود.
بالطبع، هناك دائماً أسباب للتشكيك لأي لجوء إلى الأصول، التوراتية أو المجازية، ولكن سعيد هنا يُجري تجربة فكرية لتحريضنا على التفكير على نحو مختلف. في الحقيقة، إنه يعيدنا إلى شخصية موسى، ليظهر أن لحظةً تأسيسية جوهرية في اليهودية، اللحظة التي تبلغ الرسالة فيها للشعب، هي لحظة تقوم على شخصية لا تمييز واضحاً وحيّاً فيها بين العربي واليهودي. أحدهما متضمّن في الآخر- هل هذه أيضاً شخصية يمكن من خلالها فهم كيف يمكن لهويتين أن ترتبط الواحدة منهما بالأخرى خارج شروط الحاضر حيث إسرائيل، بزعم أنها تمثّل دولة قائمة على مبادئ السيادة اليهودية، تمارس أشكال الحكم الكولونيالي على الفلسطينيين من خلال الحرمان، الاحتلال، مصادرة الأرض، والترحيل.
البعد الثاني لهذا النص ينبثق فعلياً من الأول؛ حيث إن نص سعيد فيه شيء من الالتماس، التحريض على التفكير بأن “النفي” يَسِمُ تاريخ الشعبين الفلسطيني واليهودي، وبالتالي، من وجهة نظره، فإن هذا الأمر يؤسس لتحالف محتمل، بل ومحبذ أيضاً. من الواضح، أن هذه الأشكال من النفي ليست متساوية أو متناظرة: الدولة الإسرائيلية مسؤولة عن التهجير القسري للفلسطينيين واضطهادهم المستمر؛ طرد اليهود من أوروبا وتحطيمهم، يؤسّس، بحد ذاته، تاريخاً كارثياً منفصلاً. لنفترض أن هناك أنماطاً تاريخية للكارثة التي لا يمكن قياسها أو مقارنتها باستخدام أي معيار مألوف أو محايد. ومع ذلك، أثمة طرق أخرى للاستقراء باستخدام التاريخ الشخصي للنفي للفهم والوقوف في وجه نفي الآخرين؟
يدعو سعيد الشعب اليهودي إلى أن يضع في اعتباره تجربته الخاصة؛ أنه طُرد من الأرض وجُرِّد من الحقوق، لتشكيل تحالف مع من طردتهم إسرائيل. دعوته تفترض أنه ربما توجد، أو ينبغي أن توجد، مقاومة يهودية لإسرائيل، وأن الشعب اليهودي قد يتبع مساراً مختلفاً عن ذلك الذي اتخذته إسرائيل. حتى لو سلّمنا، وهو ما ينبغي علينا فعله، بالتاريخ الفريد للاضطهاد اليهودي، فإن هذا لا يعني أنه وفي كل سيناريو سياسي بأن اليهود سيكونون دائماً هم الضحايا، وأن العنف الذي يمارسونه سيُنظر إليه دائماً على أنه دفاع عن النفس. في الحقيقة، إن التسليم بتفرّد تاريخ واحد هو ضمناً أن تكون ملتزماً بتفرّد كل تاريخ مماثل.
عند هذه النقطة، يمكن للمرء أن يطرح سؤالاً من نوع مختلف. والأمر ليس أن يتم التأكيد على أن الصهيونية مثل النازية، أو أنها تكرار لا واعٍ مع الفلسطينيين الذين يرمزون لليهود هنا، إذ إن مثل هذه المماثلة تخفق في الأخذ بعين الاعتبار النماذج شديدة الاختلاف للاضطهاد والنفي، والتعامل مع الموت التي تميز القومية الاشتراكية والصهيونية السياسية. الأمر بالأحرى، هو التساؤل عن الكيفية التي يمكن من خلالها استقراء مبادئ من نوع معين عبر مجموعة من الظروف التاريخية، ثم استخدامها لفهم ظروف أخرى. إنه نقلة تقتضي فعلاً من الترجمة السياسية التي ترفض هضم تجربة في أخرى، وترفض أيضاً ذلك النوع من التخصيص Particularism الذي يمنع أي وسيلة محتملة لربط مبادئ من نوع، لنقل مثلاً، حقوق اللاجئين على أساس اعتبارات مقارنة بين هؤلاء وأمثلة أخرى من الطرد التاريخي.
قد تكون الحالة، بالفعل، أن الإرث الأخلاقي والسياسي من الإبادة الجماعية التي قامت بها النازية ضد اليهود (والتي كانت، حقيقة، إبادة جماعية لعدة أقليات) هو معارضة كل أشكال عنصرية الدولة ونماذج العنف، وإعادة النظر في حقوق تقرير المصير وأن تمنح هذه الحقوق لأي شعب، سواء أكان يعتبر أقلية دائمة (في إسرائيل) أو تحت ظروف الاحتلال (الضفة الغربية وغزة) أو انتزعت أرضه وحقوقه (الشتات الفلسطيني في 1948 و1967).
ربما تكون الثنائية القومية غير ممكنة، لكن هذه الحقيقة المجردة ليست كافية للوقوف ضدها. الثنائية القومية ليست مجرّد حل مثالي “مستقبلاً”، شيء قد نتمنّى أن يحدث في مستقبل أكثر مثالية، لكنه حقيقة تعيسة تُعاش عبر شكل تاريخي من الاستيطان الاستعماري، وعبر التقريب والإبعاد اللذين أعاد هذا الشكل إنتاجهما من خلال الممارسات العسكرية والتنظيمية اليومية للاحتلال. حتى وإن لم يكن لا اليهود ولا الفلسطينيون شعبيْن متآلفين، إنهما، مع ذلك، مرتبطان في إسرائيل/فلسطين معاً بأساليب معقدة وصعبة من خلال نظام من القوانين الإسرائيلية والعنف العسكري؛ الأمر الذي أنتج حركة مقاومة اتخذت أشكالاً عنفية ولا عنفية.
لكن، وبدلاً من البدء بتاريخ الصهيونية كمشروع استعماري لفهم كيف جُمع اليهود والفلسطينيون معاً، يقترح سعيد أنه يمكن للمرء أن يعيد التفكير بالأصول الإنجيلية، ليس لأن الإنجيل كان أساساً شرعياً لتأسيس أي نظام سياسي -فهو لم يكن كذلك- ولكن لأنه يقدّم شخصية قد تساعدنا على التفكير بطريقة جديدة. موسى هو مركز تفكيرهم، حالة حيّة على الاندماج. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن موسى كان يهودياً غير أوروبي، فإن اليهود العرب هم مصدر فهمنا للديانة اليهودية -إنه شخصية لا يمكن الفصل بين العربي واليهودي داخلها. تنطوي هذه الحقيقة على نتائج ضمنية معاصرة، ليس فقط إعادة التفكير في تاريخ الشعب اليهودي بطريقة لا تفترض جذوراً أوروبية. من هنا، ضم المزراحيم والسفارديم كمركز لتاريخ الشعب اليهودي، بل أيضاً فهِمَ أن العرب اليهود يؤسّسون حالة أو تعايشاً (يفهم على أنه مفصل مشترك مع الغيرية) كمبدأ مؤسس للحياة اليهودية.
ومن ثمّ فإن سعيد يلاحظ أن غير الأوروبي من وجهة نظر اليهود الأشكيناز هو ضروري وجوهري لفهم معنى الديانة اليهودية. لدى قراءتي لكلمات سعيد حول هذا الموضوع، وجدت نفسي ممتنة لفهم الهوية اليهودية على نحو لم أكن لأتوصل إليه لولا سعيد. بهذه الطريقة، تصرّف سعيد كغير الأوروبي الذي قد “يجد” الشعب اليهودي من جديد. وعلى الرغم مما قد يُقرأ في ذلك من الغطرسة، إلا أن الأمر صعقني، وكأنه استحضار مؤثر، لدى استعادة هذا التحالف الأصيل الذي لا يمكن تخطيه. لم يكن سعيد متحمّساً أبداً لما بعد البنيوية ونقدها للموضوع (لقد حذّر بقوة من النقد الفوكوي للإنسانية، مثلما فعل في الاستشراق)، رغم ذلك فمن الواضح أن أكثر ما يعجب سعيد في مديح فرويد لموسى كغير أوروبي، المصري مؤسس اليهود، هو التحدي الذي تطرحه شخصية موسى على السياسات الهوياتية المتشددة.
إذا كان موسى يجسّد تطلعاً سياسياً معاصراً، فهو التطلع الرافض لأن يكون منظِّماً حصرياً على مبادئ الهوية القومية، الدينية أو العرقية، التطلع الذي يقبل الاختلاط والتمازج كشروط لا رجعة فيها للحياة الاجتماعية. أكثر من ذلك، بالنسبة لسعيد، فإن فرويد يمثل بجرأة وجهة النظر التي حتى وهي الأكثر تحديداً، الأكثر تحققاً، الهوية الاجتماعية الأكثر عنداً. وبالنسبة لفرويد فهذه كانت الهوية اليهودية- هناك حدود موروثة تمنعها من أن تكون متحدة/ مندمجة في هوية متجانسة ومحددة، فريدة وحصرية. يصر سعيد على أنه لا يمكن التفكير في الهوية أو العمل عليها وحدها، لا يمكنها أن تؤسّس أو تتصوّر نفسها “من دون ذلك الاختراق أو العيب الجذري والأصلي والذي لن يتم كبته، لأن موسى كان مصرياً، وبالتالي فخارجُ الهوية دائماً هو داخلُها؛ حيث الكثير صمد، وعانى، وربما، لاحقاً، انتصر”.
من الملفت للنظر هنا أنه، وعلى الرغم من أن سعيد يتأمل في أصول اليهودية، يجد هناك، في موقع ذلك الأصل، تمازجاً مع الآخرية (ما يمكن أن يطلق عليه الفلاسفة القاريون الغيرية المتأصلة)، “قوة هذه الفكرة،” يقول لنا، “إن بالإمكان إيضاحها والتكلم بها إلى الهويات المحاصرة الأخرى أيضاً، على اعتبار أنها جرح علماني مقلِق ومعطِّل، ومهدِّد للاستقرار”. (فرويد وغير الأروبيين).
وبالرغم من أن معنى “جرح علماني” لا يتضح مباشرة/ لكن ربما يفهم سعيد العلمانية بأن تجرح أو تبتر الأنماط غير العلمانية من الانتماء السياسي. بهذا المعنى، فإن العلماني يجرح القيم الاجتماعية التقليدية المزعومة. ومع ذلك، بعد الجرح، يبدو أن أشكالاً جديدة من الانتماء تصبح ممكنة. يتساءل إن كان يعد ممكناً لنا أن نستمر بالتفكير بهذه الفكرة في شعبين، شعب شتاتي، يعيش في مكان واحد؛ حيث الشتاتي يُفهم باعتباره تحقيقَ الهوية فقط مع ومن خلال الآخر، يصبح الأساس لنوع من الثنائية القومية. هل يمكن لهذه الفكرة أن تلهم بشرط السياسات في الحياة الشتاتية؟ يتساءل سعيد: هل يمكن لها أن تصبح الأساس غير المتزعزع جداً في أرض اليهود والفلسطينيين ذات الدولة ثنائية القومية حيث “إسرائيل وفلسطين جزأين وليسا خصمين لتاريخ كل منهما وواقعه الأساسي؟”. (فرويد وغير الأوروبيين).
مقتطف من كتاب “مفترق طرق”
ترجمة نوال العلي
العربي الجديد