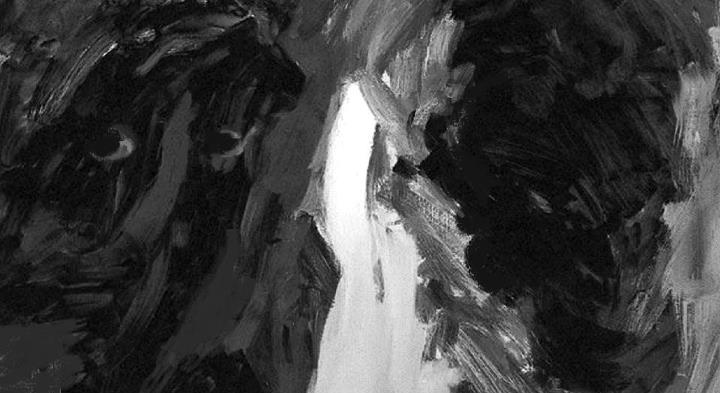‘حروب’ سورية: تعددت التسميات والمسمّى واحد!
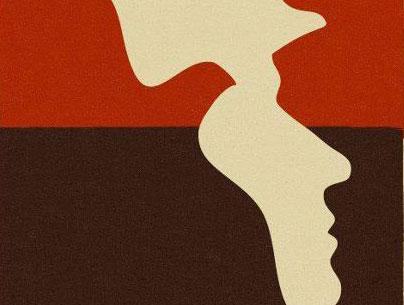
صبحي حديدي
مزيج من الخفة والاستخفاف، والجهل المتأصل أو التجهيل المتعمد، كان وراء تصريح هرفيه لادسو، مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، بأن ‘سورية باتت الآن في حرب أهلية شاملة’؛ ليس استناداً إلى أي دليل آخر سوى أنّ ‘الحكومة السورية فقدت السيطرة على بعض المناطق التي سيطر عليها المسلحون، وهي تحاول استعادة السيطرة عليها’. ولكي يغطي على أنماط الفشل الذريع التي انتهت إليها أعمال المراقبين الدوليين، وكان أحدث فصولها عجزهم عن الاقتراب من بلدة الحفة بسبب اعتراض الشبيحة لهم، وإطلاق النار على سياراتهم، أعلن لادسو أنّ ‘مهمة المراقبين هي حفظ السلام، في حين انه لا يوجد سلام لحفظه’.
ثمة، بادىء ذي بدء، حماقة ‘تقنية’ محضة، في المساواة ـ ثمّ الحديث عن ‘سلام’ و’حفظ سلام’ بعدئذ ـ بين قوّات عسكرية نظامية تتجاوز 200 ألف مقاتل، مجهزة بجميع صنوف الأسلحة الثقيلة، من الدبابات والمدفعية إلى القاذفات والحوّامات والزوارق الحربية؛ وفصائل ‘الجيش السوري الحرّ’، ذات العديد القليل، والسلاح الفردي الخفيف، والانتشار المبعثر، وانعدام حلقة القيادة المركزية. وثمة، تالياً، تلك السقطة الأخلاقية الصرفة، في المساواة بين الضحية والجلاد، وزجّ القتيل (الأعزل، المدني، الطفل والمرأة والشيخ…)، مع قاتله (العسكري المحترف، عنصر الأمن المدرّب، عضو المليشيا، والشبيح المتطوّع أو المرتزق…)، في سلّة واحدة، غائمة المصطلح وعائمة المعنى، اسمها ‘الحرب الأهلية’.
صحيح أنّ مجازر استثنائية على غرار الحولة والقبير، ليس من حيث الفظاعة الوحشية والهمجية القصوى فحسب، بل أيضاً من حيث الطرائق العملياتية في تنفيذها (على يد ضباط كبار، أسوة بأفراد مدنيين من الشبيحة والميليشيات)، أخذت تعزز نظريات المسير نحو ‘حرب أهلية’ من طراز ما. صحيح، كذلك، أنّ هذه المجازر، لجهة وقوعها في مناطق محددة ترسم نوعاً من ‘خطوط تماس’ ديموغرافية/طائفية، رسّخت أيضاً احتمالات انزلاق بعض جيوب النظام المتنفذة نحو ما يشبه ‘التطهير الطائفي’. كذلك كان تلميح بشار الأسد، في خطابه الأخير، إلى أنه لم يعد ‘رئيس’ كلّ السوريين، وأنّ الحسم العسكري له الأولوية على الحلول السياسية، أضاف عنصراً ترجيحياً يوحي بأنّ صراع النظام ضدّ الانتفاضة قد اتخذ صفة جديدة، ‘أهلية’ على نحو ما…
إلا أنّ حقيقة الأمر، ومعطيات واقع الحال على الأرض، ما تزال تشير إلى خطل شديد، يبدو حتى الساعة شبه قاطع، في أي استخدام لمصطلح ‘الحرب الأهلية’، بصدد توصيف سلسلة تسميات لحروب متنوعة، سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وثقافية ودينية وطائفية، تنتهي جميعها إلى مسمّى مركزي واحد: حرب الشعب السوري، بجميع اعراقه وأديانه وطوائفه، وغالبية طبقاته وفئاته الاجتماعية؛ ضدّ نظام الاستبداد والفساد والتوريث، الذي ـ رغم كلّ ما فعله ويفعله في استغلال الطوائف والأقليات ـ لا طائفة له ولا دين، سوى عقيدة السلطة ومذهب النهب. إنها، اليوم كما طيلة 15 شهراً من عمر الانتفاضة، حرب الشعب المصرّ على التغيير والمستقبل الأفضل، بوسائل سلمية على النطاق الأوسع، وبوسائل أخرى تعسكرت جزئياً وموضوعياً؛ ضدّ نظام يتشبث بالسلطة حتى آخر خطوط الدفاع، الأمنية والعسكرية، التي تزداد عنفاً وهمجية.
واليوم أيضاً، كما في أطوار سابقة من عمر الانتفاضة، يجد القائلون بمصطلح ‘الحرب الأهلية’ حرجاً بالغاً في إطلاق الاسم المناسب على المسمّى الفعلي، كأن يُقال إنّ تلك الحرب تدور بين ‘دين’ وآخر (إسلام مقابل مسيحية)، أو ‘طائفة’ في وجه أخرى (السنّة مقابل العلويين، في المقام الأوّل). ولا تُحصر مفردتا ‘دين’ و’طائفة’ بين أهلّة، هنا، إلا لأنّ مثل هذه المصطلحات ذات طبائع دلالية عالية الإشكال ودائبة التبدّل، وليس من الحكمة اعتمادها كمسلّمات لمعانٍ متفق عليها، في العموم؛ فكيف إذا كانت روافع تحليل لمسائل بالغة التعقيد، تخصّ تشخيصات الحروب الأهلية والطائفية. فلا الدين معطى لا خلاف على مضامينه، خاصة عندما يتصل الأمر بفرقاء يخوضون مواجهات مسلحة قد تبلغ حافة الحرب الشاملة المفتوحة؛ ولا الطائفة كذلك، بل العكس هو الصحيح، لأنها مقولات موضع خلاف يستدعي التمييز وليس التعميم.
طراز ثانٍ من الحرج، يرتدي هذه المرّة صفة الافتقار إلى توفّر عناصر ذلك الاحتراب الطائفي، أو الأهلي، كما يتوجب أن تتبدى خارج النطاق الوحيد المتوفر الآن، أي انتفاضة الشعب السوري. في صياغة أخرى: هل ستنخرط الأديان أو الطوائف في احتراب داخلي، ضمن صفّين لا ثالث لهما: واحد يناهض النظام، وثانٍ يدافع عنه؟ أم أنها ستتقاتل على هذَين الخطّين، أوّلاً؛ ثم ستنخرط في صراع على الفروقات ما فوق الدنيوية، الفقهية واللاهوتية والمذهبية، بين دين ودين، وطائفة وطائفة؟ وإذا جاز هذا التوسيع لمضامين الاحتراب، فهل يجوز زجّ السوريين عشوائياً هكذا، في صفّين، أو بالأحرى في قالبَيْن، لم يعد فيهما مكان لمطالب الشعب الواحد، في الحرية والديمقراطية والتعددية والعدالة والكرامة ودولة القانون…؟
ساجلنا من قبل، ونساجل اليوم أيضاً، بأنّ هذا سبب أوّل لا يجعل ذلك الاحتراب، أياً كانت تسمياته الأخرى، مآلاً محتوماً في الطور الراهن من مسار الانتفاضة السورية؛ وهو بالتالي لن يقع إلا في مساحات اشتغال الخطاب الترهيبي الذي يعتمده النظام بهدف كسر روح المقاومة، وردع المواطنين، ودفع ‘الأغلبية الصامتة’ إلى الإمعان أكثر في انعزالها. سبب آخر، رديف، هو أنّ التطلع إلى الحرّية والمستقبل الأفضل ليس محلّ اختلاف بين أديان السوريين وطوائفهم، بل هو غاية تستقطب الاتفاق التامّ، وكانت هذه حالهم في الماضي، منذ فجر الاستقلال، كما هي حالهم اليوم أيضاً. وفي المقابل، ما دام النظام لا يمثّل مصالح طائفة واحدة، أو دين منفرد، فإنّ أنصاره لن يدافعوا عن بقائه لأسباب دينية أو طائفية، بصرف النظر عن توفّر هذا المقدار أو ذاك من الولاء العصبوي.
هذا يفضي إلى سبب ثالث يجعل احتمال الحرب الأهلية أو الطائفية غير وارد اليوم، ويختصره السؤال التالي: إذا صحّ أنّ أديان المجتمع السوري وطوائفه لم تنجرف إلى اقتتال طائفي أو ديني طيلة تاريخ سورية، القديم والوسيط والحديث والمعاصر؛ فما الذي سيجعلها تقتتل اليوم، دفاعاً عن نظام الاستبداد والفساد والنهب والحكم العائلي، وخاصة بعد سلسلة جرائمه بحقّ الشعب والوطن؟ وإذا كان الانتداب الفرنسي قد فشل في إقامة دويلات سورية، مناطقية أو طائفية، وتمكّن السوريون من خوض حرب الاستقلال بقائد درزي، ونائب له علوي، ونائب ثاٍن كردي… فكيف لا يكون مصير مشروع التفتيت الذي ينخرط فيه نظام العصابات والميليشيات والشبيحة، على شاكلة المشروع الذي دبّرته إدارة استعمارية، بل أسوأ؟
طبائع الجغرافيا السورية سبب رابع يُقصي احتمالات الحرب الأهلية، إذْ أين ستدور، على الأرض؟ بين أية منطقة ومنطقة؟ وهل ستسمح المعطيات الديموغرافية بوقوعها في أية بقعة، هكذا اعتباطاً، لا على التعيين؟ بل هل سيسمح الاختلاط السكاني المركّب لأبناء سورية، وفسيفساء توزّعهم الإثني أو الديني أو الطائفي، بتحديد بقعة واحدة يمكن للنظام أن يدير عليها جولات توتير عسكري بين عناصر تلك الفسيفساء؟
واستطراداً، هل ستدور تلك الجولات، أو تُدار، على ركائز انفرادية أم ائتلافية، بمعنى أنّ طائفة واحدة سوف تخوضها ضدّ طوائف أخرى، أم ستتحالف مع سواها؟ ولماذا، ما دمنا في الافتراض المكروه ذاته، سوف يصمد ذلك التحالف إذا كان مجبراً على الانخراط في واحد من أقصَيَْن: مع الشعب، من أجل سورية حرّة كريمة أفضل؛ أو مع النظام، من أجل بقاء الاستبداد والفساد والنهب والحكم العائلي؟
هذه أسئلة جارحة بالطبع، ومثار حرج وتهيّب وتطيّر؛ طُرحت من قبل، ولا مناص من طرحها اليوم أيضاً، لأنها ذات طبيعة لازمة تماماً عند نقاش احتمالات حرب أهلية او طائفية في سورية، ولا يكفي إغماض العين عنها، وكأنّ الاجتماع السوري يكفي بذاته، ولا حاجة إلى الجغرافيا. المراقب الغربي ـ من طراز لادسو، أو رهط زاعمي ‘الخبرة’ بشؤوننا وشجوننا ـ يستهوي لعبة الاختزال هذه، فيقفز مباشرة إلى إحصائيات ديموغرافية صرفة، حول نسبة هذه الطائفة أو تلك بالمقارنة مع المجموع السكاني؛ ثمّ يتخيّل نشوب الصراع بين تلك النِسَب، على النحو الأكثر اعتباطاً، ودونما تمحيص في تمثيلاتها على الأرض، أو تدقيق مفاعيلها الجيو ـ ديموغرافية.
سبب خامس يخصّ توازنات تلك السيناريوهات، من الجوانب العسكرية واللوجستية الصرفة، إذْ أين سيقف الجيش السوري، في مجموعه العريض، إذا وقع احتراب بين أبناء الوطن الواحد؟ فهذا الجيش ليس كتلة بازلتية صماء، متماسكة في المطلق حول معتقد مشترك، يسهل زجّه في جولات الاقتتال وكأنه مجرد قطعة على رقعة شطرنج. هنالك، داخل الجيش كما داخل الأديان والطوائف، مصالح سياسية واجتماعية واقتصادية، وتباينات مناطقية وثقافية، بل إثنية أحياناً، تكسر أسطورة حجر البازلت ذاك، وتجعل انخراط الجيش أمراً محتوماً، على صعيد الأفراد، ثمّ على صعيد تشكيلات عسكرية يمكن أن تتوسل غاية توحّد أفرادها. ولهذا يندر أن تجد، في صفوف عرّافي الحرب الأهلية أو الطائفية في سورية، مَنْ يخوض في تفصيل دينامية انخراط الجيش في الصراع، والشائع هو تهويل الأخطار وتضخيم العواقب.
ويبقى، بالطبع، ذلك السبب السادس الذي يتكىء على اعتبار شائع (مسكوت عنه أكثر من سواه، في الواقع)، يفترض أنّ أبناء الطائفة العلوية سوف يسارعون إلى الوقوف خلف النظام، صفاً واحداً متجانساً متماسكاً متماثلاً، إذا اندلعت مواجهات طائفية. وهذا افتراض سطحي تماماً، خامل وبليد، فضلاً عن كونه بالغ الخبث ومسبَق الظنّ بطائفة لم تكن في أيّ يوم أقلّ إسهاماً في معارك سورية الوطنية والسياسية والطبقية. ولا أجدني أتردد في تكرار يقين سبق أن شدّدت عليه مراراً: رغم كلّ هواجسهم المشروعة، أو تلك التي يغذّيها الرهاب الصرف، لن تُساق غالبية أبناء الطائفة العلوية إلى هدف السلطة المركزي، المتمثل في إقناعهم بأنّ مصيرهم مرتبط وجودياً ببقاء أو سقوط النظام. ليس هذا من باب التمنّي الصرف، كما يمكن أن يلوح عادة؛ أو إغماض العين عن حقائق الجهود المضنية التي بُذلت، وتُبذل على الدوام، من أجل تجنيد شرائح واسعة من أبناء الطائفة العلوية؛ بل هو يقين تسنده معطيات فرضها ماضي الطائفة وحاضرها، وحقيقة أنها ليست أداة صمّاء بكماء عمياء يُلقي بها النظام أينما شاء، وكيفما أراد.
والسوريون الذين صبروا، وصابروا، بعد عشرات المجازر وآلاف الشهداء، وشهدوا من الأهوال ما لم يسجّل التاريخ في أحلك ظلماته، وبذلوا من التضحيات ما جعلهم مفخرة الشعوب في أربع رياح الأرض، وكتبوا في ثقافة المقاومة مجلدّات وأسفاراً… هيهات أن يمنحوا الرهان على الحرب الأهلية فرصة فوز واحدة. وفي هذا يستوي مراهن خارجي من أمثال هرفيه لادسو، مع مراهن محلي من أمثال بشار الأسد.
‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس