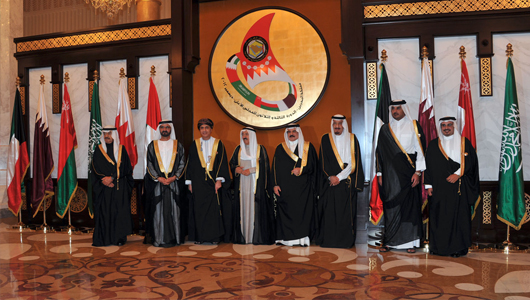حسابات إسرائيلية في سورية/ عبد النور بن عنتر
أربك انفجار الأزمة في سورية، وتحولها إلى حرب أهلية وإقليمية/ عالمية بعد العسكرة السريعة لانتفاضتها الشعبية، إسرائيل وأوقعها في معضلاتٍ حقيقية، فإسرائيل التي راهنت دائماً على الأنظمة التسلطية العربية، الملكية والجمهورية، غير المعادية لها، كانت “مطمئنة” بعض الشيء للنظام السوري، على الرغم من عدائهما وصراعهما التقليدي في لبنان ودعم سورية حزب الله. ويعود هذا “الاطمئنان” إلى أن الجبهة السورية أكثر الجبهات العربية -الإسرائيلية استقراراً منذ حرب 1967، فعلى الرغم من احتلال إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ يونيو/ حزيران 1967، فإن خط وقف إطلاق النار بين البلدين لم يشهد اشتباكات عسكرية تذكر. ويمكن الحديث عن نوع من “التوافق” بين سورية وإسرائيل بشأن عدم جعل الحدود ومنطقة الجولان المحتلة مسرحاً لصراعهما، بل ولعدائهما إقليمياً، خصوصا أنهما اتخذا وإيران من لبنان مسرحاً للصراع، بل وللحرب أيضاً، في غالب الأحيان بالنيابة، عبر حزب الله. لذا فبقاء النظام السوري كان ولا يزال مصلحة إسرائيلية، ما دامت جبهة الجولان هادئة، ولا توجد هناك فرص جدية لإعادته إلى سورية التي ستصبح حينها دولةً مطلةً على بحيرة طبرية، المصدر الأساسي للمياه السطحية في إسرائيل. لذا تمسّكت إسرائيل، خلال المفاوضات حول الجولان في التسعينيات، بخط 1923، بينما تمسكت سورية بخط 4 يونيو/ حزيران 1967.
من هنا، تأتي المخاوف الإسرائيلية من الانتفاضة الشعبية السورية، قبل عسكرتها وتحولها حربا أهلية، تتقاطع وصراعات إقليمية ودولية، ما جعل سورية التي عبثت سنواتٍ بأمن لبنان،
“غياب استراتيجية إسرائيلية واضحة حيال الأزمة السورية وعملها وفق مخططات تكتيكية”
مسرحاً لعبث الصغار والكبار من الفواعل الإقليمية والدولية. ويبدو أن إسرائيل واعيةٌ بأنها قد تخسر نظاماً لم يخلق لها متاعب تذكر على جبهة الجولان المحتل، وستجد نفسها أمام انتفاضة قد يتمخض عنها نظام ديمقراطي معادٍ لها تماماً، ويطالب بالاستعادة الفورية للجولان. خصوصا أن الدعم الغربي باسم الحرية الديمقراطية للانتفاضة السورية، للتخلص من نظام الأسد، يجعل صعبا اتهامها بالإرهاب مثلاً، لو هي أقامت نظاما ديمقراطياً، وطالبت باسترجاع الأراضي السورية المحتلة. إنها المعضلة الاستراتيجية التي واجهتها إسرائيل في الأشهر الأولى من الانتفاضة السورية، والتي تميزت بدرجةٍ عاليةٍ من اللايقين. ويتناغم الموقف الإسرائيلي تماماً وموقف القوى الغربية التي واصلت الوقوف إلى جانب الأنظمة التسلطية على حساب الانتفاضات الديمقراطية، ولم تتخل عن رموزها إلى آخر لحظة، بعد أن اتضح لها أن المسائل تكاد تحسم نهائياً. هكذا تم التخلي عن زين العابدين بن علي وحسني مبارك، قبل أن تساهم الفواعل نفسها، بدعم دول عربية، في إعادة التسلطية في مصر وإجهاض الانتفاضة الشعبية، فيما تبقى الحالتان التونسية والليبية استثناءً، الأول من حيث نجاح الانتفاضة الديمقراطية، والثانية من حيث عسكرتها والتدخل الأجنبي لإسقاط النظام.
أما النظام السوري فهو الآخر أمام معضلة، فمن مصلحته إقحام إسرائيل في الصراع المحلي، لضرب شرعية الانتفاضة الشعبية باتهامها بالتواطؤ مع العدو التقليدي لسورية، ولكن إن فعل فهو سيبدّد عقوداً من الهدوء مع إسرائيل، ما جعل الأخيرة تفضله على غدٍ “ثوري” مجهول. على ما يبدو، راهن على الخيار الثاني، أي عدم فتح جبهة مع إسرائيل، هو في غنىً عنها، خصوصا أن استيطان الجماعات الإرهابية، لا سيما داعش، ودخولها في الحرب الأهلية السورية، أحدث توافقاً بين المصالحة الأمنية للنظام السوري وإسرائيل. وكان لهذا التوافق انعكاسٌ على مجريات الحرب ميدانياً، لأن إسرائيل تحركت لدى الإدارة الأميركية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لإقناعها بعدم تزويد الثوار السوريين بصواريخ جو – أرض لإمكانية استخدامها ضد المقاتلات الإسرائيلية. هذا التهديد غير مستبعد، والواضح أن إسرائيل كانت تتخوف حينها من احتمال نجاح فصائل المعارضة المسلحة السورية في قلب النظام، لكن مخاوفها على المديين، المتوسط والبعيد، جعلتها تساهم في التفوق الجوي للجيش النظامي على فصائل المعارضة المسلحة.
ولا يعني التقاء المصالح الأمنية بالضرورة توافقاً استراتيجياً في المجال العسكري، فإسرائيل كانت، ومنذ عقود، تسعى إلى إفشال خيار التوازن النووي عبر الأسلحة الكيميائية. حيث إن دولا عربية، لا سيما سورية، عملت على موازنة الحصرية النووية الإسرائيلية بتطوير أسلحة كيميائية كفيلة بإيجاد توازن الرعب في المنطقة. لذا، لما توالت المعلومات حول استخدام نظام الأسد السلاح الكيميائي ضد الثوار، انتهزت إسرائيل الفرصة، وطالبت بضرورة التخلص من
“تتخوّف إسرائيل من تداعيات التوافق الروسي – الإيراني إقليمياً”
هذه الأسلحة السورية. وكان لها ما أرادت، مع التوصل إلى الاتفاق الدولي، برعاية روسيا والولايات المتحدة، بشأن نزع السلاح الكيميائي السوري. واستخدمت إسرائيل هذه الحجة لضرب مواقع عسكرية سورية مراتٍ، خصوصا أن تورّط حزب الله في الحرب الأهلية السورية زاد من خطورته على أمن إسرائيل، لأن في وسعه نشر قواته ليس بعيداً عن الجولان المحتل، فضلاً عن تطوير قدراته القتالية، وحصوله على أسلحة جديدة، وربما متطورة…
عملياً أصحبت إسرائيل أمام عدة معضلات: وجود قوات حزب الله المساندة نظام الأسد بالقرب من المثلث الحدودي بين إسرائيل وسورية والأردن؛ وجود قوات تابعة لتنظيمات جهادية معادية للنظام السوري ولإسرائيل؛ وجود قوات فصائل المعارضة السورية المسلحة؛ وجود وحدات الجيش النظامي السوري. والبديل الأخير هو الأقل سوءاً بالنسبة لها. وعلى الرغم من عمل إسرائيل دائماً على التمتع بحرية المبادرة عسكرياً، فإنها تواجه بعض الصعوبات. فردها، في فبراير/ شباط الماضي، على طائرة بدون طيار، قالت إنها أقلعت من قاعدة بالقرب من تدمر، وقصفها الأخيرة انتهى بإسقاط الجيش السوري مقاتلة إسرائيلية من نوع إف – 16، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها منذ عام 1982. ما يعني أن النظام السوري استعاد بعض قدراته العسكرية، وأن التحالف الثلاثي الروسي – السوري – الإيراني يتجسد على أرض الواقع، ليس فقط من حيث استرجاع النظام زمام المبادرة، والسيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية. ولكن أيضاً من حيث استرجاعه بعض قدراته العسكرية. كما أن إسرائيل التي تراهن على التدخل الروسي لضرب الجماعات الإرهابية في سورية، ولوقف التصعيد على الحدود الإسرائيلية – السورية، تلاحظ أن هذا التدخل يدعم النظام، كما يدعم تحالفها مع إيران. وتتخوّف من تداعيات التوافق الروسي – الإيراني إقليمياً. ذلك أن الأزمة السورية تدعم العمل والتنسيق بين روسيا وإيران وحزب الله والنظام السوري.
على أساس ما سبق، يمكن القول إن إسرائيل أمام خيارين، أحلاهما مر. من جهةٍ، من مصلحتها ضرب النظام السوري، وبالتالي إضعافه أمام فصائل المعارضة المسلحة والتنظيمات الجهادية. وفي الوقت نفسه، من مصلحتها بقاؤه، وبالتالي، تغليب كفته على حساب من يقاتلونه. إنها معضلة استراتيجية. وهذا ما يفسر غياب استراتيجية إسرائيلية واضحة المعالم حيال الأزمة السورية، وعملها وفق مخططات تكتيكية، حسب مقتضيات الساعة، وتطورات المعارك ميدانياً في مسرح الحرب السورية، وامتداداتها الإقليمية والدولية.
كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا
العربي الجديد