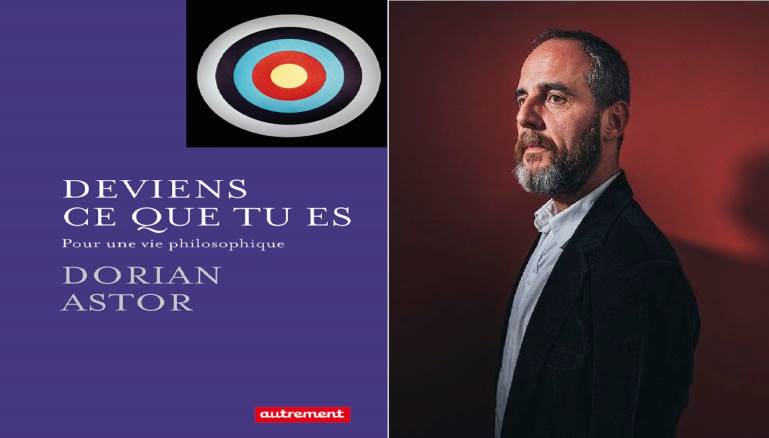حوار مع فضيلة الشيخ رياض درار: سوريا، الإسلام، العلمنة
أجرته: ناريمان عامر (مراسلة الآداب في دمشق)
رياض درار أستاذ وخطيب في جوامع دير الزور (سورية)، ومناضل سياسيّ من أجل الحريّة. قضى سنين في سجون النظام السوريّ. عضو في “هيئة التنسيق الوطنيّة،” وعضو مؤسّس في “المنبر الديموقراطيّ السوريّ.” وهو أيضًا من الشخصيّات المستقلّة التي شاركتْ في “نداء روما.”
سوريا الآن، أين، وإلى أين؟
لم تؤدِّ سوريا دورًا منذ الاستقلال، وإنّما كانت ذاتَ وظيفةٍ ملحقةٍ باللاعبين الكبار، وإنْ ساهمتْ في إفشالِ أدوارٍ أو إضعافها. فالعرش الهاشميّ في العراق أو الأردن عملا دائمًا على استقطابها لصالح بريطانيا أو أمريكا، حتى منتصف الخمسينيّات، حين بدأتْ مصرُ الناصريّة تبحث عن دورٍ لها، فالتحقتْ بها سوريا في إطار الوحدة، لكنّها لم تساهمْ في الدور القوميِّ الصاعد؛ بل إنّ البعث أفشل الوحدةَ، وفكّك المشروعَ القوميّ وأدخله في صراعات جانبيّة.
كما أنّ الحكومات السوريّة المتوالية أضعفت الثورة الفلسطينيّة بمحاولةِ استقطابها. وساهمتْ كذلك في إسقاط الدور الانفتاحيّ اللبنانيّ؛ فبدخول القوّات السوريّة إليه أصبح للبنان أيضًا دورٌ ملحقٌ بالوظيفيّة السوريّة التي قدّمتْ أكبرَ خدمةٍ في سحق الحركة الثوريّة والديمقراطيّة الناشئة، قبل أن ينزاح الدورُ الوظيفيُّ السوريُّ من لاعبٍ إلى آخر، لينتهي به المطافُ في خدمة الحضور الإيرانيّ المتنامي في لبنان والمنطقة.
في كلّ الأدوار المتصاعدة في المنطقة، كانت الوظيفيّة السوريّة مسخّرةً لخدمةِ اللاعبين الكبار. وها نحن نجد أنفسَنا من جديدٍ نخدمُ سياسةَ “الشرق الأوسط الجديد،” بإرادةٍ منّا أو بغباءِ تصرّفاتنا. فمشروعُ الشرق الأوسطِ الجديد أو الكبير، وإنْ تعثّرَ غير مرّةٍ، مازال يسير بخطًى ثقيلة. ففي العام 2002 فضحت الصحافةُ العالميّةُ اجتماعًا سريًّا بين وفدين رفيعين، أمريكيٍّ وكرديّ، بحضور وكيل وزارة الخارجيّة الألمانيّة، وفيه أُقرّتْ إقامةُ دولةٍ كرديّةٍ تُقتطع من إيران والعراق وسوريا وتركيا (الأخيرة هي العنصرُ المعطّلُ حاليًّا). أحداثُ اليوم تسهم في توضيح هدف الاجتماع؛ ذلك أنّنا نتلمّس سعيًا إلى جرِّ تركيا وإيران إلى صراعٍ يضعفهما، وإلى إتمام مشروع الشرق الأوسط الجديد عبر تكوين دويلات طائفيّة وعرقيّة في المنطقة:
ــ فإلى جانب الدولة الكرديّة (يُقدّر عددُ سكّانها بـ30 مليون نسمة) يُنتظر أن تقومَ دولةٌ فارسيّةٌ شيعيّةٌ في إيران، بعد فصل دولة خوزستان وعاصمتُها الأهواز (يُقدَّر سكّانها بمليونين ونصف المليون)، إضافةً إلى ما يؤخذُ من شمالها الغربيّ لضمّه إلى الدولة الكرديّة.
ــ وفي جنوب العراق تُقام دولة شيعيّة عاصمتُها بغداد (بتعدادٍ سكّانيٍّ يُقدَّر بعشرين مليون نسمة)، وفي الرمادي دولةٌ سنيّةٌ (يُقدَّر سكّانها بعشرة ملايين).
ــ تبقى سوريا ذاتَ نظام جمهوريّ يغلب عليه مذهبُ أهل السنّة، وعاصمتُها دمشق (بتعدادٍ سكّانيٍّ يُقدَّرُ بخمسة عشر مليونًا) بعد اقتطاع القسم الشماليّ الشرقيّ ليُضاف إلى الدولة الكرديّة. وتقام دولة درزيّة عاصمتُها السويداء (يُقدَّر سكّانها بأكثر من مليون). ويبقى الساحلُ السوريُّ دولةً علويّةً عاصمتُها اللاذقيّة أو طرطوس (يُقدَّرُ سكّانها بخمسة ملايين).
ــ في فلسطين تقوم إمارةٌ إسلاميّةٌ في قطاع غزّة (يُقدَّر سكّانُها بثلاثة ملايين)، وهي قيدُ التطبيق من خلال تعزيز القطيعة الفلسطينيّة بدعمٍ من إسرائيل والولايات المتّحدة. وفي الضفّة الغربيّة تقوم عدّةُ كانتونات عاصمتُها رام الله. فمشروع الشرق الأوسط الجديد يهدف إلى حماية أمن إسرائيل على المدى البعيد.
آليّةُ تطبيق هذا المشروع تقوم على إثارة النعرات الطائفيّة. ولعلّ القنوات الفضائيّة خيرُ مثالٍ على بثّ التفرقة عبر عدّة وسائل، أبرزُها: البحثُ في الكتب المغرقة في التشدّد عن المسائل التي تثير الفتنَ بين أبناء الأمّة الواحدة على أسس طائفيّة وعرقيّة. وتساهم في تدعيم هذه الآليّة الأنظمةُ الديكتاتوريّةُ والشموليّةُ المسيطرة. لكنّ استمرار العنف للبقاء في سدّة الحكم سيؤدّي إلى انهيار الدول، وإلى بروزِ مجموعاتٍ تعيش على القتل والدمار، فاسحةً المجالَ لإيديولوجيّاتٍ تقوم برسمِ مشاريع المنطقة عبر إدخالها في صراعاتٍ لا تخدم إلا المشروعَ الصهيونيّ.
ما يحدث في سوريا حتى الآن لا يخرج عن هذه الصورة… مع ضرورة القول إنّ مطلب التغيير الذي خرج الشعبُ السوريُّ من أجله كان بعيدًا عن تصوّر هذه المآلات. فمع تصاعد العنف في سبيل إسكاتِ إرادة التغيير، خُلِقَ عنفٌ مضادٌّ، وبدأنا نشهدُ انحرافًا جوهريًّا في حركة الشارع من مطلب “الحريّة والديمقراطيّة” إلى مطلب “إسقاط النظام.” وزاد الطينَ بلّةً دخولُ الأطراف الإقليميّة بدايةً، والعالميّةِ في نهاية المطاف، إلى الساحة السوريّة، كأطرافٍ فاعلة؛ وهو ما بدأ يضيّق الخناقَ على الخيارات الوطنيّة التي طُرحتْ في بداية الأمر، ويُضيّق الخناقَ على الإرادة المستقلّة في توجيه الأحداث. إنّ الارتهانَ لموازين القوى الخارجيّة في صراعٍ داخليٍّ أخرج الحلَّ من أيدي أطراف النزاع ليصبحَ المشهدُ مرتهنًا بالإرادات الخارجيّة ــ وهذا ما نعملُ جاهدين للتخفيف من غُلوائه.
رأى بعضُهم أنّ “نداء روما” كان عاملًا إضافيًّا في تفتيت المعارضة، فيما رأى آخرون أنّه لا يضيف شيئًا إلى الثورة السوريّة. ما الذي كنتم ترجونه من لقاءِ روما وماذا تحقّق؟
كان “لقاء روما” قد سبق مؤتمرَ القاهرة الذي جمع المعارضةَ (بشقّيها من الداخل والخارج) مع ممثّلين من “الجيش السوريّ الحرّ” والمجلس العسكريّ، وخرج بوثيقتين (عن العهدِ الوطنيّ وعن المرحلة الانتقاليّة) وبخلافاتٍ عديدةٍ حول إدارةِ الصراع والمسألة الكرديّة…الخ. اللقاء جاء بدعوة من جمعيّة سانت ايجيديو، التي تعمل في مفاوضات السلام، وحلِّ النزاعات، والحوارِ بين الأديان، وتساند الضعفاءَ والمحتاجين، وتسعى إلى تكوين الصداقات عبر القارّات. وعندما استجبنا دعوتها كان ذلك لدعم المبادرة العربيّة ــ الدوليّة، ومساندةِ كوفي عنان لتحقيق النقطِ الستّ.
في روما خرج “النداء” بمشاركة سبعة عشر ناشطًا، وبتوقيعهم الشخصيّ. وهو مجرّدُ إعلان مبادئ، جوهرُه مبدأ التفاوض، ويُفترض أن تتبنّاه الجهاتُ السياسيّة، وإلّا بقي صرخةً في الهواء، لكنّها صرخةُ ضميرٍ من مجريات الحدث السوريّ.
لم يكن النداء عاملًا في تشتّت المعارضة؛ فالمعارضة أصلاً لم تستقرّ على طريقٍ مشتركٍ للحلّ، ومازالت تتخبّط في المواقف والولاءات. وبعد أن أصبحت العسكرةُ صاحبةَ التأثير على الأرض وفي المواقف السياسيّة، وجدنا مَن انتقد النداء (تجب الإشارةُ إلى أنّ النداءَ ظهر عندما كانت دمشق تواجه أقسى موقفٍ ألمَّ بأحيائها منذ بداية الثورة).
انطلق النداء من الإقرار بوجود أزمةٍ في سوريا، يفاقمها الحلُّ الأمنيُّ في مواجهة انتفاضةٍ تطالبُ بالحريّة والكرامة، ومن الإقرار بأنّ تصاعد العنف وتعميمه سيؤدّيان إلى خسائر إضافيّة هائلة. ومن ثمّة فإنّ المشاركين، وهم مواطنون من فصائلَ متعدّدةٍ من المعارضة، يناضلون من أجل الحريّة والكرامة والدولة المدنيّة الديمقراطيّة، ويقرّون بحقّ الدفاع المشروع عن النفس. كما أنهم يدعون إلى حلٍّ سياسيٍّ يكون من حقّ الجميع، بمن فيهم “الجيشُ الحرّ” والمسلّحون، لأنّه مخرجٌ آمنٌ من العنف والحرب الأهليّة والتقسيم.
من إيجابيّات المشاركة في لقاء روما أنّه فتح علاقةً مع أطرافٍ أوروبيّةٍ معتدلة. كما أنّ الجمعيّة المذكورة وأمثالها قد تساهم في تقديم مساعداتٍ إغاثيّةٍ عبر معارضة الداخل. ثم إنّ علينا، عند انسداد الأفق، أن نسعى إلى فتح نافذةٍ للمعنى، ولا نتوقّفَ عند نداءٍ واحد، بل على كلّ واحد أن يرفعَ عقيرته بما يراه مناسبًا.
استحوذ “الجيشُ السوريّ الحرّ” على المشهد السياسيِّ للثورة. ماذا تبقّى من حظوظٍ للحراك السلميّ؟
الحديث عن حراكٍ سلميٍّ الآن لا يخرج لدى القائمين عليه عن كونه إثباتَ وجودٍ في لحظةٍ تاريخيّةٍ حرجةٍ تمرُّ بها سوريا. هو لا يخرج عن كونه رفضًا للعنف، وتأكيدًا على حضورِ حواملَ ما تزال ترى في الحراكِ المدنيِّ الطريقَ الأنجعَ للوصول إلى الهدف، وترى أنّ السياسة لا الرصاصَ هي ما سيقود إلى الطريق الآمن. لكنّ مَن كان ينتظر جدوى سياسيّةً آنيّةً من هذه الحوامل سيصاب بخيبة أمل؛ فلا يمكن الحديث عن سياسةٍ منتِجةٍ في زمن الحرب (من أقدم تعريفات السياسة أنها “إخراج الحرب من المدينة”)، والآن الساحةُ السوريّة أصبحتْ ساحةَ حرب. فالنظامُ أعلنها صراحةً، وردَّ “الجيشُ الحرُّ” أنّه ماضٍ في هذه الحرب، وللأسف تراجعتْ مظاهرُ الحراك السلميِّ ليسيطر الجيشُ الحرُّ على المشهد.
لكنّنا نرى أنّ هذه الصورة لن تدوم طويلاً لأنها ليست من مصلحة أحد! ومن هنا نقول إنّ دورنا آتٍ بعد نهاية الحرب، وكيفما مالت الكفّة. فتحديدُ خيارنا السياسيّ بالسلميّة لم يكن من منطلقٍ أخلاقيٍّ وحسب، وإنّما من قناعتنا أيضًا بأنّه الطريقُ الأجدى في مواجهةِ نظامٍ استبداديّ. هذه المرحلة مرحلةُ كمون، وهي غير مثمرةٍ بالمعنى المباشر، لكن ستأتي أُكْلها على المدى البعيد. نأمل أنْ يتمَّ خلالها العملُ على مفهوم البناء في مواجهة التهديم الذي يفرزه النظامُ بضرب كلِّ البنى المناوئة له، وفي مواجهة التهديم الذي تحمله الثوراتُ عمومًا (والثورةُ السوريّةُ بشكلٍ خاصٍّ) بعد الاستعصاء السياسيّ. لذلك يؤملُ الآن من قادة الحراك السلميّ والمنتمين إليه إعدادُ النفس لثورةٍ موازيةٍ يغْلب بُعدها الثقافيُّ التأسيسيّ وطابعُها المدنيّ، تكون جاهزةً للمرحلة الأصعب: مرحلةِ ما بعد الحرب.
يتخوّف بعضُ الناشطين من أنّ الشعورَ الدينيّ أصبح الحاملَ الوحيدَ للثورة السوريّة. إلى أيِّ حدٍّ هذا التخوّف صحيح؟ وإلى أيِّ درجةٍ سيكون محدِّدًا لخريطة سورية الجديدة؟
الشعب السوريّ أغلبُه متديّنٌ بالفطرة. هو يؤمن ويمارس حياته من دون تعقيد، ويؤدّي العبادات بوصفها عادةً، ويعيش مع آخرين لا يؤدّونها. بل إنّ بعضهم يعيش حياةً لاهيةً، مشغولًا بالدنيا عن الآخرة. ومع ذلك فالجميعُ متعايشون بلا لوم أو عتب: إنّه الدين الشعبيّ بالمفهوم السياسيّ.
أمّا ظاهرة التشدّد فبدأتْ في التسعينيّات عبر تبنّي الفكر السلفيّ. فقد ساهم امتدادُ ظاهرةِ التديّن السياسيّ في دعمِ قوًى أرادت أن يتجاوز الدينُ دوره في إعداد الفرد لحياةٍ صالحةٍ لكي يدخلَ في مواجهةٍ مع مثقّفين علمانيّين ويساريّين وليبراليّين. ولهذا اندفعت الصحفُ ودُور النشر الخليجيّة بشكلٍ خاصٍّ إلى نشر كتاباتٍ حصد أصحابُها الملايينَ من الحضّ على طاعة وليّ الأمر، وتبرير المظالمِ وقسوةِ الحياة بوصفها “اختباراتٍ إلهيّة،” والدفاعِ عن تقصير الثوب وإطالةِ اللحى، ووصفِ الاشتراكيّة والقوميّة بالإلحاد. ونشطت الفضائيّاتُ الدينيّةُ المتشدّدة. وقد سُمّيت هذه الطفرةُ الدينيّة “صحوةً إسلاميّةً،” وكان من أسبابها: تفشّي البطالة بين الشباب، وانتشارُ ثقافة الغيبيّات، وانحطاطُ الوعي، ونجاحُ الإعلامِ في تحويل الدين إلى إيديولوجيا تتحكّمُ في سلوك الأفراد وعقولهم، وهزيمةُ المشروع النهضويّ العربيّ.
كان للأنظمة المستبدّة اليدُ الطولى في تقديم العون الماليّ والإعلاميّ والدعويّ إلى مشاريع “الصحوة” على أرضيّةِ أنّ “الساسة يُدخلون الدينَ في السياسة متى أرادوا.” وقال القرضاوي في كتابه الدين والسياسة: “فطالما لجأ هؤلاء إلى الدين ليتّخذوا منه أداةً في خدمة سياساتهم والتنكيل بخصومهم. وقد طلبوا من أهل الفتوى إصدارَ فتوى بمشروعيّةِ الصلح مع إسرائيل، وفتوى بتحليلِ فوائد البنوك وشهادات الاستثمار، فاستجاب لهم كلُّ رخوِ العود ممّن قلَّ فقههم أو قلَّ دينهم.” وفي المقابل فإنّ هذه “الصحوة” ثبّتتْ أنظمةَ الاستبداد، وكرّستْ عمالتَها، وساهمتْ في قمع المعارضة الديمقراطيّة، ولم تُصلح أخلاقَ الناس، ولم تضبطْ حياتهم، ولم تواجهْ مستعبديهم، وإنّما غرقتْ في الطقوس التعبّديّة والقشور الخارجيّة!
ومع الاحتلال الأمريكيّ للعراق اندفع المقاتلون ليدافعوا عن أرضٍ عربيّة. وراح العاملُ الدينيُّ يتصاعد مع مشروع الجهاد؛ فالشباب الذين خرجوا إلى الجهاد في العراق لم يكن أغلبُهم ملتزمًا بعباداتٍ أو طقوسٍ دينيّة، بل خرجوا بنخوةٍ ووطنيّةٍ وحماسةٍ بثّها فيهم مشايخُ الدعوة، وفتاوى لرجالِ دينٍ تخلّوْا عنهم حين عادوا. وحين عادوا كانت المعتقلاتُ في انتظارهم، والتّهمُ تُنسَبُ إليهم باعتبارهم من تيّارات “القاعدة” وغيرها!
في السجون بدأتْ دروسُ التطرّف والتكفير. وما كانوا يخرجون من أقبية المخابرات، التي طبعتْ في نفوسهم ندوبًا لن ينسوْها، إلّا وهم معبَّؤون بالفكر الدينيّ المتشدّد. ومع ظهور ثورات الربيع العربيّ، لاحت فرصةُ انفجار تلك القنابل الموقوتة. وعلى الرغم من أنّ الثورة السوريّة بدأتْ سلميّةً وشعبيّةً تعبّر عن مجمل مكوّنات المجتمع السوريّ الدينيّةِ والعرقيّة، وعلى الرغم من محاولتها المستمرّة تأكيدَ وحدةِ الشعب في مواجهة الاستبداد، فإنّ العنف المنظّم أفرز عنفًا مضادًّا، وجعل من الشباب السابقي الذكر مجموعاتٍ تخرج من مخابئها وتتوسّع يومًا بعد يوم، محاولةً الهيمنةَ على المشهد السياسيّ وتوسيعَ رقعةِ حاضنها الاجتماعيّ، على حساب المدّ الوطنيّ الذي بدأتْ به الثورة. وربّما يكون مبكّرًا الحديثُ عن تشكيلاتٍ متشدّدةٍ ناجزةٍ بالمعنى الإيديولوجيّ؛ لكنّ ما هو عامٌّ، للأسف، هو توسّعُ رقعة التشدّد ــ وهو ما يجد مبرِّرَه في زيادة القمع، وفي دخول عناصرَ أجنبيّةٍ متشدّدةٍ دينيّةٍ إلى الأراضي السوريّة.
في كلمةٍ ألقيتَها في “المنبر الديمقراطيّ” قلتَ إنّ العلمانيّةَ منبثّةً في صلب الإسلام. في ظلِّ صعود الإسلام السياسيّ في المنطقة، إلى أيِّ مدًى يمكن أن يجد هذا الطرحُ أذنًا صاغية؟ ومن هو الحامل الاجتماعيُّ الذي تراهن عليه بطرحٍ كهذا؟
الإسلام يدعو إلى إنسانيّةٍ شاملة، لكنه ليس مشروعَ دولةٍ كونيّة، بل مشروعُ ديمقراطيّاتٍ تتعدّد بتعدّدِ المجتمعات، وتشترك في فضاء الحريّة، وتعمل على اختراق الحضارات للتكامل بينها وللتواصل والتعارف والتثاقف. وحين دعوتُ إلى إقامةِ بناءٍ وطنيّ يقوم على عقدٍ اجتماعيّ تتلاقى فيه العلمانيّةُ مع الإسلام، عنيتُ بذلك تشكيلَ مرجعيّةٍ مشتركةٍ للجميع على أرضيّة المواطنة المشتركة التي تخدم الحريّةَ الفرديّة، وتقيم المساواةَ والعدالة الاجتماعيّة، وتحترم التعدّدَ الدينيّ، وتؤسّس التضامنَ الوطنيّ… عكس ما تكون عليه المجتمعاتُ التقليديّةُ التي تقوم على القهر والإذعان، وتتّصفُ بأنّها مجتمعاتُ عصائب وطوائفَ وعشائرَ وإقطاعيّاتٍ لا ديمقراطيّةَ فيها لأنّ السلطةَ فيها مطلقةٌ، والنخبَ الحاكمةَ فيها تتماهى مع الدولة وتنشدُ الخلودَ لقادتها.
لقد أردتُ إقامةَ مقاربةٍ علمانيّةٍ إسلاميّةٍ لأنّ النظام الإسلاميّ – على غير ما شهده تاريخُ الحكومات التي حكمتْ باسم الإسلام – نظامٌ متجدّدٌ متحرّكٌ على أصوله، ينزع إلى استيعاب التعدّد، بل رفعِهِ إلى مستوى أطروحةٍ إنسانيّةٍ قائمةٍ على شرط الحريّة والديمقراطيّة.
لم يقدّم الإسلام شكلًا للدولة، فلا ضيرَ إنْ صارت الديمقراطيّةُ وسيلةَ تعبير المجتمع عن اختياراته في الدولة وممارساتِها وشكلها. فالديمقراطيّة تقع ضمن نظام الأفكار العامّةِ والمقاصديّة للإسلام، ولا تتعارضُ مع قيمه. الإسلام سبق بالشورى كلَّ مقدّمات الديمقراطيّة، فهو ليس بعيدًا عن جذرها. والشورى في صلب المعنى التفسيريّ لآيات العبادة، لأنّها أُدخلتْ بين عبادتين أساسيّتين (الصلاة والزكاة): “والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاةَ وأمرُهم شورى بينهم وممّا رزقناهم يُنفقون” (الشورى 38). والحقّ أنّ الممارسة الديمقراطيّة تنقل الثقافةَ السياسيّةَ العربيّة من ممارسة السياسة بالغلبة، إلى النظر إليها في وصفها مشاركةً في صنع القرار.
والديمقراطيّة من مستلزمات المبادئ العلمانيّة، لذا فهي تلتقي مع الإسلام في هذا الجانب. من تعريفات العلمانيّة أنّ العلمانيّ غيرُ كهنوتيّ وغير مقدّس؛ وفي الإسلام لا قدسيّةَ إلا لله، وكلُّ أمرٍ نسبيّ لا قداسةَ له، وإنما هو شأنٌ علمانيٌّ، أي دنيويٌّ. والرسولُ الكريمُ أشار إلى هذا بقوله: “أنتم أعلمُ بشؤون دنياكم.”
وهذه إشارةٌ إلى معنى آخرَ للعلمانيّة، هو الماديّة، بمعنى أنّها مجرّدُ قطاعٍ من قطاعات الحياة يشير إلى الاعتقادات والممارسات التي تقوم الممارسةُ فيها على العقل. والإسلامُ، بدوره، استند إلى العقل في اعتماد الأحكام، وإدارةِ أمور الدنيا على قواعدها. وعليه، يكون العلمانيُّ هو الإنسان المشغول بأمور المعاش في الحياة الدنيا، ويقابله الكاهنُ المنقطعُ في المؤسّسة الدينيّة، أو الشيخُ المرتبطُ بتحقيق المسائل الدينيّة، إذ الكاهنُ والشيخُ لا سلطةَ لهما إلا سلطة التوجيه والتذكير: “فذكّرْ إنّما أنتَ مذكِّر، لستَ عليهم بمسيطِر، إلّا مَن تولّى وكفر، فيعذّبُه اللهُ العذابَ الأكبر” (الغاشية 23 – 24).
بهذا المعنى تكون العلمانيّةُ رؤيةً إجرائيّةً للواقع، لا تتعامل مع أبعاده الكليّة والنهائيّة كمعرفة، ولا تتّسم بالشمول، وتلتزمُ الصمتَ تجاه مجالات الحياة الأخرى (المطْلقات والكليّات الأخلاقيّة والدينيّة – الماورائيّات)، ولذلك لا تتفرّعُ عنها منظوماتٌ معرفيّةٌ أو أخلاقيّة، بل ترى الإنسانَ يعيش رقعةَ حياته العامّة وحسب، وتتركُ له حيّزه الذي يتحرّكُ فيه. وفي هذا لا تتعارض مع الإيمان الدينيّ.
والدولة في النظام العلمانيّ تقوم على الحريّة الدينيّة لجميع أبنائها، ولا تتدخّل في معتقداتهم، بل تحمي الجميعَ، ولا تتبنّى دينًا تفرضُه أو تُلزم به أحدًا.
الإسلامُ يمتلك شريعةً تمثّل ثروةً قانونيّةً شاملةً لمكوّنات الحياة، ومن ثمّة يمكن أن ينبثق عنه نظامٌ يحلُّ محلَّ الأنظمة الحاكمة. لكنّ أنظمةً قامت باسم الإسلام وفرضتْ رؤيةَ أصحابها باسمه، وقام فقهاءُ السياسة بربطه بمصالح السياسيّين خلافًا لروح الإسلام وتطبيق الرسول:
فالصحيفةُ التي جعلها الرسولُ بينه وبين سكّانِ يثرب، بمختلف انتماءاتهم، كانت أوّلَ دستورٍ أعلن أنّ الدولة تقوم على مبدإ المصالح بين الناس، ولا تعتمد مرجعيّةَ المشايخ والكهّان. وهي احتوت على مبدإ دستوريّ يدور حول حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان، وحريّة التديّن، وقامت على معيار الكفاءة لا الولاء. والصحيفةُ التي تأسّستْ عليها دولةُ المدينة كانت إعلانًا دستوريًّا يتّفق مع التوجّه العلمانيّ الأصيل للإسلام: “هذا كتابٌ من محمد النبيِّ رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش، وأهلِ يثرب، ومَن اتّبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنّهم أمّةٌ واحدةٌ من دون الناس. وإنّ من اتبعنا من يهودٍ، فإنّ له النصرَ والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم.”
لقد كانت الصحيفةُ دستورًا ملزِمًا لأهل المدينة، من المسلمين والأربعَ عشرةَ قبيلةً وثنيّةً ومسيحيّةً ويهوديّة… وأكّدتْ نقطتين رئيستين تجمعهما العبارةُ الشهيرةُ اليوم: “الدينُ لله، والوطنُ للجميع.” فقد جعلتْ كلَّ الفئات المختلفة دينيًّا وحدةً وطنيّةً سياسيّةً متعايشةً، حيث الجميعُ أمّةٌ واحدةٌ من دون الناس، يجمعهم وطنٌ واحدٌ هو يثرب، يتساوون فيه في الحقوق أمام الحكومة، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينيّة، ويتضامنون في الدفاع عنه إذا تعرّضَ لأيِّ اعتداءٍ خارجيّ.
بهذه الروحيّة يمكن التقاربُ مع الرؤية العلمانيّة التي تقوم بفصل الدين عن الدولة، حيث إنّ الدولةَ ضرورةٌ، ومنشأ ضرورتها النظامُ والأمنُ والإعمار، لأنّ عدمها جورٌ مطلقٌ على حدِّ قول الإمام عليّ: “لا بدّ للناس من أميرٍ برٍّ أو فاجر.” بل قيل: “سلطانٌ غشومٌ خيرٌ من فتنةٍ تدوم.” لاحظوا أنّ وجودَ أميرٍ فاجرٍ أو غشوم يتعارض مع الأمان الاجتماعيّ الذي يَنْشده الإسلامُ لحامليه، لكنّهم قالوا ذلك وفق وعيٍ اجتماعيّ لا وفقَ فقهٍ إسلاميّ. والوعي الاجتماعيّ يتغيّر، وتبعًا لتغيّر وعي الأفراد لأدوارهم ومواقعهم وحقوقهم وواجباتهم تتغيّرُ الأدوار، وبذلك يتغيّرُ شكلُ الدولة أداءً ودورًا ومصدرَ شرعيّةٍ وآليّاتِ تطبيق.
هذا، وقد لحظ الإسلامُ مدى التنوّع البشريّ، ودعا إلى احترامه وجعلِه مصدرَ حيويّةٍ في العالم: “يا أيّها الناسُ إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائلَ لتعارفوا” (الحجرات 13). ومفهوم التعارف غايةٌ في ذاته، وهو نابعٌ من التنوّع: “ولو شاء اللهُ لجعلكم أمّةً واحدةً” (المائدة 48).
لذلك حين يُدعى إلى الفصل بين الدين والدولة، فإنّ في ذلك حمايةً من تدخّلِ الدولة وآليّاتها في الدين، وحمايةً للدين ذي الأصول الثابتة من الدولة كمتغيّرٍ. الدعوة العلمانيّة هي لصيانةِ المتغيّر من الثابت، ولصيانةِ الثابت من تعقيدات المتغيّر.
بهذا المنظور يمكن أن نرى أنّ تطوّر النهضة الإنسانيّة قاد إلى ثقافةٍ تستمدُّ مرجعيّتَها من العالم المحيط وضروراتِ التعايش معه وفيه. هذه الضرورات أرست مفاهيمَ جديدةً وأدّت إلى تحديث المجتمع، وتحديثُ المجتمع قاد إلى الفصل بين المؤسّسة الدينيّة والمؤسّسة السياسيّة، وهو ما أدّى إلى إعادة تنظيم المجتمع على أسس الحريّة والمساواة والعدالة والعقلانيّة والحقوق المدنيّة. وهي عمليّةٌ لا تتوقّف على جيلٍ معيّنٍ بل هي في صلب المستقبل الذي لا يتوقّف، وتجعل الإنسانَ ـــ من دون النظر إلى عرقه أو جنسهِ أو لونه أو دينه ـــ نقطةَ ارتكازٍ في المجتمع، وتقدّم له الضمانات القانونيّةَ اللازمةَ لممارسة تلك الحقوق واستقلاليّته.
العلمانيّة لم تكن خيارًا إيديولوجيًّا، بل واقعٌ تاريخيٌّ وموضوعيٌّ. وهي حركةٌ متفتّحةٌ أبدًا على التحوّل، بلا نهائيّات ولا غائيّات، وتؤدّي إلى الاستقلال النسبيّ للمجتمع الدينيّ والمساواةِ الكاملة للمواطنين أمامَ القانون. إنّها ليست مجرّدَ فصل الدين عن الدولة، بل صارت رؤيةً تحمل ملامحَ جوهريّةً لإنسانيّة الإنسان، وتعبّر عن طموحه إلى السيطرة على المعوّقات التي تقفُ في طريق تقدّمِه وسعادته.
من هنا أعتقدُ أنّها ليست بصدد معاداة للدين، وإنّما هي وسيلةٌ للتجديد الدينيّ نفسه بما يتلاءم ومستجدّاتِ الحياة. ولعلّها تكون من أساسيّات الإصلاح الدينيّ المرتجى الذي يبعدنا عن التطرّف.
نحن هنا لا نأتي بجديدٍ خارج الإسلام، بل هو من صلبِ سماحة الإسلام. إنّنا فقط نحتاج إلى تجديدٍ فكريٍّ دينيّ، وفتح الأفق أمام الديمقراطيّة، ونبذ الوصايةِ على الشعبِ. وهذا يدفع كلَّ مستلهمٍ للحريّة إلى أن يساهمَ بدوره في استبعاد الأحكام الفقهيّة القائمة على الأوامر والنواهي التي تضع العقبات في طريقِ تطوّر الإنسان بإيقافه على حدود المدينة المنوّرة مكانًا وعلى وجود الصحابة زمانًا، وكأنّ الدنيا توقّفت!
إنّنا نعوّل على إعادة النظر في معنى النصِّ الدينيّ وعلاقته بالناس، وعلى تطوير الثقافة، والتكيّفِ مع العالم، وإعادةِ الصلةِ بالمكتسبات التي صنعتها الشعوبُ وما حقّقته من نهضةٍ تقوم على تأمينِ كرامة الإنسان وحريّته.
في غزوة تبوك، تخلّفَ أبو ذرٍّ عن الركب، فقال الأصحابُ الكرامُ للرسول: “تخلّف أبو ذرٍّ يا رسولَ الله!” فردّد: “إنْ كان به خيرٌ فسيلحق بنا.” وأنا أقول إنْ كان لأفكارنا من خيرٍ فستبقى وتنتشر، ومن كان به خيرٌ فسيلحق بنا.
دمشق
مجلة الآداب » صيف 2012