حول بعض خصائص الكتابة السورية الجديدة/ ياسين الحاج صالح
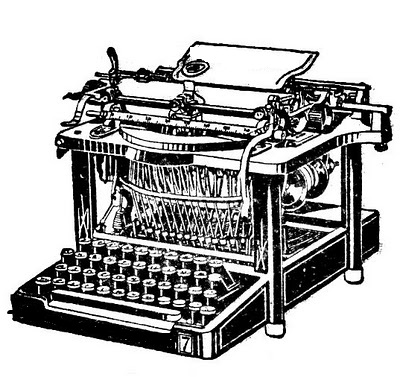
إلى ناجي الجرف.. في رحيله الطويل، الأخير.
أخذت تظهر بعد الثورة السورية كتابة مغايرة، يتنامى اختلافها عن الكتابة السابقة للثورة، عند الكتاب أنفسهم أحياناً، وأكثر عند كاتبات وكتاب جدد، ثم أكثر عند مجتمع أوسع، يتكلم ويكتب. أطلقت المعمعة السورية قدرات متسعة على الكلام والتعبير، وأخذت تكسر قيوداً مرئية وغير مرئية كانت تقيد الجيل الأقدم: قيد السلطة الرقيبة أولاً، قيود إيديولوجية ودينية ثانياً، قيد ضيق الأفق المحلي ثالثاً، وقيود “الكتابة الصحيحة” وتمايز الأنواع الكتابية أخيراً. من شأن أي قائمة بأسماء كتاب وكاتبات جدد أن تكون مجتزئة وتعسفية، لكن ليس لهذا السبب وحده لن تقترح هذه المقالة أسماء بعينها كممثلين للكتابة الجديدة، فالكتابة الجديدة ليست حصراً ولا هي في الأساس كتابة كُتّاب، إنها نتاج تلاقي ما لا يحصى من محنٍ وتجارب مع منابر شخصية وفّرتها وسائل التواصل الاجتماعي أساساً لعددٍ لا يُحصى من الناس، ومع منابر عامة ليس جميع الكاتبين فيها كتّاب. الأمر يتعلق باتساع قاعدة الكتابة، بظهور أدوات وتجارب تعبيرية جديدة، وبتضيّق الفارق بين الكاتب واللاكاتب. يتعلق أيضاً وأساساً بالثورة والصراع السوري. الكتابة الجديدة هي جوهرياً سيرة فوضوية للثورة أنجزها لاكتّاب وكتّاب.
تستعرضُ هذه المقالة خصائص تميّز الكتابة المنظمة إن جاز التعبير، نتاجات منشورة في منابر متعددة (سورية أساساً، وبقدر أقل في المنابر «العربية» الأقدم)، كتبها كتّاب. لكن يلزم أن يبقى في الذهن أن هذه المواد تستند إلى قاعدة أوسع بكثير من الكتابة غير المنظمة، والتعبيرات المكتوبة لعدد لا يحصى من اللاكتاب، وعموم الناس.
1- مركزية التجربة الشخصية
أول خصائص الكتابة الجديدة، المنظمة وغير المنظمة، استنادٌ واسعٌ إلى التجربة الشخصية الحيّة. أساسُ ذلك بديهي: كثرة غير مسبوقة من تجارب منفلتة من نسقنا المألوف، وكثرة الأشخاص الذي خَبِروا هذه التجارب بأنفسهم. هناك عددٌ كبيرٌ جداً من السوريين والسوريات لديهم ما يقولونه عن أوضاع قصوى عاشوها شخصياً، أو اختبروها عن قرب وكانوا شهوداً عليها. يتعلق الأمر بملايين فعلاً إن فكرنا بحجم التهجير الداخلي والخارجي، وبعدد المعتقلين والمعاقين. بصورةٍ ما يتعلق الأمر بكل السوريين، بمن فيهم الموالون للنظام، وإن كان لا يبدو أن بين هؤلاء الأخيرين من كتبوا شيئاً مختلفاً، وهذا ربما لأنهم غير قادرين على وصلِ ما يُحتمَل أنهم خبروه أو عانوه من تجارب بحسّ للعدالة، بخيارٍ طوعي حر، بتمردٍ يدركون أنه مكلف. كتاب النظام يكتبون من فوق، كتابة «عاقلة» و«عقلانية»، تُدافع عن عقلٍ سابقِ التكون، عن «الوطن» وعن «الدولة»، وعن «الجيش العربي السوري» وعن «المقاومة» (أتباع إيران من قتلة حزب الله).
بين المشاركين في الثورة والمنحازين إليها بصورٍ مختلفة كانت الكتابة ورواية القصة، قصصهم الشخصية وقصص غيرهم، استمراراً لثورةٍ مصادرة، لم يعد أكثرهم قادرين على المشاركة فيها مباشرة. ومنها تجارب وقصص تعرضوا لها على يد المجموعات الإسلامية التي صعدت في الثورة، واستولت عليها بصورةٍ ما.
هناك ذاتٌ جديدة تشكل هذه التجارب ركيزتها، ذاتٌ انخرطت في الصراع وعاشت الخطر، اعتُقلت وعُذبت، كادت تموت، بقيت محاصرة في البلد أو خرجت منه مضطرة. هناك ذوات كثيرة تتحرر أو تصارعُ لتتحرر، تعمل على تحرير نفسها عبر الصراع، وإن يكن غير قليلين منهم خرجوا محطمين بقدرٍ ما منه. رواية حكاية الصراع تساعد في الصراع مع التحطم الذاتي وبناء الذات الجديدة، وكذلك في التقاء شركاء. هذا شيء جديدٌ في سورية، يُرجَّح له أن يؤسس لجيل جديد من الكاتبات والكتاب، هم صناع الثقافة والتفكير السوري الجديد في السنوات القادمة.
وتتقابل مركزية التجربة الشخصية في خبرات سوريين كثيرين اليوم، مع أي سلطة خارجية لمرجع سياسي أو إيديولوجي أو ديني. وقد يُنظر إليها في يوم ما كمحطة أساسية، أو الأساسية، في ولادة الذات في إطار سوريٍ ومشرقيٍ أوسع.
وسواء تعلق المرء بمن يعشن ويعيشون في البلد اليوم في مناطق النظام أو مناطق خارجة عن سيطرته، أو من خرجوا منه، فالصراع متواصل بصورة مختلفة والقصص تتكاثر كل يوم. التناثر متواصل أيضاً، والانفصال عن السلطات الخارجية.
وكي ندرك أهمية هذه النقطة يكفي أن نشيرَ إلى أن جيل أستاذتنا، وبعض جيلنا، كتبوا كثيراً مما يكاد يخلو تماماً من تجارب حية، من صراع شخصي، من عناء وتمزق، ومن شكٍّ وحيرة، دع عنك من مخاطرة بالحياة، وهو ما اقترن في كل حال بحضور قوي لمرجعيات ناجزة، كانت تكفل صحة ما يقال، مما لا تكفل معناه تجاربُ غائبة. الصحيح كان تطابقاً مع شيء يسبقه، ليس إنتاجاً لمعرفة وقيم جديدة، ليس صراعاً.
2- حسّ تراجيدي
وتتمثل الخاصية الثانية في حسٍّ مأساوي يجعل من الكتابة نفسها فعل صراع (تكلم ميغيل دو أونامونو على «الحس المأساوي بالحياة» في كتاب صدر بهذا العنوان عام 1912، في سياق أسبانيا كثيرة التناقضات غير المعالجة في زمنه). ولا يتصل الحسّ المأساوي بتجارب الصراع والموت والتعذيب وحدها، ولا بالمشقة الهائلة للصراع وكلفته البشرية والمادية الرهيبة، ولكن كذلك بقوة الحدث واستعصائه على الاستيعاب، وبمواجهة واقعٍ قاسٍ متغيرٍ بأعصاب مكشوفة، بفعل انهيار أطر التفكير الاجتماعية وأدواته الفكرية المعتادة قبل الثورة («سورية الأسد» وعالمها الثقافي والسياسي الضيق). الحسّ المأساوي في كتابة اليوم لا يُختزل في وصف الفواجع، ولا يُطابَق بحال التفجع والمعاناة الأليمة، ولا يحيل حتماً إلى تجارب التعذيب والقتل وتمزق الأجساد وتحطم الأسر. الحس المأساوي هو ما يتخلل تفكيرنا وكتابتنا ونحن نفكر في هذه التجارب من صراع مع أدواتنا وصيغنا التعبيرية المعتادة (مسترخية، فاترة الانفعالات، متكيفة…)، ومن شكٍّ في صلاحيتها ومن محاولة تطويعها أو اختراع غيرها في محاولة لتوليد معنىً من هذه التجارب. أي هو صراعٌ مع النفس والأدوات، في ظل صراع بالغ القسوة وغير مضمون مع عدو فائق الوحشية. الحسّ المأساوي الذي يتخلل الكتابة اليوم يُحيل إلى فقدان اليقين، إلى الحيرة والشك وفقدان الضمان، وإلى تحول الكتابة ذاتها إلى فعل صراع. المأساوي هو الصراع بين المرجع والتجربة، بين يقين المرجع وبين انفلات التجربة. وليس المرجع مجرد مذهب أو نظرية، بل هو رابطة اجتماعية وإطار اجتماعي للتفكير والتقييم والحكم. تلك الرابطة تقطعت، وهذا الإطار تفكك، وهما كان يحمياننا من قسوة التجربة، ويقللان من أحساسنا بفداحة ما نعيش. المرجع يغلفنا، ينظم العالم حولنا، يزوّدنا بموقع وهوية، بمقابل أن نتخلى له عن حكمنا الشخصي. يتحطم، فتغمرنا التجربة وقد تسحقنا، ونضطر للمشي على رؤوسٍ لم نعتد على المشي عليها. ليس من «يفصل» تحت التعذيب وحده من تسحقه التجربة، ولكن كذلك عدد كبير ممن لا يجدون في متناولهم أدوات لتنظيم التجربة والتحكم بها، تعذبهم قسوتها، فيحتمون منها بالحشيش أو بالدين. التدين الإسلامي، وفي أشكاله المتصلبة الراهنة، يبدو هرباً من الصراع، وتقمصاً لدورٍ مسبق، مأمون. ولعل اللغة الإسلامية التي تسدل على وجه التجربة هي بدورها محاولة لنزع قسوة التجربة، وإسدال حجاب كلامي معهود على أعصابنا المُعرّاة. ولعلها من وجه آخر علامة على «عِيٍّ» جمعي أصاب السوريين، عبر فرض لغة أسدية فقيرة عليهم طوال نحو جيلين، فلم تبقَ في متناولهم غير لغة الدين التي كانت متنحية عن الفضاء العام، لكنها الأقرب إلى المتناول في النطاقات الخاصة.
لدينا تجارب قصوى غير مسبوقة، فعلت بنا كثيراً مما لا نحيط به بصورة كافية، لكن ماذا نفعل نحن بها كي نعلم ماذا ألمّ بنا؟ نكتب لنعرف، أو لنعبّر على الأقل. غيّرتنا تجاربنا، فكيف نغيّرها، نستوعبها ونتحكم به ونحولها إلى مُلكٍ لنا؟ إلى معنىً جديد لحياتنا واجتماعنا وسياستنا؟ لا نبقى نحن أنفسنا ونحن نصارع هذه التجارب، لكن لا نعرف كم تغيرنا وكيف تغيرنا وماذا نصير.
ولا يرتد المأساوي بعد ذلك إلى أننا لا نحيط بتغيرنا، المأساوي هو التغيّر بحد ذاته، من حيث أنه لا تغيّر بلا موت، لا يتغير الواحد منا إن لم يمت. التغير/الموت وحده ما يمكن أن يكون تغيراً مولّداً للمعنى، مُنتِجاً لثقافة وتفكير جديدين. ليس التغير شيئاً يُقبل عليه الناس ويقبلونه من تلقاء أنفسهم، على ما توحي الاحتفاءات النظرية بالتغيّر في زمننا. التغيّر في كل وقت حدثٌ مأساوي، تكونت المجتمعات وتكونت الثقافات حول مقاومته. تغيّرت ثقافات وتغيرت مجتمعات بفعل «الحداثة» العنيفة وفي إطارها، لكن ليس هناك مجتمعات أو ثقافات هي حليفة طبيعية للتغيّر.
وفي المسار العيني المعلوم لصراعنا، يحيل الحسّ المأساوي، من جانبٍ آخر، إلى صراع الالتزامات وتناقض كل المواقف المحتملة، واستحالة التركيب. ليس بين خيارات السوريين منذ تفجّر الثورة ما ليس متناقضاً، بصرف النظر عمّا إذا كنا نتحمل التناقض أم نهرب منه. والحال أن خياراتنا تتراوح بين القبول بالتناقض والصراع، ومحاولة بناء تفكيرنا وأدوارنا حولهما، أي القبول بالمأساوي، أو بالعكس رفضهما رفضاً خارجياً، فنتحول إلى عنصر غافل من عناصر المأساة وطرف سلبي من أطرافها. وليس في قبول المأساوي ما يضمن التحكم به، لكنه يبقى الخيار الأنسب من أجل توليد معنىً من شأنه أن يُكرّم المأساة.
ولعله ينبغي القبول أيضاً بأن المعنى مرجأ، ليس هنا، ليس شيئاً معطىً، وليس على وشك أن يولد. ليس لنا أن نجهض مأساتنا بأن ننسب لها، متعجلين، معانٍ فجة. وعلى أي حال لا يعني إرجاء المعنى (يتكلم عليه جاك ديريدا في سياق مغاير) غير القبول بالصراع والعيش معه. من شأن المصادرة على معنىً عاجل للصراع أن يضفي النسبية على آلام رهيبة، فيجعلها «ثمناً محتوماً» أو «مرحلةً لا بد منها» أو «ما كتبه الله لنا»، فيلغي ما هو مأساوي ونبيل في صراعنا الفاجع.
هذا الصراع في الكتابة وفي النفس معادلٌ للثورة المتعثرة في الواقع الاجتماعي والسياسي، واستئنافٌ لها.
3- تداخل الأنواع الكتابية
الخاصية الثالثة تتصل بالصراع مع النوع الكتابي والأسلوب. طوالَ نحو عقد قبل الثورة كانت مقالة الرأي هو النوع الكتابي الأبرز الذي يجري تداوله عبر وسيط تكنولوجي، الموقع الإلكتروني، كناشر، ليصل إلى جمهورٍ أوسع. الكتابة السورية الجديدة ممتنعة على التصنيف: ليست مقالة رأي، ليست تحقيقاً صحفياً، ليست قصةً، ليست شهادة شخصية، ليست خواطر مرسلة. الكتابة المنظمة ذاتها هي أقرب إلى مزيج من هذه الأشياء، يحضر فيه المتكلم بقوة، ليس ضمير المفرد المتكلم بالضرورة، ولكن مركزية الراوي. وهو ما يُحيل إلى ذات جديدة، مجربة، لديها ما تقوله عن تجاربها. ولعله يحيل من جانب آخر إلى نهاية «الحداثة» الفكرية و«الموضوعية»، وقد تظاهرتا لدينا (خلافا للغرب) بمزيج من إعدامٍ سياسي وكتابي للتجربة الشخصية، وبعيش في عالم من المجردات (الحداثة ذاتها، العقل، العقلانية، العلمانية، الديمقراطية، القومية، الإسلام…).
وهناك أيضاً تقاربٌ بين الكتابة والصورة، كان غير مُتَصورٍ من جيل الكتاب الأكبر والجيل المتوسط. وفي هذا ما يشير مجدداً إلى «أنا» يظهر، وإلى غزارة التجربة الشخصية.
هناك اليوم حريةٌ حيال الشكل، تحيل في جانب منها إلى أزمة المراجع وأزمة أشكال كتابية سابقة، ولعلها من جانبٍ آخر تحيل إلى أوضاع تأسيسية، تنمحي فيها التمايزات الموروثة بين الأنواع الكتابية والأشكال التعبيرية، وأُطُرِ الفعل والتفكير الاجتماعية عموماً، ويأخذُ وقتاً ظهور تمايزات جديدة. ثم أنها تتصل دون ريب بكون الأمر يتعلق بتجارب تعبيرية عند كثيرين ما كانوا كُتّاباً من قبل، وجدوا أنفسهم في خِضّم تحولٍ مهولٍ في حياتهم الشخصية، وفي حياة بيئاتهم ومجتمعهم وبلدهم. هؤلاء يصنعون كتابة تشبههم، أقل رسميةً وانضباطاً بأشكال مقررة. وعلى أي حال، ليس هناك نوعٌ كتابي واحد يستطيع أن يُحيط بهذه التجارب الحارقة المترامية الأطراف.
أنتجت الكتابة الجديدة قليلاً من الكتب حتى اليوم، قليلاً من الروايات، لكنها في سبيلها إلى نتاجات أكبر. في السنوات المقبلة، أُرجّحُ أن يتلامحَ جيلٌ جديد من الكاتبات والكتاب، يحققون في مجالاتهم المتنوعة الثورة المخذولة التي لم تتحقق في الواقع.
وبفعل الحرية حيال الشكل يبدو لي أن الأدب، الرواية بخاصة، هي الشكل الأنسب للكتابة السورية الجديدة. هذا لأن الرواية تستطيع استيعاب صيغ تعبير تتراوح بين التقرير الصحفي والخواطر والقصة والشهادة، وكذلك التحليل الاجتماعي والنفسي، فضلاً عن كونها متعددة الأصوات، وتتيح مساحةً للتأمل الشخصي أحادي الصوت لا تتاح في غيرها.
على أنه لا بد للرواية أن تتشكل بتجاربنا الجديدة، وأن تكسر مرة أخرى سلطة المرجع.
4- ثقة بالنفس
ورابع خصائص الكتابة الجديدة يتمثل في ثقةٍ بالنفس مكتسبةٍ بمشقة، تستندُ إلى اختبار سوريين كثيرين أقاصي التجربة الإنسانية على نحو لا يضاهيهم أحدٌ فيه في عالم اليوم. وما يُسبِغُ أهميةً استثنائية على هذه الخاصية هو واقع أن النظام الأسدي عمل على تحطيم ثقة السوريين بأنفسهم، وعلى غرس الشعور بالنقص والضآلة في نفوسهم، هذا بينما كان ينسب الشخصية والثقة والحرية إلى نفسه، وتحديداً إلى الطاغية الأسدي الحاكم، الموصوف بالاستثنائية والعبقرية والعظمة. كان السوري العام شخصاً ضئيل القيمة، يجري إذلاله في كل وقت، وبالكاد تسمع له شكوى. غاية ما كان يمكن أن يفعله أكثر السكان هو ستر المذلة، وإبقاؤها طي النفس. وهو ما كان ينطبق بقدر غير قليل على الكاتب السوري والمثقف السوري والفنان السوري، رغم أنهم كانوا دوما أقلّ انكشافاً وهشاشةً من عموم الناس. التفاعلُ بين شروط الحياة العامة والخاصة غير الكريمة، وضروبٍ متنوعة من التواطؤ من قبلهم، كان ينعكس في الكتابة تذمراً، أو حتى تفجعاً ونواحاً، دون التجاسر على لوم أحد، ومع تجهيل المسؤولية. وهو ما جعل الثقافوية الإيديولوجية الطبيعية للمثقفين في الزمن الأسدي، زمن بشار بخاصة، أي إلقاء المسؤولية على ذهنيات السكان وطرق تفكيرهم غير المستنيرة.
اليوم هناك خروجٌ من القصور الاختياري، وهو ما كان كانط ينسبه إلى التنوير، يستندُ إلى فعل تمرد سياسي وليس إلى «تنوير عقلي» مسبق. تنويريونا الأعلام تجهيليون وظلاميون بكل معنى الكلمة.
على أن هذه الخاصية، والخصائص الأخرى كلها في الواقع، تتشابك مع خاصية معاكسة، تتمثل في الإجهاد خصوصاً، وفي حجم مهولٍ لما ينبغي الاهتمام به ومتابعته. هناك عالمٌ بأكمله تَقَوَّض، ووقعَ بين أيدينا أو على رؤوسنا. كيف نواجه كل ذلك؟ خيار الانسحاب ذاته قلّما يكون متاحاً.
نشعرُ مع ذلك أن الثورة أنقذتنا من تعفنٍ لا ينتهي، وإن تكن حطمت كثيرين منا أيضاً.
ويتمثل أهم مظهر للثقة بالنفس في التمرد على التبعية والتقليد مما كان شائعاً في أوساط المثقفين السوريين: محاكاة أصل صحيح ناجز، والانضباط به والعيش تحت سقفه والركون إلى سلطته. اليوم هناك تجاسرٌ ينمو على محرّمات وتكسيرٌ لها. وأولها المحرّم السياسي الذي كان قبل قليل قوياً مُهاباً، ومعه قرينه المحرّم الطائفي الذي كان مخيفاً لا يُدانى. ومنذ الآن، وبينما لا يزال الهيكل العظمي للأسدية منتصباً، فقدَ هذان المحرّمان حرمتهما و«سكسيتهما»، فلا يكادُ قولٌ آخر في شأنهما ينتج قيمة سياسية أو فكرية مضافة. المحرّم الديني يجري انتهاكه أكثر وأكثر، بموازاة الأشكال العدوانية من تنصيبه صنماً مروعاً مكان المحرمين السياسي والطائفي، والخروج من الدين يتجه لأن يكون ثقافةً وتيارات عامة، وليس فعلاً فردياً معزولاً يجري في السر أو في نطاقات خاصة لأفراد متشابهين. وإن يكن ذلك محصوراً أساساً في الشتات السوري اليوم، فإن الاستعداد له ينمو في الداخل أيضاً. والمحرّم الجنسي وما يتصل به لن يبقى بمنأى عن الثقافة لوقت طويل. موازين القوى بيننا وبين المحرّمات تتعدل أكثر وأكثر لمصلحة أفراد ومجموعات يسائلون بشجاعة وغضب هذه المحرمات، والسلطات الحامية لها، عن شرعيتها ومبرر وجودها.
ويتصل بهذه الثقة أيضاً تحررٌ متزايد من الشعور بالنقص حيال الغرب، وحيال الإسلاميين، فضلاً عن النظام قبلهما. هذه الحرية الجديدة التي يجري اكتسابها بمشقة، ولا تزال تواجهها تحديات كبيرة جداً من السلطات والمحرمات المذكورة، ومن مشاعر إحباط منتشرة، هي بدورها استئنافٌ للثورة واستنادٌ إلى قرارِ التمرد البدئي الذي كَمَن في كفاحها المهول، منذ أطفال درعا إلى اليوم.
في مواجهة هذه الثورة الكبيرة، أعني الثقة المكتسبة بالنفس، يقف نظام الإذلال الأسدي، ولا يبدو أنها مصادفة أن يقف إلى جانبه النظام الدولي بأكمله، والإسلامية السلفية. الواثقون بأنفسهم متحررون، يفكرون من رؤوسهم ويقررون لأنفسهم، ويتعاونون مع غيرهم، وهي ممارسات خطرة يلزم مواجهتها بكل قوة. فإذا أعاد ولاة أمر الأسدية الدوليين تنصيبها على سورية، فلن تعيد هذه نصب المحرمين السياسي والطائفي فقط، بل هي قبل غيرها من سيعيدون نصب المحرم الديني (السني، ولا يبعد أن يطور النظام منظمته السلفية الخاصة أيضاً، مثلما سبق له أن «طور» البوطي و«معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم» و«القبيسيات» بعد سحق تمرد أواخر السبيعنات ومطلع الثمانينات)، وتعزيز المحرم الجنسي. الجنس مباح للنخبة الأسدية، وفي صيغه الإذلالية مباح لأتباعها. كل النساء السوريات، غير المواليات بخاصة، مباحات لها على نحو مثّلت عليه الممارسة الواسعة للاغتصاب والانتهاكات الجنسية في المقرات الأمنية. أما الأفعال الجنسية لعموم الناس فلا بد من مراقبتها وإخضاعها، يساعد الأسديين في ذلك رجال دين متنوعون. الطائفية بالذات ستعود قدس الأقداس من جديد، لأنها مساحة التقاء المحرم الديني بالمحرم السياسي بالمحرم الجنسي (احتكار الطوائف الحياة الجنسية، للنساء بخاصة).
5- راديكالية
في المقام الخامس هناك مساحات تتسع من راديكالية سياسية وفكرية تتصل بالثقة المكتسبة بالنفس، والوضع المأساوي المستميت لكفاح السوريين ولمآلاته الراهنة. تتصل كذلك بإدراك الطرق المسدودة التي تسير فيها الخيارات المعروضة على السوريين والتشكيلات السياسية القائمة حولها، وتعدد جبهات الصراع. النظام الأسدي ليس العدو الوحيد، وإضافة داعش أو حتى عموم السلفيين إليه لا تستنفده، لدينا مشكلة مع العالم في نظامه اليوم، ومع القوى النافذة فيه. وهذا بينما يجعل صراعنا مأساوياً أكثر، فإنه من جهة أخرى يعبر منذ الآن عن تحوله إلى «مسألة سورية» مرشحة لأن يدوم فصلها الحالي طويلاً، ولأن تتمادى فصولاً بعده على ما توحي الترتيبات التي يتداولها النافذون الإقليميون والدوليون في شأن قضيتنا. ثم إنه من جهة ثالثة يُدرج صراعنا في عملية تغير عالمية يزداد الشعور بضرورتها، بما قد يجعل من القضية السورية محركاً محتملاً لتغيرات عالمية أوسع. ومن وراء مواجهة ثلاث قوى غير تحررية، لدينا مواجهة مع عدو كبير كان عوناً لهم دائماً: أنفسنا. وهذا ظاهر من واقع أن «المعارضة السورية»، بتشكيلاتها المختلفة، كانت تافهة، تابعة، ركيكة.؛ ممثلون صغار في تراجيديا كبيرة.
الراديكالية اليوم هي مواجهة النفس وتغيير النفس، بوصفها الأساس الصلب لمواجهة العالم والمشاركة في تغيير العالم. وهذا ما يضعنا في مواجهة مع الديني- السياسي، هي على كل حال مواجهة مفروضة بفعل الأشكال العدوانية لتحكم المجموعات السلفية في المجتمعات المحلية الواقعة تحت سلطتها.
الراديكالية على الجبهة الدينية هي اليوم سند الراديكالية السياسية ومصدر اتساقها. لا يتعلق الأمر بنقدٍ مرواغٍ للإسلاميين مورس كثيراً قبل الثورة، ليس دون أن يُسائل الأطر الاجتماعية والسياسية للنقد، ومنها بخاصة أنظمة مثل النظام الأسدي والروابط الطائفية النامية في كنفه، بل وفي انفصالٍ تامٍ عن قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ومع استعداد طيب للاندراج في صراعات العقائد. نقد الدين وأهله اليوم له مقدمة لا بد منها هي نقد هذ الضرب من النقد، والاستناد إلى تجاربنا في السنوات الخمس المنقضية من أجل نقدٍ جذري للسلطات، لوكلائها الإيديولوجيين (العلمانية التسلطية)، وللإسلاميين بتنويعاتهم المختلفة، وكذلك لعالم اليوم القائم على ضروب متنوعة من الاستثناء، تتكثف أشد وطأتها في إقليمنا من العالم.
6- منظور عالمي
وتتصل بما سبق خاصية سادسة يمكن تلمّسها في كتابات سورية جديدة: منظور عالمي يتولد أكثر وأكثر عن إدراك أن العالم قضية سورية، بقدر ما إن سورية قضية عالمية. لعبَ «العالم»، والمقصود القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً، والمؤسسات الدولية، دوراً رجعياً في القضية السورية، وكان في محصلته داعماً للفاشية الأسدية، وكافلاً لحصانتها من العقاب، ومُسهلاً في النتيجة لتحول سورية إلى مرتع لقوى طفيلية إرهابية. «العالم» فينا اليوم (فوق سبعين دولة تحارب في بلدنا، منها أربعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة، وهذا غير مسبوق من حيث نطاقه في أية صراعات دولية سابقة، منذ الحرب العالمية الثانية؛ وأكرمنا بالجهاد في بلدنا مجاهدون جوالون من 70 بلداً أو أكثر)؛ ثم إننا في العالم (الدياسبورا السورية تتوزع على عشرات البلدان، 20% تقريباً من السوريين تهجروا/ هجروا بلدهم في السنوات الأربعة الأخيرة). والتغير السوري مرتبط بتغير العالم، ليس كشرطٍ مسبق، ولكن كترابط في العمليات والمسارات والمآلات. العالم ككل تغير نحو الأسوأ أثناء سنوات صراعنا الخمسة تقريباً، هذا بينما كانت سورية تتحول إلى بلدٍ محطم، على يد حاكم مالك تافه، يحميه الأقوياء.
ينمو في الشتات السوري، وهو شرط معزز لهذه الخاصية، حس بالحاجة إلى شركاء في العالم، شركاء يشبهوننا ونشبههم، ننخرط في قضاياهم وقضايانا، ونعمل معاً من أجل عالمٍ يتحرر.
في الوقت نفسه يتطور لدى عدد متزايد منا حساسية مغايرة، يعززها شرط الشتات، تقضي بألا نفصل أنفسنا عن العالم على طريقة القوميين والإسلاميين. نحن من العالم وفيه، ومسؤوليتنا أياً يكن تعريفنا (كسوريين، كعرب، كمسلمين، كبشر) عن تدهوره ليست هامشية. لسنا مجرد ضحايا، نحن شركاء، ضعفاء ربما، تعرضوا لسحقٍ متكرر، لكننا نستطيع العمل من أجل تحررنا وتغيّرنا. تغيّرنا هو نصيبنا من تغيير العالم، وهو سند عملنا من أجل تغيير العالم.
ثم إن هذا العالم الحديث منا، ليست لنا ذاتية متكونة من وراء ظهره أو في انفصالٍ عنه. وهو ما ينطبق على الإسلامية المعاصرة، بما في ذلك السلفية الجهادية، ليس من جهة حقل الصراع والعداوة العالمي الذي تشكلت فيه ولا يمكن فهمها خارجه، ولكن حتى في هيكلة عقيدتها (الحاكمية الإلهية التي تجمع بين مفهوم السيادة، وهي مفهوم حديث يخص الدولة- الأمة، وبين مصادرة السياسة، وهي خاصية للدول الشمولية في القرن العشرين). لا نفهم شيئاً من خصوصيتنا المزعومة إن عزلناها عن العمومية العالمية.
هذا العالم مريضٌ فعلاً، ولا يمكن التقدم نحو معالجته دون النظر إليه كمصلحة عالمية، للناس كلهم. لا يقتصر الأمر على أن الإسلام ليس هو الحل، بل إن الإسلام كنفيٍ سلبيٍ للعالم، مجردٌ وعقيم، هو أحد وجوه مشكلة العالم، وأبرز وجوه مشكلتنا نحن. ليس هناك أطروحة إسلامية تقترح على العالم علاجاً، يجعل منه عالم العالمين لا عالم الأقوياء. لا يقترح الإسلاميون شيئاً معقولاً يمكن الأخذ والعطاء معه، فقط العداء الحقود للعالم والنفي السلبي الذي يُفاقم مرض العالم ولا يعالجه. هذا إفقارٌ للإسلام ذاته فوق كونه إفقارٌ للعالم. يفترض المرء أن عقيدة مبنية على التوحيد والعدل، وعلى تقبل عقائد سبقتها، يمكن أن تكون لها أطروحة في شأن إصلاح العالم لا تستطيع داعش وأشباهها انتحالها. ولعله ليس خارج السياق كثيراً القول إن الإسلام الذي يُدافع عنه كخصوصية مهددة اليوم، كان ميثاق عالميتنا في الواقع، وليس كفيل انعزالنا المذعور. وحده الانخراط في العالم، ضد نظامه التمييزي الراهن، لكن ضد أشكال نفيه العدمية كلها (ونصيبنا منها كبير)، وضد النفي العدمي السلبي للإسلام ذاته (وهو شائع ومرشح لشيوعٍ أكبر)، ما يمكن أن يكون أساساً لعالمية جديدة، أعدل وأكثر حرية.
ظاهرٌ أن الإسلاميين ليسوا مؤهلين لطرح هذه القضايا التي تطرح نفسها على السوريين وغيرهم، ويطرحها السوريون على أنفسهم، وقد أسهمت صيغٌ من الإسلام في استباحة بلدهم، وتسهيل الاستباحة العالمية له. لكن تجربة الثورة السورية هي سندٌ كافٍ لطرح هذه الإسئلة التي تجد أكثر أكثر طريقها إلى الكتابة والنقاش العام.
من هم منتجو الكتابة السورية الجدد؟
ليست هذه الخصائص محققة في نتاجاتنا في سنوات التفجّر، لكنها ميولٌ عامة تتلامح في النتاج المتاح من جهة، واتجاهات مرغوبة مستحقة للعناية من جهة ثانية. الكتابة الجديدة هي نفسها خاصية صراعية، في وضعٍ صراعي في جوهره. لقد تحرّجت المقالة من تسمية كاتبات وكتاب بعينهم كممثلين للكتابة الجديدة، لكن يمكن ذكر مواد لرزان زيتونة، سعيد البطل، نائلة منصور، ريم الغزي وغيرهن كثير. الكتابة الجديدة نتاجُ طلبٍ على التعبير ولّدته قوة الحدث وانتشاره وشموله كما سبق القول، وهي جوهرياً هي سيرة فوضوية للثورة والصراع السوري، وهي عمل فوضوي بدوره، أنجزه كتاب ولا كتاب.
وبقدر ما إنه تَحضرُ في الكتابة الجديدة قضايا لم تكن في تداول السوريين من قبل، شهادات شخصية، تقصيات ميدانية من أجل التوثيق والذاكرة، فإن هذه بدورها توسّع من مجال الكتابة لتشمل حقوقيين وناشطين سياسين و«مواطنين صحفيين» وثائرين ميدانيين. وفي الوقت نفسه الكتابة الجديدة أحد وجوه جهد جمعي للإمساك بالحدث، كانت الكاميرا من أدواته الرئيسية، من كاميرا الهاتف المحمول إلى كاميرات أكثر تطوراً، يحتمل أن سورية كانت من أنشط أسواقها في سنوات الثورة.
تتميز الأوضاع التأسيسية باختلاط متعدد المستويات، وفي وضعنا نلحظ اختلاطاً على أكثر من مستوى هو ما أنتج الكتابة الجديدة. من جهة ما سبقت الإشارة إليه من اختلاط الأنواع الكتابية وضياع الحدود بينها وظهور كتابات خارجة على النسق في بنائها أو في قسوتها أو في موضوعاتها؛ ثم من عدم تمايز الكاتب واللاكاتب، فكثيرٌ من ممثلي الكتابة الجديدة ليسوا كتاباً: أحمد ابراهيم ليس كاتباً، وسعيد البطل لم يكن كاتباً، وريم الغزي ليست أساساً كاتبة… وكثيرٌ من المواد التي نُشِرَت في هذا الموقع ليست لكتّاب أصلاً. وهو ما يضفي على الكتابة الجديدة طابعاً ديمقراطياً غير مسبوق في سورية، من حيث أنها الكتابة المنفتحة على غير الكتاب أو أهل الاختصاص. ومن أوجه الاختلاط أيضاً أن الكتابة الجديدة تقترن بقدر متزايد بأدوات تعبير أخرى: الصورة أساساً، ثم الصوت البشري، وبدرجة أقل الرسوم والفيديو، والموسيقى. ولعل في ذلك ما يضيء مركزية دور الكمبيوتر والهاتف المحمول (وبخاصة «السمارت فون» الذي يجمع بعض خصائصهما معاً) في حياة كثير من السوريين، في الداخل والشتات، على نحو ربما يفوق غيرهم. ليس في الأمر تفضيلٌ غير عقلاني لجهاز مكلفٍ من قبل من هم محاصرون ولاجئون، إنه عقلانيٌ جداً بالضبط لأنهم محاصرون ولاجئون، من حيث أن هذا الجهاز وسيلة اتصال وكاميرا وآلة تسجيل ودفتر كتابة، وجريدة وراديو وتلفزيون، وركيزة أساسية للهوية والتاريخ الشخصي. من غيره يموت المحاصر ويضيع اللاجئ. لولا صور مضايا، وقد صورها مواطنون محليون واقعون تحت الحصار، ربما لمات الألوف، أو الأربعين ألفاً من سكانها جميعهم، دون أن يسمع بهم أحد. فإذا كانت حقيبة السفر رمزت للاجئ الفلسطيني يوماً، فإن الهاتف المحمول هو ما يرمز إلى اللاجئ السوري، والسوري عموماً اليوم.
والمهم هو أن شبكة الكمبيوترات والهواتف المحمولة، توفر للسوريين في شتاتهم قدراً من تواصل وترابط فُقِدَا عبر تحطيم مجتمعهم. مواقع التواصل الاجتماعي ليست، بخصوص السوريين، مواقع «تواصل» تكمل مفعول طرق اتصال أخرى، ولكنها ضربٌ من مجتمع بديل ليس لهم غيره في شروطهم المعلومة.
وعبر الفيسبوك وغيره، هؤلاء السوريون كلهم «كتّابٌ جدد»، معبرون، مصادر لأخبار وقصص، ورواة لحكايات غير مسبوقة، ومسجلون لمحنهم الشخصية أو لجوانب من المحنة العامة، أصحاب آراء، مساجلون، ومتأملون. هذه الكتابة غير المنظمة هي الأساس الي تستند إليه كتابة منظمة بقدر متفاوت.
وبفعل تلاقي الثورة التي محت الفارق بين الشخصي والعام في حياة معظم السوريين مع الوسائط التكنولوجية، هناك وجه اختلاط آخر يميز الكتابة الجديدة: اختلاط المحكية والرسمية أو الفصحى في التعبير والكتابة. المحكية توفر مساحة أكثر شخصيةً للتعبير.
أريد أن أقولَ إن الكتابة الجديدة كتابة من تحت، ليست شيئاً نخبوياً «رفيع المستوى»، إنها بقدرٍ لا بأس به كتابة مجتمع مقتلع، ومجتمع كتابة مختلفة. قد لا يحلل هذا المجتمع الوضع العالمي، لكن له رأياً في العالم، يدين قادته جميعاً، ويراه عالماً غير عادلٍ يجب تغييره؛ قد لا يطور تفكيراً منظماً بخصوص الحاجة إلى تغيير شامل، لكنه «يلعن كل شيء»، ويُسند لعناته إلى أوضاع محسوسة وأمثلة حية كل مرة؛ قد لا تكون لديه أفكار حول دور التجربة والخبرة في المعرفة، لكن معارفه مبنية على خبرات حية أكثر بما لا يقاس ممن لديهم أفكار نظرية عن الموضوع؛ قد لا ينتظم تفكيره حول مدركات التناقض والصراع والتراجيديا، لكنه يعيش الصراع ويتمزق في صراعه، ولا يجد في متناوله سنداً أو ضمانة. وقد لا تكون غدير فراس أو زبيدة اسماعيل (وقد نَسبَت المرأتان نفسيهما إلى زوجيهما المخطوفين، فراس الحاج صالح واسماعيل الحامض) كاتبتين، لكنهما تكتبان صراعهما اليومي ضد الوحشية واليأس وتقطّع الروابط، وتعلنان بغضبٍ تراجيدي أنهما لن تسامحا ولن تنسيا.
والأكيد المؤسف أن عدداً هائلاً من الشهادات والقصص تضيع، بعدد الحيوات التي حُطّمت وأكثر. هناك من لا تتاح لهم فرصة التعبير، أو من لا ينصت لهم أحد.
ليس في ما سبق ما يغني عن تطوير صيغ كتابية عالِمة أو منظمة، أكثر عمومية وتجريداً، تراجعُ نفسها وتنعكس على نفسها، وتطور لغة إنسانية أعم، وتقبل «إعادة الإنتاج» والتعميم. لكن كتابة لا تستند إلى صرخات المنكوبين ولعناتهم، غضبهم ويأسهم، رجائهم وأساهم، لا تؤسس لجديد إنساني. لا تتأسس الوحدة البشرية على غير الوضع الذي يتشابه فيه البشر أكثر ما يتشابهون: الكرب.
فإذا كان ما قيل هنا قريباً من الصواب فإننا حيال مقدمات تحول كبير، يطال نطاقات السياسة والدين واللغة والمجتمع، وتشارك فيها نساء بكثرة، ولها أفقٌ عالمي. هذه ثورة.
من الثقافة الأسدية إلى الثورة الثقافية
بقدرِ ما إن الكتابة الجديدة فعلٌ صراعي، فإن كلاً من الخصائص السابقة تتصارع مع خاصية معاكسة. في مقابل التجربة الشخصية لا تزال الكتابات المرسلة شائعة، وبعضها هجومي أيضاً: يحاكم تجارب اليوم باسم مواثيق للصواب سابقة عليها، ولم تختلط بها في أي وقت. كتابات أدونيس مثلاً التي تتكلم على عربي مجرد أو مسلم مجرد يبدو أنه يبقى مماثلاً لنفسه في كل وقت، سواء كان راكناً إلى أوضاع قمعية ساحقة، أو كان محتجاً سلمياً أو ثائراً مسلحاً أو مقتولاً تحت التعذيب أو مهجراً في مناف بعيدة. والرجل ليس وحيداً في ذلك، إنه سلالة كاملة. والواقع أن الكتابة الجديدة ليست أمراً محسوماً في أوساط الثورة ذاتها، فعدا ما تقدم قوله من أنها اتجاه مستشرف من جهة، ومرغوب من جهة ثانية، فإن مشقة تفكير جديد وكتابة مغايرة، وفي أوضاع فظيعة إنسانياً، تغري بالركون إلى أساليب تعبير وكتابة قديمة، «الكتابة من فوق». وهذه كتابة هاربة من التفاصيل والتجارب، ومن الصراع.
والحسّ المأساوي يتقابل مع تقاليد كتابة بلا صراع ولا توتر، حين لا تكون مليئة باليقين، فإنها تمشي في المنتصف وتوزع حنقها بالقسطاس على الجميع، أو هو يتقابل مع كتابة نائحة لا تصارع التجربة ولا تقبل التناقض ولا تولّد معنىً جديداً. أو يجري الهروب من الصراع بنسبة معانٍ جاهزة إليه، تسلبُ المنخرطين فيه حريتهم وحيرتهم. الحسّ المأساوي ليس انعكاساً سلبياً لمآسٍ واقعة، بل هو صراع معها يحتمل أن يفضي إلى التغير والانعتاق، أو إلى التحطم والموت.
وامتناع المكتوبات على التصنيف يتقابل مع استقرار أنواع كتابية قديمة، عند الكتاب الأكبر سناً بخاصة، ومع خشية من التجريب.
والثقة بالنفس تُنازعها في كل وقت أوضاع الإجهاد، أو الإحباط واليأس، أو صَغارٌ مديد ينقل تبعيته بخفة من سيد إلى سيد، من السيد الأسدي مثلاً إلى سيدٍ إسلامي، أو إلى سيد من المنظمات الغربية، أو من دول عربية موسرة.
والراديكالية يخصم منها ولاء لمعتقد أو لمرجع، أو سعي وراء إجماعٍ مستحيل باسم الوطنية.
والعالمية يخصم منها بدورها انبهارٌ أو شعورٌ بالنقص، أو استعدادٌ للتبعية، أو إدمانُ دور الضحية، أو ميلنا الشائع إلى التشكي والانتحاب.
ثم أن الصفة الديمقراطية للكتابة الجديدة وتَضيّق المسافة بين الكاتب واللاكاتب، والمحكي والفصيح، يتقابل مع منطق الندرة السائد الذي يقرر أن الكتابة الجيدة نادرة، وأن مفاتيح أبوابها بيد «الكتاب الجيدين»، الفصحاء، فلا يدخلها إلى قليلون.
فإذا كانت التجربة الشخصية والغنى بالتفاصيل الحية، والحسّ التراجيدي، وتداخل الأنواع الكتابية، والثقة بالنفس، والراديكالية، والعالمية، والديمقراطية، هي خصائص كتابة جديدة، كتابة من تحت، وثقافة جديدة، ثورية، فإن الخصائص المقابلة من تهويم وتجريد وانفصال عن التجارب الحية، ومن كتابة صورية ساكنة لا صراع فيها ولا حياة، ومن عالم أنواع كتابية جامد، ومن عبدية ومرواغة وافتقار إلى الشجاعة، ومن تسليم بمنطق القوة، ومن نزعة محلية ضيقة، وطبعاً من تمييز موطّد بين الكاتب وغير الكاتب، وبين الكتابة وحياة السكان، هذه كلها تميز ما يمكن تسميتها الثقافة الأسدية. كان هذا هو الطابع العام للثقافة في «سورية الأسد»، ليس عند الموالين وحدهم، ولكن عند قطاع واسع من أهل الكتابة.
وتتمثل الخاصية الجوهرية للكتابة الأسدية في أنها غير مسكونة، أجلي منها البشرdepopulated writing، فلا تحضر فيها أصواتهم، ولا يروون ولا تروى قصصهم، ولا ذكر لاعتراضاتهم أو إشارات إلى احتجاجاتهم وغضبهم، ولا نجد أطراف من سيرهم ومحن حياتهم، ولا يرد فيها شيء له علاقة باليومي وتفاصيل الحياة. هذه الكتابة غير المسكونة تشبه سورية الأسد نفسها من حيث أن سكانها غير مرئيين ولا صوت لهم، مطرودين من الفضاءات العامة في بلدهم، الفضاءات المكرسة، بالمقابل، للسلالة وسلطانها وأبدها.
هذا للقول إن الكتابة فعل سياسي في كل حال، وأن الكتابة الجديدة، المسكونة بأصوات الناس وسيرهم وصورهم وحكايتهم وتفاصيلهم وموتهم، هي وحدها الكتابة الديمقراطية، ولو لم تكتب على جبينها أنها كذلك.
هذه الكتابة، والثقافة الأسدية عموما، هي ما تواجهها اليوم كتابة جديدة وذاتية جديدة، عامرة بالناس.
في كل حال، نحن في وضع صراعي، نصارع فيه أنفسنا وضد أنفسنا، بقدر ما نصارع قوىً وقيوداً خارجنا. النتيجة غير مضمونة، لكن قطائع متعددة تبدو ضرورية، قطيعة سياسية وقطيعة فكرية وقطيعة دينية وقطعية اجتماعية، وتحمّل تبعاتها مرغوب.
سيحتاجُ استقلال الكتابة الجديدة والثقافة الجديدة أكثر وأكثر إلى تنظير، اقتراح مفاهيم وقواعد لتحويل التجارب إلى أفكار وثقافة. ومن شأن الاشتباك مع تجاربنا ومحاولات ترجمتها المترددة إلى معانٍ، وما نخوضه من صراع مأساوي لتوليد المعنى، مواكبٍ للصراع الجاري متعدد المستويات، أن يطلق ثورة في الثقافة، وفي الصمود بمواجهة الثورة المضادة للمعاني القديمة، الديني منها وغير الديني.
موقع الجمهورية





