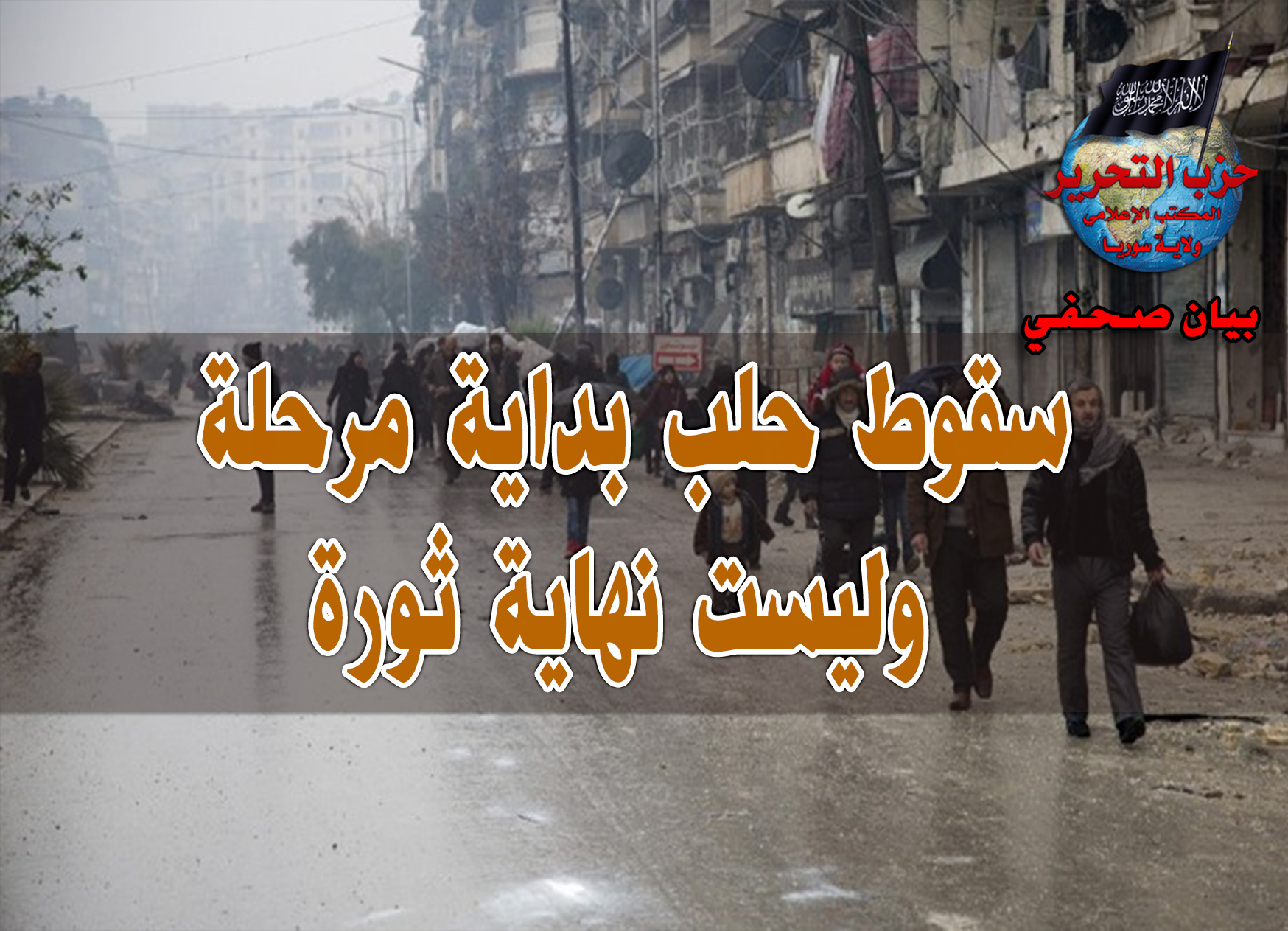حين يصبح شافيز ناصريا.. ومحددات الهوية في الأنا والآخر
أنور بدر
بعيد انهيار المعسكر الشيوعي ونهاية الحرب الباردة، كان على الادارة الأمريكية وقتها أن تكتشف مبررات أيديولوجية لحروبها القادمة، حيث وضع جيمس ولزي المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية نظرية ‘الحرب العالمية الرابعة المفتوحة’ التي ستلي الحرب الباردة باعتبارها الحرب الكونية الثالثة، حيث اكتشفت في الأصولية الإسلامية نوعاً من الفوبيا التي يمكن استثمارها في حروب لا تنتهي، قد تمتد لمئة عام أو أكثر وتتسع لمساحات من الجغرافيا الإقليمية والقارية بحسب انتشار الإسلام السياسي، فكانت حروب القاعدة في افغانستان، وبعدها جرى تبرير غزو العراق واحتلاله، فالإسلام السياسي يمكن اعتباره العدو الجديد لتبرير هذه الحروب، واستنزاف المنطقة العربية إلى وقت غير محدد.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى أي مدى ساهم المسلمون والعرب في صناعة هذه النظرية أو الاستجابة لمقتضياتها، من خلال بلورة الهوية الجديدة للإسلام السياسية في مواجهة معسكر الشر أو الآخر الغربي؟.
في العالم المعاصر يسهم كثيراً علم الاجتماع الحديث والمصالح الاقتصادية المتنامية في بلورة محددات الهوية ضمن المجتمعات الغربية، بينما جرى اختزال المسألة في بلادنا إلى حدود الأيديولوجيا والثنائيات الضدية التي تقسم العالم إلى خير وشر، إلى أنا وآخر ليس بالمعنى الفردي، بل هما الأنا والآخر الجمعيان، اللذان يعيدان تأطيرنا ضمن حظيرة القطيع، حيث يصبح الاسلام واحدا بكل تعددياته الفقهية والسياسية، ويكون الغرب واحدا بكل مكوناته المتناقضة أيضاً، حتى أن شافيز الأحمر في فنزويلا يصبح لحظة وفاته واحدا من قطيع الأنا، مما مكن أحد منظري القومية العربية السيد معن بشور ان يمنحه في لحظة سياسية وأيديولوجية محددة لقب الناصري، نسبة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بنفس الوقت الذي يُعمّد فيه كأحد أولياء الله الصالحين لدى بعض المستضعفين في الأرض.
مما يؤكد أن ثنائية الأنا وللآخر لم نكن الوحيدين في صناعة محدداتها، لكننا اكتشافنا قدرات هائلة لنكون مشاركين بجدارة في احتلال فضائها الجاهز لاستيعابنا، فنظرية ولزي عن الحرب الكونية الرابعة لم تكن أكثر من قراءة في استعداداتنا الكامنة التي صنعت للغرب ما يعرف بظاهرة ‘الفوبيا الإسلامية’، التي أهلت كل مسلمي العالم ليكونوا الأعداء أو العدو الجديد، مما شكل نقطة اتفاق بين القاعدة وملالي طهران، على تناقضاتهما، لاعتبار أمريكا هي الشيطان الأكبر، والذي يمكن أن ينقسم العالم تبعا للموقف منه، وهو ما يمكن أن تختصره عبارة شافيز للمخرج الأمريكي مايكل مور، بأنه سعيد بلقاء شخص يكرهه بوش أكثر منه، حيث نكتشف أن ما يكل مور، مع احترامي الشديد له، يمكن له أن يحتل خانة ‘الناصرية’ أيضا، كما أصبحت روسيا في إطار الثورة السورية جزءاً من محور الممانعة والتصدي.
المسألة لا تحتاج أكثر من قلب المعادلة ليصبح إرهاب الأصولية الإسلامية هو الوجه الآخر لاعتبار الإسلام هو الضحية المعتدى عليها، ويكون الغرب هو المعتدي الآثم باستمرار، حيث ننجح دائما في اكتشاف شواهد تثبت هذا المنطق، وفي أحيان أخرى نخترع هكذا شواهد، إن أعيانا اكتشافها، وأعتقد أن جيلنا يتذكر بوضوح فتوى مرشد الثورة الإسلامية في إيران الإمام آية الله الخميني، بتاريخ 14 شباط/ فبراير من العام 1989، بعد أشهر على صدور رواية ‘آيات شيطانية’ للكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في ايلول/ سبتمبر من العام 1988، والتي حكمت بالموت على مؤلف الكتاب وناشره ‘وعلى جميع المسلمين تنفيذ ذلك أينما وجدوهم، كي لا يجرؤ أحد بعد ذلك على إهانة الإسلام، ومن يُقتل بهذه الطريق فهو شهيد’.
هذه الفتوى لم تقف عند حدود العقاب الشخصي لمن ارتكب إثما من وجهة نظر الإمام الخميني، بل اندلعت المظاهرات حينها في أغلب بلاد المسلمين، في مشاهد عنف استهدفت سفارات الدول الأجنبية، وبعض الشركات والأشخاص، وقتل بعض العاملين في السلك الدبلوماسي، وتكرر المشهد لاحقاً في ردود الفعل المشابهة التي عمّت بلاد الإسلام والمسلمين الغضبين في بلدان الغرب عموما وفي أمريكا بشكل خاص إثر نشر كاريكاتير في إحدى الصحف الدانماركية بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2005 يسيء للرسول الكريم وبالتالي يسيء لمشاعر المسلمين، وشهدنا موجة غضب مشابه منذ أشهر قليلة احتجاجاً على فيلم ‘براءة المسلمين’، التي كان احراق القنصلية الأمريكية في بنغازي ومقتل ديبلوماسي أمريكي أحد نتائجها.
هذه الحوادث المشابهة من أفعال ومن ردود الأفعال، تجعلنا نبتعد عن البراءة قليلاً في فهمنا لما يحصل، ونتساءل: هل يمكن أن تكون هكذا افعال استفزازية مقصودة بمصدرها؟ ومطلوبة بنتائجها أيضاً؟ وكل الغربيين أو الأمريكيين الذين تستهدفهم هكذا احتجاجات هم أعداء للإسلام والمسلمين أو للعرب؟ وهل يمكن أن يكون بين الضحايا الأجانب مؤيدون أو متعاطفون مع قضايانا كعرب أو كمسلمين، وما موقفنا من عشرات رجال الشرطة والمتظاهرين الذين يقتلون في هكذا حوادث، ناهيك عن اصابة المئات من المسلمين؟ وما هو تبرير هذا السلوك؟،
وفي هذه الحالة هل نتحمل نحن المسلمون المستهدفون في هذه الأفعال ما يصدر عنا من ردود غاضبة؟ وما ينتج عن ردودنا وعن غضبنا من إساءات للآخرين وصولا إلى جرائم القتل؟ أم الحق على هؤلاء الأفراد الذين يقومون باستهدافنا واستفزازنا أيضاً؟ وهل يحق لنا أن نعمم المسؤولية انطلاقاً من هؤلاء الأفراد ووصولاً إلى مستوى الشعوب والدول والديانات الأخرى؟ وأي عدالة تلك وأي إسلام يأخذ البريء بذنب المجرم؟.
دعونا نلقي نظرة على حدث معاكس في اتجاهات الفعل وردود الفعل أيضاً، وأقصد رواية ‘الإغواء الأخير للمسيح’ لمؤلفها اليوناني المسيحي نيكوس كازانتزاكي، والتي نقضت الكثير من المعتقدات المسيحية حول السيد المسيح ووالدته مريم العذراء، بل شكلت إساءة لهما في نظر الكثيرين، حتى أن بابا الفاتيكان حينها أصدر حرماً كنسياً يشمل طباعة وقراءة هذه الرواية، لكن شيئا من هذا لم يحدث، ولم يتطرق الحرم الكنسي لمؤلف الرواية أو ناشرها، وحتى في سوريا والمنطقة العربية لم تثير ترجمتها للغة الضاد التي قام بها الراحل ممدوح عدوان أي ردود فعل دينية أو موجة من الغضب تطال المقدسات الإسلامية أو شخص الكاتب أو الناشر أو المترجم أو أي أحد من المسلمين.
لا جديد في ردود أفعالنا التي أريد لها أن تبقى في هذه النمطية البائسة، نمطية تحكم كامل تفكيرنا وتقودنا إلى أفعال جمعية، تبرر لنا رؤية الآخر كنمط أو تيمة معادي للإسلام والعرب عموماً، نمطية بائسة تمنعنا من التفكير، وتحيلنا إلى كائنات قابلة للاستفزاز، كائنات تتحرك بآلية القطيع المحكوم بغرائزه ومشاعره، وتغمرنا السعادة والنشوة في أفعال الانتقام، والتهديد بالانتقام، حيث رفع السلفيون في الأردن شعارا في وجه الأمريكيين: ‘ترقبوا أفعالنا الحرة ردا على حرية أقوالكم’.
والسؤال الآن: لمصلحة من يكون تحرير الأفعال؟ وهل يخدم هذا الشعار شعوب المسلمين وقضاياهم؟ أم هو يخدم أجندات أرادها أعداء الإسلام والعرب حين سعوا إلى تثبيت صورة الإسلامي الغوغائي الذي يشهر مديته للقتل فقط؟ والسؤال الأهم: هل من أفق لنا كي نتحرر من تلك النمطية الغرائزية التي حكمتنا طويلاً؟ وهل من أفق لنتحرر من إطار الثنائيات الضدية التي ترى العالم خير وشر، أسود وأبيض فقط؟ ومتى نكتشف جمالية ألوان قوس قزح التي فجرها الربيع العربي؟.
كاتب سوري
القدس العربي