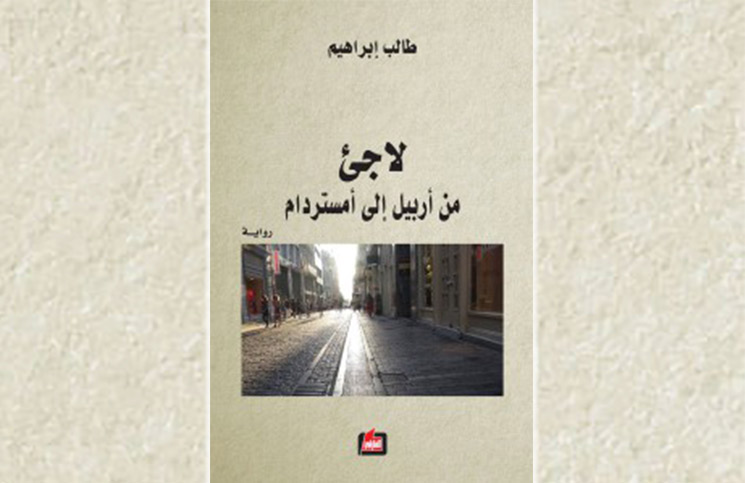“خمس مدن” تركية لتانيبار: صراعات الأصالة والحداثة/ محمد م. الارناؤوط
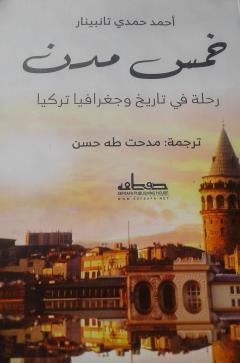
تبرز في السنوات الأخيرة دار “صفصافه” المصرية لتتحفنا بترجمات عن آداب وتجارب الشعوب الأخرى، وخاصة ما هو خارج الدائرة المركزية الأوربية الغربية، وهو ما تُشكر عليه بطبيعة الحال. وفي هذا السياق فقد أصدرت مؤخراً كتاب الروائي التركي أحمد حمدي تانيبار
“خمس مدن – رحلة في تاريخ وجغرافيا تركيا” (القاهرة 2016) ، ترجمة مدحت طه حسن.
ويعتبر أحمد حمدي تانيبار (1901-1960) من أهم الكتّاب في تركيا في المرحلة الجمهورية حتى وفاته، إذ كتب الشعر والمقالة والقصة والرواية، وتعتبر روايته “طمأنينة” التي تُرجمت إلى العربية من علامات التحديث الفارقة في الأدب التركي المعاصر. ونظراً لمكانته يقام كل عام في استانبول مهرجان أدبي يحمل اسمه، كما يحمل متحف الأدب التركي المعاصر في استانبول اسمه أيضاً. وقد حظي هذا الكتاب بتقدير خاص من منظمة اليونسكو نظراً لقيمته بعد أن ترجم إلى الانكليزية وصدر في لندن عام 2013.
كاتب مخضرم
يمثل تانيبار الجيل المخضرم من الأتراك الذين عايشوا نهاية السلطنة العثمانية والجمهورية الكمالية العلمانية، بما تحمل تلك الفترة الانتقالية من مخاض صعب نتيجة للحروب (الحرب البلقانية 1912-1913 والحرب العالمية الأولى ثم حرب الاستقلال مع اليونان 1919-1923 ) التي حملت معها المآسي (المجازر والهجرات القسرية الخ). ومن ناحية أخرى يمثل تانيبار الجيل المخضرم من الكتّاب الذي عرف الأدب التركي الحديث الذي يحمل قيم التنوير والتحديث ضمن المعارضة للحكم المطلق للسلطان عبد الحميد الثاني وساهم بدوره في موجة جديدة من التحديث انطلقت مع العهد الجمهوري والنظام العلماني الجديد في تركيا.
في كتابه هذا، لدينا رحلة عبر التاريخ والجغرافيا أو الجغرافية التاريخية لتركيا المعاصرة التي اختار خمس مدن مهمة ارتبط بها خلال تجوال الأسرة والوظيفة (أنقرة وأرضروم وقونيه وبورصة واستانبول). ولكن ما وراء ذلك لدينا ما أهم: العلاقة بين الماضي والحاضر، وتفسير السحر للحنين إلى الماضي في تركيا، وما يحمله من دلالات بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل.
نموذج أتاتورك
وفي الواقع إن تانيبار هنا كأنه يتحدث عن مجايليه من العرب الذين أُخذوا بسرعة التغيرات في النظم السياسية مع الانقلابات العسكرية من بكر صدقي إلى حسني الزعيم وجمال عبد الناصر (الذين أعجبوا جميعاً بأتاتورك)، وما جرّت من تغيرات اقتصادية واجتماعية وعمرانية على العواصم والمدن الكبرى، ومن إخفاقات بطبيعة الحال، كانت تحرّك من حين إلى آخر هذا النوع من الحنين إلى الماضي.
الماضي لدى تانيبار لايقف عند السلطنة العثمانية بل يتعدّاها إلى السلاجقة (الذين أخذوا حيزاً أكبر في الطبعة الثانية للكتاب) ومن كان قبلهم (بيزنطة) ليبرز هذه التوليفة الساحرة الخاصة بتركيا من شرقها (أرضروم) إلى غربها (بورصة)، ومن وسطها (أنقرة) إلى شمالها (استانبول). وبأسلوبه الأخاذ يأخذنا في رحلة الحضارة في آسيا الصغرى التي تعاقبت عليها الدول والامبراطوريات من الحثيين الى العثمانيين، مستكشفاً التفاصيل في كل واحدة من هذه المدن التي تتميز بخصوصية يعبّر عنها في كل مجال: السياسة والدين والثقافة والعمارة والاقتصاد الخ.
ولكن مع هذا الوصف الساحر لهذه المدن هناك رسائل مهمة في المقدمة والخاتمة. ففي المقدمة ينطلق تانيبار من أن كتابه هذا “يُعدّ نوعاً من الصراع بين الشغف الذي ننمّيه تجاه الحداثة، والندم الذي نشعر به تجاه مافقدناه من حياتنا” سواء بين الجيل الواحد أو بين الأجيال التي تعيد اكتشاف ذاتها أو اكتشاف الفروق بين ذواتها بالاستناد إلى الموقف من الماضي الذي انقضى والحاضر والمستقبل الذي يبدو في الأفق.
رؤيا “نبوية”
في الخاتمة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الكتاب أُنجز في 1960، نجد ما يمكن أن نسميه “رؤيا نبوية”. فالمؤلف ينتهي إلى القول “إن المشكلة الكبرى الضاغطة على الجميع هي: عند أي نقطة وكيف يجب أن نرتبط بالماضي؟”. في ذلك الوقت بالذات برز جيل أردوغان ليفهم الماضي على طريقته ويعمل على حاضر/ مستقبل يستلهم الماضي العثماني. في تلك السنة (1960) ختم المؤلف معلقاً “علينا ألا ننسى أن المجتمع التركي يقف على عتبة حياة جديدة، وأن اسطنبول تنتظر بشوق بالغ هذه الحياة الجديدة التي ستخلق قيماً طازجة”. إن هذه الفكرة في التعاطي مع الماضي كـ “لحظة من التنوير” لإعادة النظر في حاضر ومستقبل تركيا التقطها لاحقاً أحمد داود أوغلو في كتابه “العمق الاستراتيجي” بالتركيز على الميراث السلجوقي- العثماني والمجال الحيوي لكي تظهر تركيا أخرى قوة إقليمية، وهو ما نُسب إلى أردوغان باسم “العثمانية الجديدة”، التي لم تعد تكتفي بترميم التراث العثماني العمراني داخل تركيا، بل في كل المجال العثماني السابق الممتد من البوسنة إلى اليمن لتعيد التواصل مع الماضي الذي يمثله.
الترجمة والسياق الثقافي
ولكن مع سحر الرحلة في هذه المدن العريقة وتساؤلات المؤلف عن تداخل الماضي مع الحاضر، لم تساعد الترجمة في الانسجام المتواصل مع المؤلف، بل كانت تعيقه في كل صفحة تقريباً. فالترجمة تمّت من الانكليزية، في الوقت الذي أصبح لدينا عشرات من المترجمين من التركية إلى العربية في العقود الأخيرة. ومع التقدير لما أنجزه المترجم مدحت حسن من ترجمات من الانكليزية (“الطفل الخامس” لليسنغ و”قلب الظلام” لكونراد الخ) إلا أن هذه الترجمة بالذات تثبت ما يقال إنه لايكفي للترجمة الجيدة معرفة اللغتين، وإنما من الضروري معرفة السياق الثقافي للموضوع الذي هو تركيا وميراثها السلجوقي – العثماني.
في هذه الحالة، عدم معرفة للسياق الثقافي، لدينا مئات الأخطاء في الأسماء والمفاهيم التي لم يوفق المؤلف في ترجمتها نظراً لأن التقليد الأوروبي يقتضي أن تترك الأسماء كما تكتب بالتركية، وحين يقرأ المترجم هذه الأسماء والمفاهيم بالانكليزية تبدو بعيدة عن الأصل أو حتى مزعجة للقارىء العربي.
أخطاء في الأعلام
فقد التقى المؤلف أتاتورك حين زارهم في المدرسة بأرضروم (التي تصبح إيرزوروم) وسأله عن “مدرسة ميدراس” التي لايفهم القارىء منها شيئاً لأن سؤال أتاتورك كان عن المدرسة الدينية التي تُسمى “مدرسة” (المأخوذة من العربية)، ويتحول اسم أديب خوجا إلى “أديب خوكا” وخليل إلى “هاليل” الخ. أما في الفصل المتعلق بقونيه، فالأخطاء تكثر إلى حد لا يحتمل عندما يتعلق الأمر بتاريخها السلجوقي وتراثها الصوفي الذي تشتهر به. فالمولوي يتحول إلى “ميفليفي”، وتتحول طرق الصوفية القلندرية والحيدرية إلى “الكالندر” و”هايديري”، و”الآخيّة” التي تعرّف عليها ابن بطوطة في رحلته إلى “الآهي”، ولكن اللخبطة تبدو أكثر مع أهم ما يميز قونيه: جلال الدين الرومي وديوانه “المثنوي” وشمس الدين التبريزي. فمولانا يتحول إلى “ميفلانا”، والمثنوي إلى “الميسنيفي”، وشمس الدين إلى “سمس”، وكتابه “مقالات” إلى “ماكالات”، والتكية الى “دار رهبنة الدراويش”، والشاعر المعروف يونس إيمره (الذي تحمل اسمه عشرات المراكز الثقافية التركية في العالم) إلى “يونس العمري”، على حين أن ابن مولانا جلال الدين سلطان ولد يتحول إلى “السلطان فيليد”، ورقصة المولوية السماع وليس السماح إلى “السيما” الخ.
وإذا انتقلنا إلى اسطنبول المعروفة أكثر للعرب نجد قدراً أكبر من الأخطاء وهو يذكر أشهر السلاطين ويصف أهم المنشآت المعمارية في هذه المدينة. فالمؤلف يعتمد هنا على وصف الرحالة التركي المعروف أوليا جلبي الذي يتحول هنا إلى “ايفيليا سيليبي”، فيتحول مسجد بيازيد إلى “مسجد بييازيت”، ومسجد السلطان أحمد يتحول إلى “مسجد السلطانامت” وجامع السلطانة الوالدة إلى “جامع فالد” والسلطانة خديجة زوجة محمد الرابع إلى “هاتيس”، بينما يتحول السلطان سليمان القانوني إلى “سليمان واهب الشريعة” وشيخ الاسلام إلى “شييهوليسلام” الذي يتكرر عدة مرات (أي أنه ليس مجرد خطأ مطبعي يحدث مرة واحدة)، وغير ذلك من الأخطاء التي تنبّه القارىء إلى وجود خلل ما في الترجمة التي كانت تحتاج إلى مراجعة من قبل من له علاقة بالسياق الثقافي التركي، والأفضل من ذلك هو الترجمة من اللغة الأصلية بطبيعة الحال.
في هذه الحالة بالذات يجدر بدار النشر أن تسحب هذه الطبعة وتعيدها مرة أخرى بعد مراجعة الترجمة وتصويب الأخطاء الكثيرة.
ضفة ثالثة