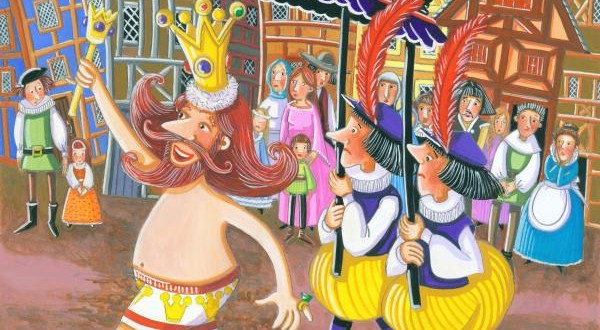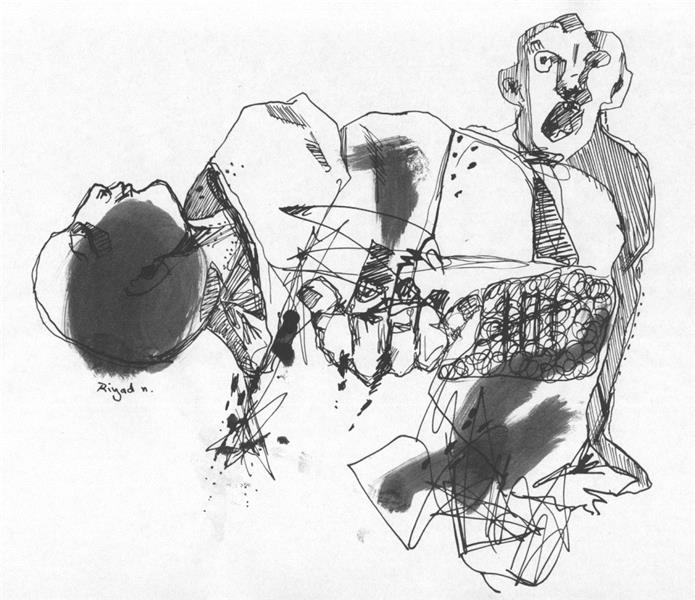دفاعاً عن الشعراء
روجيه عوطة
لأنهم يكتبون من عرق جبين الموت. لأنهم يسايرون النسيان المحشو بأعباء طفولة قذفت بهم إلى هاوية مقلوبة، فيها يصرخون بصمت، يضجّون بهدوء، ويحفرون قبوراً لا تتسع سوى لأجسادهم التي اقتلعها الضوء من رحم مسمومة بالإنشداد إلى نعاس أبدي سمّوه الطمأنينة.
لأنهم أصدقاء الأنبياء المنبوذين، المطرودين، المشنوقين على منصّات الحلم، رغبةً بحياة تستحقهم وتستحق تطهيرهم الأرض والسماء من أساطير الخطيئة. لأنهم يستيقظون على عجل، يلبسون على عجل، يصادقون على عجل، يعشقون على عجل، وعندما تقرع نعوشهم كالأجراس الصدئة يتأخرون عن مواعديهم، فتضطر النهاية، أو البداية، إلى خيانتهم واصطحابهم إلى الضفة الأخيرة بعد أن يطعنهم سكّين الوقت من الخلف. لأنهم شعراء، وهذا يكفي، يحقّ لهم ما لا يحق لغيرهم. من حقهم التكاسل، التأمل، الكتابة، التفرغ للشعر، والإمتناع عن العمل إلى حد التسكع الدائم على أرصفة الأوراق والطرق. كسل الشعراء أبو جميع قصائدهم وحق من حقوق هؤلاء الكادحين الذين ينطبق عليهم القول الفرنسي: “الكسول الحقيقي عامل بارع متقن. ينجز أعماله بسرعة ودقة حتى لا يضطر إلى إعادتها لاحقاً”.
البستاني في ماخوره
مع أنه أكثر الشعراء كسلاً، لنقل هرباً من “حياة الوقت” إلى “وقت الحياة”، لا يقبل بودلير أن يستسلم للكسل. صحيح أنه كان من روّاد المواخير، وأمضى فترة طويلة من حياته يتعاطى الحشيشة والمخدرات، لكنه يعتبر أن الكسل نوعان، نوع إيجابي، منه يُخلق الشعر، ونوع سلبي مقرون بالغبطة والتفاؤل بلا أيّ ضرب من ضروب الخيال الخلاّق. الشاعر “عصابي كسول” بالنسبة الى كاتب قصيدة الحشيشة، ومن الضروري أن يختار بين رعب الحياة ونشوتها، أو بين الموت الرقيق، الساكن، والهادئ، والموت الخلاّق، الجدلي، الذي تنبجس لذة الحياة منه. كالعادة يضعنا بودلير أمام رؤيته الشعرية الانفصامية، نتيجة أزمته النفسية، ومرضه السكيزوفريني الذي أصابه منذ طفولته مع موت والده وزواج أمه، و”فشله” الاجتماعي المتكرر. حوت قصائده ونصوصه رموز الكسل، وعكستها بانفصام جوّاني تتجاور الخطيئة فيه مع الطهارة، المحدود مع اللامحدود، والقبح مع الجمال، والسوداوية مع السعادة، والحزن مع الفرح. ما خلق استيطيقيا “حدّ السكين”، ومتعة المرآة المكسورة التي تعكس الوجه بخفة مبهمة، “الغموض والحسرة من سمات الجمال أيضاً”. تنطبق الرؤية الشعرية هذه على أسطورة الخلق، بحيث نقرأها في المرآة البودليرية لتظهر لنا علاقة التكاسل بين حواء التي قطفت التفاحة وآدم الذي التهمها من دون القيام بأدنى حركة تشير إلى عمل ما، كأن كسله سلبي غير خلاّق، على عكس حواء الخلاّقة وكسلها الذي احتكّ بأفعى الخيال وأربك سكون الفردوس الذي يطرد منه كل كائن يتخيّل رغماً من كسله، مهدداً حديقة الخمول، أي الجنة، بالفوضى والإنهيار. حواء في مرآة بستاني “أزهار الشر” أكثر شاعرية من آدم الذي أكل ربما من شجرة الخمول المرادف للخلود في الجنة قبل أن تطعمه الكسولة الخلاّقة من ثمار “شجرة المعرفة”، ويعاقبه إلهه بلعنة العمل الشاق والحرمان من ألفة النعاس الذي يمارسه بودلير جيداً في حديقته البحرية، وبستانه الشعري الشاسع. البحر بالنسبة إليه مساحة التكاسل المريح، التي تصطحب الشاعر إلى الماوراء، وإلى عالم بعيد “عن المشفى حيث كل مريض تتملكه رغبة تبديل سريره”، ورغبة عبادة الوقت الذي “استأنف ديكتاتوريته الفظة” في رعاية الإنسان الغارق في لهوه العصابي في كل دقيقة يعتبرها الدقيقة الأخيرة وعتبة العبور إلى التراب غير المبلل بمياه البحر، هذه الساعة “الضخمة، المهيبة، الكبيرة مثل الفضاء”، و”الخفيفة كتنهيدة والسريعة كنظرة” الى حديقة الكسل ذات الطاقة واللذة اللانهائية التي تعتري الجسد مثل “بحر في بحر” أو كـ”حلم حجر” من حجارة غرفة باسكال الذي اكتشف أن “كل مآسي الإنسان تأتي من شيء وحيد، أنه لا يعرف كيف يسكن مرتاحاً في غرفة” ينقّب داخلها عن المجهول. تنقل بودلير من ماخور إلى آخر، وتالياً من قصيدة إلى أخرى، منقّباً عن جنّة الكسل الخلاّق كي يلحق الهزيمة بعزلته، بـ”الشبح المرن” الذي لاحقه في كل أيام حياته.
مقارعة العدم الطائش
لكل شاعر تجربة خاصة في التكاسل، أبولينير الكسول في “الفندق”، نيكولا بوالو في رسائله، غوتييه، هوغو، ميشو، بريفير، وغيرهم من الشعراء هجروا الوقت وتفرغوا لتمزيق غشائه عنهم والتخلص من كسل أجسادهم ونقله إلى شخصيات النصوص أو إلى القراء.
يشترك كل واحد منهم في العمل مع الآخرين في أرجاء الإمكان بحسب تجربته الخاصة ومعادلاته الشعرية التي تتبع صياغات الآنية في الحياة ودروبها الرمزية أو التي يحبّرها الشاعر رمزياً. كلما انشدّ جلد الرمز، أخفى الشاعر تجعد لغته واستقام في دربها ليصيبه دوار شعري ويهبط جسده على “كنبة يونيسكو”، حيث كان هذا الكاتب المسرحي، الشاعر بعبثيته، يتمدد كي يكتب نصاً أو يقرأ. ينتهي الدوار على درب الرمز بتطابق الحلم مع الجلد في لحظة تكاسل، يتماثل الشاعر فيها مع رغبته التي تدمث القصيدة وتنيرها ببقائها معلّقة فيها. لا يلتحق كل قارئ بدوار الكسل إلا إذا سار على الدرب الرمزي الذي اتبعه الشاعر قبله، وتيقن من خفته في قراءة الكلمات والتحقق من المزاج الذي يجري في فضائها.
تثير القصيدة الأكثر رمزية عاصفة من الكسل في رأس القارئ وتدفعه إلى الجلوس متأملاً فيها ومفككاً مفاصل رغبتها المتفرعة والمتقاربة في نظرة أورفيوس التي أفقدته حبيبته ونفته إلى دوار الشعر مقترباً من التعبير عن محنة فقدانه أوريديس في ظلام الجحيم.
لم يجهل أورفيوس حقيقة كسله، “إنه يموت دائماً” و”يزول في قلق الزوال” وقلق الشعر الذي يجبره على “الموت أكثر منا بقليل” وعلى التكاسل أكثر منا بقليل كي “يقول”، وما القول سوى “حركة الموت النقيّة” بحسب موريس بلانشو، وما الخمول سوى رعونة العدم والاختناق النصفي في متاهة الكلام عن الموت المخفف بزوال الشاعر، الذي كان عليه أن يذهب ليرى “الحياة من جهة الموت”، على قول عقل العويط، أو يتلصص عليها من جهة الكسل. يكتب الكسل قصيدته الخاصة به، وتالياً يخضعها لميتافيزيقاه التي تتجاوزها المدلولات بتحررها من صمتها اليائس وعبء التعارض بين شكلها وباطنها المتحقق في دال يُراد به وضع الشاعر وجهاً لوجه أمام ذاته واستخراج العابر من حضوره في النص، وتأسيس وجود جديد به. “أن يصير الشاعر ذاته، تلك هي الحياة، وما نحن إلا الحلم”، يقول هولدرلن، إذ تزيل قوة المعنى الشعري الحدود بين الحلم والحقيقة، وتماثل بين الإثنين في عالم الشاعر وأرض الكسل الراسخ فيها.
يحيا الشاعر كسله على دروب الترميز المضاءة بحرارة رغبته التي تتأهب، بعد هبوط صاحبها في الدوار، لمقارعة العدم، فيسخر الكسل من الموت مثلما يسخر منتصف الليل من الليل وسواده.
التقنية والكسل وجودي
بعدما سيطرت التقنية على عالمنا الحديث، أصبح من السهل أن ننجز مهماتنا بسرعة من دون اجتياز المسافات. على رغم ذلك ما زلنا نشعر بضيق الوقت الذي لا يترك لنا فسحة للتأمل والتفكر في أمورنا الحياتية البعيدة من روتين اليومي و”مونوتونيا” الوظيفة والعمل الذي اعتقدنا أننا سنحصل على الراحة بعد إنجازه. إذاً، لم نستفد من التقنية إلا في تسريع وتيرة عملنا وزيادة إنتاجنا الاقتصادي من ناحية، وإصابتنا بالخمول والكسل من ناحية أخرى. فضلاً عن تحكم الآلة والبرامج الإلكترونية بحياتنا التي أضحت أوتوماتيكية وافتراضية أيضاً. انعكست أزمة الإنسان الحديث هذه على القصائد المعاصرة، التي يربط أصحابها بين التقنية الأوتوماتيكية والقلق، والكسل الوجودي الشبيه بضجر شعراء القرن التاسع عشر. نقرأ في كتاب فادي ناصر الدين الأخير، “أبيض حكي الرحمن”، قصيدة بعنوان “فيتامين سي”، يتحدث الشاعر فيها عن ولد كسول مترنح يتمدد على الكنبة، “حامل الريموت وعمينتشي من الموت”، متعباً من الكلام والنوم، ومنتظراً انتهاء وهم الحياة. في كتابه “سيرة عاطفية لرجل آلي”، يكتب فيديل سبيتي: “تصل عارضة الملابس، نحيفة وممتلئة الصدر إلى حافة الشاشة ثم تعود إلى الكواليس. يقول إن التالية ستخرج من التلفزيون لا بد، ولكنها تعود على أعقابها. لن يستسلم، لا بد أن إحداهن ستقرر الخروج من الشاشة لتلاقيه إلى كنبته. لا بد أن هذا سيحدث في يوم ما”. من يتتبع مسيرة سبيتي الشعرية في كتبه الثلاثة يلاحظ مدى الكسل الذي يعبر عنه في قصائد تُشعر القارئ بطاقة الضجر الإنتحاري، المقرون بصور بسيكولوجية متشعبة يخفيها الشاعر في داخله.
سعى العديد من الكتّاب إلى استثمار قوة الكسل في نصوصهم الأدبية، كمارسيل آشار الذي نصح الكتّاب المسرحيين بأن يتكاسلوا في كتابة المسرحيات، ومارسيل جوهاندو الذي رأى في العبقرية كسلاً متنبهاً لذاته، وأندره جيد المتحدث عن توهج الكسل وخبثه، وكسول الحيّ اللاتيني الروائي الفرنكوفوني ألبر قصيري الذي كتب من وراء طاولته في مقهى الضجر و”العطالة” الخلاّقة، متأملاً في سكان “بيت الموتى المحتوم” وتنابل المدن الهشة، وغيرهم من الأدباء الذين عرفوا أين ينتهي تأملهم ويبدأ كسلهم غير الخلاّق.
للتخلص من كسلي أعترف به. منذ مدة وأنا أصارع الخمول الذي يعتريني عند كل صباح خريفي، ويدفعني إلى تأجيل أعمال أو زيارات عليَّ القيام بها، أو نصوص يجب أن أستكمل مراجعتها قبل أن أبدأ دروسي الجامعية. لذا قررت أن أستفيد من قوة كسلي وأكتب عنها كي أطمئن أنني لست الوحيد يستيقظ مبكراً، يحضر فنجان قهوته على مهل ويجلس متأملاً في حديقة منزله الريفي أو قارئاً في كتاب ما، ثم ينتقل إلى حياته الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي ويقرأ ما كتبه أصدقاؤه، لا سيما الكسالى منهم، متذكراً ما قاله برتراند راسل “الوقت التي تستمتع بإضاعته ليس وقتاً ضائعاً”.