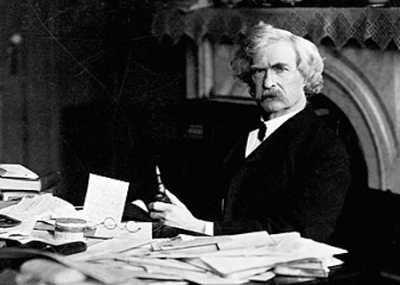ذلك الباب الذي فتحته لي/ رشا عمران

كي أصدق أنك رحلت، فتحت النوافذ التي أغلقناها طوال وجودك، وأبعدت الستائر السميكة، وتركت للهواء أن يدخل بغباره، وجلست على الكنبة الصغيرة التي كانت تتسع لنا معا. أمامي الرفّ الذي وقفتَ أمامه طويلا، وأنت تقلب الكتب، باحثا عما يعيدك إلى هناك، إلى الزمن الذي تعتقد أنك منه أتيت! ذلك الزمن، ووجودك اليومي فيه، هو ما يجعلك الآن تحب نساءك اللواتي انتهيت منهن، أكثر مما أحببتهن وهن واقعاً وحاضراً في حياتك. حولهن الزمن إلى تاريخٍ مضى، وأنت المهووس بالتاريخ، الشغوف برموزه، الباحث عما يعيدك إلى هناك، في الأسماء، في الأشكال، في الانتماءات، في الهندسة، في الفن، في الزرع، في اللغة، في الغناء والموسيقى. كلما أوغلت في عمقه أكثر أشرق وجهك وتوسعت ملامحه، وكنت أراقب عينيك، كيف يزول حزنهما شيئاً فشيئاً، أراقب وجهك يستدير ويشرق كأول الفجر، أراقب نبضك يتسارع ويهدأ، وأنت تأخذني معك، ونمشي في ذلك العالم الغريب.
كنتُ كما أليس، أخرج من الباب إلى عالم العجائب، ثم أبدأ بكتابة الحكاية، أوصلتني إلى الزمن العتيق، إلى حيث نشوء الإنسان الأول، جعلتني أعيش في ذلك الزمن، وكنت أغافل غيبوبة حديثك، وأشرد قليلا، أتخيلني معك هناك. أنا وأنت نتدرّج في التاريخ البشري، بانقلابات جسدينا وتطورهما وتحولهما، من صعودهما في عالم الزواحف إلى اعتداد الآلهة بفتوّتها وغرائزها وشهواتها وشبابها الذي لا يقربه الشيب والعجز. دخلت معك مملكة الموت. كتبنا كتاب الموتى، ولعبنا لعبة الحياة، شيدنا هرمنا الخاص، وأنرنا مناراتنا العالية، ثم بنينا معاً برج بابل، واخترعنا أول حرفٍ بأبجدية أوغاريت، وكنا قبلاً قد اكتشفنا النار، النار العظيمة التي أحرقت جسدي وأعطته ألوانه الحالية.
زرعنا معا أول حبة قمح، حبة القمح تلك التي تركت لها لون وجهي، وأعطيتُ لها من روحك لتطيب. انتظرتك عند باب السواد، حيث الداخل إلى هناك لا يعود، لكن انتظاري لك أعادك. شغفي بك أعادك، وحين عدت عادت دورة الحياة إليها، وارتدت عادتي إلي، وصرنا أنا والحياة نلد بعضنا، ألدها وتلدني، تلدني وألدها، وكانت غايتها أن تنتج نفسها ليستمر الكون. وكانت غايتي أن أنتجها لأستمر معك، لكنك لم تنتبه إلى شرودي في عالمك، لم تعرف كيف دخلت فيه معك، كان علي أن أخبرك، لكنني فضلت الاستمرار في صنع حكايتي معك فيه وحدي. وهكذا، أنت تحكي لي، وأنا أشدك من يدك لنكمل اللعبة. صنعنا الأختام الأولى. أنتجنا أول خيوط الحرير، بنينا السفينة الأولى، وبها ذهبنا لنعرض ما أنتجنا، أنا وأنت من أشفق الطوفان علينا وتركنا. هل أشفق فعلا!؟ أم أنه لم يستطع جرفنا، فنجونا وبقينا إلى الآن لنحكي الحكاية؟!
أعرفك منذ ذلك الوقت، منذ ذلك الزمن أعرفك، ملامحك نفسها، جسدك بالرائحة نفسها، جلدك بالطعم نفسه، أنفاسك بالحرارة نفسها، لأصابعك الملمس نفسه، واللكنة نفسها لصوتك، اللكنة الحزينة حتى في أقصى ذروة إشراقها، اللكنة التي كما لو كنت منذورةً لها، منذ فقدتك ذات مرة أول الزمن، ومنذ فقدتك وأنا أبحث عنك. آلاف السنين وأنا أبحث عنك، مئات العصور وأنا أبحث عنك، بحثت عنك في المعابد، في الهياكل، في القلاع القديمة، في الأسواق، في الحمامات، في الفنون، في الشعر، في الكتابة، على خشبات المسارح، على المدرجات الحجرية، في البحار، في الأنهار الكبيرة، وتلك الصغيرة أيضاً، ويا للغرابة أين وجدتك أخيرا!
أنت وجدتني، مددت يدك التي أعشق طريقتها بالإمساك بي وسحبتني، ثم صنعت لي هذا الحب الذي أعيش فيه كل يوم، وعلي الآن أن أصدّق رحيلك، علي أن أجلس وحدي على الكنبة الصغيرة التي كانت تتسع لنا معا، وأراها تضيق بي. سريري الذي كان لنا معا يضيق بي. بيتي يضيق بي. مدينتي تضيق بي. علمي يضيق بي، وحدها روحي تتسع وتتسع وتتسع، ثم تستحضرك كل لحظةٍ، كي لا تضيق حياتي بي.
العربي الجديد