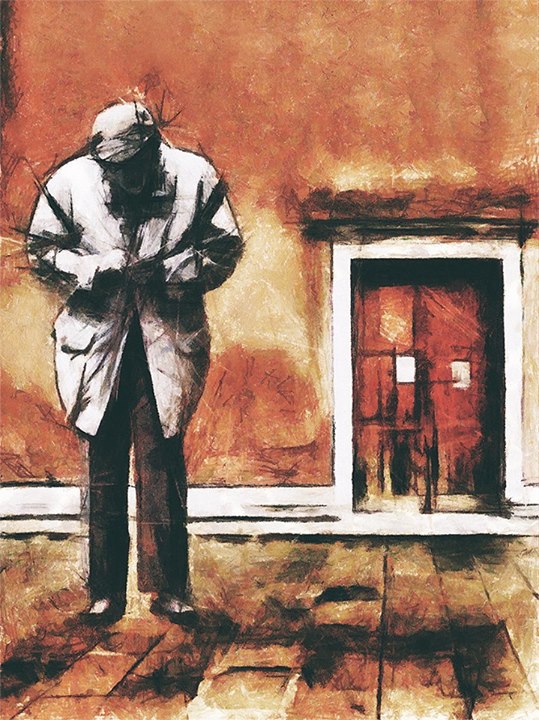ربيع الشام ما خبا يوما
باسل ابو حمدة
ربيع الشام ما خبا يوما.. هنات مرت، لكن توتها الوردي لا يتوقف عن كسب قلوب مزيد من العاشقات والعشاق يتحلقون حول عربات البائعين المتجولين الذين جالوا المكان وما برحهوه، هاهم تعبق حارات دمشق العتيقة برائحة توتهم، توت شامهم، توتهم الشامي الذي وإن بدا مراً ذات مرة لن يبقى كذلك دوما.
في شام تسعينيات القرن الماضي، همس صديقي الشامي بأذني بمثل شعبي شامي ربما إختزل آنذاك في ظل تكميم الأفواه والرقابة المشددة على القلوب قبل العقول حقبة كاملة عنوانها القمع والقهر والاذلال.. حقبة بدت حينها سرمدية بلا نهايات في عيوننا جميعا نحن الذين حللنا ضيوفا على خضرة غوطة الشام وفاكهتها الفواحة وبياض عرائش الياسمين في عمارتها ومياه ينابيعها الباردة المنحدرة من ريفها الغربي والمحملة بدفئ المتوسط وإعتدال بيئته.. حقبة طالت وما بدلت إيمان أهل الشام بشاميتهم ولا بشامهم بأزقتها وأسواقها وسراديقها وخاناتها التي تبدلت الوجوه عليها وما تبدلت.
‘ لكل واحد عشرة أيام’، عبارة أدهشتني وسيرت القشعريرة في شراييني ولم تقنعني وأنا أراه وأرى نفسي في قبضة طاغية، لكن صديقي الشامي غير المسيس والغارق في تجارته وصــــناعته حتى النخاع كان يرى ما استعصى على رؤية النخب المثقفة بكل أنواعها والتي راحت تتكيف مع ذلك الواقع الفريد وكأنه سيدوم إلى أبد الآبدين، فهل كان صديقي الشامي قد وضع يده قبلنا جميعا على سر بقاء مدينته الشامية مأهولة على مر التاريخ؟ أم أنه كان يعبر عن ثقته بنفسه وبأبناء جلدته وقدرتهم على إستعادة شامهم من تلك القبضة؟ لكن من أين جاء بكل تلك الثقة بالمستقبل وبكل ذلك الوضوح في رؤية تشي بأن الشام لأهلها مهما تعرضت لمحن وويلات؟.
الآن وبعد أن انحسرت قبضة الجلاد ولو قليلا عن شام صديقي وبدأت دمشق تستعيد شيئا من زهوها، تختلط المشاعر التي تراودني ما بين رغبة جامحة في عناق صديقي الشامي وتهنئته على رؤيته السديدة وعلى استعادة مدينته وما بين شعوري بالخجل مما إقترفناه بحق الشام حين سلمنا بتبعات تلك الحقبة التي رحنا نقيس كل تفاصيل حياتنا وحياة من يحيطون بنا على قدها، لكن الواضح والذي لا لبس فيه هو أن ابتسامة نبيلة تنطبع الآن على محيا صديقي الشامي، لا لشعوره بنشوة انتصار وإنما إنتصارا لشاميته التي لم تخذله يوما في مدينة لم تغلق أبوابها السبعة في وجه ضيف أو مستغيث، لكنها أوصدت قلبها أمام طاغية أمهلته ولم تهمله حتى أزفت ساعة الرحيل مع إنتهاء أيامه العشرة.
كأنها قراءة في فنجان أو لنقل كما يحب المثقفون الماركسيون أن يرددوا: إنها الحتمية التاريخية بلا رحمة لا تعترف بدوام الحال مهما طال ومهما حاول الطغاة لي عنقها وحرفها عن مسارها واستبقائها وديعة لديهم في أقبية أجهزتهم المخابراتية جنبا إلى جنب مع نزلاء تلك الأقبية التي أكلت من لحومهم وهم أحياء يتفرجون على بلاد نخرها سوس الفساد وآفة الظلم ووباء الجريمة المنظمة ومصادرة الحريات وسرقة لقمة العيش من أفواه الفقراء والمستضعفين في الأرض. كانت نفوس أهل الشام تشحن بمشاعر الخذلان، كانوا يشحنون أنفسهم بأنفسهم، حتى أزفت الساعة ودقت ساعة البوح، فكانت المواجهة الأولى في قلب الشام، في ساحة الحريقة التي لم يتردد صديقي الشامي وأمثاله من تجار الشام بعائلاتهم العتيقة عتق أحياء مدينتهم وساحتهم التي سميت كذلك على اسم الحريق الكبير التي أتى في زمن غابر على جل أحيائهم وأسواقهم، التي تفوح منها رائحة منتجاتهم التقليدية وكأن لسان حالهم يقول: فليأت الحريق هذه المرة أيضا طالما سينبلج منه فجر شامي جديد يتكفل بعودة الابتسامة إلى وجوه أطفال الشام بعيد عن مفردة القائد الأوحد والزعيم الخالد لا لشيء إلا لأن قاموسهم الشامي لا مكان فيه إلا لتفتح الياسمين في صباحات شامية متهادية تتراقص على أنغام أصوات تتعالى مع تقدم نهارات الشام.
الشام لا طاقة لها على اللون الواحد، إعتادت التنوع، يطرب أهلها وزوارها على صخب أسواقها وتداخل دور العبادة فيها وتشابك اللهجات المحكية في جنبات نهاراتها وقرقعة القبابيب في حماماتها بتلاوين عمارتها ومناشف روادها والياسمين الطافي على سطوح بحيراتها.
الشام ترحب بالجميع، لكنها لا تنسى أن تغربلهم وتلفظ المارقين منهم، الشام لا تنكر تاريخها ولا تستحي من تعاقب الأمم والحضارات على مسبحة ذلك التاريخ، وتعلن على رؤوس الأشهاد أن مسجدها الكبير بمآذنه الأربعة لم يكن كذلك على الدوام وأنه كان غير ذلك تماما في حقب أخرى مرت ولم تندثر بل شكلت إضافة لبنيانها ولعاداتها وتقاليدها وكرم أهلها ورحابة صدورهم، لكن الشام طردت غزاتها وسراق ضحكات أطفالها.
الرغبة جامحة لمطالعة وجه صاحبي في مقهى النوفرة وعراقة المكان بادية في عينيه الزرقاوين الصغيرتين، أراه يدعوني إلى هناك لا ليذكرني بالمثل الشعبي الواشي، بل ليقول لي إن هذه هي شامه لم تتبدل ولا تزال قادرة على الابتسام رغم سواد حقبة طالت وكثرت أوجاعها، لكني أرى بوضوح تساؤلا يكاد يقفز من تقاسيم وجهه الطفولي، تساؤل لا ينتظر له إجابة، لكنه يبقى مفتوحا على انسانية الانسان وعلى البديهيات والمسلمات مفاده أن من يدكون أحياء الشام وأسواقها من المؤكد أنهم لم يتذوقوا طعم توتها المتورد ولم تتمكن روائح الياسمين والزهورات من اختراق خياشيم أنوفهم السميكة وأن نظراتهم وقفت عاجزة عن التقاط كنه أزقتها الظليلة، ما حال دون أن تتحد نبضات قلوبهم مع نبض قلب الشام، فبقوا جاهلين بها لا يعرفونها وهذا ما يفسر سلوكهم العدواني اتجاهها وعدم مراعاة خصوصية أبنيتها العتيقة التي دخلت التاريخ منذ زمن بعيد قبل أن تخلق منظمة مثل منظمة ‘اليونسكو’.
المؤكد أو ما بات كذلك هو أن المارقين على الشام لم يحظو بسماع صديقي وهو يتلفظ بالمثل الشعبي واثقا مما يقول في وقت مبكر، فلو تسنى لهم ذلك، لكان بمقدورهم استيعاب معادلة صاحبي الشامي، ولكان بوسعهم فهم سياقات مدينة فتحت لهم ذراعيها لكنهم تنكروا لجميلها لم يتوانوا في محاولة بترهما مع كل منعطف كانت تمر به الشام ومعها البلاد والعباد جميعا، ولكان بمقدورهم جعل الأحداث التي تعصف بالشام تأخذ مسارا مختلفا يجنبها ويلات حرب باتت معلنة ويعفي أهلها من آلام إضافية لا لزوم لها، لكنه طبع الطغاة الذين تعميهم السلطة وتفقدهم أهلية قراءة التاريخ كما يجب وتقوقعهم في دائرة مغلقة تحجبهم عن الحقائق الساطعة التي يزخر بها.
‘ كاتب فلسطيني
القدس العربي