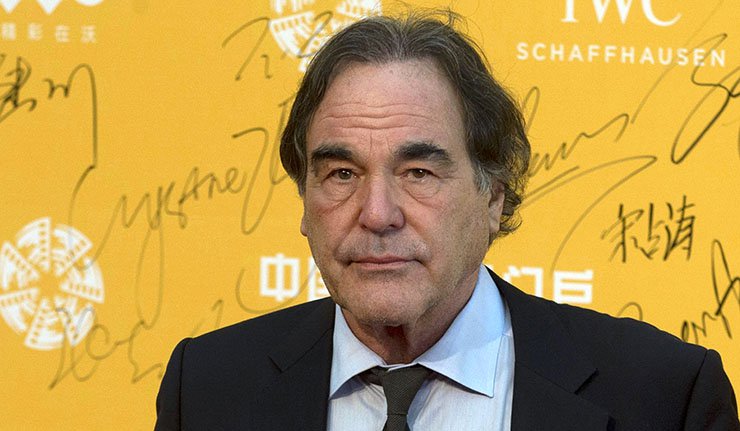ربُى الجمال: مناجاة حلب الأخيرة أو كيف يموت السوري رخيصاً قبل الحرب كما أثناءها!/ حازم درويش

السوريون الذين تلقى عليهم أسلحة كيماوية من قبل نظام يفترض أنه يحكمهم، لا يحتلهم، وتنام مدنهم الكبرى بخراب عميم واحتلالات شتى بلا سكانها الذين على مدى سنوات حرب النظام السبع الماضية على غالبيتهم، إما قتلوا أو لجأوا إلى خارج بلادهم أو في داخلها. هؤلاء السوريون على اختلاف أطيافهم وطوائفهم عاشوا على مدى أكثر من أربعين عاماً من حكم الأسدين الأب والابن خراب بلادهم وحيواتهم يوماً بيوم. وحاولوا لخبرتهم اليومية العميقة بكل أشكال المخابرات البيضاء-السوداء والملونة التي سلطها هذا النظام عليهم ألا يخسروا أقل ما بقي لديهم من صورتهم عن أنفسهم وألا يصلوا إلى هذا اليوم الذي سيقتلون فيه بهذا الدم البارد. لكن لم يمنعهم شيئ من أن يصلوا إلى كل ما هم فيه الآن. لا شيء تغير! كل ما في الأمر أن ما كان يحصل بالمفرق وبالخفاء بات بالجملة وعلناً! ربى الجمال، مطربة حلب التي تحلّ ذكرى وفاتها المهينة الثالثة عشرة هذه الأيام “فشلت في محاربة طواحين الهواء هذه كلها” على ما يروي حازم درويش في نصه عن حياتها و”مقتلها” اللذين يقولان كيف أن السوريين كانوا لا محالة ذاهبين إلى هذا الموت الرخيص الذي يحدث لهم الآن.
على المسرح الآن تقف غير راضية، الصالة ممتلئة بالمدعوين، لكنها لا ترى أحداً. مرة جديدة ترى نفسها مرغمة على فعل شيء لا تريده. شيء أقل بكثير مما تتوقعه من نفسها أو ترتضيه لها. ألحوا عليها لتصور أغنيات ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، يقولون إنها فقط بهذه الطريقة ستحقق نجومية لطالما بحثت عنها وانتظرتها. لكن من يفهم حقاً ما كانت تبحث عنه وتنتظره طيلة حياتها؟ كيف ستعيد الشرح لهم كل مرة من جديد؟ لا تظن أنهم في وارد الإصغاء، ثم إن الزمن زمن مسايرات وبيع وشراء ذمم ومصائر من تحت الطاولات ومن فوقها، وتدبير “لقمة عيش” تتحول أحياناً في لمحات بصر وتدليس وتنازلات بين الأبواب وخلف النوافذ المغلقة، إلى ثروات يعيش بها أصحابها موفوري النعمة ومرتاحي الضمير حتى من دون كرامة، حتى لو أصبح عنصر مخابرات صغير يمون بكلمة أو برصاصة على سوق بكامله في مدينتها أو على صوت وفرقة ونجومية. إذاً على من ستقرأ مزاميرها؟ ألم تفعل ذلك مراراً؟ الآن باتت هذه السيرة تضايقها أكثر من الماضي، إذ لا هي استطاعت أن تغيّر نفسها، على جزيل ما عانت وخبِرت، ولا الزمن عاد في مصلحتها أو في مصلحة ثقافتها وما تمثله. هل ستظلّ تحارب طواحين الهواء هذه كلها؟ هل ستستطيع ألا تفعل؟ مشكلة من هي أنها رُبى الجمال؟
ارتضت كحلّ أخير أن تؤدي أغنيات ألبومها الجديد هذا في حفل مصوّر، تظلّ خلاله واقفة أمام فرقة موسيقية مكتملة. هكذا ترى نفسها وصوتها، هكذا ترى مكانتها. أقل من ذلك صعب، لا بل مستحيل. لا هي تقدر على أقل من ذلك، ولا المدينة التي جاءت منها تغفر لمن يرضى بأقل من ذلك. معيار الطرب واستحقاق النسب إليه في حلب صعب جداً، مرّ. ربُى تعرف ذلك جيداً أكثر من غيرها، لا بل لربما هي الوحيدة فقط التي تعرفه. الحلبيون لم يهزمهم موسيقياً في زمن آخر غير أم كلثوم، لم يعترفوا بأحقية موسيقية من خارج حلب إلا لها، ولم تكن فطنة الحلبيين في أم كلثوم في صوتها فقط، بل في وقفتها الصارمة على المسرح، وفي استبدادها الفني مع ملحنيها وعازفي فرقتها أيضا. ربُى تعرف هذا كله. كيف ترضى بأقل منه؟ كيف تظلّ ربُى؟ كيف تصل إلى مكانتها التي صالت شرقاً وغرباً لتأخذها، بمعية مخيلة حلب عن الطرب، وبمعية ما كانته حلب يوماً ما وضاع بالجملة والتفصيل، ولم يبقَ منه إلا تفاصيل متناثرة، ومحاولات منهكة كربُى وصوتها وكآخرين، بدا لهم أنهم ينفخون في قربة مثقوبة لتدارك أقدارهم وأقدار المدينة، لكنهم لم يستطيعوا أن يتوقفوا؟
عزف الفرقة على المسرح يتواصل، تحاول أن تسايرهم ولا تستطيع، الأخطاء التي لاحظتها أثناء التمرينات قبل الحفلة كلها تفاقمت، تشعر بأنها مقيدة، مستهدفة. أين كل ما تخيلته لنفسها ولصوتها ولأغانيها؟ تريد أن “تسلطن”، لكن لا شيء يساعدها على ذلك، ولا حتى تصفيق الحاضرين أو حركة يديها المتمايلتين بتأفف وحسرة. الحفل يهبط عن الصورة التي رسمته لها كل لحظة أكثر. كيف تظل واقفة هنا؟ تذكرت حفليها في حلب في نادي الحرية خريف 1997. على رغم كل ما حققته من ألق على مسارح باريس وقرطاج ودار الأوبرا في القاهرة وفي حفل فندق صحارى التاريخي الذي غنت فيه “اسأل روحك”، ظلت حفلات حلب وبخاصة تلك الحفلتين هي ما يصالحها مع كل هزائمها ومحاولاتها لتكون ما أرادت أن تكونه. في تلك الحفلتين، الحلبيون يسمعونها “على الأصول”، أصولهم، فيعينونها لتكون قريبة أكثر من الصورة الكلثومية المشتهاة إياها، وتظن معهم أن هزيمة المدينة وثقافتها وناسها، التي بدأت قبل أكثر من قرن، والظلامية في زمن عبد الناصر، والمذلة المهينة في زمن ثمانينات آل الأسد الأسود، ليست قدراً نهائياً ولربما هم ذاهبون إلى تجاوزها. هل يستطيع الحلبيون ذلك، هل يتمكن صوت ربُى من مساعدتها على دفن هزائمها الشخصية وهزائم حلب المديدة أيضاً؟ هذا كثير على صوت. كثير على ربُى، لكنها لا تستطيع شيئاً غيره. يعود إلى مخيّلتها الآن ذلك الشاب الحلبي الذي حضر حفلي نادي الحرية وأهداها في نهاية الثاني وردة حلبية “جورية” على ما يقول الحلبيون، وردة حمراء خمرية، أخذتها، زرعتها في صدرها وغنت له “اسأل روحك” كما طلب. فقط لأن عينيه لم تتزحزحا عنها فيما كانت تغنّي في الحفلين. كيف تكون في حضرة ربى وصوتها وتتلهى بتفاصيل أخرى عنها؟ هذا ما لا تملك ربُى جواباً عنه. لذا تتعاظم خيبتها الآن من حفل هذا المساء في الشام ومن الفرقة الموسيقية، فتترك الحفل إلى غرفتها مصدومة وهي تحاول ألا تصدق أن حلب وذكرياتها بعيدة، وأن هذا كله الآن في الشام يحصل لها ولصوتها ولصورتها، هنا على المسرح كما حصل خلف الكواليس قبلاً، على الحقيقة لا المجاز.
في غرفة الفندق تحاول أن تفهم سبب هذا الذي يحصل لها. ليس باستطاعة المنظومة الإعلامية/ الأمنية في هيئة الإذاعة والتلفزيون في دمشق تحمّل ربُى الجمال كما هي، شخصيتها وصوتها وخلفيتها الحلبية الأرمنية أشياء أكبر بكثير من أن تهضمها عقول ونفوس العاملين في دوائر التلفزيون السوري العائشين من خير النظام وعلى نعمته. يريدون لها أن تستسلم وكان هذا الحفل محاولتهم الأخيرة. هذا بات واضحاً وحقيقياً لها الليلة أكثر من أي وقت مضى، وبات واضحاً أيضاً أنها لن تستطيع أن تقاوم أكثر. فكرتها عن صورة تريد الوصول إليها وتريد بها دوماً العودة إلى حلب، تهشمت أيضاً. انهارت ربُى تماماً!
لم تنته تلك الليلة بها إلا في المشفى حيث ستعالج من نوبتها العصبية التي ألمّت بها في الفندق، ثم ستنقل إلى بيتها. النوبة هدأت في البداية، لكن زوفيناز (الاسم الحقيقي لربُى) غادرت مكانها وزمانها اللذين تعيشهما في 2005 استردت اسمها وعادت مرةً أخيرة بذاكرتها إلى حلب.
ذكريات دار الأيتام مع شقيقتها في الستينات، البرد الذي أذاب قلبها وعظامها. العجز الذي يلفّ المدينة وناسها بمن فيهم الأرمن حولها بعد أنّ هشمها عبد الناصر وتلاميذه السوريون وحولوها إلى مستودع للدمى الصامتة. بدايات التراتيل في كنيسة الأربعين شهيد. انتظار عطف أم ميتة، لن يأتي. الهجرة المرغمة إلى بيروت مع أب قاسٍ ظهر فجأة، الهرب إلى الأردن للعمل في دير راهبات الوردية. ومن ثم وما أن تدخر مالاً قليلاً، العودة مجدداً إلى حلب. لكن حلب التي عادت إليها في أواخر السبعينات كانت قد أصبحت شبح مدينة. تغادرها بعد حفلات قليلة إلى الشام ثم من هناك إلى أميركا وباريس، تقاوم أقداراً لم ترها يوماً لها ولم تمنع عنها شغفها بالغناء لتتوج هناك في مسابقة دولية كأفضل صوت سوبرانو في العالم، ولكن أيضاً لينكسر قلبها مرة أخيرة في زواج أرادته أبدياً كاملاً كما فكرتها عن كل شيء، لكنه سرعان ما تهشم ولم يسفر إلا عن طفلها الوحيد.
برد! تفكر في هذا كله وهي في بيتها قرب دمشق الآن ولا تحس إلا بالبرد. برد يفتت العظام، ينهكها وصوتها. يختنق الصوت فيها. أين حلب الآن؟ تريد العودة إلى حلب. من يأخذها إلى حلب؟ تريد أن تنطق برغبتها هذه، بكل ما رمته خلفها وحاولت ألا يدمرها، لكنها لم تعد تسمع صوتها! فقدت قدرتها على النطق قي جلطة دماغية مفاجئة، فتنقل إلى مستشفى أول لن تستطيع تحمل تكاليفه، وتتنصل فيه جهات رسمية كثيرة من المساعدة بحجة أعذار مختلفة، لتغادره بعد أيام إلى منزلها ومن ثم إلى مستشفى آخر قريب أقل كلفة. هناك عاشت ربى لحظات وتفاصيل هزيمتها حتى النهاية. كل ما حاولته لحلب ولنفسها لم يجدِ. كان عليها أن تصدّق الهزيمة قبل زمن طويل، ألا تهرب منها، ألا تحاول شيئاً آخر. لم تستطع! أيضاً لربما حدست في صوتها وسيرتها ومحاولاتها بكل الخراب والموت الآتي بعد سنوات قليلة إلى حلب. وهو ما لن تتحمل أن تراه. لذا كان من الأجدى لها في تلك الليلة الباردة من أبريل/ نيسان ذلك العام، حتى وإن كانت ستدفن وحيدة في أرض الشام الباردة في جنازة لن يحضرها أحد، أن تغادر هذا كله مرّة وإلى الأبد، بصحبة صورة أخيرة لها في حلب مع وردة خمرية جورية، تضعها في صدرها فيدفأ القلب وتعود المدينة ومعها “زوفيناز” إلى نفسها وناسها.
درج