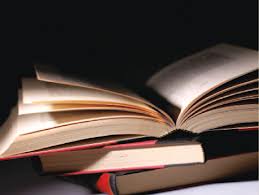سارقو الكتب/ ريبر يوسف

لم يَكُن الكاتب الأسترالي ماركوس زوساك قد أنجز آنذاك كتابة روايته (سارقة الكتاب)، التي تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي تمحور حول طفلة ألمانية اعتادت على سرقة الكتب بغرض بيعها، إلى أن تحوّلت فيما بعد إلى قارئة ذات أهمية داخل الملاجئ، إبان الحرب العالمية الثانية. عُرِفَ عن الطفلة تلك أنها كانت تقرأ للناس داخل الملاجئ لحظات القصف على ألمانيا.
بدأ السياق من القيام بتلك العملية المكروهة والممنوعة في تراث أغلب البشر، وهي السرقة، وقد حاول العديد من المفكرين والفلاسفة، بدءاً من دوستويفسكي ومروراً بفوكو وليس انتهاءً بالمخرج الألماني سيباستيان شيپَر، والذي قال: “أحياناً الجريمة تفيد”، إبان حصول فيلمه (فيكتوريا) على أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي، إذاً، حاول العديد من هؤلاء وغيرهم التطرق إلى الدوافع المتعددة، والتي تفضي إلى النتيجة عينها. فمثلاً، يمكن لأي من كان طرح هذا السؤال، هل ثمة رابطة ما بين شخص يسرق رغيفاً لحظة الجوع، وآخر يسرقه لتزداد أرغفته، وثالث يسرقه لأنه اعتاد على القيام بهذا الفعل؟ إذاً، لم يك آنذاك قد كُتبت رواية (سارقة الكتاب) عندما شاع بين مجموعات هائلة من الكتاب وغيرهم من عشاق الكتب والقراءة في مدن الحسكة والقامشلي وعامودا فكرة سرقة الكتب بغرض قراءتها ومن ثم تداولها وتدويرها فيما بينهم بغرض مطالعتها، كانت ثمة مهارة غاية في الدقة والحرفية لحظة القيام بذلك الفعل المريب، بل وصل الحال عند الكثير منهم إلى ابتكار وصياغة أدوات ووسائل جديدة للقيام عبرها بسرقة الكتب من المكتبات والمعارض التي كانت تقام هنا وهناك داخل تلك المدن وخارجها.
لكن لم تكن تلك العملية مفضية إلى جوهر وسياق شخصية اللص العامة، اللص الذي لا يوفّر شيئاً في طريقه إذا ما تيسّرت له سرقته، إذ أن هؤلاء الشباب كانوا يملكون الفكرة المنتمية إلى جوهر فكرة المجتمع من فعل السرقة عموماً.
يبدو أن ثمة دوافع لا متناهية وراء تلك العملية آنذاك، العملية التي جعلت كافة دور النشر تهاب هؤلاء القرّاء النهمين. كانت ثمة نشوة هائلة تلي نجاح أحدهم في سرقة كتاب من متجر أو معرض ما، كانت ثمة مباهاة مثيرة تدفعهم فيما بعد إلى الإفصاح عن طريقة السرقة تلك لأصدقائهم، بغرض تعليمهم تقنيات جديدة للقيام بذلك الفعل. لم ينل تأنيب الضمير من تلك المجموعات بعد إقدامهم على عملية السرقات تلك، كانت هناك سيكولوجيا تخصهم وتختلف عن تلك التي كان اللص العام يمتلكها، لا سيما أنهم لم يكونوا يستفيدون من تلك الكتب المسروقة مادياً، إلى جانب أنهم كان يتملكهم نوع من الفخر والتباهي على إثر ذلك.
لم يحدث، أو لم أسمع بأحد قد كُشف أمره لحظة قيامه بسرقة كتاب. يقول بعضهم: “كنّا نقدم على تلك العملية لأننا لم يكن بمستطاعنا شراء الكتب باهظة الثمن، والتي بكل الأحوال لم تكن أسعارها تتناسب ودخلنا، أي لم تكن هناك عدالة في وضع أسعار الكتب داخل مجتمع عاطل عن العمل وفقير، كما لو أن الحكومة، وبالاتفاق مع دور النشر كافة تقوم برفع أسعار الكتب لتبقى بعيدة عن متناول الطبقة الفقيرة في مجتمعات اغتالت أنظمتها الشمولية الطبقة الوسطى فيها”، ويقول البعض الآخر منهم: “كانت القراءة داخل مجتمع يبحث عن الخبز رفاهية، أي كيف لكائن يقدم على شراء كتاب في اللحظة التي كان همّ الناس فيها الحصول على الخبز وحسب”. ثمة من كانوا يتفقون مع سارقي كتب مجتهدين لسرقة بعض المراجع باهظة الثمن بغرض قراءتها والاستفادة منها خلال دراستهم الجامعية. حدث هذا قبل سماع الناس هناك بالإنترنت، أي في الوقت الذي كان فيه العلم والثقافة رهناً بالدولة الشمولية التي استوردت فيما بعد طابعات استخدمها الكتاب وعشاق القراءة لإعادة طباعة الكتب على أوراق مقابل مبلغ ضئيل من المال.
لم يكن بمستطاع الفقراء قراءة كتب كانت دور النشر والدولة تتسابق في جعلها باهظة الثمن، إلى الحد الذي كان ممكناً فيه شراء خاتم ذهبي بسعر ثلاثة كتب، في بيئة كانت تسلق القمح فتتموّن لشتاء مريب.
ضفة ثالثة