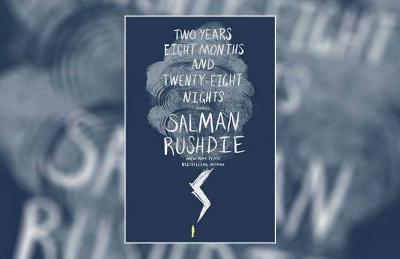سنان أنطون.. الأشياء قبل أن تتداعى/ نوال العلي
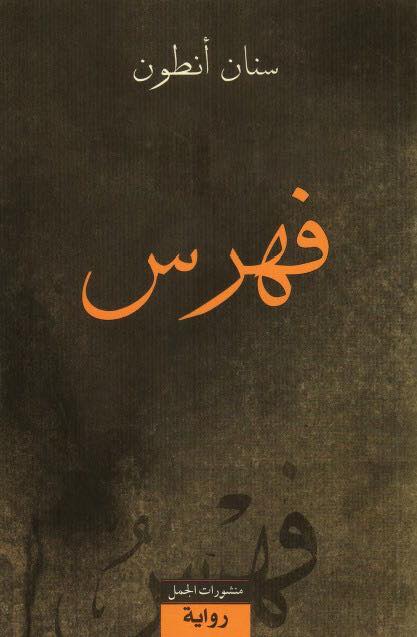
لم يتمكّن زوجان مهاجران في ألمانيا من زيارة كالينينغراد، مدينتهما الأصلية، إلا عجوزين بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. تجوّل الاثنان في المدينة، ولم يتعرّفا فيها على شيء إلا شاهدة قبر كانط والمطر الذي كان يهطل عليها، وبالصدفة عثرا على النهر القديم خلف الأبنية الجديدة، كأنه مختبئ خلفها، اقترب العجوز وانحنى على نهر بريغوليا وغرف بيديه من الماء وغسل وجهه ثم بدأ بالصراخ، لقد احترق جلده من ماء النهر المسموم. أحدهم علّق على هذه القصة قائلاً “يا للنهر المسكين!”.
عاد أكاديمي عراقي ترك بلاده عام 1993 – مهاجراً إلى أميركا – لزيارتها عام 2003، ظلّ يؤجّل زيارة بيته القديم في بغداد حتى اليوم الأخير قبل سفره. أخذ سيارة أجرة من ساحة الرصافي إلى البيت في حيّ “الأمين الأولى”، وحين اقترب رأى السيارات أمامه تدور وتعود بالاتجاه المعاكس والجنود الأميركان يأمرون المركبات بالتراجع، حاول سائق الأجرة أن يصل إلى البيت من طريق ثانٍ، فألفاه مغلقاً هو الآخر، اقترح الرجل أن ينزل ويكمل مشياً فقيل له إنهم لا يسمحون للمشاة أيضاً بالعبور. لم تحدث الزيارة. يا للبيت المسكين!
الزوجان في القصة الأولى كتبت عنهما جريدة فرنسية، لكن راكب السيارة المستأجرة في القصة الثانية هو نمير، والحادثة وقعت في “فهرس” سنان أنطون؛ رواية معقّدة عن المنفى والزمن والنوستالجيا والحرب والموت، والإنسان وسط هذا. ليس أن رواية أنطون ينقصها الحكايات، بل إنها مزدحمة بها، لكنها ذكرتني بخبر العجوزين والنهر.
ذكرتني أيضاً بتامينا، في “كتاب الضحك والنسيان” لـ كونديرا، حين تقول: “أنا مهاجرة من براغ إلى باريس، ولن يكون لدي الطاقة أبداً على الهجرة من باريس إلى براغ”. على العكس من تامينا سيعبر نمير، في رواية أنطون، من الحاضر إلى الماضي، سيقطع الجغرافيا من أميركا إلى بغداد مع إجراءات عاطفية ونفسية احترازية؛ إنه يزور بغداد لأيام قصيرة في عمل وسيكون مقيّداً بجدول مواعيد (الوقت ليس ملكه)، حجة لتحاشي التعرّض لأقاربه لوقت طويل (تجنب استرجاع الذكريات)، على وشك استلام وظيفة جديدة في أميركا (المستقبل ينتظره، يؤكد ذلك لنفسه بالحديث إلى غرباء عن وظيفته المنتظرة مثل نادل الفندق)؛ كل هذه الظروف الوقائية التي وضع نفسه فيها واعياً أو لاواعياً ستسقط، ستنهار بعد عودته إلى أميركا، إذ المسافة التي قطعها بالطائرة ستقطعها الذاكرة كل يوم في المنفى، ستزور المكان نفسه، والأشخاص أنفسهم، وتصل إلى البيت نفسه من دون أن يوقفها حاجز أميركي؛ الالتفاتة التي تحوّل المنفي كل مرة إلى ملح.
علاقة المنفي بالمنفى مثل علاقة المجنون بمستشفى المجانين، لا المستشفى لديه نية علاج المجنون ولا المجنون قابل للعلاج أصلاً. ثمة شيء ينهار في نمير وأحد أسباب انهياره زيارة قصيرة بعد عشر سنوات من الغياب، ستبدأ آثارها في الظهور عليه بعد عودته إلى نيويورك، يزيد في الأمر تعقيداً وجوده هناك بعد احتلال بلد المنفى للبلد الأم. ثمة تفسيرات متعددة نفهم بها التداعي البطئ والخفي لشخصية معقدة وحادّة الوعي وقويّة ومهاجرة ومنفية. وإن أردنا استخدام الـ نوستالجيا كواحدة من هذه التفسيرات فلا بد أن يكون ذلك بحذر شديد، إذ أن النوستالجيا، في حالة نمير لا ينطبق عليها المألوف، هي ليست بالنسبة إلى الذاكرة، مثلما هو الكيتش بالنسبة إلى الفن (العبارة لتشارلز ماير). كما أنها ليست فقط كما يعرّفها شاتوبريان: “شعور بالأسف” لا الحنين. أسف نمير مثقف ومفكر فيه، أي أنه عُمّق وجرى تعقيده، وفيه أيضاً شعور غامض بالذنب والغضب يفلت في تصرّفات وأفعال مقاومة صغيرة وردود فعل حادة؛ رفض تعليم طالب/جندي أميركي أفعال الأمر، النفور من زميل المدرسة القديم/ بزنسمان عراقي أميركي، المماطلة في إنجاز أطروحة الدكتوراه…
يلتقي نمير البغدادي بودود في شارع المتنبي، كقارئ باحث عن إصدارات شعرية أولى نادرة وقديمة، عن العراق القديم، الأقدم حتى من حياة نمير فيه. ودود أيضاً قارئ آخر وكاتب؛ صاحب مخطوطة “الفهرس” وإحصاء المفقودات غير المرئية/المحسوبة/المهمّشة/المجهولة.
وإن كان ودود، ليس خارج المكان/العراق، لكنه خارج الزمان، أي أنه منفيّ هو الآخر داخل المكان من حيث هو منفي عن الزمان الذي وقع قبل الفقدان، ربما لهذا يؤرشف للدقيقة الأولى، لأن الدقيقة الأولى بعد فقدان العراق، كما عرفه، بصورة نهائية هي لحظة بداية منفى ودود.
العمل يتحرّك بين قارئين كاتبين منفيّين، وثمة ست مكتبات على الأقل في الرواية، الكتب تتحرّك طيلة العمل في الكراتين والبيوت والمكاتب والحقائب والذاكرة؛ كتب حقيقية تُسرق أو تستعاد أو تتلف، وأخرى يفَكر بكتابتها، ثمة الكتاب/مخطوطة ودود، ومخطوطة أخرى تتحدث عن نفسها إلى أن يأكلها الحريق، هناك ألبوم طوابع (هو وثيقة تاريخية وحكاية شخصية) يموت أيضاً في الحريق. ثمة تنقّل كثير بين الأماكن والشقق والوظائف.
وبينما تتحرّك مخطوطة ودود وتكبر وتتكوّم في ملفات، تتراخى أطروحة نمير تتباطأ ويتهرّب منها صاحبها؛ طريقة أخرى يقول فيها أنطون شيئاً عن سيولة زمن المنفيين، وليست “فهرس” إلا محاولة لوضع حصاة في هذا الزمن، يتمحور حولها جريان هذا الوقت السائل بلا معنى، أرشيف يوقّت بلحظة الانفجار، القنبلة أيضاً تسقط على الذاكرة، وأنطون يجرّب تعريف أعمال هذا الانفجار. [في الصفحة 197 ثمة 11 سطراً من دون فاصلة واحدة ومن دون أي جملة مفيدة، كل العبارات فيها مشظاة ناقصة وخائفة من أن تكتمل، نفهم “طشاش” من الهلوسة؛ ثمة حفرة، شخص لم ينتظر شخصاً آخر، بيت اختفى، إنها “لذة الهذيان” يقول الكاتب في موضع آخر، “اللسان (يهيم) بلا وجهة معيّنة ولا مقصد”]. لا يخفى على القارئ ولا الكاتب أن محاولة تجميد لحظة زمنية هي مشروع شعري أكثر من أن يكون سردياً، وفي هذا جزء كبير من خصوصية وتحدّي هذه الرواية.
ثمة أعمال كثيرة كتبت واستخدمت فكرة المخطوط الذي يظهر في الرواية ليصبح آلة أو ماكينة السرد، من بينها رواية إلياس خوري الأحدث “أولاد الغيتو”، وهذا تكنيك ليس بجديد طبعاً منذ “دون كيخوته” وحتى “القلعة البيضاء” لباموك والتي تستند أيضاً، إضافة إلى العثور على مخطوط، إلى فكرة الثنائيات (شخصية واحدة لكن مقسومة على اثنين أو مصيرين)، وهذه “المرآتية” تكنيك قرأناه في “موسم الهجرة إلى الشمال” (فيها أيضاً مخطوط مذكرات مصطفى سعيد) وفي “شقيقان” ملتون حاطوم وحتى في “عائد إلى حيفا” لغسّان كنفاني. يجمع بين هذه الأعمال أنها روايات عن الهجرة والمنفى والعلاقة بالمكان الأول؛ ما يجعل التكنيك نفسه وعلاقته بأدب المنفى أمراً يستحق الدراسة.
غير أن الحيل السردية في “فهرس” لا تقف عند هذه الثنائيات ولا المخطوط، استدرج صاحب “إعجام”، الشخصية إلى منطقة الأحلام، والهلوسة، لنرى مع نمير الحلم الذي يقف فيه بين قطارين: أحدهما ذاهب إلى المستقبل لكن يتم إنزاله منه فليس معه تذكرة، وقطار ذاهب إلى الماضي وهذا أيضاً لا يستطيع الركوب فيه لأن ليس معه تذكرة، الحاضر رصيف يقف عليه عاجزاً عن التحرك، الحاضر لا قيمة له ولا وزن، وإن كان كذلك فلا يمكن أن يكون له مستقبل. المنفي شخص خارج الزمان وليس المكان فقط. وفي هذا لا فرق بين ودود ونمير، بل إنهما واحد، احتمالان عراقيان لشخص واحد، هذا نمير لو أنه بقي، وهذا ودود لو كان خرج، وفي الحالتين خرج العراقي من الزمن كما نعرفه، تنازعته الأمكنة والأشياء إلى أن قُذف في مجرة هلامية وسقط في سيولة الزمن.
تواصل حياة نمير العيش في أكثر من ماضٍ، بينما يقوم حاضره بمتابعة الماضي مثل تلفزيون، لا يظهر العراق/الراهن في أميركا إلا على شكل خبر أو إحصائية أو صور فظيعة، والماضي يغيّر جلده ويعيش، ويرسل رائحة قوية لا يمكن تجاهلها، ولا معرفة مصدرها والتخلص منها؛ الحالة النموذجية للمنفي. الماضي في “فهرس” أنطون، مارد، يتلوّن ويظهر في هيئة أشياء؛ كاشان، شجرة سدر، مخطوطة، ذكرى، طير، عين، ويظهر أيضاً في ودود (لماذا يعطي هذا مخطوطته إلى غريب؟ ولماذا تكون أول فكرة تخطر لنمير قبل حتى أن يقرأ المخطوطة هي أن يترجمها؟).
في بعض أفلام الرعب يحاول أحدهم أن يسكن بيتاً جديداً لكن أشباحاً تظل تظهر وتطلب أن تروي ماضيها للساكن الجديد. ولأنها لا تستطيع، تمنع البيت من مواصلة العيش بوصفه بيتاً، ومع الوقت تُحوّل المسكن إلى مكان مهجور ومخيف. هذه الرواية الطموحة ضدّ الهجر، أتخيل قسوة دخول بيت الذاكرة والجلوس على حطام وتبويب الخسارة واحدة واحدة. “فهرس” تجرّب في أن الأدب بديل حتمي للتاريخ المفقود، تُنطق أشباح الأشياء، تتيح لها أن تروي العنف الذي تعرّضت إليه، وأن تقدّم براهين وجودها.
وهذا النوع من الكتابة يذكّر بموجة بدأت في أميركا وأوروبا في الثمانينيات وشملت التاريخ وعلم الاجتماع والأدب، تبنّت مقولة بدأها فوكو ثم كبرت مثل كرة الثلج؛ وأخذت الأرشيف إلى مدى أوسع مما كان قبلاً ليشمل كل أنواع الأشياء، وحين يحدث هذا في الأدب فإنه يجعل من الكتابة عشبة الخلود، وإنطاق سنان أنطون لتفاصيل هي أقرب إلى الـ ephemera، هو إعادة الحياة إليها ووضعها في مركز بعد أن كانت هامشاً مقدّراً للزوال والنسيان والتلف. لو جمعنا هذه التفاصيل قبل أفولها في غرفة واحدة، فإننا نؤثث صورة حلوة وقديمة للعراق: كتب، شعر، طوابع، أطفال، عازفة بيانو، بيت، سجادة…إلخ.
خيار أنطون هذا، يحيل إلى سؤال حول ميله إلى السرد المتقطع، على مستوى الحكايات الصغيرة (الأشياء والتفاصيل وحياة نمير)، ثم على مستوى الحكاية الكبيرة (العراق)؛ ثمة الفهرسة المشظاة التي يقدمها ودود، ويوازيها ذكريات نمير التي تعود مثل ضوء يظهر ويختفي عن طفولته وحياته في العراق، ثمة بلد منفى أهله “منه وفيه” (لنتذكر قصة الطفل وسام وترحيله بسبب التبعية).
لا يسهّل مهمة الكاتب العمل مع شخصيّتين مهدّدتين بالموت والاكتئاب والوعي والفشل والفقد، كيف يمكن لشخصيات متشظية ومُثقلة ومشتتة أن تقول حكاية متماسكة؟ الجواب يأتي في بناء رواية أنطون التي تبدو وكأنها كانت قصة متسلسلة متماسكة ثم انفجرت فيه قنبلة.
العربي الجديد