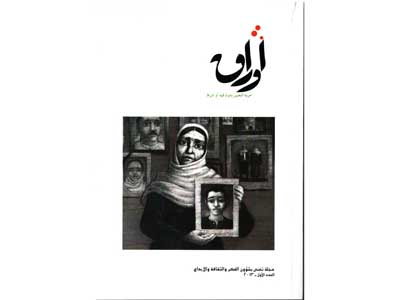سنة 2016 كما عاشتها ليلى السليماني/ ليلى سليماني

فصل الشتاء
أحب من هذا الفصل ما يكرهه الآخرون: الكآبة، البرد، اللون الرمادي. الليل الذي يبسط ظلامه. بحلول الساعة 17، بعد نهار عمل، أكون سعيدة بالتقاء تعبي بالغروب. في هذه الحالة، أمشي في الشوارع، مستعيدة على مهل طريق الواقعي، طريق العالم الحقيقي. أهجر شخصياتي لبضع ساعات: إذ تحتكرني المشاغل اليومية. إعداد وجبة غذاء، لعب، ملء حوض الاستحمام بالماء، قراءة قصة.
الشتاء هو فصل الكتابة.
“العالم الحقيقي”، أرغب أكثر من أي وقت مضى في الهروب منه. من مكتبي أستمع إلى مناقشة. نفس الكلمات، دائمًا. إرهاب، إسلام، اعتداءات. في الوقت الحاضر، إنهم يتجادلون حول مشروع قانون إسقاط الجنسية. تصل الصرخات المرتفعة إلي.
لكل واحد رأي، ومنذ عدة أشهر، أكتشف مدى جزم وسواد وتشاؤم تلك الآراء. لقد تملّك الخوف الأذهان حتى بجواري.
وددت النزول لشرب كوب من النبيذ وتدخين سيجارة. لكنني لن أفعل. لم تعد لدي رغبة في الكلام. لم تعد لدي رغبة في إبداء الرأي، أنا من يُنادى عليها أحيانًا للكتابة عن النساء المسلمات والإرهاب والهوية. صرت مسجلة في لائحة المشتركين الغائبين.”
لا تفيد المناقشات الكبرى إلا لشيء واحد: التشويش على الذات وعلى الآخرين”، على حد تعبير تشيخوف.
في إحدى الأمسيات، كنت أتحدث إلى صديق جزائري. يعيش بالقرب من “لابيل إكيب” ( La Belle Equipe). تحدثنا عن أحداث الساعة، عن داعش وعن اعتداء “الباتاكلان”. غادر صديقي بلده خلال العشرية السوداء. بإمكانه أن يحكي الكثير عن المعلمين الذين تم ذبحهم، وعن النساء اللواتي كن يتحدين الخوف للخروج بدون حجاب.”هجرتُ الجزائر العاصمة وعائلتي وحياتي. كنت أرغب فقط في مجالسة سيدة جميلة على رصيف مقهى، أسكر معها، أشدّ على يدها في الشارع. بعد ذلك جاء هؤلاء السفلة وقتلوا فكرتي”.
أنا الآن بصدد الانتهاء من كتابة رواية. على الحاسوب، تحمل الوثيقة اسم “نونو”. منذ نهاية يناير، اعتزلت في البادية. أعيش مع لويز ومريم وبول، وسط صمت منزلي “النورماندي”. بعد مرور يومين فقدت الإحساس بالزمن. أمشي في الممر، ملفوفة في بطانيتي البنية القديمة، وأنا أتكلم بصوت مرتفع. آكل من الطنجرة، أغفو فوق لوحة مفاتيح الحاسوب. اليوم، كتبت مشهدًا كاملاً، وأضحك مثل متعصبة.
منزلي هو الأدب. فيه أريد أن أعيش. إنه المكان الذي استطيع فيه التخلص من هويتي الاجتماعية والإثنية ومن نوعي. الكتابة تمرين تحرير خارق للعادة. خلف مكتبي، أكون متحررة من كل الاستدعاءات للمثول التي يرجعني العالم الواقعي إليها.
فصل الربيع
“إذا كنت لا تستطيع مغادرة المكان الذي توجد فيه، فأنت في جهة الضعفاء”. فاطمة المرنيسي.
“مهاجر”. إن قبح هذه المفردة يقول بالضرورة شيئًا من قبحنا نحن. إنها مفردة خاصة بالمسافرين من دون تذكرة، أولئك الذين تتعفن أجسادهم في عنابر السفن أو في قاع البحر. كلمة لا تقول أي شيء، تزوق الواقع، تمحوه، تجعله سخيفًا. منذ أشهر وأنا مسكونة بالأشباح. أثناء الليل، أفكر في جسد الأطفال الذين ألقت بهم الأمواج على الشواطئ. أفكر في ابتسامة محمد ذي العشر سنوات، والذي أقرأ حكايته في مقال صدر بجريدة “لبيراسيون”. كان قد فقد أبويه خلال العبور، وكل ليلة، في مخيم ” كالي” (Calais)، يصرخ مناديًا على أمه.
كان المنفى والهجرة دومًا جزءًا من حياتي. في مدينة الرباط، خلال تسعينيات القرن الماضي، أتذكر طوابير الانتظار الطويلة التي كانت تتكون، منذ الرابعة صباحًا، أمام القنصليات. قصص شبان انطلقوا من مدينة بني ملال أو مدينة خريبكة، والذين كانوا يحرقون جوازات سفرهم قبل ركوب البحر. تأتي عائلات بجميع أفرادها إلى مرتفعات مدينة طنجة لتجلس وتنظر إلى إسبانيا. أنا لم أنظر قط إلى البحر بهذه الطريقة. لم أعرف أبدًا ماذا يعني أن تكون سجينًا في بلدك.
أنا الآن في المغرب للاشتغال على “جنس وكذب”، كتاب سيضم شهادات نساء مغربيات عن جنسانيتهن. في الدار البيضاء، أركب تاكسي. يغني السائق “Your Song” لإلتون جون. يسألني عن مهنتي. أجيبه بأني كاتبة، بأمل ألا يجلب ردّي سوى حالة من الشك. لكن الرجل انحنى وتناول من تحت الكرسي نسخة، في حالة سيئة، من رواية “لمن تقرع الأجراس” لإرنست همنغواي. سألني: هل تعرفينه؟ ثم حكى لي كيف اشترى تذكرة قطار، خلال ثمانينيات القرن 20، وقام بجولة في أوروبا. وقع في حب إنكليزية، طُرد من “كالي” [منذ ذلك الحين] وعمل في مطعم مغربي بأمستردام في غسل الأواني. “زرت السويد كذلك لكني لم أشاهد شفقًا قطبيًا. حينما أحكي هذا السفر لابني، فهو لا يصدقني. لم يسبق له أن غادر المغرب، وبالتأكيد قد لا يغادره مطلقًا”.
وجدت عنوانًا. ستحمل الرواية اسم “أغنية هادئة”. التهويدات هي ألحان مخيفة، ومنومة، إنها تذكر على حد سواء، بعذوبة وبرعب الليالي الطفولية. أمسك بالكتاب لأول مرة. بعد حين، سيرحل ليعيش حياته بعيدًا عني. سيكون لِـ لويز الوجه الذي سيعطيه آخرون.
فصل الصيف
“تهب الرياح ! ينبغي أن نحاول العيش”. بول فاليري.
الصيف فصل ثقيل، ومتعب وغير نافع. أشعر فيه بالملل. إنه يعاكس عزلتي، ورغباتي في السكون. المطر حليف ملازمي البيوت والكسالى.
أقضي ثلاثة أيام في موسكو. أجلس على مقعد في الحديقة الصغيرة المحاذية لمنزل تشيخوف. من باب البيت، تشير علي الحارسة بالدخول. تريني مكتب الكاتب، والمسرح الصغير الذي كان يتدرب فيه ممثلوه، وصور العائلة المعلقة فوق السرير الذي كان يقيل فيه. على هاتفي، كانت التنبيهات تتكاثر.
أعرف نوعية هذه التنبيهات. شاحنة ملقاة بأقصى سرعتها على ممر الإنكليز. عشرات القتلى. يستحيل النظر إلى صور هذا السباق الجهنمي.
البحر الأبيض المتوسط، هذه السنة، ملوث بالحقد والدم.
فصل الخريف
“آه! آه! يقول الصرصار، لم أعد غاضبًا؛ اللمعان في العالم مكلف كثيرًا. كم سأحب انعزالي العميق! لكي نعيش سعداء، يلزم أن نعيش مختبئين”. فلوريان.
بعد أشهر من الشكوك والعمل، توجد رواية “أغنية هادئة” الآن على رفوف المكتبات. الدخول الأدبي استثناءٌ فرنسي طريف. خلال أسابيع قليلة، ستثير الكتب الأهواء. تنزل المقالات النقدية. المهرجانات تتتابع. ألتقي من جديد بالأصدقاء، القهاوي في العربة – الحانة، واللقاءات في محلات بيع الكتب وحصص التوقيعات.
يوم 3 نوفمبر، أحصل على جائزة الغونكور.
كتابتي لهذا لا يجعل منه شيئًا أكثر واقعية. أتذكر كل التفاصيل الدقيقة لذلك النهار. أتذكر شمس الصباح فوق شارع أبيس (La rue des Abesses) حيث شربت قهوة، ووصولي إلى دار غاليمار للنشر، وضحكات ناشري، وتدافع الصحفيين أمام مطعم شي دروان، (Chez Drouant). أتذكر طعم الكعكة بالأناناس، والكلمات التي ألقيت، وحرارة المعانقات. أتذكر فرحي أيضًا، الكبير والخالص إلى حد بعيد. أتذكر نظرة أمي. “هل تغيرت حياتك”؟ سألني البعض. لا، وأرغب في أن استغرق وقتًا طويلاً لأحياها. في القطارات التي أقلتني من تولوز إلى بيارتز، ومن نيم إلى لوفان، أتساءل. ماذا يعني أن تكوني امرأة حرة؟ ماذا تفعلين بصوتك حينما تعرفين أنه صوت مسموع؟ كيف تبقين صريحة، وكيف تفسرين أن المرء يحتاج أحيانًا إلى التزام الصمت؟ أتساءل أيضًا عن مادة الشجاعة الحقيقية، وعما إذا كان من الجبن رفض الخوض في المجالات التي أنجر إليها. كيف لي ألا أتيه؟ كيف أحافظ على طعم العزلة؟ كيف أحمي شغفي المقدس بالأدب؟
قريبا سيعود فصل الشتاء وسأذهب للاختباء في نهاية الممر، في منزلي النورماندي. سيبدأ أجمل فصل.
المترجم: عبد الرحيم نور الدين
ضفة ثالثة