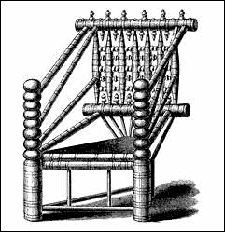“سوريا الأسد”.. كيف هندس النظام المجتمع بالمليشيات المحلية؟/ عبيدة عامر

كل بضع ساعات، يكسر أزيز الطائرات الحربية، السورية والروسية، المتجهة لقصف جوبر على طرف المدينة أو دوما على بعد ربع ساعة في السيارة، خشخشة أحجار الطاولة في المقاهي قرب جسر الثورة، وتجذب أنظار طوابير المصطفين لشطائر الجبن الشهيرة في القيمرية، دون أن تمنع شرطة المرور من توزيع المخالفات، وأخذ الرشاوى، قرب جسر فيكتوريا.
ليس هذا سوى طُعم يريد رئيس النظام السوري بشار الأسد -الذي يحاول أن يبدو عاديًا وهادئًا كذلك، ببدلة رسمية وربطة عنق زرقاء- أن يبتلعه الناظرون، رغم أن الصيد واضح. بيد “جنود الأسد”، كما يسمي عناصر المليشيات أنفسهم، وعلى الحواجز المنتشرة كالمتاهات في دمشق المدينة، وكما يمكنك أن تراها على المباني الكبيرة واللوحات الدعائية: سوريا الأسد”.
هكذا وصف الكاتب والباحث السويدي “آرون لوند” دمشق المدينة، التي عاش بها لإتقان العربية قبل اندلاع الثورة السورية، وزارها نهاية عام ٢٠١٦ الماضي، مع زميله الباحث في “مؤسسة القرن” The Century Foundatoin “سام هيلر”، الذي عاش في دمشق كذلك سنتين قبل الثورة، وأكد أن دمشق الياسمين والشعر والحارات القديمة: “لبست زيها العسكري”، في سوريا الأسد.
مطلع عام ٢٠١٥، قبل أن يتم النظام سيطرته على كل مدينة حلب، لم ير الصحفيان الدنماركيان “روبرت دولرمز”، و”تيون فويتن”، محيط فندق البارون الشهير، -الذي كتبت به أغاثا كريستي روايتها جريمة في قطار الشرق- في حلب، مدمرًا وواقفًا على العظم، كما رأوا حمص القديمة، التي خرج منها الثوار قبل ذلك بعام تقريبًا.
إلا أن المشترك الواضح الذي رأوه، أو بالأحرى لم يروه، خلال ١٢ يوما من السفر على امتداد ١٢٠٠ كم في المدن السورية الثلاثة الأكبر “دمشق وحلب وحمص”، التي تشكل جوهر سوريا سياسيًا واقتصاديًا وديموغرافيًا، هو غياب الجيش النظامي تمامًا في “سوريا المفيدة”، الممتدة جزئيًا حول محور دمشق حمص حلب، بالإضافة لحماة، وبعض مناطق الجنوب التي يسيطر عليها النظام، وحضور المتطوعين ضمن المليشيات التي يمثل أكبرها: قوات الدفاع الوطني، والتي يصل عددها إلى ١٠٠ ألف عنصر، بالإضافة إلى ما يقارب المئة مليشيا أخرى، موزعة على خطوط طائفية وعرقية وعشائرية و”عصابية” مترافقة مع استراتيجية “المصالحات” ووقف إطلاق النار؛ لتعويض خسائر الجيش النظامي الذي تراجع عدده من ٣٢٥ ألفا إلى ١٥٠ ألف عنصر، بسبب الخسائر في المعارك والانشقاقات والهرب من الخدمة النظامية.
في البدء كان “التشبيح”
لم يكن لأحد أن يتخيل في قرية “الحرف” العلوية الصغيرة في جبال الساحل، التي لم يكن بها شارع واحد في السبعينيات، أن يدخلها تلك الفترة شخص بسيارة؛ لكنه كان فيصل سلوم، الذي فتح صندوق سيارته المليئة بالدخان والسمنة، المهرب من لبنان في أيامها، وتقمص زي “سرايا الدفاع”، وتوجه ليبيعها في شوارع اللاذقية المدينة حينها. توسعت صفقات سلوم، ودخل معه شريكاه وصديقا طفولته: فايز وغسان، وزادت أعمالهم وغناهم وزبناؤهم الذين وصلوا إلى حلب، في وقت كانت الدولة تدعي به الاشتراكية ومعاداة الإمبريالية، وتمنع كل البضائع الأجنبية؛ ومنها الدخان الأمريكي على سبيل المثال، ومعه زادت مشاكلهم بازدياد نفوذهم، في معقل النظام السوري وطائفته في الساحل، حتى انتهت لتوقيف سلوم بأحد المرات، وأخذ سيارته البيجو، ثم مرة أخرى، أدت لإنهاء شراكة أصدقائه معه، دون أن توقف طموحه.
خرج سلوم من السجن، وعاد من لبنان بسيارة أخرى، مرسيدس (شبح) هذه المرة، ليصبح “الشبيح الأول”؛ ولكن ليس الشبيح الأكبر، بطبيعة الحال، في مدينة النظام وعائلته، الذي لا بد أن يكون من العائلة نفسها، وبالفعل كان الأكبر هو فواز الأسد، ابن جميل الأسد، شقيق رئيس النظام السوري حينها حافظ الأسد، الذي اعتمد على نفوذه وقوته وأمنه منذ صغره، ليبدأ التهريب والتخويف في القرداحة، مسقط رأس العائلة، ويتوسع شيئًا فشيئًا ليسيطر على الساحل، مستخدمًا عصابته التي أصبحت معروفة بـ”الشبيحة”، لاستخدامها سيارات الشبح، والتي أصبحت فيما بعد (المليشيا الأولى)، بعد اندلاع الثورة.
لم يكن التسليح المدفوع والتجنيد خارج الجيش النظامي مستهجنًا في “سوريا الأسد” المحكومة بحالة أشبه بـ”المافيا”، العصابة العائلية المعتمدة على التهريب، وكان “الشبيحة” أبرز هذه الظواهر.
بعد اندلاع الثورة، ومع دخول “الشبيحة” الأصليين لصف النظام، خصوصًا في الساحل ومشاركتهم بقمع الثورة، حضر مصطلح الشبيحة، الذي يُقصد به “عصابات النظام”، وتحديدًا من الطائفة العلوية، ممثلًا لظاهرة “المليشيات” ولم يكن معبرًا بشكل دقيق؛ إذ تداخل مع “اللجان الشعبية”، التي تطوع عناصرها بأنفسهم لحماية النظام، أو تم تجنيدهم على يد المخابرات ورجال الأعمال الداعمين للنظام في سوريا؛ حيث لم تكن ظاهرة “الشبيحة” مليشيا علوية وحسب، بل ممثلة لتجنيد شعبي لأقلية واضحة لصالح النظام، وبشكل جزئي على أساس الطائفة، مقابل أسس أخرى كثيرة.
بدأ النظام منذ اندلاع الثورة باستخدام المال والأمن لشراء ولاءات الشباب العاطلين عن العمل، وتوزيع السلاح والسيارات والأذونات الأمنية لدى الشباب الموالين وعائلاتهم؛ عبر تسليح شبكات الوكلاء الكبيرة المؤسسة على مدى أربعة عقود من حكم عائلة الأسد؛ ليشمل المجندون: عائلات الجيش، المنتسبون والمقتنعون بأفكار حزب البعث، الفرق المدعومة من المخابرات، الأقليات الدينية، العشائر العربية السنية، واللعب على المصالح الأخرى التي كانت تخاف من الثورة، التي هيمن عليها العرب السنة.
بدأت اللجان الشعبية بقمع المظاهرات والبحث عن مظاهر الثورة في مناطق تواجدها، مستخدمة العصي والسكاكين فقط في بعض الأحيان، ثم تدرجت لتصبح سلطة محلية، تحولت إلى مليشيات مسلحة، ترافقت مع تراجع دور الدولة، وتسلح الثورة المسلحة وتوسعها، ثم انضم لها -خصوصًا بعد عام ٢٠١٣- تدفق كبير من المليشيات الأجنبية الشيعية، بتنظيم وتسليح إيراني، كان أكبرها وأبرزها حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى عدد من المليشيات العراقية.
“تعفن النظام السوري”
تجيد إيران لعبة المليشيات، وتحبها، وتمثل لها سوريا امتدادا جغرافيا وديموغرافيا حاولت اختراقه قبل اندلاع الثورة بعقود، ومثل لها ضعف النظام واستعانته بها فرصتها الذهبية لكل ذلك معًا.
في عام ٢٠١٢؛ كانت المهمة الرئيسة لحسين همداني (القيادي في فيلق القدس الذي قتل قرب حلب في عام ٢٠١٥، والمنتدب من قائد الفيلق نفسه قاسم سليماني، بأمر من المرشد العام للثورة الإيرانية علي خامنئي) هي إنقاذ النظام السوري، وكانت وسيلته المفترضة، بطبيعة الحال، هي الطريقة “الباسيجية”، المعتمدة على المتطوعين؛ التي نجحت في إيران، ثم في العراق، فعمل على تنظيم وتجنيد المتطوعين من داخل سوريا تحت مسمى “قوات الدفاع الوطني”، التي تسعى للاعتماد على السوريين قدر المستطاع، والحد من المخاطر الإيرانية، ووصل عددهم إلى ١٠٠ ألف مقاتل، تحت قيادة سورية، وتجنيد وتنظيم وتدريب إيراني.
كيف أصبحت إيران دولة الميليشيات الأولى؟
لم يجد الأمر نفعًا، فقد كان “تعفن” النظام السوري أسوأ مما يُعتقد؛ فاضطرت إيران في عام ٢٠١٣ لحشد المتطوعين من خارج سوريا، من لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان وإيران، لجانب النظام، مع مزيد من الحشد الداخلي، المنظم وغير المنظم، داخل المجتمع السوري نفسه.
خطوط متباعدة
تتباين هذه المليشيات في عددها وقوتها؛ حيث تتكون بعضها من عشرات، مرتبطة بمنطقة أو بحي ما، بينما تتكون بعضها من آلاف المقاتلين، وتملك سلاحًا ثقيلًا، وحضورًا إقليميًا، ومعسكرات تدريب وشبكات تجنيد، كما أنها تتباين في سيطرة النظام السوري عليها، وفي دوافع التجنيد داخلها؛ دون الغياب الكامل لجيش النظام السوري، الذي ضاعف “قوته الكامنة في ضعفه”، بزيادة اعتماده على الخطوط “الفاسدة والعشائرية والطائفية داخله”، كل ذلك لتعويض النقص والسعي لاستعادة السيطرة.
ومثل جيش النظام؛ تكمن قوة وضعف هذه المليشيات بتنوعها وتباعدها، على خطوط تمويلها وتجنيدها وتنظيمها وتدريبها، وأخيرًا في خطوط ولائها، سواء لداخل أو خارج النظام.
بلهجة علوية متكسرة، وبلحية طويلة ذات هيئة داعشية، وبربطة رأس فلسطينية، ووشم تشبيحي كبير على اليد؛ يوصي علاء الختيار (الذي وصف نفسه بـ”الشهيد” والذي قُتل وهو يقاتل) في وصيته الوداعية، “يهود الداخل” -كما أسماهم- أهله “ألا يحزنوا عليه”، موضحًا أنه قتل “لأجل الأجيال القادمة”، بحسب ما تظهر الوصية المصورة، ضمن صفوف “نسور الزوبعة”، ذات الشعار النازي، الجناح العسكري لـ”الحزب القومي السوري الاجتماعي”، أحد أكبر المليشيات التي تقاتل في صف النظام، والمعتمدة بدرجة كبيرة على الحشد “الأيديولوجي”، الوطني أو القومي، والذي تشاركه به كل من مليشيات “كتائب البعث”، المشكلة من المنتسبين لحزب البعث، و”الحرس القومي العربي”، ذات الفكر الناصري القومي، والتي ظهرت في حلب حاملة صور جمال عبد الناصر، و”المقاومة السورية- كتائب تحرير إسكندرون”، التي قادها التركي معراج أورال، المعروف باسم علي كيالي، والتي كانت مسئولة عن عدد من المجازر الطائفية في الساحل بداية الثورة.
في الطرف الآخر من سوريا، في أقصى الشرق في الحسكة؛ يظهر المقاتلون المسيحيون المسلحون في مقطع دعائي مصور وهم يجولون في أحد الشوارع بسلاحهم ولباسهم العسكري، مع أغنية: “نحن مشغولين، ورح نبقى مشغولين، لا إلنا أسامي، ولا عناوين، بدنا نحرر بلدنا من المحتلين”، ويظهر المقطع لوحة كتب عليها “مركز الأمن”، وبجانبها شعار كتائب “سوتورو”، الموجودة في مناطق المسيحيين السريان شمال شرق سوريا، كواحدة من الكتائب التي شكلت على أسس دينية، بجانب “قوات الغضب”، المشكلة من مسيحيي حمص، و”كتائب الموحدين”، و”كتائب حماة الديار”، المشكلة من دروز الجنوب، مقابل كتائب أخرى قاتلت بجانب الثورة، من داخل هذه المجتمعات ذاتها.
بلهجة أخرى، وتحفيز آخر، وأغنية أخرى، “يلطم” الرادود الشيعي الشهير علي بركات، الذي غنى لتحفيز الشيعة وتجنيدهم في سوريا: “سيد باقر أنت القائد، خلفك نمضي إنا نعاهد، فلواؤك بالنصر أتانا، وليوثًا جئناك نجاهد”؛ في الأغنية الأشهر للواء الإمام الباقر، المشكل من الشيعة /عشيرة البقارة، والذين تشيع عدد منهم في حلب، بتمويل وجهد إيرانيين؛ مثل عدد من المليشيات الشيعية، المحلية الأخرى، مثل (الغالبون) و(جنود المهدي) و(قوات الرضا) وغيرهم، والتي تتشابه في هويتها البصرية مع حزب الله؛ مما يعكس مركزية التمويل والتدريب والتجنيد، واختلاف الجنود.
يظهر مقطع آخر مقاتلي لواء القدس الفلسطينيين، وهم يقاتلون في صفوف حلب، بمقدمة من “قوات الدفاع الوطني”، ووصف يقول إن هؤلاء المقاتلين يقاتلون “مع إخوتهم من رجال الله بالخط الأول للمواجهة على جبهة الشيخ سعيد، في مواجهة التكفيريين من أتباع القاعدة وآل سعود وعملاء القطريين”، في واحد من أصل عشر مليشيات من فلسطينيي سوريا، بعضها تشكل بعد الثورة من فلسطينيي المخيمات في سوريا، مثل “لواء القدس” و”حركة فلسطين حرة”، وبعضها كان امتدادًا للوجود الفلسطيني والفصائل القديمة، مثل “فتح الانتفاضة” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة”، التي قمعت الثورة بالسلاح، لجانب النظام، في مخيم اليرموك، أكبر مخيمات الفلسطينيين في سوريا.
قوات النمر بقيادة سهيل الحسن (مواقع التواصل)
بجانب كل خطوط التجنيد هذه؛ برزت من داخل جيش النظام السوري نفسه قوات شبه مسلحة، ما بين المليشيات والجيش، كانت تمتاز باستقلالية عن الجيش؛ لكنها تنتسب له، ولعل أبرزها (قوات النمر)، التي يقودها اللواء المعروف سهيل الحسن، والتي خاضت معارك حماة، ومعارك حلب، وتتبعها قوات فرعية مثل “قوات الفهود”، بالإضافة إلى تشكيلات جديدة لـ”الشبيحة”، تم تأسيسها على يد رجال أعمال مؤيدين، وأكبرها وأبرزها “مليشيات البستان”، التابعة لجمعية البستان الخيرية، التي يترأسها ابن خالة رئيس النظام السوري “رامي مخلوف”، و”صقور الصحراء”، التي توصف بأنها قوات نخبة، تم تأسيسها على يد محمد جابر، بتشكيلات من ضباط سابقين ومحاربين متطوعين من مليشيات أخرى، بالإضافات إلى “عصابة” (لواء أسود الحسين)، التابعة لمحمد توفيق الأسد، قريب الرئيس، والذي قتل في صراع عصابات داخل اللاذقية بخمس رصاصات في الرأس في مارس /آذار ٢٠١٥.
ورغم أنها ليست وحدات جيش نظامية، إلا أن عددًا كبيرًا من هذه المليشيات يستخدم كل الأسلحة الثقيلة ومضادات الدروع التي يستعملها الجيش النظامي نفسه، أو قوات الحرس الثوري الإيراني، من دبابات وحاملات جنود وأسلحة مدفعية.
روسيا تغير قواعد اللعبة
“أخي المواطن، كي تكون بطلاً من أبطال الانتصار على الإرهاب، وكي تنال شرف الدفاع عن سورية، بادر بالانتساب إلى الفيلق الخامس اقتحام”.
( إعلان على القنوات التلفزيونية السورية)
إذا كان الفضل بإدخال المليشيات وتنظيمها وتدريبها و”عسكرة” المجتمع يرجع لإيران؛ فإن ثمرة هذا الفضل لن تكون إيرانية؛ فمع التدخل الروسي وتغير قواعد اللعبة بالمعنى العسكري، بالقصف الجوي الكثيف، والتدخل البري بالقوات الخاصة والمستشارين الروس، وتغير الخارطة لصالح النظام بعد التدخل الروسي مع مطلع أكتوبر /تشرين الأول ٢٠١٥، تدخلت روسيا في خارطة المليشيات، وسعت لتوثيق علاقتها بالمليشيات الموجودة أساسًا، وسحبها لصالحها، وقادت بعضها بشكل مباشر، مثل “لواء القدس” و”الإمام الباقر” و”كتائب البعث” في حلب، بطريقة تسعى لاكتساب الهيمنة السياسية، دون تمويل أو تأمين للتجنيد.
كان هذا أحد أضلاع الاستراتيجية الروسية للتدخل في بيئة الصراع السوري من جانب المليشيات، أما بقية الأضلاع فقد توزعت على بقية أطراف الصراع جميعًا، من معارضة مسلحة، ومجتمعات محلية، ونظام سوري، أو ما تبقى منه.
من جانب المعارضة، عملت روسيا على شراء ولاءات بعض الفصائل وجرها لجانبها، مقابل عدم قتالها للنظام السوري، بحسب ما أكد رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم – المدعوم من البنتاغون-، مصطفى سيجري، مترافقة مع تعزيز لسياسة “المصالحات” التي يقودها “مركز عمليات حميميم”، في اللاذقية، واستطاعت عقد عدة مصالحات أمنت بها السيطرة السياسية وأعادت بعض البلدات الاستراتيجية لـ”حضن الوطن”، بحسب تعبير النظام، مقابل خروج المسلحين، وتسوية أوضاع الشباب الذين لم يخدموا في الجيش.
أما الضلع الرابع، والأهم، فهو محاولة إعادة إحياء الشرعية السياسية والعسكرية للنظام، عبر تشكيلها في ٢٢ نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠١٦، لما أسمته: “الفيلق الخامس- اقتحام”، وعملت بكل ما تملكه لتجنيد الشباب ضمنه؛ حيث وجهت خطب الجمعة لدعوة الشباب للانضمام للفيلق، وحشدت باستخدام التلفاز ورسائل الهواتف المحمولة والإذاعات والجرائد ونشرت الصور والدعايات، كما قدمت راتبًا، يمكن وصفه بالمغري، وتركت الشباب يخدمون في أماكن تواجدهم، بما يعكس الحاجة لـ”جنود سوريين ضمن القوات المسلحة” تحديدًا؛ لا مجندين ضمن القوات المساندة، الممثلة بالمليشيات المحلية، أو القوات الرديفة، التي يقصد بها المليشيات الأجنبية المؤيدة، بما يبدو محاولة روسية لتوسيع الهيمنة على النظام السوري، ضمن التنافس مع إيران التي تملك القوات الرديفة وجزءًا كبيرًا من القوات المساندة، وهو ما بدا واضحًا عندما ضمنت روسيا اتفاق إجلاء المدنيين في حلب، ثم عرقلته مليشيات إيران، في اليوم الأول من عملية الإجلاء، بالإضافة لعدم حضور إيران لمحادثات “أستانة” التي دعت إليها روسيا النظام السوري.
وإذا كان هذا “التشظي” داخل النظام السوري وجيشه هو ما أنقذ النظام في مرحلة ما؛ فإنما في المستقبل الآتي من توسع هذه الأطراف الصغيرة والمزيد من تشظيها، وتوسع وتضارب مصالحها وصلاحيتها، وقدرة النظام وإيران وروسيا على التحكم فيها لا زالت محل شك، وهي مرتبطة بعامل يبدو بعيدًا أو منسيًا أو متجاهلًا، وهو الاقتصاد السوري، الذي يحكم ويضبط نسق كل هؤلاء الفاعلين معا، والذي يبدو أنه يسير في طريقه إلى الانهيار، حاملًا معه، لا انهيار النظام والحكومة اللذين يمثلهما الجيش والنظام وحسب؛ بل استقرار المنطقة بأكمله عندما تخرج هذه المليشيات عن السيطرة..!
ميدان