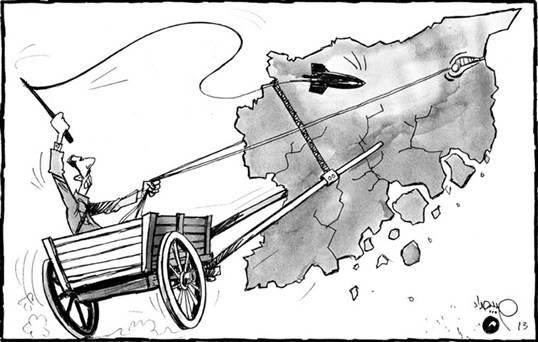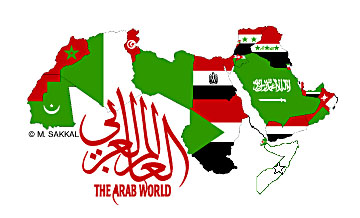سوريا بعد سنتين: طاولة مستديرة
يقول فرانز فانون في كتابه معذّبو الأرض إن «العنف وحده،الذي يرتكبه الناس العنف المُنظَّم والموجَّه من قبل قيادة، يقدم المفتاح للجماهير كي تفك شفرة الواقع الاجتماعي. بدون هذا الصراع… ليس هناك من شيء سوى عرض كرنفاليّ والكثير من الهواء الحارّ. كلّ ما يبقى هو إعادة تكيّف ضئيلة وبعض الإصلاحات في القمة وراية، وفي الأسفل، في القاع، جمهور لا شكل له، ذاو، وغارق في العصور الوسطى». قد يكون تحليل فانون مديناً جداً لنظرية في التقدم بالية مستندة إلى نظرية التحديث، ولكنّ تبصّراته بأن التغير السياسي الجدّي يستلزم العنف وأنّ العنف علاجيّ لأولئك المُضطهدين تفترض الأسئلة التالية:
– هل تتفق مع فانون في تأييده للعنف كجزء جوهري من الصراع السياسي؟
– إلى أي حدّ الثورات السلمية ممكنة؟
– هل يمتلك العنف في سوريا احتمال التحرّر الذي حدده فانون في الحركات المضادة للاستعمار أم هل هناك شيء آخر يجري؟
– هل هناك طرقٌ لم تُسلك في سوريا؟ هل كان الإصلاح ممكناً؟ مرغوباً؟
– هل جعلت طبيعة الحكم الاستبدادي في سوريا العنف الطريقة الوحيدة لإنهاء الاستبداد وهل هذا هدف ملائم في حد ذاته أم هل يجب أن يكون هناك برنامج سياسي ثوري؟
-هل كانت هناك طرق لجعل العنف أكثر تحريراً وتحويلياً (وفق تراث فانون) أكثر مما يبدو أنه عليه؟
بمناسبة مرور عامين على اندلاع الثورة السورية، توجّهت “جدلية” إلى عدد من الكتاب السوريّين بحزمة الأسئلة المذكورة أعلاه. وأما الإجابات فكانت بالمواد التالية:
ديمة ونوس: العنف ليس الحل ولكن
[ بمناسبة مرور عامين على اندلاع الثورة السورية، توجّهت “جدلية” إلى عدد من الكتاب السوريّين بحزمة أسئلة تنطلق من مقولة فانون حول العنف ودوره في التغيير الثوري. تقارب الأسئلة جدلية العنف والسلم في التغيير السياسي. فتقف عند مفهوم الثورة السلمية وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع. كما تتعرض إلى العنف كوسيلة للتحرّر، خصوصاً من نظام حكم استبدادي. والمدى الذي تفرض فيه طبيعة الحكم وسائل مقارعتها ومقاومتها. والسؤال المحوري: ما العمل؟]
لا أستطيع أن أقول إن العنف هو الحلّ. لكنني أعتقد في الوقت ذاته، أن العنف الذي يمارسه النظام منذ سنتين، فتح أمام السوريين خيارات لا بد أن تكون أفضل. العنف الذي يتحدث عنه فرانتز فانون في كتابه “معذبو الأرض”، يشير إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار. وإن تأملنا السياسة الداخلية للنظام السوري خلال السنوات الأربعين الماضية، نجد أنها سياسة تعتمد العنف الممنهج في نواحٍ عدة. بدءاً من مصادرة الهوية تحت شعار “العلمانية” وصولاً إلى نهب الثروات وإجبار الشعب على تقبّل ظروف حياتية (اجتماعية- اقتصادية- صحية- تربوية…) موغلة في البؤس. وأعتقد أن مسألة مصادرة الهوية تلك، هي سبب رئيسي لما وصلت إليه الثورة حتى هذه اللحظة ولما ستصل إليه لاحقاً. في الواقع، سورية لم تكن بلد “التعايش السلمي” فقط لأن أهلها أرادوا ذلك، بل لأنهم كانوا مرغمين أيضاً تحت وطأة الحذاء العسكري، على أن يتعايشوا مع بعضهم البعض. وهذا الأمر يبدو حضارياً في معناه السطحي والاستشراقي والسياحي. إلا أنه خلّف في الواقع، جهلاً معيباً، وخوفاً وريبة من الآخر. من هو الآخر؟ ما دينه؟ ما طائفته؟ ماذا تعني تلك الطائفة؟ ما الفرق بينها وبين الطوائف الأخرى؟ وذلك الجهل، ساعد النظام على استفزاز هلع الطائفة العلوية وعلى إحكام قبضته على الطوائف كافة. ثمة آخر لا نعرف ملّته، سيأتي ليحتل “أرضنا”، وسيذبحنا! هذه العبارة، ليست من اختراعي. إنها “الفاتحة” بالنسبة إلى معظم أهل الساحل. يرددونها دون توقف، يمارسون حياتهم حالياً انطلاقاً من تلك العبارة، ويخططون لمستقبلهم على خلفية تلك العبارة.
بالعودة إلى فانون الذي يقول ما معناه أن التغيير الحقيقي لا يتم بتفاهم ودي، أيضاً، يبدو أن ثورة الشعب السوري ضد النظام لا يمكن أن تكون ثمرة تفاهم ودي. وأنا هنا لا أحلل بل أستعرض ما حدث خلال سنتين. إذ أثبت النظام عدم قدرته على خطّ أي تفاهم يدفعه إلى تقديم تنازلات ولو طفيفة. كما أثبت استعداده لتدمير كل ما يعترض طريقه للبقاء. والمفاوضات الوحيدة التي خاضها النظام منذ سنتين وحتى اللحظة، تدور حول كمية الدمار التي “يحق” له أن يحدثها، نوع الأسلحة والصواريخ التي “يحق” له استخدامها، عدد الأشخاص الذين “يحق” له قتلهم. عدا عن تلك الأمور، لا أعتقد أن مفاوضات حقيقية كانت تدور بينه وبين حلفائه الروس أو الإيرانيين أو “المعارضة الوطنية” في الداخل.
أما عن العنف كمفردة تنتمي إلى زمن “طلائع البعث” وليس إلى زمن “فانون”، فأجد أن كماً هائلاً من العنف تمت ممارسته بصمت وبصوت منخفض ومن دون إثارة أي ضجيج. في المدارس والمؤسسات الحكومية والشوارع والبيوت والمكاتب ووسائل النقل العامة والخاصة والمقاهي والمطاعم.. في النهاية، الصورة التي تتربع الجدران وزجاج السيارات ويافطات الإعلان، هي بحد ذاتها شكل من أشكال العنف. في كل مكان وكيفما تلفّت “المواطن” ثمة عنف صامت يمارس بحقه وبحق إنسانيته. والأصعب، هو التعايش مع ذلك العنف. والتعايش هنا قد يعني الاستسلام والخوف، لكنه لا يعني النسيان. “المواطن” لم ينسَ إنسانيته المهدورة ولا الإهانات المجانية التي يتعرض لها كل لحظة، ولا الأثمان الباهظة التي دفعها تحت شعارات “طنانة” كالمقاومة والمجهود الحربي والعزلة والحصار الاقتصادي.
ولا أعرف إن كان السياق الذي استخدمتم فيه العنف، مناسباً ودقيقاً. فانون تحدّث عن العنف كخيار للتحرر من آلة الاستعمار وكحل “شرعي”. الظرف الذي عاشته الثورة السورية مختلف تماماً عن هذا التوصيف من جهة وعن الظروف التي عاشتها الثورات العربية الأخرى من جهة ثانية. على الرغم من كل ما حدث من مجازر وانتهاكات وقتل وإراقة دماء وتعذيب وتدمير للبنى التحتية وامتهان لكرامة المواطن السوري (وهنا لن أضع المواطن بين مزدوجتين، لأنه بات مواطناً للمرة الأولى منذ عقود)، لم يتحول العنف إلى حالة عامة والأهم أنه لم يتساوى عند الموالين كما عند المعارضين للنظام. منذ الشهر الأول للثورة، ثمة عنف مريع مارسه النظام وأعوانه ضد المواطنين إلا أن الثورة برأيي لم تقع في فخ العنف المفرط ولا في فخ الطائفية (باستثناء حالات فردية تتزايد مع مرور الوقت). في الوقت ذاته، أجد من الضروري القول إن السكوت عن الانتهاكات التي يمارسها الثوار، ليس سوى تواطؤ على الثورة وعلى المرحلة المقبلة. ويجب إيجاد صيغة أكثر جدية وحزماً من الإدانات التي يكتبها المعارضون والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي.
لا يمكننا الحكم على الثورة السورية بالمعايير السياسية والاجتماعية والأخلاقية السائدة والمتعارف عليها. وسلمية الثورة كذلك لا يمكن أن تخضع لتقييم نظري عما إذا كان بالإمكان الاستمرار فيها من دون رفع السلاح. كل من يدعو إلى تسليح الثورة، متآمر. وكل من يدعو إلى سلميتها متآمر أيضاً. هل يحق لمعارضة الخارج أن تدعو الشارع لحمل السلاح؟ بالطبع لا. فهي لن تدفع الثمن. ستقصف أحياء بأكملها على رؤوس سكانها، بحجة مخزن للأسلحة أو مخبأ للمسلحين! طيب، هل يحق لها أن تطالب بسلمية الثورة؟ أيضاً لا. فهي لن تدفع الثمن. سترتكب مجازر بحق أبرياء ولن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. ستصول اللجان الشعبية وتجول وترهب المواطنين العزل وتهينهم وتمارس كل أنواع العقد النفسية والأمراض بحقهم. لذلك أرى أن سلمية الثورة لم تكن خياراً. بل كانت مأزقاً أو شرّاً لا بد منه.
أما عن إمكانية الإصلاح، فسورية كانت من البلدان القليلة جداً التي لا تحتاج إلى تغيير جذري أو إلى قطيعة كاملة مع الماضي. الإصلاح كان ممكناً والنظام كان بوسعه البقاء دون أثمان باهظة. ليس البقاء في الحكم فقط، وإنما توطيد ذلك البقاء وجعله أقرب إلى “الشرعي” و”المنتخب” بشفافية وليس مستفتى عليه. إلا أن النظام فضّل التضحية بمئات الآلاف على أن يضحي بشخص واحد أو بمجموعة من الأشخاص. وهذا ليس أمراً يدعو للحزن. على العكس تماماً، من حسن حظ الشعب السوري وجيل “طلائع البعث” وأولاده، أن النظام لم يتنازل ولم يضحِ ولم يلين. الشعب لم يعد يريد التصفيق لجلّاده.
حسن عباس: معنى العنف وحدوده
[ بمناسبة مرور عامين على اندلاع الثورة السورية، توجّهت “جدلية” إلى عدد من الكتاب السوريّين بحزمة أسئلة تنطلق من مقولة فانون حول العنف ودوره في التغيير الثوري. تقارب الأسئلة جدلية العنف والسلم في التغيير السياسي. فتقف عند مفهوم الثورة السلمية وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع. كما تتعرض إلى العنف كوسيلة للتحرّر، خصوصاً من نظام حكم استبدادي. والمدى الذي تفرض فيه طبيعة الحكم وسائل مقارعتها ومقاومتها. والسؤال المحوري: ما العمل؟]
– ربما وجب علينا قبل الإجابة على السؤال تحديد معنى العنف، وحدوده. إذا كان العنف هو بذل قوة لإرغام طرف على الإتيان بما لا يريد فعله من تلقاء نفسه، فإنه أمر مشروع، وعنصر جوهري في الصراع السياسي. إذ ليس من طبيعة السلطات، ولا من مصلحتها، أن تتنازل عن مكتسباتها عن طيب خاطر. مما يجعل ممارسة القوة ضدها (العنف) أمرا لا مهرب منه.
لكن، إن كان العنف واحداً في الجوهر فإنه متعدد في الأشكال والأحجام والطبائع. المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات أشكال “ضرورية” من العنف، ولا يمكن تصور صراع سياسي من غير ممارستها. وهي أشكال عنف “مشروع”، لكن حمل السلاح والقتل وتخريب الأملاك الخاصة والعامة أشكال عنف “غير مشروع”. وأعتقد أن معيار الشرعية في تقييم العنف يرتبط بمبادئ حقوق الإنسان، فكل عنف لا يتجاوز تلك الحقوق هو مشروع، ونتكلم هنا عن الصراع السياسي فقط.
– الثورة بذاتها وبتعريفها عملية إرغام على تغيير أو على تغيير جذري، فالعنف بالضرورة، جوهر الثورة. لكن، هنا أيضاً، واعتماداً على المعيار المذكور في الرد الأول، يمكن القول إن الثورات السلمية ممكنة في المجتمعات، أو في الدول، التي تُضبط نزاعاتها على أرضية حقوق الإنسان. أما في دول الاستبداد فلا أعتقد أن هذه الثورة ممكنة، لأن العنف هو جوهر السلطة والضامن لوجودها ولا مناص من عنف مضاد لإرغامها على التغيّر أو التغيير.
– ليست غاية العنف في كتاب “فانون” مطابقة لغايته في ما يجري اليوم في سوريا. فانون يتكلم عن حركة تحرر ضد استعمار كولونيالي غريب عن المجتمع، في سورية حركة تحرر من عنف سلطة من صلب المجتمع. الغاية في الحالة الأولى تبرر كل أشكال العنف لأن الصراع بين خارج وداخل، والتحرر لن يولّد صراعا داخل الوطن المتّحد، وإن كان من الممكن أن يولّد خلافات حول أسلوب قيادة البلاد. الغاية في الثانية تبرر عنفاً مشروطاً، لأن الوضع المنشود يفترض مصالحة وطنية توقف العنف الكامن لدى طرفي الصراع. العنف ضد الاستعمار مطلق ويمتلك احتمال التحرر. العنف ضد النظام محدد والتحرر المرجو من ممارسته غايته العدالة والكرامة للجميع.
– كان الإصلاح حلاً مرغوباً، وممكناً، على الأقل على المستوى النظري. لكن بنية النظام “الأمنوقراطي” كانت عاجزة عن رؤية أي إمكانية لحل الأزمة عن طريق الإصلاح. ثمة “معجزة” كان من المشتهى أن تقع، لكن المعجزات لا توجد سوى في الكتب الدينية وحكايات الأطفال، لم ير النظام غير الحل الأمني، ولم تحصل المعجزة.
– على صعيد النظرية والتجريد، ليس من الممكن البتة احتمال انتهاء الاستبداد دون ممارسة العنف، غير أن هذا لا يجوز أن يعني ممارسة العنف من أجل إنهاء النظام فحسب، وإنما كوسيلة لتحقيق ثورة حقيقية، وهذا ما يفترض وجود برنامج سياسي ثوري، يحسن “دوزنة” العنف في مرحلة إسقاط النظام وفي المرحلة التالية له: مرحلة بناء الدولة الجديدة. في هذه المرحلة الثانية والأخطر لا مفر من ممارسة العنف لنزع السلاح وضبط الفئات المسلحة، لمنع الانتقام، لتنفيذ شروط العدالة الانتقالية، لتحقيق سلطة الدولة….إلخ.
– نعم دون شك، بوجود قيادة تنظم العنف وتوجهه. المشكلة الكبرى في سورية هي أن ما كان عليه أن يكون القيادة السياسية للثورة، التي تقود العنف، وتقنونه، وتسيّره، صارت تابعة للعنف المنفلت من عقاله. ضعف هذه القيادة وتشرذمها منع العنف الثوري من تجميع قواه وتنظيمها، وأتاح بالمقابل للنظام الزمان الكافي ليتمادى في حله الأمني قبل أن يتأكد بأنه ليس ثمة أي جدوى منه.
محمد العطار: هل هناك طرق لم تسلك في سوريا؟
[ بمناسبة مرور عامين على اندلاع الثورة السورية، توجّهت “جدلية” إلى عدد من الكتاب السوريّين بحزمة أسئلة تنطلق من مقولة فانون حول العنف ودوره في التغيير الثوري. تقارب الأسئلة جدلية العنف والسلم في التغيير السياسي. فتقف عند مفهوم الثورة السلمية وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع. كما تتعرض إلى العنف كوسيلة للتحرّر، خصوصاً من نظام حكم استبدادي. والمدى الذي تفرض فيه طبيعة الحكم وسائل مقارعتها ومقاومتها. والسؤال المحوري: ما العمل؟]
– أعتقد أن نجاح الثورات في تحقيق مرادها بالشكل السلمي، لا يرتبط فقط بالنهج الذي يعتمده الثائرون، الأمر أيضاً مرتبط وبشكل وثيق بطريقة استجابة السلطة وتعاطيها مع مطالب التغيير. إذا حدث واستجابت السلطة بطريقة تسهل من عميلة التغيير وانتقال السلطة، حتى وإن أبدت أشكالاً معينة من الممانعة لهذا التغيير، فإن فرص نجاح الثورة سلمياً تكون مُحققة، عبر اعتصامات وتظاهرات وحشود وإضرابات نقابية وعمالية. وحتى إن لم تظهر السلطة رغبة طوعية بالاستجابة لمطالب التغيير ولكنها على الأقل امتنعت عن استخدام العنف المفرط في مواجهة هذه المطالب، فإن فرص وسائل الاحتجاج السلمي تبقى كبيرة بإنجاح التغيير. نجد نماذج لهذا في حركات احتجاجية نجحت في دول أوروبا الشرقية إبان انهيار المعسكر الشرقي.
الاحتمال الثاني هو بحصول تخلخل أو أشكال من الصراع تمهد لانقلاب داخل السلطة نفسها، وبطريقة تحتوي العنف – إن تفجر – داخل دائرة السلطة فقط. وهو النموذج الذي تدفع فيه مطالب التغيير الشعبية الضخمة بعض أركان السلطة لتغيير موقعها أو للانحياز بشكل براغماتي لمطالب التغيير. وهذا نموذج قريب لما حصل في بدايات الربيع العربي في تونس ومصر وبطريقة مشابهة نسبياً في اليمن. حيث انحازت مؤسسة الجيش في تونس ومصر وبعد ضغط شعبي واسع لرغبات التغيير وتخلت عن رأس السلطة. فيما انقسم الجيش في اليمن، ودار صراع داخل عشيرة الرئيس. ومثل هذا السيناريو لا يأتي أحياناً كنتيجة لتصاعد الضغط الشعبي فحسب، وإنما أيضاً كنتيجة لضغط دولي أو توجيه رسالة صارمة وواضحة من المجتمع الدولي. في حينها تكون احتمالات الانشقاق أو الانقلاب ضمن مؤسسة السلطة نفسها أكبر، وبالتالي تتمكن الثورة من المضي سلمياً. (في سوريا مثلاً لم يتوفر هذا العامل، بل على العكس،لم تشعر الرسائل المتناقضة والمتخاذلة من المجتمع الدولي، والإشارات المتواطئة من قبل دول المفترض أنها عدوة كإسرائيل مثلاً، لم تشعر أطراف في النظام بجدية الضغوط للخلاص منه، وهو في تقديري ما أطال تماسك الحلقة المقربة منه).
اختصاراً، أعتقد أن إصرار الثائرين على الالتزام بأشكال الاحتجاج السلمي، لا يكفي فقط لإنجاح ثورة جذرية وشاملة، إن لم تأت استجابة السلطة بأحد الأشكال المشار إليها سابقاً. وأعتقد أنه من الإجحاف القول، إن اللجوء إلى أشكال المقاومة المسلحة لإحداث التغيير، هو مجرد وقوع في فخ يضعه النظام الحاكم. يجب التذكر دوماً أن الثورات ضد أنظمة شمولية ومستبدة وهائلة القمع، تأتي على شكل انفجارات شعبية مفاجئة وحتمية، ولا تكون نتيجة لتحضيرات تشرف عليها نقابات أو تنظيمات سياسية معارضة، والتي هي في الغالب إما مسحوقة تماماً أو غير موجودة بالأصل (المثالين الليبي أو السوري). وبالتالي فإن حركات شعبية ضخمة وممتدة أفقياً عبر البلاد المُقطعة الأوصال بالهيمنة الأمنية والعسكرية، لا يمكن إلا أن تستجيب وبأشكال متفاوتة ومختلفة بحسب ظروفها لأشكال القمع الممارسة عليها، وهي بالتالي تطور أدواتها باستمرار لمجابهة تصعيد النظام القمعي على مطالبها المشروعة بالتغيير، وفي إحدى المراحل تتنقل إلى أشكال المقاومة المسلحة، وهو انتقال يكون حتمي في الغالب.
[هل هناك طرقٌ لم تُسلك في سوريا؟ هل كان الإصلاح ممكناً؟ هل كان مرغوباً؟]
– الشق الأول من هذا السؤال، يعتبر واحداً من أكثر الأسئلة التي يرددها الناشطون السوريون على أنفسهم بعد سنتين من الثورة. والسبب في حقيقة الأمر لا يعود إلى تزعزع الإيمان بضرورة الثورة، بقدر ما يعود إلى الرغبة بعدم تصديق كمية الدماء التي أريقت وحجم الدمار والخراب الذي أصاب البلد.
أعتقد أن المنتفضين في سوريا، وتحديداً على مستوى الشارع والحراك الثوري، قد أظهروا صبراً وصموداً مذهلين (ومازالوا)، ولم يهملوا أي طريق قد يؤدي إلى انتقال أسهل وأسلم للسلطة، رغم انتقال قطاعات واسعة منهم لاحقاً إلى العمل العسكري. لنتذكر بأن السوريين وحتى أوائل آب 2011، وبعد نصف سنة من اندلاع الثورة، كانوا ملتزمين على اختلاف مناطقهم ورغم عدم وجود مظلة سياسية موحدة تمثلهم، بأشكال الاحتجاج السلمي. (وقد جاء ذلك باعتراف صريح لبشار الأسد في أحد خطاباته). في حينه مثل اجتياح حماة نقطة فاصلة، تصاعد بعدها اللجوء إلى العمل العسكري. إلا أن الذراع العسكري لم يشتد عوده ويصبح هو سمة الثورة الأولى، حتى نهاية الربع الأول من العام 2012. وحتى حينه لم يدخر الثوار في الداخل مع امتدادهم عبر سوريي الخارج، جهداً في ابتكار أدوات المقاومة المدنية، وفي تقديم مقترحات للانتقال السلمي إلى مرحلة جديدة.
في المقابل، النخب السياسية المعارضة قصرت في أمور شتى، أولها في توحيد جهودها في إطار مظلة شاملة وفاعلة، دون أن يعني هذا بالطبع أن تصهر خلافاتها حول تفاصيل مختلفة عنوةً، وإنما على الأقل إيجاد جسد واحد متنوع الطيف ذي آليات فاعلة وواضحة. كما أن جزءاً من المعارضة يلام على عدم التقاط إشارات (بدت في حينه واضحة) حول عدم وجود نية في تدخل عسكري خارجي، وبالتالي فقد أدخلت نفسها في بعض الأوهام التي أضاعت الكثير من الوقت والجهد. فيما يلام جزء آخر على تمسكه بمواقف متعالية وواعظة تجاه الشارع الثائر، وتحديداً فيما يخص اللجوء المشروع إلى خيار المقاومة المسلحة، وصرف جزء كبير من الجهد على معاداة كتل معارضة أخرى وتحويلها إلى خصم موضوعي بديل للنظام. كما أن جهوداً إضافية كان يمكن بذلها من قبل عموم الكتل المعارضة على صعيد بناء جسور أقوى مع بعض الجماعات التي تعتقد بأنها ستكون معرضة للتهديد إذا سقط النظام. عموماً فإن حتى هذا القصور في أداء المعارضة السياسية، بحسب اعتقادي، لم يكن له وزن كبير في إمكانية تغيير مجرى الأمور وتجنب حجم الدمار الهائل الذي نقف أمامه اليوم، وإن كان تلافيه، لو حدث، كان سيدفع عجلة الثورة بشكل أسرع.
حقيقة الأمر أن الطرق التي لم تسلك في سوريا، والتي كان من شأنها توفير الكثير من الدماء والأهوال، هي طرق رفض النظام حتى النظر إليها. في كافة أطوار الأزمة حتى اللحظة، من الإصرار على وصف المطالب المحقة بالمؤامرة، إلى تعطيل مبادرة الجامعة العربية، وصولاً إلى دفع البلاد إلى أن ترتمي في أحضان التدخلات الخارجية. كانت الطرق متوفرة لو أراد النظام. بدأت بالاستجابة السريعة والناجعة لمطالب إصلاحية جذرية في الأسابيع الأولى، وصولاً إلى تسليم السلطة وتنظيم عملية انتقال سهل لمرحلة جديدة. وحدها هذه الطرق التي لم تُجرب في سوريا، ووحدها كانت ستحقن الدماء والفوضى.
– أما الشق الثاني من السؤال: هل كان الإصلاح ممكناً؟
يسود الاعتقاد أن قسماً كبيراً من السوريين كانوا سيعودون إلى منازلهم لو استجاب النظام للمطالب الإصلاحية التي راجت في الأيام الأولى للثورة. ولو أظهر رغبة جدية في تغيير بعض سياساته وتحديداً على مستوى التعاطي الأمني، وعلى صعيد السياسات الاقتصادية. لا أستطيع الجزم حول صحة الأمر، وبخاصة بوجود كُثر كانوا تواقين لانطلاق شرارة الانتفاضة حتى ينضموا إلى نادي الثورات التي لا تتحقق إلا بإسقاط النظام. ولكني أميل إلى فرضية تقول: أن استجابة النظام الفورية والفعالة للمطالب الإصلاحية في البداية، كان من شأنها أن تُخمد شرارة الثورة في المهد. لا يتعلق الأمر بقناعة السوريين الحقيقية بأن هذه الإصلاحات ستحيل حياتهم إلى أحوال من الرخاء، لكنهم كانوا سيعللون النفس بالتخلي عن المضي في طريق كانوا يعلمون أنه سيكون دموياً ومؤلماً. السوريون يعرفون نظامهم جيداً، وكانوا على دراية أن اقتلاعه بالقوة سيكون عملاً مُضنياً، وبالتالي لربما ارتضوا بالمكاسب الإصلاحية، على أمل خوض نضال طويل وبطيء لإحداث تغييرات على مستوى البنية السياسية، دون أي ضمانات بالطبع أن هذا سيحدث حتى بعد عقود.
بكل الأحوال هذا لم يحدث البتة، فلم يبدِ النظام أي مرونة أو أي رغبة في تقديم تنازلات ولو بسيطة. في حقيقة الأمر أعتقد أن الأمر منطقي للغاية. النظام السوري بوصفه نظام استبدادي، شمولي، بنى ركائزه على تحالفات اقتصادية وطائفية محسوبة بدقة شديدة. واشتغل لعقود على أسطرة رموزه، وترسيخ وجوده بأدبيات إيديولوجية تم تعميمها قسراً (حزب البعث)، وأضاف لاحقاً في عهد الأسد الابن، انتهاج سياسات نيوليبرالية لصالح طغمة مقربة ازدادت قوة وثراء، مع عدم إجراء أي تعديلات أساسية في عقليته الأمنية. كل هذه المكونات تجعل من المتعذر حقاً على النظام إجراء أي إصلاحات جذرية. على العكس من السائد باتهام النظام بالغباء لانتهاجه سياسة أمنية ومن ثم أمنية عسكرية لقمع الثورة، أعتقد أن النظام تصرف بالطريقة الوحيدة التي يجيدها ويعرفها وتنسجم مع بنيته، لا يتعلق الأمر بالذكاء أو الغباء! على عكس مصر وتونس وغيرها، لا يمكن هنا فصل رأس النظام وإعادة تكوين الجسد بما تبقى. في سوريا هناك تداخلات عضوية وعميقة بين رأس النظام وجسده، عبر العائلة والطائفة ورأس المال وأجهزة الاستخبارات والجيش. إضافة إلى تغول غير مسبوق للنظام على الدولة ومؤسساتها. النظام في سوريا ابتلع الدولة وهيمن على مفاصلها. يدرك النظام قبل غيره أن أي تنازلات أو إصلاحات حقيقة، تعني تفكيكه تدريجياً وبشكل سريع، وعليه فهو لم ولن يقوم بأية إصلاحات جذرية. حقيقة بات السوريون يعرفونها اليوم كما العالم، وعليه فهم يعلمون أن لا طريق سوى باقتلاع النظام إن كان هناك بصيص أمل في أن تنهض سوريا من جديد، لتكون دولة ديمقراطية وحديثة، دولة مؤسسات حقيقية.
[هل تجعل طبيعة الحكم الاستبدادي في سوريا العنفَ الطريقة الوحيدة لإنهاء الاستبداد وهل هذا هدف ملائم في حد ذاته أم هل يجب أن يكون هناك برنامج سياسي ثوري؟]
– الحقيقة أن أجزاء من الإجابة على هذا السؤال، وتحديداً فيما يخص حتمية استخدام القوة لإنهاء الاستبداد، قد أوردتها مسبقاً في إجابتي على السؤالين السابقين، وبخاصة كيف أن هذا الاستخدام جاء تدريجياً، ووفق ظروف موضوعية تبلورت مع تصاعد عنف النظام المُمنهج. هناك كم معتبر من الكتابات والنقاشات والتحليلات التي رصدت الظروف والأسباب التي دفعت بشرائح واسعة من المدنيين (الذين انخرطوا أولاً في الحراك السلمي) إلى حمل السلاح إلى جانب المنشقين عن الجيش (هؤلاء شكلوا أولاً نواة العمل العسكري المناهض للنظام).
تنوعت الآراء ومن قبل مراقبين غير سوريين، بين فريق يرى العمل العسكري ومنذ البداية بوصفه الخيار الوحيد في مواجهة نظام كالنظام السوري، (جلبير أشقر مثالاً). وفريق يرى أن تطور الحراك الثوري، واستناداً على ظروف الواقع العياني قد أوصل السوريين إلى هذه المرحلة وهو أمر طبيعي (فواز طرابلسي مثالاً). وفي التحليلين هناك قبول بحتمية هذا الخيار كرأس حربة في معركة السوريين لاقتلاع الاستبداد.
من نافل القول الحديث عن أن الخيار العسكري ليس غاية بحد ذاته، ولا يجب تنزيهه من كل انتقاد. هناك تحديات جسيمة تترتب على الحل العسكري، منها التعامل مع حملة السلاح مستقبلاً وضرورة خلق آليات لاستيعابهم، وهذا يفتح الباب على موضوع إعادة تشكيل جيش وطني جامع. في هذا المجال لا شك لدي بأن كثيرين ممن اضطروا لحمل السلاح سيكونون سعداء بالتخلي عنه عندما تنتفي الحاجة له. حتى اليوم يمكنك التواصل مع عديدين من حملة السلاح التواقين لاستئناف حياتهم كطلبة جامعيين أو حرفيين أو مهندسين ..الخ، هؤلاء ليسوا قلة.
من ناحية أخرى، من غير الإنصاف القول بغياب تام لبرامج سياسية ثورية، فالسوريون ومنذ الأيام الأولى توافقوا على مبادئ ثورية، صالحة باعتقادي لتكون أركاناً لبرامج سياسية ناضجة، هناك مجموعات حراك ثوري ومنذ مراحل مبكرة، وضعت برامج سياسية أو حتى خارطة طريق متكاملة لانتقال السلطة (لجان التنسيق المحلية مثالاً)، وهناك برامج سياسية لفصائل معارضة، أخرها كان وثيقة القاهرة للائتلاف الوطني. وهنك أوراق ومقترحات عديدة تم وضعها، تحمل تصوراً لسوريا المقبلة وتتطرق للشأن الاقتصادي والحقوقي إضافة إلى الشأن السياسي وشكل الدولة المُقبلة . الأدق ربما القول بعدم وجود إجماع على برنامج سياسي واحد من قبل جميع الثوار على اختلاف مناطقهم وأدواتهم، لأسباب متعددة ويطول شرحها هنا.
بالطبع أهم فوائد وجود مثل هذا الإجماع هو تنظيم العمل العسكري. تشكيل المجالس العسكرية والقيادة المشتركة بوجود الائتلاف الوطني كواجهة سياسية تنسق مع القيادات العسكرية كان فقط البداية. لكن هناك المزيد من العمل يجب أن يتم، لمواجهة تحديات أخرى إضافة إلى موضوع تنظيم السلاح لاحقاً، وهي مواضيع لا تقل أهمية، كضبط الممارسات الخاطئة لبعض الكتائب المقاتلة والتي تستغل شيوع العمل العسكري لتقوم بأعمال نهب وسرقة، أو أعمال عقابية وانتقامية. إضافة إلى موضوع شديد الخطورة وهو التعامل مع الفصائل الجهادية التي ربما ترفض الانضواء تحت برنامج سياسي ثوري موحد للعمل العسكري. بوجود برنامج سياسي موحد تتبناه المقاومة العسكرية، يتم معرفة حجم الفصائل الجهادية ووزنها، فكثير من الفصائل ذات الوجهة الإسلامية ليست بالضرورة منضوية تحت نفس توجهات فصائل جهادية متشددة كجبهة النصرة وكتائب الأنصار، وهو الأمر الذي لا يميزه الإعلام (الغربي منه تحديداً). إضافة إلى إمكانية استقطاب مقاتلين من هذه الفصائل، فهم في جلهم سوريين وليسوا غرباء قدموا من الخارج.
أسامة سعيد: بيان العنف
[ بمناسبة مرور عامين على اندلاع الثورة السورية، توجّهت “جدلية” إلى عدد من الكتاب السوريّين بحزمة أسئلة تنطلق من مقولة فانون حول العنف ودوره في التغيير الثوري. تقارب الأسئلة جدلية العنف والسلم في التغيير السياسي. فتقف عند مفهوم الثورة السلمية وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع. كما تتعرض إلى العنف كوسيلة للتحرّر، خصوصاً من نظام حكم استبدادي. والمدى الذي تفرض فيه طبيعة الحكم وسائل مقارعتها ومقاومتها. والسؤال المحوري: ما العمل؟]
نصبَ النظامُ خشبة المسرح التراجيدي، فاتحاً الأبواب كلّها لقتل شعبه وحصاره وتجويعه، كعقاب جماعي على كل من تُسوّل له نفسه الاقتراب من الكرسي المعمّد بالدم، والذي صرّح رامي مخلوف، في بيانٍ ـ حوارٍ مع النيويورك تايمز، في بداية الأحداث، أننا «سنقاتل حتى النهاية» دفاعاً عنه، منصّباً نفسه ناطقاً باسم النظام والجيش والطائفة، معتقداً أن أبناء سوريا، ليسوا سوى حطب لموقد ثروته وثروة الشركاء الآخرين. وها هو النظام، يكرر، في خطابه، اللغة نفسها، كما لو أن هذا البيان ـ الحوار كُتب من قبل جميع أطرافه، دون أن يكترثوا بأن جغرافية نفوذهم تتقلّص، ودون أن تهمهم معاناة ملايين السوريين على مدى عامين، من أجل كرسيّ، أقل ما يُقال فيه، إنه ليس ثمرة نضال واستحقاق، بقدر ما هو وراثة، كما لو أنّ الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها ليست سوى رصيد ماليّ مُطوَّب باسم شخص يحقُّ له أن يورّثه بوصية مكتوبة أو شفهية لمن يشاء، وها هي سوريا تدفع بدم أبنائها كلّهم ثمن هذا التوريث، فيما الوارث نفسه لا يسمع ولا يرى ولا يحسّ بما يجري في سوريا، فهل هو فيها حقاً؟
لم تصدر في ظل حزب البعث جريدة أو مجلة مهمة، أو محطة تلفزيونية أو إذاعة مهمة، أو تؤسس جامعة أو معهد أبحاث مهم، لم يرتفع دخل المواطنين، ولم تتحسن حياتهم، وكانوا بحاجة إلى أكثر من عمل في اليوم كي يؤمنوا خبزهم. ولم تتوقف السجون عن استقبال كلّ من يشكك بفردوس الشعارات الطنّانة والواقع المتردّي. مُورسَ عنفٌ تواطأ الجميعُ على عدم رؤيته، وقد ارتُكبَ بكل شراسة، لإخماد أي صوت معارض. ألم يكن هذا عنفاً ضد التنمية، وضد المواطنة وسياقها الحقيقي؟
فبماذا يفتخر الأبناء البارون لحزب البعث ومؤسساته الأمنية حين يُسألون ما الذي يقدّمه النظام لسوريا، في هذه اللحظة المصيرية، والتي تقف فيها سوريا أمام مفترق طرق، سوى أشلاء أبنائها الذين يسقطون في جميع المدن، واضعاً فئة اجتماعية بأكملها في فوهة المدفع، عبر إيهامها بأنها المستهدفة، وهي التي تخسر أبناءها، الذين حُرموا من التنمية في أريافهم فلم يجدوا أمامهم سوى التطوّع في الجيش ومؤسساته الأخرى لكي يعيشوا؟
هل ثمن الكرسي تدمير سوريا؟ هل ثمنها تدمير الجيش العربي السوري وأبنائه، الذين يخضعون لسلطة هرمية لا تكترث بآرائهم؟ وهل يصحّ أن نعتبر الجميع متورطين ومدانين يجب أن يُقتلوا؟ وهل هذا العنف المنفلت من عقاله، عنف السلطة التدميري، الذي يهدف إلى العقاب الجماعي، والذي يحصد في طريقه الأطفال والنساء والشيوخ، وكل من يقع في مرمى النيران في الأراضي المتمردة الخارجة عن الطاعة، والعنف الآخر المضاد، الذي دفعه عنف النظام إلى تبني لغة طائفيه وغرائزية، ويفتقد للرؤية والبرنامج، سيؤدي إلى حلّ في سوريا؟ على الرغم من غياب التكافؤ في المعادلة، يمكننا القول إن الجواب في غاية الوضوح… إن هذا العنف المزدوج سيحيل سوريا إلى رماد وأشلاء ودماء نازفة.
بدأ العنف في سوريا مع أول طلقة استهدفت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في حراك خلاق مشحون بمؤثرات الربيع العربي، ومتطلّع إلى خلع نير النظام الأحادي الأمني المستند إلى إيديولوجية مكرورة وممجوجة مفروضة بـ «البوط والتقرير» على الجميع في سوريا. وفي مجتمع يكمن فيه خطاب العنف على كافة المستويات، فإن هذا العنف أخذَ طابعاً انفجارياً انتقامياً لعبتْ الأطراف العربية والإقليمية والدولية كلّها دوراً في إدخاله في مسار يهدف إلى تدمير تدريجي لسوريا وتعميق الهوة الطائفية بين أبنائها.
إن العنف في سوريا الذي بدأته المنظومة الأمنية للسلطة ضدّ المتظاهرين ولّد عنفاً آخر شبيهاً به، عنفاً كان الهدف منه في البداية حماية المتظاهر السلميّ، كما قيل، إلا أنه وبعد أن خضع لتلاعبات إقليمية ودولية، صار عنفاً انتقاميّ الطابع، يهدف إلى القضاء على الدولة واستلام السلطة، إلى تكرار السيناريو الذي لا يتوقف عن إنتاج نفسه في الجغرافيا العربية. يهدف بكل بساطة، إلى القضاء على فرادة الحراك، وعلى إمكانية انتقاله عبر الحدود، بشكله السليم، إلى بلدان عربية أخرى، هي أيضاً بحاجة إلى تغيير جذريّ.
قد يكون فانون على حق، في السياق الذي قال فيه ما قاله، ولكنّ غاندي قد يكون محقّاً أكثر منه في سياقنا، إذ كيف نؤمن بقتل الإنسان من أجل الإنسان؟ ألن نكرّر المعادلة التوراتية، ونقتل الأخَ من جديد، لكي نبني نظاماً قائماً على القتل، يكرّر الأنظمة المتعاقبة القائمة على المعادلة نفسها؟ ألن نكرّر العنف الشامل الذي هدف إلى القضاء على الحراك؟ ذلك أن العنف هنا، في السياق السوري، ليس مرتبطاً بحركة تمتلك أهدافاً واضحة، وتتبنى رؤية سياسية عقلانية للحل يجمع عليها السوريون كلّهم، بقدر ارتباطه بجماعات متفرّقة، منقسمة، تغلب عليها انتماءات دينية ويدعو بعضها علناً إلى تأسيس الدولة الدينية. إنه عنف تنابذي، إلغائي الطابع ـ السلطة أحد أطرافه ـ ولا يهدف إلى البناء بقدر ما يهدف إلى هدم النسيج السوري.
وإذا ما دقّقنا في التفاصيل سنجد أن القوى التي تحمل السلاح على الأرض لا تندرج في إطار مشروع واحد يعكسُ التطلعات الجمعية للشعب السوري بكافّة مكوّناته، بل نجد أن الفئات قابلة للتصنيف وفق مرجعيات معيّنة، وقد تكون عابرة للدولة الوطنية أو عابرة للحدود، كمثل ظاهرة المجاهدين الذين فجأة نراهم قادرين على اختراق أي حدود في العالم بحسب الطلب، وقد يكون بينهم حالمون ـ كما يرى البعض ـ ولكن لم نر إلى الآن سيراً ذاتية فردية تؤرخ لتجارب من هذا النوع.
فُجع الحراك السوري بعنف النظام، وبتلاعب دول الجوار التي لا تريد للحراك أن ينجح في سوريا عبر دعم أطراف على حساب أطراف، عبر التذبذب في المواقف، عبر ازدراء واحتقار اللاجئين، وعبر صناعة الطابع القاعديّ للعنف المسلّح. اشتركت الأطراف كلّها في تدمير احتمال النضال السلمي البريء في سوريا. كان العنف الذي سُلّط شرساً، إلا أنه كان يجب ألا ينهي الملحمة النضالية السلمية الرائعة التي لو استمرت بكامل زخمها لقدمت رؤية جديدة خلاقة وغير مسبوقة تبدأ من سوريا وتشع في الاتجاهات كلّها.
تغيّر المشهد وانحدرت اللغة، فبدلاً من أن نسمع عن برامج سياسية حول سوريا المستقبل، المتعالية على الجراح، سوريا التي تحتضن أبناءها كلّهم، لا نسمع على المواقع سوى بيانات تدعو إلى الانتقام والتشفي، والإبادة، ونزع الملكية الشرعية، كما لو أن إعادة إنتاج العنف تقدم حلولاً سحرية لجميع المشكلات، وكما لو أنّ إعادة إنتاج الاستبداد في أشكال جديدة، صارت الهاجس الأكبر. ولن نغفل هنا القول بأن عنف النظام هو الذي دفع إلى هذا التطرّف، فلغة القتل والتنكيل التي تزرع الموت لن تحصد سوى الدمار.
إن العنف الحاليّ الممارس من قبل النظام والعنف المضاد الذي ولّده هما امتداد للعنف على مدى تاريخنا وهو عنف تآكلي تمزّقي لن يبني دولة ولا مجتمعاً، ولكن ربما من هذا الرعب كله، والزلزلة كلّها، والصدمة الجماعية والتمزقات والتهدّمات والتشرد وهدم البيوت بطريقة إجرامية فاقت كل التوقعات والاعتقالات الجماعية وعمليات النزوح نحو الداخل ونحو الخارج قد تولد احتمالات لولادة جديدة تعكس وعياً جديداً، يبني سوريا على أسس جديدة.
من هذا العنف الشرس، من هذه اللوحة الرمادية، ستولد سوريا أخرى تطرح الأسئلة من جديد وتعيد النظر في كلّ شيء وهذا هو الوعد المتجدّد للأجيال الجديدة.
يتوسع العنف المضاد ويمتدّ حاملاً عناوين ذات طابع إلغائي مطلق، تغذيه المواقف وطبيعة اللغة المستخدمة، والتي هي ممارسة للقتل كالرصاص. ثمة تعادل بالعنف، أو توازن للعنف، ليس بالطبع من ناحية القوة النارية، بل من ناحية الطبيعة الخطابيّة الانتقامية للعنف. كلّ طرف يرى في الآخر جثة يجب أن تُنتهك، كل طرف يمارس تصنيفه الخاص: أولاً نضع الجسد في الفئة الخاصة به ثم نسجنه، نذلّه، نغتصبه، نقطع رأسه، أو نطلق عليه النار، أو نقصفه بصاروخ عابر للقطر، لا يهم، المهم زراعة الرعب وقد أبدع النظام في هذا.
من الطبيعي أن تلجأ الأنظمة الاستبدادية إلى العنف، فهي قائمة عليه أصلاً، والدولة حتى في شكلها المتحضر إن هي إلا هرب إلى الأمام، نحو نسيان وتمويه لبؤرة العنف التي صدرت عنها.
إن كلّ من يبرر جريمة شريك فيها على كل المستويات، حتى لو كان المقتول إرهابياً حقيقياً، فكيف إذا كان مواطناً عادياً؟ لم يؤد العنف في العقود الأخيرة إلى حلول بل ترك الأمور عالقة في كثير من البلدان، ومن ضمنها بلدان الربيع العربي. ولكن ما الذي أنتجه القضاء على النظام الذي نصبه السوفييت في أفغانستان؟ ما الذي أنتجه العنف الذي أطاح بصدام حسين؟ هل أنتج يوتوبيا عراقية أم آفاقاً جديدة للعنف؟ إن العنف المنفجر في سوريا مشحون بخطاب إيديولوجي دينيّ متوارث، يتم تصنيعه إقليمياً عبر اختراع لعبة الصراع السني ـ الشيعي.
إن ما تقدمه اليوتيوبات من مناظر مريعة، ولغة التعليق المستخدمة، تكشف عن جلادين لا يعرفون الرحمة تزخر بهم صفوف النظام وبعض جماعات المعارضة، ويبدو أن كل طرف يستخدم القاموس المناسب لتبرير عنفه، فثمة من يقاتل الإرهابيين وهناك من يقاتل الكفار الصفويين والمجوس والنصيريين وهلمّجرّا. إن من يعزف على هذا الوتر يخلق مناخاً تضاديّاً تطوعّيا يخدم خططه للتجييش والتشكيل الميليشياوي.
لا أحد يقدر أن يقف في طريق التغيير في سوريا. ولكن التغيير لا يتم بالقتل الأعمى، والهجوم على مكتسبات الشعب السوري، ولا بالانتقام من طبقة الموظفين عبر استهدافهم وقتلهم فهم في النهاية لا يملكون شيئاً إلا وظائفهم وهم لا يدافعون عن النظام بقدر ما يدافعون عنها.
إنّ عنفاً مُتلاعباً به، تديره قنوات إقليمية ودولية، لن يقود لا في سوريا ـ ولا في غيرها ـ إلى سوريا جديدة ديمقراطية تعددية. إن العنف الانتحاري يعكس أنانية مقيتة، فمن يفجّر نفسه ليقتل وليخرب الممتلكات العامة والخاصة، لا يمكن أن يقود عنفه إلى أي أفق لولادة جديدة، فهو يقتل نفسه والآخر، ويقتل أي إمكانية لأي شيء ظانّاً أنه بهذا يحقق الخلاص الفردي، أي الذهاب إلى الجنة، والخلاص الجمعي عبر إرساء التجربة السياسية الدينية لإيديولوجيا المجموعة التي ينتمي إليها. إن هذا النوع من القتل قائم على مبدأ الرشوة (تيري إيغلتون). هناك وعد بالفردوس مقابل هذا القتل.
لا يمكن للعنف أن يكون منتجاً على أي مستوى في السياق السوري: لا عنف النظام المنفلت من عقاله ولا عنف الجماعات المسلحة. إن «السلمية» هي لغة التحضر والعصر والوقوع في فخ العسكرة أصاب الحراك السوري مقتلاً. كان الحراك المسلّح بمزيد من السلمية، بمزيد من التضحيات هو الحل الأمثل، ولكنّ حملة القمع والقتل غير المسبوقة لم تترك منفذاً سوى الانجرار إلى اللعبة، مما حرفَ التطلعات كلّها، وأدى إلى تقوقع فئات المجتمع السوري ضمن مرجعياتها، وإلى تحويل الحراك إلى خطاب أغلبية عددية، وفي خضمّ هذا كلّه لم نر برنامجاً سياسياً أو بياناً مطمئناً، كانت حرباً افتراضية ضروساً تذبح فيها المواقع والشاشات بعضها بعضاً متزامنة مع حرب على الأرض يذبح البشر فيها بعضهم بعضاً.
إن العنف قد يكون في سياقات معيّنة منتجاً ولكنه في السياق السوري سيقود إلى مزيد من العنف، إلى مزيد من التشفّي والانتقام وتراكمات الحقد، إلى أن ينفجر البركان وتخرج الماغما دفعة واحدة.
من المعروف، مما هو متداول في الدراسات المتعلقة بالموضوع، أن الدولة تحتكر العنف، أنها نتاج العنف ومُدجّنته، وهي التي تمنح لنفسها حقَّ استخدامه، وتبتكر شرعية قابلة للتعميم، هي شرعية حقّ حصر استخدام العنف بالدولة، ولكن ما حدث في سوريا خرقَ هذه المعادلة: كي تستخدم العنف، من أجل غايات معيّنة، ومن منظور سلطوي، يجب أن تكونَ دولةً، ولكي تكون دولة يجب أن تُرسي أسس الدولة، أما أن تمارس العنف دون أن تعمّق التجربة المؤسساتية، أي دون أن تصنع دولة بالمعنى الحقيقيّ للكلمة، فهذا يعني أنك تضع نفسك في مكان مفضوح، وهكذا بدل أن تكون الدولة مسؤولة عن الحل الأمني صارت الطائفة مسؤولة، وبدلاً من أن تكون المؤسسات الأمنية مسؤولة صارت فئات معيّنة مستولية على هذه المؤسسات مسؤولة، وهكذا أعيد إنتاج المشهد في سوريا على مصراعيه: تبدّى فشل ذريع على مدى عقود في تأسيس دولة مواطنة وقانون، وبدلاً من أن يُبْنى مجتمع منفتح على بعضه صُنعتْ تجمعات سكانية ضمن منظوماتها المستعادة جاهزة للتجييش والتوظيف وهذا ما يشهد عليه الواقع السوري بكل قوة.
موقع جدلية