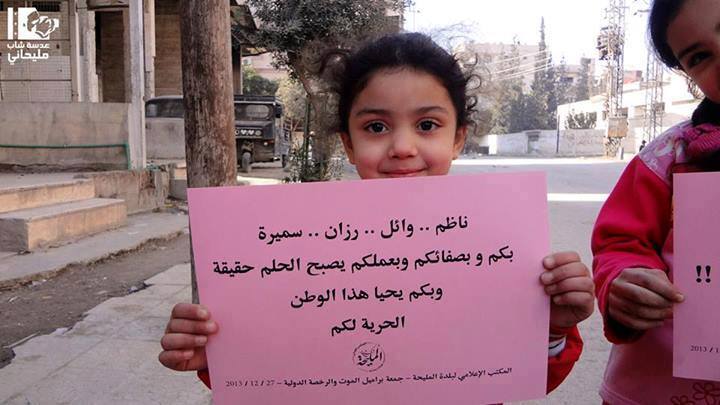سوريا وروسيا وحدود العلاقة “الحميمة”: سلامة كيلة

سلامة كيلة
الدعم الروسي للنظام السوري يوحي بأن العلاقات حميمة منذ زمن طويل، خصوصاً أن العلاقات كانت كذلك لعقود. لكن هذه النظرة تتجاهل صيرورة تحوّلات مرت بها. لقد كانت العلاقة حميمة حين كانت الحرب الباردة، حيث تحالف النظام مع الاتحاد السوفياتي رغم أنه لم يكن يقطع مع الإمبريالية الأميركية ويركز علاقاته الاقتصادية مع أوروبا.
وبالرغم من أنه كان يدفع نقداً قيمة كل الصفقات التي يجريها مع البلدان الرأسمالية فقد كان يشتري السلاح والأدوية من روسيا والبلدان الاشتراكية الأخرى بالدين. لهذا حين جرى التحوّل في الاتحاد السوفياتي قبل سقوطه جرت تصفية المديونية السورية التي بلغت حينها 12 مليار دولار على أساس أن تصبح العلاقة بعدئذ تقوم على “الحساب الرأسمالي”.
وتعزز هذا التوجه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتصار الرأسمالية. الأمر الذي فرض تراجع العلاقات الاقتصادية، وانحصارها في أدنى مستوى يتمثل في شراء قطع الغيار الضرورية، وأجور خبراء ظلوا يمارسون دورهم في سوريا.
بالتالي لم يعد لروسيا مصالح حقيقية في سوريا. وخصوصاً مع تأزم الاقتصاد السوري في تسعينيات القرن العشرين، أي مع نهاية عهد حافظ الأسد الذي كان ينطلق في سياسته الخارجية من ضرورة تحقيق التوازن الذي يسمح للنظام بأن يبقى “مستقلاً”.
الأمر تجاوز ذلك مع مجيء الرئيس السوري بشار الأسد، حيث عمل “الطاقم الجديد” على التخلص من كل الكوادر التي تدربت في الاتحاد السوفياتي من المواقع الأساسية في الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى. وارتبط بناء أجهزة الدولة تلك في الميل الذي فرضته سيطرة فئة جديدة على الاقتصاد، وسعيها لتحقيق الانفتاح الاقتصادي الكامل، الذي كان يعني منطقياً التوجه نحو “الغرب”.
فاللبرلة تفترض الارتباط بالمركز الإمبريالي، وتوسيع العلاقة الاقتصادية مع السوق الرأسمالي. لهذا ظلت العلاقات الاقتصادية قائمة مع هذا “الغرب”، وتوسعت. ودخل فيها النشاط المالي للفئة الرأسمالية (رجال الأعمال الجدد، الذي يسيطر عليهم حلف عائلي) التي باتت تسيطر على الاقتصاد والسلطة. وبدا التشابك الاقتصادي في هذا السياق. ورغم أن روسيا باتت رأسمالية لم يجرِ السعي لتطوير العلاقة معها.
بعد أزمة اغتيال رفيق الحريري، والحصار الأميركي لسوريا، وبالتالي انسحاب الشركات النفطية الأميركية التي كانت تسيطر على حقول النفط السورية، جرى الاتفاق مع روسيا على تشغيل بعض الحقول. لكن دون أن تتوسع العلاقات، التي سارت نحو النشاط المالي في الخليج، ومن ثم إلى تركيا، وبعد إذ إلى بعض بلدان أوروبا الشرقية. وظلت العلاقات التجارية قائمة مع البلدان “الغربية”.
كما ظلت العلاقات السياسية للنظام “باردة” مع روسيا، رغم تطور الحصار الأميركي. فقد عززت السلطة تحالفها مع إيران التي وقعت معها اتفاقاً إستراتيجياً لم يحدث زمن حافظ الأسد. وكذلك تحالفت مع تركيا، التي وقعت معها اتفاقاً إستراتيجياً أيضاً.
وبالتالي لم يقد الحصار الأميركي إلى أن يكون البديل هو روسيا. حتى فرنسا التي دعمت السلطة خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد على أمل أن تكون هي المسيطرة، انقلبت ضده بعد تلمسها أن كل المشاريع الاقتصادية تذهب للشركات الأميركية، رغم أنها رعت عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري. وحتى حينما عمل ساركوزي -بعد أن أصبح رئيساً- على فك الحصار عن السلطة، ظلت متمسكة بأن تكون وجهتها أميركا.
فقط في سنة 2010 حصل تقارب تمثل في إعادة تأهيل القاعدة البحرية الروسية في طرطوس (التي بنيت سنة 1981 وأغلقت سنة 1983 بناء على ضغط أميركي)، ومن ثم أنجزت صفقة صواريخ إس إس 300 التي كان البحث فيها قد بدأ من سنوات سابقة، ولقد أنجزت بعد أن دفعت إيران قيمتها.
وبالتالي فقد بدأت الثورة والعلاقة السورية الروسية ليست قوية، وكانت العلاقات الاقتصادية في أدنى مستوياتها. وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول السبب الذي جعل روسيا تتحمّس كل هذا الحماس في دفاعها عن النظام.
حين اندلعت الثورة كانت روسيا قد خسرت ليبيا للتو، ولم تتحقق الوعود الأميركية بالتعويض حينها (دخول روسيا منظمة التجارة العالمية). لكن الأهم هو توصل روسيا إلى أن الوضع الأميركي قد أصبح صعباً بعد الفشل في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي شهدتها سنة 2008، الأمر الذي جعلها تؤسس لسياسة جديدة تقوم على فرض “نظام عالمي جديد”، ينهي الأحادية الأميركية ويؤسس لثنائية جديدة أو لعالم متعدد الأقطاب.
من هذا المنظور كانت المسألة السورية مدخلاً لتحقيق ذلك، حيث عملت على إظهار ذلك عبر مجلس الأمن للتأكيد بأن أميركا لم تعد هي المقررة في السياسات الدولية، وأن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد الذي يفرض أن تكون روسيا شريكاً أساسياً في رسم هذه السياسات. وبالتالي أن يرتبط حل المشكلات الدولية، وتقاسم العالم بالتوافق بينهما.
لكن هذا الهدف الدولي، الجوهري لروسيا، لم يتم دون اتفاق مع النظام السوري. فقد عملت روسيا ككل قوة إمبريالية على أن يكون لموقفها ثمن سوري. وهي الصيغة التي أقامت العلاقة مع إيران على أساسها، حيث باتت تدافع عنها دولياً مقابل اتفاقات اقتصادية. ما الذي حصلت عليه روسيا من النظام إذاً لكي تدافع عنه بهذا الشكل “الجنوني”؟
في زيارته إلى موسكو بصفته نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (ووزير حماية المستهلك) وقّع د. قدري جميل عدداً من الاتفاقات الاقتصادية، ربما تحتاج إلى دراسة خاصة لكي يتوضح الطابع “الإمبريالي” للعلاقة الاقتصادية الجديدة.
لكن ما كان تسرّب قبل توقيعها بأشهر هو أن روسيا ترث الاتفاقات الاقتصادية التي كانت السلطة قد وقعتها مع تركيا. والتي كانت جزءاً من السياسة الاقتصادية التي أفضت إلى انهيار اقتصادي كبير كان في أساس الانفجار الشعبي، وكان قدري يعتبرها جزءاً من السياسات السيئة لـ”الفريق الاقتصادي” الذي وقعها، هذه السياسات التي قال إنها سوف تؤدي إلى كارثة، وفسّر بداية الحراك الشعبي في مراحله الأولى كنتاج لها (وليس مؤامرة إمبريالية، افتتاحية عدد أبريل/نيسان سنة 2011 من جريدة قاسيون).
لهذا باتت لروسيا مصالح جديدة نتجت عن استغلالها أزمة السلطة في دمشق التي أصبحت بحاجة إلى “حماية دولية” تتيح لها ممارسة كل عنفها الداخلي وهي ترى أن إنهاء الثورة يحتاج إلى عنف شديد يمكن أن يفتح على تدخل دولي، لأنها كانت تتخوّف كثيراً من تكرار تجربة ليبيا، رغم استحالة ذلك أصلاً (نتيجة ضعف أميركا ورفض تركيا). ولهذا تسعى روسيا لكي تضمن هذه المصالح المستجدة، لكن كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ هل بالتمسك ببشار الأسد إلى النهاية؟ أم يمكن أن تدعم تغييراً يضمن استمرار علاقتها “الحميمة” بالسلطة الجديدة؟
ربما تكون المصالح هي الأهم، لهذا لا يعود التمسك ببشار الأسد هو الأولوية. لكن كيف تتوصل إلى بديل يحقق مصالحها هذه؟
مشكلة روسيا تكمن في أن تأثيرها في البنية الصلبة للسلطة ضعيف بعد أن فقدت مواقعها كما أشرنا قبلاً. لهذا يبدو أنها تراهن على أن تضعضع السلطة وضعفها سوف يفرض قبول البعض في السلطة بحل يفتح على “مرحلة انتقالية” برعايتها. هذا الأمر ربما هو الذي يجعل تصريحات المسؤولين الروس “متناقضة”. لكنها أيضاً تريد موافقة أميركية على “وضع اليد” على سوريا، ربما من أجل كبح التدخلات الإقليمية والدولية الأخرى، وتسهيل المسار الانتقالي.
إذاً، هناك مصالح مستجدة لروسيا في سوريا، وهي التي تجعل روسيا تتمسك بالنظام بهذا الشكل “الهمجي”، برغم كل الهمجية التي يمارسها. على أمل أن تجد بديلاً “تابعاً”. فهي أيضاً تريد الاستقرار لكي تستفيد من العلاقة الاقتصادية الجديدة.
الجزيرة نت