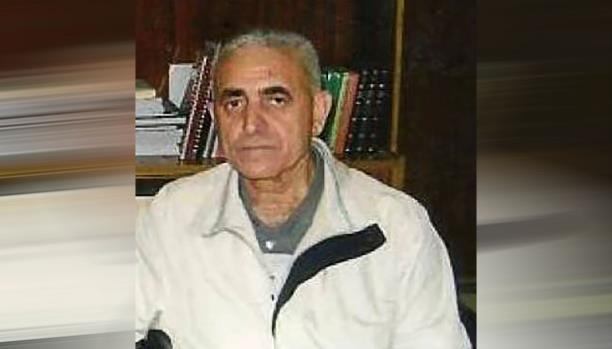سورية دون حال الطوارىء: مَن الذي سيتنحى؟
صبحي حديدي
إذا تكرّم بشار الأسد، فوجد وقتاً لتوقيع مشاريع القرارات التي أحالها إليه مجلس الوزراء، حول رفع حال الطوارىء وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم حقّ التظاهر، فإنّ بين الأسئلة الطريفة الفورية ذاك الذي يقول: وماذا سيفعل، بعد انقلاب المشاريع إلى قرارات نافذة، كبار الضبّاط في مختلف الأجهزة الأمنية، من أمثال اللواء على مملوك، واللواء زهير الحمد، والعميد ثائر العمر، والعميد أنيس سلامة، والعميد حافظ مخلوف (من جهاز المخابرات العامة/ أمن الدولة)؛ أو اللواء عبد الفتاح قدسية (المخابرات العسكرية)، واللواء جميل حسن (مخابرات القوى الجوية)، واللواء محمد ديب زيتون (شعبة الأمن السياسي)؟
كانت مهامّ هؤلاء تنصبّ على اعتقال المعارضين، نساء ورجالاً، شيباً وشباباً، والتنكيل بهم، وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، أو إلى محاكم مدنية ليست أقلّ ارتهاناً للجهاز الأمني، بتهم شتى صارت مضحكة أكثر ممّا هي مخزية (“وهن عزيمة الأمّة”، في المثال الأشهر). وكان بين مسؤولياتهم، “الجسام”، منع المواطنين من السفر، سواء رفعوا صوتاً معارضاً، أو عبّروا عن رأي مختلف، أو اشتُبه بهم جراء تقرير ملفق كتبه مخبر حاقد؛ ثمّ ابتزاز الممنوع من السفر حول أسباب سفره، التي قد تكون قاهرة، صحية أو عائلية مثلاً، بغية امتهان كرامته والضغط عليه.
وأمّا خلال الأسابيع التي أعقبت اندلاع الإنتفاضة السورية، فإنّ هؤلاء الضباط انخرطوا في مهامّ أخرى، أكثر تعقيداً والحقّ يُقال، لم تكن جديدة عليهم تماماً، وإنْ كانت قد اكتسبت صبغة مختلفة، واستدعت تقنيات مستجدة لم يكن هؤلاء الألوية والعمداء والعقداء على دراية كافية بها قبلئذ. كان عليهم استخدام كلّ أساليب الماضي في تفريق أو قمع مظاهرة ما، في درعا أو دوما أو اللاذقية او بانياس أو حمص، بما في ذلك إراقة الدماء وإطلاق القناصة و”الشبيحة”؛ كان عليهم ارتكاب هذا كلّه، ولكن… بعيداً عن العدسات الصغيرة التي يحملها المواطنون في هواتفهم الجوالة، أو آلات التصوير البسيطة التي صارت في متناول اليد!
وبالطبع، كان وأد الصورة، مثل استعادة أساليب مجازر حماة وجسر الشغور وحيّ المشارقة، خلال أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات، خياراً مستحيلاً ينتمي إلى ماضٍ ولّى وانقضى؛ ومعه انهارت جدران الخوف، الرمزية المجازية أو الواقعية الفعلية، إزاء شبح عنصر المخابرات، القاهر القاتل المروّع الذي لا يحاسبه قانون، بل تعطيه القوانين ترخيصاً بالقتل العشوائي، وتمنحه حصانة من أيّ وكلّ حساب. ولقد اتضح أنّ ثقافة الصورة هذه، واندراجها ضمن ثقافة أخرى في التدوين والتوثيق والتواصل الاجتماعي، أوسع نطاقاً وأبعد اثراً، باغتت تقنيات الماضي التي اقتاتت عليها الأجهزة طيبة عقود، وجبّت ما قبلها من معادلات في التطويع والترويض والقمع.
وما خلا تلفيق الأكاذيب لكي ترددها أبواق الأجهزة (مثل الزعم بأنّ مشاهد الفيديو الهمجي البشع، الذي يلتقط عناصر الأمن و”الشبيحة” وهم يدوسون على أجساد المواطنين في قرية “البيضة”، لم تقع في سورية)؛ أو التنويع على وصم المتظاهرين بصفات “المندسين” و”العملاء” و”السلفيين” و”الجهاديين”، واتهامهم بأعمال القنص وترويع الأهالي وتهريب السلاح؛ لم يعد أمام الأجهزة الأمنية سوى الرجوع إلى بعض أساليب الماضي التي لا غنى عنها، مثل الإعتقال، وتفريق التظاهرات بالغاز المحرّم دولياً، والقتل العشوائي باستخدام الرصاص الحيّ.
وثمة دلائل عديدة على أنّ الأجهزة الأمنية، التي شاركت وتشارك في قمع الإنتفاضة، مباشرة أو من خلف كواليس متعددة الإختصاص، أخذت تعيش حال “اغتراب” بين ماضيها غير البعيد (حين كانت تبطش وتستبدّ وتقمع، دون حسيب ولا رقيب)؛ وحاضرها الراهن الذي يشهد تمسكها بأساليب الماضي ذاتها، ولكن مع فارق حاسم هو أنها صارت مضطرة إلى ارتكاب الجرائم ذاتها بحقّ شارع باتت الجريمة تزيده إصراراً على المقاومة والصمود والإرتقاء باساليب الإحتجاج، من جهة أولى؛ وباتت الجريمة تُرتكب تحت سمع وبصر العالم بأسره، من جهة ثانية.
فإذا استغرق رأس النظام أسبوعاً لكي يُجبَر على نسف أكذوبة الأجهزة حول فيديو قرية “البيضة”، وتمّ الإعلان عن إقالة الرائد أمجد عباس مسؤول الأمن السياسي في بانياس وبطل تلك الجرائم الهمجية؛ فكم من الأسابيع يحتاج وزير العدل الحالي تيسير القلا عواد، بصفته رئيس ما يُسمّى “لجنة التحقيق في أحداث درعا واللاذقية”، لكي يقترح أي شكل من أشكال محاسبة عاطف نجيب، ابن خالة الرئاسة وبطل مجازر درعا؛ أو زعماء “الشبيحة” من أبناء عمومة وخؤولة الرئاسة، أبطال مجازر اللاذقية؟ وما الذي تنتظره الأجهزة الأمنية ـ وهي 17 طرازاً واختصاصاً، في عين الحاسد! ـ لكي تكشف هوية قتلة العميد عبدو خضر التلاوي، وولديه، وابن شقيقه؟ أو قتلة العقيد إياد حرفوش، والعقيد معين محلا، أو المجند محمد عوض القنبر، أو المجند محمد علي رضوان القومان، أو المجند محمد موسى الجراد، وسواهم من العسكريين الشهداء أبناء مناطق شتى من سورية؟ هل نامت نواطير النظام، إلى هذا الحدّ، عن ذئاب “المندسين” و”السلفيين” و”العصابات”؟ أم أنّ الذئب مدسوس من الأجهزة ذاتها التي يتوجّب أن تلقي القبض عليه، ولهذا فإنه حرّ طليق، يتربص بضحية جديدة؟
وهكذا، إذا تكرّم الأسد وأنعم على الشعب السوري بتوقيع مشاريع قرارات رفع حال الطوارىء، فما الذي سيكون عليه سبب بقاء اللواء علي مملوك في إدارة المخابرات العامة، إذا كان القانون سيمنعه من منع الناس من السفر، وعدم اعتقال أي مواطن إلا بأمر قضائي، أو بالأحرى حرمان سيادة اللواء من هواية الإعتقال ذاتها لعدم الإختصاص؟ وكيف سيعيش دون أن يمارس أفانين القمع جمعاء، بالكفّ والذراع واللسان والحذاء، كما يُشاع عنه؟ ومَنْ، إذا تراجعت صلاحياته واحدة تلو الأخرى، سوف يُقطعه هذه أو تلك من هبات النفوذ ومغانم السلطان؟ وهل، في سبيل إثبات الوجود وممارسة المهنة، سوف يعكف على كشف هوية قاتل الحاج عماد مغنية، في قلب العاصمة السورية، مثلاً؟
وزميله اللواء عبد الفتاح قدسية، رئيس دارة المخابرات العسكرية، هل سيتوقف عن اعتقال المعارضين المدنيين، ليتفرّغ لملفّ اغتيال العميد محمد سليمان، على شواطىء طرطوس، وإماطة اللثام عن الأسئلة الكثيرة التي اكتنفت العملية: مَن، وكيف، ولماذا؟ وزميلهما اللواء جميل حسن، رئيس مخابرات القوى الجوية، هل سيتصدى لكشف أسرار قصف موقع “الكبر” العسكري السوري، في ظاهر مدينة دير الزور، وهل سيكاشف السوريين بحقائق ما جرى، فيجيب على أسئلة مماثلة: مَن، وكيف، ولماذا؟ والزميل الثالث، اللواء محمد ديب زيتون، كيف سيفهم وظائف شعبة الأمن السياسي، إذا كان القانون سيسمح بحرّية الرأي والمعتقد والتنظيم والتظاهر، وما الذي سيتبقى من علّة وجود هذه “الشعبة” أصلاً؟
وكيف، بافتراض انحسار وظائف هؤلاء، وهي أسباب وجود وبقاء وليست مظاهر عمل وأداء فحسب، سوف تنعكس هذه التبدلات في توازنات جسم السلطة الأمني بصفة خاصة؛ ثمّ، استطراداً، احتمالات نشوب سلسلة من الصراعات الداخلية بين مختلف مراكز السلطة، حول ما سيتبقى من نفوذ أمني وأنساق نهب، وطرائق تسلّط على المجتمع، من جانب آخر؟ صحيح أنّ بيت النظام استأثر بمنابع النهب العليا، والأدسم، على نحو عائلي أو يكاد؛ إلا أنّ إدامة الإستبداد في مختلف أنماطه، من الإعتقال التعسفي إلى منع السفر وتسهيل أو عرقلة معاملات المواطنين المختلفة، كانت صانعة اقتصاد سياسي لضبّاط الأمن، الذين أخذت سُبُل التكسّب تضيق بهم يوماً بعد يوم.
تلك “صناعة” قائمة بذاتها، تتعيّش عليها المؤسسة الأمنية بمختلف تراتباتها ومراتبها، وتنطوي على سداد أثمان ترقى عملياً إلى صيغة “الجزية”، لقاء خدمات ملموسة لا تُؤدى إلا نادراً، وخدمات أخرى افتراضية لا تُؤدى أبداً، أو مقابل اتقاء الشرّ فقط، أو حتى اللطف فيه! فهل ستنتهي هذه “الصناعة”، بانتهاء القوانين التي شرعنت إطلاقها وترسيخها، سواء أكانت ضمن حزمة حال الطوارىء، أم تراكمت عبر تشريعات وقرارات وتعاميم، أو حتى بسبب “أعراف” محضة جرى الإتفاق عليها بين الأجهزة، بإذن من رأس السلطة نفسه؟ ولماذا ينتظر المرء من الذين خُسفت امتيازاتهم، أو هبطت مواقعهم من علٍ، أن يمارسوا الولاء ذاته لنظام لن يكون في مقدوره، بحكم طيّ صفحة الطوارىء والأحكام العرفية، أن يمنحهم التغطية والحصانة ضدّ القانون؟
وإذا ذهب المرء أبعد، إلى حيث يقود المنطق البسيط في واقع الأمر، فإنّ السؤال التالي هو هذا: كيف سيتعايش فساد الحيتان الكبيرة، من بيت السلطة العائلي أوّلاً، مع فساد القطط السمان الصغيرة، من بيوتات السلطة المختلفة، وعلى حساب مَن؟ وإذا توجّب أن تكون للقضاء كلمة حقّ، لكي لا يقول المرء: الكلمة العليا، فكيف سيفلت هؤلاء من المقاضاة، حتى في الحدود الدنيا التي شهدتها مجتمعات عربية أخرى؟ وإذا صحّ أنّ التناقض، وليس التعايش، هو الذي سيكون سيّد اللعبة؛ فأيّ صراع سينشب؟ وكم ستكون شدّة ضراوته؟ وما طبيعة، وطبائع، الإنحيازات التي ستتحكم بقواه وأطرافه؟
تلك، غنيّ عن القول، أسئلة إفتراضية تُساق على سبيل سجال، افتراضي بدوره؛ إذْ من غير الممكن لهذا النظام أن يتخرط في أيّ مشروع إصلاحي جدّي، وملموس. بنية النظام ـ كما ساجلتُ شخصياً منذ أن جرى توريث السلطة إلى الأسد الابن، وأساجل اليوم أيضاً ـ أشدّ استعصاء من أن تحتمل الإصلاح، وأيّ تبدّل طارىء في تكوينها المورفولوجي سوف يسفر عن كسور وصدوع وانهيارات يمكن أن تذهب بسائر البنية، وتنتهي إلى انهيارها. ذلك ما أدركه الأسد الأب منذ مطلع الثمانينيات، حين اهتزت بعض معادلات النظام وتوازناته الداخلية في غمرة الصراع المسلّح مع جماعة “الإخوان المسلمين”، ومع شرائح واسعة من ممثلي المجتمع المدني في المعارضة والنقابات والشارع الشعبي، ثمّ الصراع داخل بيت السلطة بين الأسد وشقيقه رفعت، وبين هذا الأخير وضبّاط كبار من أمثال علي حيدر وشفيق فياض وعلي دوبا.
وذلك ما يدركه الأسد الابن اليوم، في مواجهة الإنتفاضة الشعبية، من خلال المراهنة على الزمن (الذي قد يتكفل باهتراء الزخم الشعبي، أو انحسار نطاق الإنتفاضة الاجتماعي والجغرافي، وهبوط أهدافها إلى المستوى المطلبي الصرف، بما يكفل الإنقضاض عليها)؛ والتنويع بين تقديم فتات القوانين “الإصلاحية”، وتشديد إجراءات القمع. إنه، بالتالي، غير راغب في، وعاجز تماماً عن، توفير إصلاحات نوعية تكفل الحريات العامة، وتُصلح وتُعلي سلطة القانون، وتسنّ قانون انتخابات حرّة نزيهة خاضعة للرقابة القضائية، تأتي بمجالس تمثيلية كفيلة بتعديل الدستور جذرياً، وبإنهاء حكم الحزب الواحد، وإطلاق حياة سياسية معافاة، وسيرورات تداول سلمي للسلطة…
وفي انتظار أن تفرض الإنتفاضة الشعبية شروط انتقال سورية إلى حال ديمقراطية حقّة وحقيقية، فإنّ رفع حال الطوارىء في ذاته لن يرفع حال الإستبداد، ولن يجبر الحاكم على التنحي أمام إرادة المحكوم؛ ليس دون ثورة شعبية عارمة تكتمل وتتكامل كلّ يوم، فلا تجمّل السطح والمظهر، بل تُصلح في العمق، من جذور الجذور!
“القدس العربي”، 22/4/2011
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\21qpt996.htm&arc=data\2011\04\04-21\21qpt996.htm