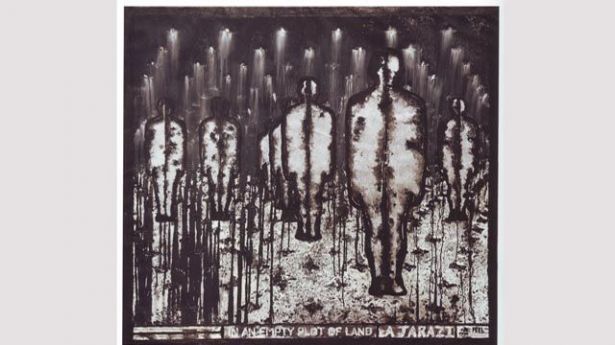سياسة التقوى: الإحياء الإسلامي ومسألة النسوية/ صبا محمود

ترجمة: عبير العبيداء
المقدمة
على الرغم من أن هذا الكتاب يتمحور حول السياسة الإسلامية في مصر فإن جذوره تعود إلى مجموعة من الألغاز ورثتها من مشاركتي في صياغة سياسة اليسار التقدمية في باكستان-مسقط رأسي. خلال السبعينات والثمانينات حينما اكتسب جيلي من الباكستانيين درجة متقدمة من الوعي السياسي، كانت القومية-ما بعد الاستعمار-قد ولى أوجها وكانت هناك خيبة أمل كبيرة مما يمكن للأمة-غير الحديثة بمقاييسنا الآن-أن توفر لمواطنيها. رغم ذلك كان لا يزال هناك شعور في أوساط اليسار النسوي في باكستان أن الماركسية النقدية والتروي تجاه قضايا عدم المساواة بين الجنسين، يمكن أن يوفرا وسيلة للخروج من المأزق وتنظيم جهودنا في تغيير الواقع المعيش. في هذا المجال ربما لم نكن نختلف عن نظيراتنا في دول مثل الجزائر ومصر وتونس، حيث أن ظروف ما بعد الاستعمار قد ولدت شعورا متماثلا من خيبة الأمل ولكنه أيضا كان ذاك الشعور الذي ننهل من معينه باستمرار نقلته لنا الوعود التي قطعتها لنا الإيديولوجيات المتلازمة-الماركسية النقدية والنسوية.
لقد بدأ الشعور بالاستقرار والغاية يتآكل لدى كثير منا في باكستان لأسباب يصعب حصرها بالكامل هنا. ولكن ثمة تطوران بارزان أحدهما هو تصلب دكتاتورية نظام ضياء الحق العسكري (1977-1988) الذي استعمل الإسلام لدعم قبضته الوحشية على السلطة وحول باكستان إلى دولة مواجهة في حرب بالوكالة ضد الاتحاد السوفياتي لصالح الولايات المتحدة. والتطور الثاني هو أن المساعدات الأمريكية لجيش ضياء الحق جعلت أي معارضة فعالة ومنظمة غير ممكنة. وعلاوة على ذلك فإن ضياء الحق وفي إطار أسلمة المجتمع الباكستاني، قد استخدم الإعلام والنظام التعليمي والأخطر أنه طوع القضاء لاستصدار قوانين تمييزية ضد المرأة (وهو ما رسخ في أذهان النسويات التقدميات أمثالي أن بقاؤنا واستمرارنا هو رهين موقف حازم من أسلمة المجتمع الباكستاني). إذا كان هناك من شك بأن أشكال البطريركية الإسلامية هي المسؤولة عن مشاكلنا، فإن هذا الشك قد تلاشى بالنظر إلى صراعات اليوم. لذا كانت السياسة النسوية تتطلب موقفا علمانيا حازما.
أما التطور الثاني فهو اندلاع الثورة الإيرانية في عام1979 وهو الحدث الذي أربك توقعاتنا للدور الذي يمكن للإسلام أن يقوم به في حالة التغيير الثوري وفي نفس الوقت بدأ ذاك الأمل الطفيف في السياسة اليسارية العلمانية ينطفئ في المنطقة. في حين أن الثورة الإيرانية كانت نتاج سياسة القمع التي انتهجها الشاه، فإنها قد تزامنت مع حركة تدريجية ومتشددة في العديد من المجتمعات الإسلامية نحو إعادة التأكيد على مذاهب المؤانسة الإسلامية وأشكالها. الأكثر إثارة للدهشة للنسويات كانت حقيقة أن هذه الحركة لم تقتصر على المهمشين والمحرومين بل لاقت دعما واسعا ونشيطا لدى أفراد الطبقات الوسطى الذين ازداد نقدهم لمحاكاة نمط عيش وعادات الغرب مع تزايد الحرص على العيش بما يتلاءم والأعراف الاجتماعية الإسلامية. كنا في اليسار الباكستاني، في كثير من الأحيان قد رفضنا هذه الطفرة في التدين بوصفها ظاهرة سطحية، على أساس أنها لم تترجم إلى نجاح في الانتخابات لصالح الأحزاب السياسية الإسلامية الباكستانية. (رغم أن تحالف الأحزاب الإسلامية قد فاز في انتخابات المجلس الوطني لأول مرة في تاريخ الباكستان سنة 2002).
تناول اليساريون التقدميون مثلي تحول “الجماهير” هذا إلى أشكال المؤانسة الإسلامية بعدة طرق: في بعض الأحيان نرجعها إلى نقص التعليم والفكر المستنير بين الغالبية العظمى من الشعب، وأحيانا إلى طبيعة الإسلام السعودي المحافظ التي جلبها العمال المهاجرون في دول الخليج العربي معهم عند عودتهم إلى باكستان وأحيانا أخرى لآثار المحاكاة التي ولدها نظام ضياء الحق القمعي حتما لدى عامة الشعب. ثم كان هناك دائما تفسيرا بأن ذاك التحالف الآثم بين العواصم الغربية (خاصة الولايات المتحدة) وممالك الخليج أثرياء النفط (خاصة السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) قد دعم بنشاط وحرض على ترسيخ نمط الإسلام المحافظ في جميع أنحاء العالم الإسلامي وذلك لهزيمة تلك الحركات التقدمية التي قد تعارض مثل هذه التحالفات.
رغم أن جميع هذه التفسيرات لها نصيب من الصواب، فقد خلصت خلال العشرين سنة الماضية أو نحوها إلى أنها داحضة. جزء من هذا الشعور بعدم الرضا متأت من الإقرار بأن الكوكبة الاجتماعية والسياسية التي حشدتها حركات الإحياء الإسلامي تختلف بشكل كبير وفي كثير من الأحيان اتخذت أشكالا مختلفة تماما عما حدث ويحدث في باكستان منذ تولي ضياء الحق الحكم إلى الآن. فعلى سبيل المثال في عدد من دول الشرق الأوسط ظلت الأحزاب الإسلامية أداتيه في الاستجابة للمطالب الشعبية بدمقرطة الساحة السياسية وإنهاء نظام الحزب الواحد واتخاذ موقف نقدي من هيمنة الولايات المتحدة في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن منظمات الرعاية الاجتماعية الإسلامية في العالم الإسلامي صعدت على نحو متزايد لملء الفراغ الذي تركته حكومات الاستقلال بما أن هذه الأخيرة تأخرت في توفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها في ظل ضغوط الاقتصاد النيوليبرالي.
إن الصعوبة التي يجدها اليساريون التقدميون-مثلي-في الإقرار بهذه الجوانب من حركات الإحياء الإسلامي سببها، في نظري، يعود في جزء منها إلى سقمنا التليد من ظهور الدين خارج الفضاء الخاص بالمعتقد الفردي. بالنسبة لأصحاب الفكر الليبرالي العلماني المشحوذ جدا والتقدمية العقلانية فإن أدنى طفح للدين في الفضاء العام يعد إهانة علنية خطيرة، تهدد بإخضاعنا إلى أخلاقيات معيارية يمليها علينا الملالي والكهنة. هذا الخوف يصاحبه ثقة عميقة بالنفس إزاء صدقية المخيال العلماني التقدمي، وأن أشكال الحياة التي تهبها هي أفضل لتلك النفوس غير المستنيرة، الغارقة في أوهام الآمال التي تعدهم بها الآلهة والأنبياء. ضمن نظرية المعرفة العلمانية، نميل إلى ترجمة الحقيقة الدينية كقوة، أو كلعبة السلطة التي يمكن إرجاعها إلى مكائد المصالح الاقتصادية والجيوسياسية.
بالتأكيد الشعور بالاستياء الشديد من عدم قدرتي-وعدم قدرة رفاق النضال الطويل-على فهم السبب الذي جعل لغة الإسلام تستحوذ على تطلعات الكثيرين في كافة أرجاء العالم الإسلامي. لقد وصلت إلى درجة زعزعة قناعاتنا-رغم حسن النية-بأن أشكالا أخرى من الازدهار البشري والعوالم الحية هي بالضرورة أقل شأنا من الحلول التي وضعناها تحت يافطة سياسة “اليسار العلماني” كما لو كان هناك وحدة في الرؤية تجمعنا تحت هذه اليافطة، أو كما لو أن السياسة التي نتبنى بفخر لم تؤد إلى كوارث مذهلة. إن مساءلة الذات هذه لا تعني أني توقفت عن مناهضة الجور سواء أكان متعلقا بقضايا الجنس والعرق والطبقة، والجنسانية التي تؤسس حاليا لوجودي الاجتماعي. إن دلالات ذلك –كما أصبحت أعتقد-أن بعض التدقيق الذاتي والشك ضروريان فيما يتعلق باليقين تجاه التزاماتي السياسية الخاصة، عند محاولة فهم حياة الآخرين الذين لا يشاركونني بالضرورة هذه الالتزامات.
هذا ليس ضربا من السخاء ولكنه تولد من إحساسي بأنه لم يعد بإمكاننا أن نفترض بغرور أن أنماط الحياة العلمانية والعلمانية في تركيباتها التقدمية تستنفذ بالضرورة سبل المعيشة الهادفة والثرية في هذا العالم. لقد قادني هذا الإدراك إلى تضييق مدى اليقين السياسي لدي بما أني أكتب تحليليا حول ما يبعث الحيوية في أجزاء من الحركات الإسلامية وقد اضطرني هذا إلى رفض أن يكون موقفي السياسي تلك العدسة اللازمة التي ينبغي لتحاليلي أن تمضي قدما من خلالها. وباختصار، فإنه قد اضطرني إلى ترك المجال مفتوحا أمام فرضية أن يكون تحليلي قد حاول تعقيد تصور ازدهار الإنسان-وهو ما أجل-ووفر صخر الأديم لوجودي الشخصي.
وإذ يركز هذا الكتاب على الحركة الإسلامية في مصر، بعيدا عن مسقط رأسي ونضالاتي التنشيئية، فذلك مؤشر على نوعية الاضطرابات الفكرية والسياسية التي شعرت أنها ضرورية حتى يتسنى لي التفكير من خلال تلك الأحاجي والمعضلات والتحديات. حقيقة أن مصر لا تواجه حاليا حربا أهلية يكون الإسلاميون الطرف الأساسي فيها، كما هو الحال في باكستان والجزائر، جعلت مصر المكان الأكثر ملاءمة لمباشرة الفكر والعمل. عمل لا يمكنه النجاح في ظل وتيرة الأحداث التي تتطلب باستمرار الانغلاق السياسي والعمل الاستراتيجي. أنا لا أعتقد أنه في أي وقت مضى-كان بإمكاني أن أرى ما أمكنني رؤيته خلال عملي الميداني في مصر لو مكثت ضمن المحيط المعهود بباكستان. آمل أن تجد محاولاتي في التفكير في هذه المحنة-ما بعد الاستعمار في العالم الإسلامي-صدى لدى قرائي.
(منشور بالتعاون مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود)