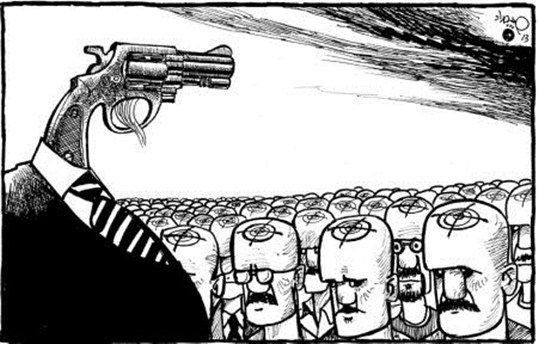شبكة العوارض الذهنية – المعرفية المعترضة طريق الإصلاح
وسام سعادة
أول التغيير في العالم العربي هو اخراج مقولة التغيير نفسها من قيد الابهام، والعود بها الى حوض الدلالة. يكون ذلك بالتوقف عن اعتبار «التغيير» نعتاً سحرياً نخلعه على من نشاء، ونحجبه عمّن نشاء ساعة نشاء.
فالرائج عربياً قانونٌ يختزل حدود كل المفاهيم والتصوّرات ويمسخها الى محض نعوت تساقُ إما على سبيل بذل المدائح أو بغرض كيل الأهاجي. هذا في الوقت نفسه التي تحمّل فيه هذه النعوت المعجبة طاقة سحرية تخال أنها تغدق بالخوارق على الممدود وتنزل باللعنات على المهجو أو المذموم.
وحتى لو سلّمنا بأن الحركة التاريخية العالمية هي حركة «الانتقال» من النظم «الديكتاتورية» إلى النظم «الديموقراطية»، وأن التغيير يقاس على هذا الأساس، فإن هذه الحركة التاريخية المفترضة، والمفترض أنها تتم على دفعات أو موجات، ليست بالنفس الملحمي تستطلع، ولا بالغائية المفرطة أو بالحتمية الغالية تقرأ.
بكلمة أخرى، ليس التغيير في جميع حالاته هو سنّة السنن التي لا رادّ لها. والحمد لله أن التغيير ليس كذلك، وإلا ما كان بالمقدور القبض على حركته في مقولة، والشخوص الى الاشكالية التي يطرحها علينا راهناً، والتي ليست من البداهة في شيء.
1 ـ الحساسيات الحداثية الثلاث
فالتغيير، وتحديداً، صنفه السياسي، مقولة ـ اشكالية، ولها تاريخها. اذ هي طرحت في العصر الحديث في أعقاب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية، وتوزعت من بعد مؤتمر فيينا بين ثلاث حساسيات أيديولوجية وسياسية متقابلة.
أولى هذه الحساسيات تقلب المعادلة الثقافية ـ السياسية للنظام القديم، فبدلاً من أن يكون التغيير هو الاستثناء والتقليد هو القاعدة أو الزمن الطبيعي لسير الأمور، اذا بنا نحيل على العكس. يجري «تطبيع» التغيير ويتكرس كقاعدة تلقائية ـ بديهية، قاعدة تنصح بالحفاظ على السريان التلقائي، في محاذرة للافراط، أو للمصادرة على الطبيعة.
في مقابل هذه الحساسية «الليبرالية»، انوجدت الحساسية «المحافظة». ليست تريد العودة فعلاً الى معادلة النظام القديم، انما تريد تغيير مقولة التغيير نفسها، بإدخال التقليد نفسه الى متنها. بحيث يكون التقليد محكاً عضوياً يلزم التغيير بأن يقدّم له أوراق اعتماده، كما يدفع التغيير الى التخصيص، بأن تتجزأ القضايا وتصير عينية تطرح الواحدة بعد الأخرى، فلا تؤدي الطفرة الى الضغط على الطاقة الاستيعابية للتغيير في المجتمع المعني.
من هنا، جاهرت هذه الحساسية «المحافظة» بأنها الأقدر على منح التغيير السياسي صفة «تقريرية» فاصلة، موجهة التهمة للحساسية «الليبرالية» بأنها تميّع مقولة التغيير عند تطبيعها، بل تسقط من التغيير دالّته السياسية.
ولم يتردّد العلامة الأسباني، المتفاخر بانتسابه الى سجل «الثورة المضادة» خوان دونوزو كورتيز (1809-1853) في ذم البرجوازية الليبرالية ـ البرلمانية، واتهامها بأنها مجرّد طبقة ثرثارة تسلب السياسة معناها التقريري، وتستعيض عن اللحظات التقريرية الحاسمة، إما بالتداول الخطابي الديماغوجي المبني على اللغو والابهار، وإما بالانصراف الى الجانب التسييري الاداري التقني البحت، واما بالزعم بأن ثنائية المزاحمة والتعاقد تسري في السياسة كما في عالم المال والاقتصاد.
ولم يتردّد دونوزو كورتيز، وفي معرض ذمّه عدمية الكائن الليبرالي، الذي يفرّغ الطبيعة من مضمونها حين يطبّع التغيير، من تقدير نبل المناضل الاشتراكي أو الفوضوي، الذي يعاديه بشرف.
فقد نهضت في مقابل الحساسيتين «الليبرالية» و«المحافظة»، تلك الحساسية «الاجتماعية»، التي نظرت الى التغيير من طرف المباينة بين تغيير الأشكال والمؤسسات وبين تغيير البنى والعلاقات. فأنكرت أن تكون الرابطة بين التغييرين المؤسسي والهيكلي قائمة بالمباشرة، بل شهّرت بهذه المباشرة المزعومة، بوصفها «وعياً زائفاً»، أي بوصفها مانعة أو معيقة لتعميق وتسريع وتوسيع منحى التغيير.
في آخر الأمر، كان على الحداثة الغربية أن تعرف كيفية التأليف بين هذه الحساسيات الثلاث («الليبرالية» القائمة على تطبيع مقولة التغيير، و«المحافظة» القائمة على ربط حلقة التغيير بدائرة التقرير، و«الاجتماعية» القائمة على ردم الهوة بين التغيير المؤسسي والتغيير الهيكلي). ولم يتأمن التأليف بشكل شامل، الا بعد أن جرّبت كل حساسية بلوغ المدى القصوي لممكناتها النظرية والعملية. فكان علينا انتظار مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبالذات مجرى تطوّر الأوضاع في أوروبا الغربية أيام الحرب الباردة، لكي نشهد انبثاق مساحة وافية ومستقرة نسبياً من «الاجماع الديموقراطي ـ الليبرالي» من حيث هو الشكل السلمي المستديم لتنظيم عملية التناقض والتفاعل بين الحساسيات الحداثية الثلاث المرتبطة بإشكالية التغيير (الليبرالية والمحافظة والاجتماعية)، ومن وراء هذه الحساسيات تنظيم عملية التناقض والتفاعل بين مبدأ الاقتراع العام وبين مبدأ التمثيل.
المفارقة ان أثر هذا «الاجماع الديموقراطي ـ الليبرالي» بالنسبة الى شرقنا العربي ـ الاسلامي بقي يخضع لتصوّر آخر بشأن الاجماع وفحواه، أي للموروث الذي يفيد بأن الأمة لا تجتمع على خطأ أو على ضلالة، وبتتمة هذا الموروث، أي حديث «الفرقة الناجية».
بشكل أو بآخر، تقدّم التيارات السياسية والأيديولوجية العربية الرئيسية، تنويعة من عدّة أنواع تخليط ما بين الاجماع، برتبته ما قبل الحداثية، وبين الاجماع، بمفهومه الحداثي.
الاجماع ما قبل الحداثي، هو شكل تنظيم عالم لم يزل مسكوناً بالسحر، أو لعالم يبقى عرضة لاجتياح الغيب في أي حيّز أو لحظة. انه اجماع يتأمن في عالم يفتقد الى قائمية خاصة به.
أما الاجماع الحداثي، فبالاضافة الى كونه تربة مشتركة لرعاية الاشتباك بين حساسيات متقابلة، ليبرالية ومحافظة، واجتماعية، وبالاضافة الى كون الدولة ـ الأمة هي الشكل التاريخي الأمضى لتحققه، الا أنه يقوم أساساً وفقاً لصورة عن العالم نجحت في تحصين نفسها ضد اجتياحات الغيب الفجائية، كما نجحت في ترويض أسباب السحر داخلها، لأجل تأسيس قائمية خاصة بهذا العالم.
هذا التخليط بين «الاجماع» المنقول وبين «الاجماع» المعقول، هو الذي يعيد انتاج ثنائية التبديع والتأصيل كثنائية لم تزل مركزية في مقاربات وسلوكيات أغلب التيارات الفكرية والسياسية على الساحة العربية.
2 ـ اعادة انتاج ثنائية التبديع والتأصيل
اذا ما رجعنا الى شرقنا العربي ـ الاسلامي، المفترض فيه أنه الأكثر تأثراً بقربه الجغرافي والحضاري من الغرب، والمشارك هذا الغرب أصوله الثقافية الهلنستية والتشريعية الرومانية، بالاضافة الى تقاسمه أو «تنازعه» الارث التوحيدي الابراهيمي، فإن عقبة ذهنية ـ معرفية كأداء تصادر مسعانا عند أول منعطف.
تتمثل هذه العقبة في الاستعداد السريع لتقبل نتائج التغيرات الحادثة عند الآخرين، مع التبرّم أو الاحجام بإزاء سيرورة التغيرات بحد ذاتها.
بل ان هذه القسمة الضيزى بين التغيرات ونتائج هذه التغيرات وتبعاتها أو تداعياتها، تعود وتستتبع بقسمة «تأصيلية» توزع النتائج والتبعات نفسها بين تلك المضلّلة والمشبوهة، الضارة والمردودة، وبين تلك المستحسنة والمسموح باستيرادها.
بمعنى آخر، تستلب مقولة التغيير السياسي بثنائية التبديع والتأصيل، أي توزيع كل كبيرة وصغيرة بين بدع حسنة قابلة للتأصيل، أو قابلة للاحالة على أصول يقوم بها التراث، وبين بدع ضالة، ليس بالامكان احالتها على أي أصل له مقام في تراثنا.
لا بل ندّعي بأن ثنائية التبديع والتأصيل ليست تحصر في الثقافة السياسية لما يعرف بالتيار الديني أو بالاسلام الحركي أو الحزبي أو «السياسي». انما هي ثنائية تشمل بفيئها كافة الثنائيات التي راجت ثم توارت على وجه التتابع أو التتالي في العقود الأخيرة، من القسمة بين تيار علماني وتيار ديني، أو بين تيار يساري وآخر يميني، أو بين تقدميين ورجعيين، وقوميين وإقليميين أو قطريين.
ثم تراهم ينقسمون بعد ذلك بشأن تقييم التجربة الاستعمارية.
ثمة رهط يجعل من مناهضة المستعمر معياراً للتأصيل والأصالة. يجعل هذا الرهط من الاستعمار جوهراً واحداً في جميع أشكاله، كما يجعل من مواجهة الاستعمار جوهراً واحداً بصرف النظر عن القوة الاجتماعية التي تواجه، أو البرنامج السياسي الذي يؤهّل للمواجهة. وينقسم هذا الرهط بدوره بين فئة تستحسن بعضاً مما يطبّقه المستعمر في «حاضرته»، أي في بيته الخاص، في مقابل التشهير بما يطبّقه نفس المستعمر «ما وراء البحار»، أو في «العزبة الكولونيالية»، وبين فئة تميل الى تقزيم هذا الاستحسان أو الاحتراس منه، اما بالتأكيد بأن خير المستعمر كلّه انما جناه من النهب المتواصل للأقاليم البعيدة التي استباحها، واما بالتأكيد بأن المستعمر لم يكسب من استئساده واستكباره الى عذاب روحه وفقرها.
وثمة من الناحية الأخرى معشر «مزدوجي الموقف» حيال الاستعمار بحد ذاته، وبما يتجاوز مجرّد التمييز بين المستعمر كما هو في بيته، وبين المستعمر اذ يستبيح حرمات الآخرين. عند هذا المعشر الثاني أن آثار الاستعمار نفسها يمكن أن توزّع بين ضارة ونافعة، وأن الآثار الضارة لا ترد الا بالاتكاء على تلك النافعة.
بعد ذلك نصير، راهناً، أمام كتلتين برزتا هذا النحو مع نهايات الحرب الباردة، ثم مع قيام فتعطل عملية السلام في الشرق الأوسط.
احدى الكتلتين تصف نفسها بـ«الممانعة». وتتراوح بين دولة يتيمة للـ«ممانعة العربية» هي سوريا، وبين حركات منها الاسلامي ومنها القومي، ومنها الما بين بين. ظهرت أول الممانعة بعد مؤتمر مدريد على قاعدة الفصل الكيفي بين ما «للتسوية» وما «للسلم»، واستباق مجرى عملية السلام للتأكيد بأن التفاوض هو مواصلة للصراع بطرق أخرى، وأن التسوية، في أحسن أحوالها، لن تكون الا مواصلة للصراع بطرق أخرى، بجعله صراعاً ضد «التطبيع» و«الغزو الثقافي».
تنظر هذه الكتلة «الممانعة» الى التأثيرات الخارجية والأجنبية على أنها شهوات ينبغي أن لا تؤخذ الذات بها، بل أن تتمنّع، وتحبس شوقها الى الاغتصاب ما استطاعت الى ذلك سبيلاً، فتمتص الاغواءات قدر الامكان، وتظل تتحايل على موجبات الاصلاح، بافتراض أن الاصلاح عيب وكشف عورة، مع اقرارها الخطابي كذلك الأمر بأن عدم الاصلاح عيب وكشف عورة. في كل الحالات، ينبغي أن يغلب التمنّع التطبّع.
أما الكتلة الثانية، فتنادي «بالاعتدال». بعضها أفراد لكن أكثرها أنظمة متسيّدة في كذا دولة عربية. ابتدعت لها الأيديولوجيا المسيطرة عالمياً نظرية خاصة، يمكن الاصطلاح على تسميتها «نظرية التطور اللاديكتاتوري»، استيحاء من نظرية نيكيتا خروتشيف في «التطور اللارأسمالي». مع ذلك فإن بعض هذا الاعتدال يزاول لعبة الممانعة بأشكال متوارية، أو هو يعتقد بأنه شكل فطن أو لبق من أشكال الممانعة.
إذا كانت المدرسة السوفياتية قد نظّرت في الستينيات لتجويز تطوّر الأنظمة الوطنية التقدمية في العالم الثالث بشكل لا رأسمالي، حتى من دون تولية الطبقة العاملة، فإن المدرسة الأميركية باتت ترى أنه في البلدان التي لا داعي فيها للتدخل العسكري المباشر، ولا داعي لا لعلاج الكي ولا لكفالة أمة، يمكن المراهنة الديموقراطية على العلاج بالمراهم، والتسليم «بتطور لا ديكتاتوري» يسقط الأساس من فكرة الديموقراطية، عنينا الارادة الشعبية العامة، أو الشعب كمصدر للسلطات، وبالذات، الشعب كمصدر للتشريع، علماً أن المقولة الأخيرة هي تلك التي تواجهها الحركات الشعبوية، القومية والاسلامية، بشكل عات.
وسواء في حالة «الممانعة»، نظاماً وتيارات، أو في حالة «الاعتدال»، أنظمة وأفراداً، فإننا نشهد القسمة نفسها، القائمة على معاودة التفريق بين البدع الحسنة والبدع الضلال. كما لو أنه يمكن التكيف مع مفترضات التحديث، أو تكييف التحديث مع طبيعة وتاريخ المجتمعات العربية والاسلامية بمثل هذه القسمة بين «اعتدال» و«ممانعة».
مع ذلك ليست تعدم موجبات المفاضلة بين «الممانعة» و«الاعتدال». ليس شرط هذه المفاضلة الاقرار بالطابع «الديموقراطي» لأنظمة «الاعتدال» في مواجهة الطابع «الشعبوي» أو «التسلّطي» للممانعة، فالديموقراطية ليست سلفة معنوية تعطى على هذا النحو.
انما قوام المفاضلة أن الممانعين ذهبوا أشواطاً غير مسبوقة على طريق اشاعة مناخات التدمير الذاتي، وانكار الهزيمة القومية والحضارية. فالممانعة شكل من أشكال العدمية بمجرّد أنها تعتبر، وخصوصاً في حال تعميم مشهدية الانفصال الانقلابي ما بعد حرب تموز في لبنان ومشهدية الانقلاب الانفصالي لحماس في غزة، بأن عهد الهزائم قد ولى، وأقبل عهد الانتصارات.
أما «الاعتدال» فإنه ليس يعي كافة أبعاد ومستتبعات الاعتراف بالهزيمة، خصوصاً اذا ما احتسبنا حالات «متطرفة» منه، تحسب أن الهزيمة القومية والحضارية هي شكل مازوشي من أشكال الانتصار، وأن العقل كان يتبختر على صهوة جواد يوم سقطت بغداد. بيد أن «الاعتدال» جملة، أنظمة وأفراداً، يبدو أقدر على الدعوة للاعتراف بالهزيمة القومية والحضارية كأمر واقع ليس من مجال الا لتحسين شروطه أو الحد منه، بدل المكابرة عليه وجعله يتعاظم.
المفاضلة تستدعي اذاً ايثار «الاعتدال» بكل ما فيه من ركود وفساد، على «الممانعة» بكل ما فيها من عدمية وشطط، من فوق ما فيها من ركود وفساد.
أما اذ تجاوزنا المفاضلة الآنية، فسيطالعنا الأساس الذهني والمعرفي المشترك والمختل، الذي اما أن يتوزّع المقولات السياسية واما يشطرها على نفسها، في لعبة فصام لا يظهر لها من آخر.
فالأجنحة «المعتدلة» تؤول الى التفريق التعسفي بين مرحلة «التربية على الديموقراطية»، وبين مرحلة «ممارسة هذه الديموقراطية بالفعل». مرحلة تربوية ثم مرحلة فنية جمالية. أو كما لو أن المسألة مماثلة لتعلّم قيادة مركبة آلية. كما لو أنه يتوجب على جيل أو أكثر «زرع» أسس الديموقراطية، بشروط غير ديموقراطية، وبالكاد ببذار ديموقراطية، في حين سينعم جيل مستقبلي افتراضي بـ«الحصاد»، دون أن يزرع.
هكذا يعهد «بتدريب» الناس على الديموقراطية، اما لأجهزة مبنية على تأبيد حال الطوارئ، وتحتاج هي لمن يدرّبها على الديموقراطية، ان لم يكن لمن يقتلعها من جذورها، واما لمنظمات أهلية غير حكومية، تنسى أن التعددية المفترض أن تقوم هي بين أحزاب سياسية بدرجة أولى، لا بين حركات اجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني، وهذا مذهب من ينتقد «محدودية» الديموقراطية «التمثيلية»، فيقترح أن «يعوّض» علينا بالديموقراطية «المحلوية» أو «بالرشاد الاداري» أو بـ«الحكمية الصالحة»، من حيث هي قبسات جزئية من ديموقراطية «مباشرة».
أما في حال العدول عن هذا الفصل بين مرحلة «يتربى» فيها الجمهور وبين مرحلة «يبدع» فيها هذا الجمهور ممارسة ديموقراطية «تمثيلية» لائقة أو ناضجة، فإننا سنتواجه مع المقلب الآخر من الفصام ذاته. حيث سيجري اختزال الديموقراطية الى لحظة انتخاب وإلى صندوق انتخاب. ويمكن على هذا الأساس أن تتواجه قوى ديموقراطية وقوى غير ديموقراطية في الانتخابات، ويمكن أن تفوز القوى الأخيرة، وأن تقلب الطاولة متى أرادت أو استطاعت.
ان اختزال الديموقراطية الى لحظة انتخابية فحسب هو يعدم كل ميزة تفاضلية بين من ينشط بالفعل من أجل الديموقراطية، وبين من ينشط بالفعل ضدها. ولطالما عرفنا حركات جماهيرية تعاني القمع لكنها تناهض الديموقراطية في الوقت نفسه، لا بل تطالب حيث لها حضور وشأو بمنع ما لا يرضيها من حريات عامة وخاصة.
وهذه هي بعض من مفارقات التيار الاسلامي، التي مهما تمايزت تلاوينه تعود وتلتقي على قاعدة مشتركة، تقضي بإعادة أسلمة المسلمين أنفسهم بحجة أن تأسلمهم غير كاف أو لم يعد كافياً.
فحين تروق «لعبة» الديموقراطية للتيار الاسلامي أو يجد أنه لا بدّ منها كمرحلة أو كملاذ لهبوط اضطراري، تراه يحبّذ «تأصيلها»، بل تمسي الديموقراطية عنده رديفاً للشورى، بضاعة المسلمين وقد ردّت اليهم. أما حين لا تعجب هذا التيار اللعبة الديموقراطية أو يضجر منها، فلن يتأخر حتى يرميها بالشرك، ويجعلها مسلكاً جاهلياً، يذكر بدار الندوة أو بملأ قريش.
وانك تجد أن معشر من يصفون نفسهم بالديموقراطيين أو بالليبراليين العرب يعودون هم أيضاً ويقعون في المطب نفسه، ولو بشكل أقل فدحاً.
فهؤلاء الليبراليون، وعلى الرغم من كونهم أقل أخذاً من حيث المبدأ بالتعليل على قاعدة الخصوصيات الانطوائية أو الفرادات الثقافوية، وأكثر تمسكاً بالمشتركات الوضعية والكونية، الا أنهم سرعان ما يتراجعون عن تقديم «الديموقراطية» كصنو للسياسة بالدرجة الأولى، للاكتفاء بها «ثقافة ادارية» ينبغي تنميتها من النخب ووصولاً الى القواعد، مع امكان أن تكون القابلة القانونية غير ديموقراطية، بل غير قانونية بالكامل.
3 استحالة التوفيق بين الإجماع الرسالي وبين المنظومة الحقوقية للحداثة:
لأجل ذلك ربما كان ينبغي الانطلاق لا من فكرة «الديموقراطية» بحد ذاتها، إنما من فكرة «الدستور». قلما وجدت فكرة الديموقراطية أنصاراً جماهيريين حقيقيين لها في العالم العرب، وقلما وجدت أعداء فعليين جادين معلنين كثراً، اذ غالباً ما تكون الحجة هي دفع الزغل بالزيغ، والدعوة قبل كل شيء للإجماع على «تعريف» للديموقراطية، تعريف لن يجري الاتفاق عليه قبل نهاية العالم.
بخلاف ذلك، فقد شكّلت فكرة «الدستور»، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين محور استقطاب ما بين القوى الاجتماعية والخيارات الكبرى في هذه المنطقة.
فقد حققت قوى الإصلاح والتنظيمات في الدولة العلية بدايات مواطنية عثمانية حديثة في أثر قيام الجيش النظامي وتبديد الانكشارية، اذ جاء إقرار خط كلخانة الشريف عام 1839 ليكرّس هذا المنحى، وكان شرط الانتقال من ثنائية الحاكم والرعاية الى ثنائية الدولة والمواطن هو الإقرار بالمساواة القانونية الشكلية بين جميع الرعايا، الذين يصيرون إذاك مواطنين بالقوة.
وقد كانت المواطنية العثمانية هي الإطار القيمي والقانوني المتمّم لضرورات التمدين والنمو السكاني، حيث أن أوّل وعي لتأخر السلطنة أمام الأمم المحيطة بها شمالاً وغرباً، والمكبدة إياها هزائم في أواخر القرن الثامن عشر، هو الوعي بالعطالة الديموغرافية، متقاطعاً مع الوعي بالتأخر العسكري، كماً ونوعاً.
أما الوعي بضرورة انتهاج المسلك الدستوري فقد جاء تتويجاً للتلاقح بين الوعي بضرورة إقرار المواطنة العثمانية وبين الوعي بضرورة ترسيخ وتوسيع الإصلاح الاداري والعسكري للسلطنة.
وعلى هذا الأساس تطلعت القوى الدافعة للتنظيمات الى قيام الدستور العثماني، وهو ما تحقق عام ,1876 مع اقرار النظام الأساسي، انما لسنتين يتيمتين. اذ أدت الهزيمة الجديدة أمام الروس، والصلح المخزي في ستان ستيفانو، الى تعليق السلطان عبد الحميد الثاني العمل بأحكام الدستور، وحله مجلس المبعوثان عام .1878
حتى العام ,1878 كانت القوى المؤيدة لفكرة «الجامعة الاسلامية» (التضامن بين المسلمين، التحديث كمساعد وحاث على هذا التضامن) هي قوى مؤيدة للتحديث والدسترة. كانت الحركة من أجل جامعة اسلامية هي الحركة الدستورية. وكانت الجامعة الإسلامية تتناقض في ذلك تماماً مع القوى المؤيدة لفكرة «الصحوة الإسلامية»، أي تلك التي تراهن على اعادة أسلمة المسلمين بحجة أن إسلامهم ناقص نخرته البدع واختل فيه ميزان الفطرة.
أما ابتداء من 1878 فقد تحولت الجامعة الإسلامية للانقلاب على الحركة الدستورية والإصلاحية، وسرعان ما بوشرت عملية ردم الهوة الفاصلة بين الجامعة الإسلامية وبين الصحوة الإحيائية أو السلفية. أما الاستبداد الحميدي، فلم يكن بمقدوره أن يعود للاستبداد التقليدي، ما قبل التنظيمات، وانما تحول الى ضرب من «حالة طوارئ مستمرّة لعقود»، ومسيرة بتفسير تآمري فظ للعبة الكبرى التي تضرب السلطنة.
إلا انه كنا نحتاج لمرحلة ما بعد ضياع السلطنة لنرى فعلاً عملية «التأليف» الأخوانية في مصر، بين فكرتي «الجامعة الاسلامية» و«الصحوة الاسلامية»، وقد كانتا في ما مضى فكرتين متواجهتين بل متناحرتين. فكرتان عجز جمال الدين الأفغاني عن التوفيق «النصف مسكوني، النصف ارتجالي» بينهما، واستنكر محمد عبده مغبة التوفيق بينهما، نظراً لتناقض ذلك مع فكرة الإصلاح الديني التربوي المتدرّج. أما محمد رشيد رضا فقد مهّد، في ظروف نهايات السلطنة، للمسار التوفيقي بين فكرتي «الجامعة الإسلامية» و«الصحوة الإسلامية»، ما سوف يدشنه «حركياً» الإمام حسن البنا عام 1928 بقيام جمعية الأخوان المسلمين كجمعية مناهضة في الأساس، لا لفكرة الديموقراطية التي «قد» يجوز تأصيلها، وإنما لفكرة الدستور التي لا تأصيل لها أو تسامح معها، كونها فكرة شريرة ضيّعت الخلافة في تركيا، وضيّعت على مصر العشرينيات، قصراً وأزهراً وأهلاً، الفرصة المثلى لحفظ الخلافة في المسلمين.
منذ عام 1928 اذاً، بدأت مرحلة جديدة من محاربة فكرة الدستور في الشرق العربي ـ الاسلامي، على أساس أن «القرآن دستورنا»، ولا شارع الا الله. لم يطل العهد كثيراً قبل أن نرى نظيراً قومجياً، وبالتحديد بعثياً للطرح الأخواني. فان لم يكن من شارع غير الله في مقال الأخوان المسلمين، فلا شارع بالمرة في مقال البعثيين.
المقابل البعثي للطرح الأخواني هو أن للأمة رسالة تعلو وتستخف بكل دستور، وانه وجب على جميع الدساتير أن تكون «مؤقتة»، جاهزة لحذفها جملة متى كانت تدعو الحاجة القومية الى ذلك.
المفارقة أنها دساتير يجب التأكيد على طابعها «المؤقت»، وعلى الطابع «المؤقت» للكيان الوطني أو «القطري» الذي هو اطار لها، في حين يقرّ من خلال طابعها «المؤقت» و«العابر» هذا، بالطابع «الأبدي» أو «الخالد» لسلطة الحزب القائد، أو القائد الحزبي، في المجتمع والدولة.
هكذا سدّدت للفكرة الدستورية طعنتان. واحدة من موقع «السياسة الشرعية» التي يمكنها تأصيل كل المقولات السياسية «باستثناء» مقولتي الدستور والمواطنة، وطعنة أخرى من موقع «الشرعية الثورية»، أو «الشرعية الانقلابية»، التي أطاحت بالتجارب البرلمانية في كل من سوريا ومصر والعراق.
لا يعني ذلك أن الطعنتين مختلفتان جوهراً من حيث القاعدة الذهنية ـ المعرفية لهما. فكل من «السياسة الشرعية» المعاد إطلاقها في «منار» محمد رشيد رضا، (بعد طي مغامرة محمد عبده في إعادة تأسيس علم التوحيد أو علم الكلام)، و«الشرعية الانقلابية» كما أسس لها آباء القومية العربية، انما تتشاركان في قاعدة ذهنية ـ معرفية مشتركة، عنوانها «الإجماع الرسالي الأمة»، الإجماع المسكون بالسحر، والمحترس من الجنّ، والمحيل إلى الغيب.
والأمة بشرط «الإجماع ما قبل الحداثي» هذه ليست الأمة بالمفهوم الحديث، كأمة عضوية ـ طوعية أو كدولة أمة، وإنما بالمفهوم ما قبل الحديث، كأمة رسالية، أمة «وسطى» بين جميع الأمم، أمة موصولة رأساً بحقيقة الحقائق، أمة يعتصم إجماعها بحبل الوحي.
في حالتي إعادة إطلاق «السياسة الشرعية» واندفاعة «الشرعية الانقلابية»، كنا أمام مواصلة للانقلاب الحميدي على الحقبة الوحيدة التي شهدت إصلاحاً سياسياً تاريخياً شاملاً في التاريخ الحديث لهذه المنطقة، أي حقبة التنظيمات العثمانية (1839ـ1878)، هذه التنظيمات التي فشلت لأنها أرادت تسخير فكرتي المواطنية والدستور كسبيل لإعادة شحن إجماع الأمة الرسالة التي تتوسط جميع الأمم، فكان ما كان.
كانت مغامرة إعادة تأسيس الإجماع الرسالي للأمة على قاعدة تظهيره كإجماع مواطني ودستوري هي المحاولة التاريخية الأولى والأخيرة لإخراج فكرة الاجماع الرسالي للأمة من سجل النظم الاستبدادية الآسيوية، ومن ثنائية الوحي أو الهوى، وما تجرّه من ثنائية تأصيل وتبديع.
حسبت التنظيمات العثمانية، هذه المغامرة الرائدة والمحبطة، أنه يمكن إنضاج «إجماع رسالي بشروط دستورية» بمثل ما خبر «الإجماع الرسالي للأمة»، مراحل مختلفة في تاريخه. إذ هو تحوّل من الإجماع الكاريزماتي للصحابة، أو «الجيل الاستثنائي» (سيد قطب) الحاضن والحامي للنص المؤسس والحافظ للمرويات النبوية، الى الإجماع على قاعدة العصبية في العصر الأموي من الملك العضوض، إلى الإجماع على قاعدة الإجماع الفقهي، في أعقاب عصر التدوين وقيام المذاهب، وهو الإجماع الذي تتمثل زاوية نظره في إقفال الاجتهاد في القضية التي صار عليها إجماع فقهاء في مذهب معين. ثم صرنا الى «الاجماع» السلطاني للسياسة الشرعية عند الماوردي وامام الحرمين الجويني، على قاعدة تثنية رأس الهرم بين خليفة وسلطان، بحيث يمكن للسلطان أن يحجم سلطة الخليفة، لكن محظر عليه أن يلغي الخلافة، أو يتخذها لنفسه، فالأئمة من قريش.
ويضاف بعدها «الإجماع السلفي» أو التنقيحي، الذي اجترحه ابن تيمية وابن القيم على أساس نفي التناقض أو «درء التعارض» بين العلوم النقلية أو السمعية وبين العلوم العقلية، واعتبار هذا التعارض اشكالية زائفة ودخيلة من أساسها، ودرؤها من خلال «إعادة توحيد» الدين، من حيث أن حجية الإسلام أنه دين للوحي (من فوق الى تحت) ودين للفطرة (من تحت) الى فوق، في آن، ولا مكان فيه، لثنائية «العقل والايمان» اليهو ـ مسيحية، كما لا متسع فيه لأي عرفان أو غنوص. قضى هذا الإجماع التنقيحي بالوصل مع الإجماع الكاريزمي لجيل الصحابة والتابعين، وباعادة تدوير الاجماع الفقهي ـ التقليدي، على هذا الأساس.
أسس هذا الاجماع التنقيحي لاحقاً لحركات الصحوة الاحيائية، التي كانت تختزن في ذاتها، في القرن الثامن عشر، وفي أشكالها المتعددة من الهند المسلمة الى الجزيرة العربية نجداً ويمناً، ما يمكن الاصطلاح على تسميته بالمقدمات «الجوانية» البدئية لاجتراح حداثة. حيث أن هذا الاجماع جاء يكسر حدية ثنائية التبديع والتأصيل، على اعتبار أن كل البدع ضلال، وان الاقتداء بالسنن كافة يغني عن كل البدع.
بيد أن مطب الاجماع التنقيحي أو السلفي، أنه بمراجعته للتقليد الكبير كما أرساه الفقهاء من «ورثة الأنبياء»، وبالذات كما أقام نظيمته الامام الشافعي، انما أعاد اطلاق التوتر بين مرجعيتي القرآن والسنّة، فصار تاريخ الإصلاح الديني في الاسلام الى سلسلة تقطعات بين نزعات «إعادة اعتبار» للقرآن تقابلها نزعات «إعادة اعتبار» للسنّة، بعد أن ضربت «الوحدة النصية» لهما، كما أقامها الإمام الشافعي.
أما من ناحية الصنيع التاريخي لبني عثمان فأمكن اجتراح تنقيح إجماعي من نوع آخر، بأثر من النموذج البيزنطي القيصري ـ البابوي، césaro-papiste، حيث الامبراطور هو رأس الكنيسة.
لم تكن وراثة العثمانيين لأسلافهم البيزنطيين مباشرة، انما من خلال أخذها عن تجربة نهوض الروس، في القرنين السابع والثامن عشر، وبشكل واضح بعد هزيمة العثمانيين أمام الامبراطورية كاثرين الثانية، وتوقيع صلح كوجوك كاينرديه عام ,1774 اذ كانت أول مرة يجتمع فيها لقبا السلطان والخليفة في توقيع معاهدة تلي القانون الدولي.
بمعنى من المعاني، كان الاجماع التنقيحي السلفي مناقضاً في الأساس للاجماع التنقيحي المقتبس عن النموذج البيزنطي. الأول ولّد دينامية «الصحوة الاحيائية»، أي تفكيك التقليد الكلاسي الكبير للاتصال مباشرة بالسلف الكاريزمي الصالح. أما الثاني فولّد دينامية «الجامعة الاسلامية»، التي احتضنت التنظيمات الاصلاحية العثمانية، ثم عادت، فقتلتها في مهدها.
المفارقة المأسوية ان فكرة الجامعة الاسلامية المتصالحة مع المواطنة والدستور لم تنقلب على نفسها شيئاً بعد شيء، انما انقلبت رأساً على عقب بشكل فظ ومباشرة بعد أن وصلت الى لحظة الذروة الدستورية. فبعد سنتين من اعتماد الدستور العثماني جرى تعليقه.
4 ـ دفاعاً عن الوراثة كحق
ما حدث لم يكن عارضاً. فالإجماع الرسالي الحريص على دعامة أن لا شارع غير الله، ليس يمكنه التوفيق بينه وبين المنظومة الحقوقية والسياسية للحداثة، لأنه لا سبيل في الأساس للتوفيق بينه وبين تفريع أصول الحق إلى ثلاث، أي الى حق الهي وحق طبيعي وحق وضعي.
الشكل الوحيد لإعادة إنتاج الإجماع الرسالي على محك الحداثة هو التخليط والتلفيق بين المصادر الحقوقية الثلاثة، ومن هنا آية العجز ومنتهى الشطط.
بتوزيع فكرة الحق بين أصول ثلاثة، فقد تمكن الغرب المسيحي من تأسيس الاستقلال المتبادل بين الفضاءات الثلاثة، الإله والعالم والإنسان.
لم يكن «انفكاك سحر العالم» مؤمناً إلا على هذه القاعدة. تلك القاعدة نفسها التي سمحت سياسياً، بالتسويغ لاستقلالية وتكامل المرتكزات الثلاثة لأي حركة دستورية، أي لمفاهيم «السلطة التأسيسية» (من حيث أنها مستقاة من فكرة الخلق الالهي بعد أنسنتها على قاعدة الاستقلال المتبادل للإله والإنسان)، و«السيادة السياسية» (من حيث هي التجسيد لفكرة الحق الطبيعي بعد أنسنتها على قاعدة الاستقلال المتبادل بين العالم، أو الطبيعة، وبين الانسان)، و«العقد الاجتماعي» (من حيث هو الإطار الميتافيزيقي الحداثي الذي استحله لنفسه الحق الوضعي سبيلاً للمواءمة بين الحقين الالهي والطبيعي، وسبيلاً لتجاوز أو «نسخ» كل منهما).
ثم أن هذا التثليث على صعيد مصادر الحق، عاد وانعكس تثليثاً على صعيد استقلال وتكامل السلطات الدستورية، بين تشريعية وإجرائية وقضائية، وفقاً لمبدأ مونتسكيو في وجوب أن تحد السلطة بالسلطة.
يقوم الإجماع الرسالي، المنقلب تلفيقاً وفصاماً ساعة يصطدم بمحك الحداثة، على أساس إنكار أي قائمية للعالم بذاته، وأي قائمية للإنسان بذاته.
لأجل ذلك، فإن كل التماس «لانفكاك سحر العالم» على قاعدة احترام منطق الإجماع الرسالي المسكون بقسمة الخلق إلى أنس وجن، إنما هو التماس محكوم بشكل قبلي، بإنكار قائمية أو واقعية هذا العالم بحد ذاته، وقائمية أو واقعية الانسان في هذا العالم بحد ذاته.
بمعنى آخر، اشتركت التيارات «السلفية» كما «النهضوية» في تنازع قاعدة مشتركة من العوائق الذهنية ـ المعرفية، التي ترسي على المفارقة التالية: أن أي إنكار لكون العالم مسكوناً بالسحر، سيؤدي، في حال عدم الخروج على الإجماع الرسالي للأمة، إلى إنكار حقيقة هذا العالم نفسه، كما سيؤدي كل إنكار لسطوة السحر على العالم إلى محاربة السحر بشعائر من السحر نفسه.
والمشكلة تعظم لأنه غالباً ما يحاول التفلت من سطوة «الإجماع الرسالي» على قاعدة تغييب الحجر الأساس في تفكيك سحر العالم، أي فكرة الحق الطبيعي.
وفي هذا الصدد، كل ما في مستطاعنا قوله الآن، هو أن ما يميز هذا الشرق العربي ـ الاسلامي، تاريخياً وانثروبولوجياً (اناسياً) ليس طغيان مبدأ الحق الطبيعي بالوراثة بوصفه منفذ الى فكرة الحق الطبيعي بعامة. إنما العكس تماماً، أي امتناع الوراثة من أن تدوّن حقاً بذاتها، واستمرار تصويرها على أنها اما أمر واقع حادث بالقوة، واما هي مرهونة بالإجماع، أو شكل من أشكاله، أو كفالة له.
وهذا يصح في السياسة والمُلك، كما في التملّك والاقتصاد. فعلى الرغم من أن الخلافة الإسلامية انتقلت من الراشدين الى الملك العضوض، إلا أن ما جرى كان أبعد من تكريس الوراثة بما هي حق طبيعي. إنما جرى تكريس مبدأ العصبية كشرط لازم لتحقيق الإجماع، وفي حدود الإجماع. لم يتأمن الحق الطبيعي بالوراثة السيادية لا في الخلافة والسلطنة، وحتى عندما جمع العثمانيون بينهما، لم يتمكنوا من إقرار الوراثة كحق طبيعي. بل كانت وصية الأب لابنه البكر بأن اقتل أخوتك ما أن تُولّى.
كذلك الملكية العقارية، ما كانت لتعرف حقاً نظراً لامتناع الوراثة كحق طبيعي. بل كانت المزرعة الضريبية (التمار أو الالتزام) تقتطع اما على أساس الاستحقاق العسكري أو الحظوة السلطانية، ولا تنتقل بالوراثة كحق طبيعي مكتسب، الا في فترة متأخرة من التاريخ العثماني.
تاريخياً، يمثل تكريس الوراثة كحق طبيعي، مرحلة رئيسية في التاريخ الحقوقي والقانوني، هي مرحلة يمكن أن تمهد لاحقاً لتجاوز حد الوراثة نفسه، من بعد تجذير «الحاضنة الوراثية» لمعنى الحق، وتطويره إلى درجة يفيض فيها، منها وعليها.
إنما العكس ليس صحيحاً. اذ لن يؤدي استتباب الوراثة المناطة بحد الإجماع، والقائمة بالتغلب، الى تكريس التوريث في حق طبيعي مستقل بذاته، بل لن يؤدي التغلب التوريثي المتمسح بقاعدة الإجماع الا الى مزيد من التمنع أمام المنظومة الحقوقية الحداثية جملة.
بهذا المعنى، يمكن المخاطرة بالقول مثلاً، إنه، في اليوم الذي يكرّس فيه مبدأ وراثة الابن البكر لأبيه في المملكة العربية السعودية بموجب قانون للتوريث، سنكون قد خطونا خطوة جبارة نحو قيام الملكية الدستورية فيها. النموذج النظري لا يحصر طبعاً في النموذج السعودي وحده.
أما في الجمهوريات العربية التي تبدو مقبلة على التوريث، والتي تخير شعوبها والعالم بين التوريث والفوضى، أو بين التوريث والمجاعة، من سوريا الى مصر، ومن ليبيا الى اليمن، فإننا أمام «جنوح توريثي» ليس يمكن تأطيره في حق. انما هو حالة متقدمة من تآكل شرعية النظم الجمهورية ونضوب مواردها السياسية، مقروناً بالتعطل شبه الكامل لآليات خلعها.
فالشرعيات الانقلابية ـ الجمهورية، وان قضت على البرلمانيات العربية السورية والمصرية والعراقية في الخمسينيات، إلا أنها كانت تبقي مجالاً لنوع تعسفي وفظ من «التداول على السلطة»، هو الانقلاب العسكري نفسه. حيث لم يكن «الحكم مدى الحياة» وارداً أو ميسّراً.
المنحى الذي تتخذه الشرعيات الانقلابية سيجنح إلى العكس بعد هزيمة 67 وأفول الناصرية. فصار الحكم مدى الحياة أكثر من وارد، في كذا جمهورية عربية، وصرنا أمام تجارب «ختم التجربة الانقلابية»، ليس بالعدول عن الثقافة الانقلابية، انما باجتراح الانقلاب الأخير، في سوريا ومصر والعراق كنهاية للتاريخ. ولم نكن أمام نموذج «الحكم مدى الحياة» ممنوحاً لآباء مؤسسين. اذ مَن مِن هؤلاء يمكنه أن يقارن بالغازي مصطفى كمال (أتاتورك) أو بالمجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة؟!
هذا الحكم مدى الحياة جاء من فرط امتناع أسباب الشرعية، وليس من فرط توفرها كشرعية تأسيسية نابضة. ان هذا الحكم مدى الحياة من دون انجازات تأسيسية هو عينه الحكم ما بعد الحياة، أو ما يمكن الاصطلاح على تسميته بـ«حالة طوارئ متواصلة الى فترة ما بعد الموت» Etat d”exception posthume، سواء تحقق ذلك بالتوريث البيولوجي الصرف (سوريا)، أو بحظر «ترويج اشاعات عن صحة الرئيس» (مصر). وهذه في عرفنا أبعد نقطة عرفها النظام السياسي العربي لجهة التخلف عن مسيرة الإصلاحات التي عرفها عهد التنظيمــات العثمانية في القرن التاسع عشر.
نص المساهمة المقدمة يوم الأحد 4 تشرين الثاني 2007
في اطار ندوة:
Global Challenges and Regional Trends – the Arab
World in Times of Change.
التي نظمها المركز الاقليمي لمنع النزاعات في الأردن بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور.