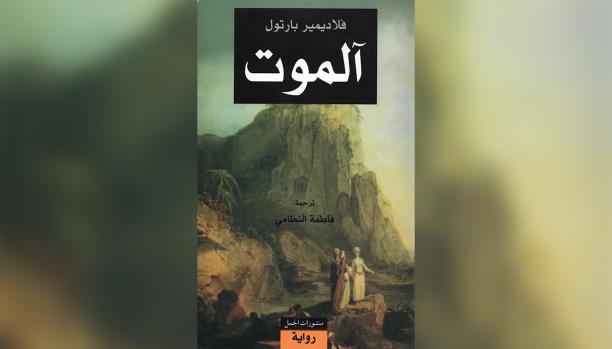صناعة الكراهية/ إبراهيم غرايبة

ثمّة ما يدعو إلى القول إن الكراهية بين الدول والمجتمعات يجري إنشاؤها وإشعالها على نحو واعٍ ومقصود، على الرغم مما في ذلك من خطورة وقسوة على مشعليها وضحاياها.. يؤشر هذا التهييج والحشد المليء بالكراهية والتحريض إلى أزمات جوهرية في السياسة، يراد إخفاؤها أو تأجيل استحقاقاتها، لكنه لا يحل الأزمات، بل يضيف إليها أخرى جديدة، ويجب القول والتذكير بأن الإرهاب ليس فقط أيديولوجيا متطرّفة، لكنه في الأساس منظومة بيئية اجتماعية وثقافية، والمتطرفون والكارهون والقتلة هم غالباً أشخاص أسوياء لم يرتكبوا جرائم جنائية، ولا يعانون من أزمات عقلية أو نفسية أو اقتصادية، لكنهم معبأون بالكراهية والشعور بالقهر والظلم والتهميش، أو وهذا هو الأسوأ معبأون بالاشمئزاز من آخرين وبالاستعلاء عليهم.
غالباً ما يرى الإرهابي نفسه الأفضل والأهم، لكن العالم لسوء الحظ لا يشاركه هذه القناعة، ولذلك يكون الإرهاب تعبيراً عن الإحباط والضرّر الذي يصيب تقدير الذات، والإحساس بالغضب والفشل. وفي ذلك، يجب النظر إلى السياسات والمواقف العامة والفردية التي تعكس شعوراً مبالغاً به بالصواب والأهمية والعظمة إنما تؤسس للإرهاب والكراهية، ولا حاجة إلى عمليات عنف وتفجير وقتل، لملاحظة الإرهاب الكامن في الشعور بالاستعلاء والتميز! وقد تلتبس هذه الرغبات التدميرية المكبوتة بدعاوى السلام ومكافحة الإرهاب والتطرّف، فتصير “مواجهة الإرهاب والتطرّف” إرهاباً وتطرّفاً.
يقول كيرت فونجوت، في روايته “جالد باجوس” “ما المصدر الخفي للشرور التي نشاهدها ونسمع عنها ببساطة في كل مكان غير ما لدينا من رادارات كهربائية عصبية زائدة التعقيد؟
“غالباً ما يرى الإرهابي نفسه الأفضل، لكن العالم لا يشاركه هذه القناعة” وأجيبك فأقول: لا يوجد مصدر آخر؛ كان كوكبنا بريئاً جداً، لولا هذه العقول الكبيرة العظيمة”. إنها مقولة تبدو صادمة جداً، لأنها ببساطة تعني أن الإرهاب والكراهية موجودان أساساً لدى أفراد يبدون بريئين، وتحملهما وتقوم عليهما دول ومجتمعات تظن نفسها تحارب الإرهاب! فالدماغ البشري يعمل بطريقة معقدة، أكثر تعقيداً مما نتخيل وبدرجة كبيرة، وتملك عقولنا وسائل تنشأ عنها تراكيب ذهنية مفرطة، تفوق ما نحتاجه ونرغبه منها، وأفكارنا ومعتقداتنا ورموزنا وملاحظاتنا هي كقبضة من ضباب، أو هي صلبةٌ مثل حجر من الجرانيت. وفي الحالتين نحتاج في تمثلها والتعبير عنها إلى أداء عصبي، وتتناسب قوة هذه الأفكار مع قدرتها على التأثير على حياة الفرد أو صياغتها، وفي التغييرات الجسمانية التي تحدثها (انفعالات وعواطف ومشاعر).
وأما بالنسبة إلى الوازع الأخلاقي؛ فإن كاثلين تايلور عالمة النفس والأعصاب بجامعة اكسفورد تصدمنا بالقول إنه ما لم تكن الأنماط القامعة نشطةً في أثناء تكوّن الحافز في مرحلة الاستعداد “التحضير”، فإن هذا الوازع لن يكون له صوت في “اللجان العصبية”؛ ولذلك سوف يفشل في التأثير في قرار الفعل، فالإنسان قد يملك كل ما يمكن أن يعطيه له المجتمع من تربية أخلاقية، وقد يبدي تفهماً واضحاً للمبادئ الأخلاقية الحاكمة لثقافته، وربما يتصرّف بحنان وطيبة مع من حوله. ومع ذلك، يصبح ممن يعذب الغير أو يكون قاتلاً، وقد يتعلم بالفعل كيف يقتل الأطفال الرضع من دون التخلي عن أخلاقياته، لكنه قد يجد من الصعب أن يعدل نفسه، ويعود إلى العيش السوي المألوف فيما بعد؛ فالتعاليم الأخلاقية لا جدوى منها، إذا لم تفعّل ويعمل بها، وتكون مشاركتها فعالة ونشطة عند اتخاذ قرار الفعل.
ولأن الأفعال المتقاربة تسببها أنماط ذهنية متداخلة، فإن التنشيط المتكرّر لفكرة إقصاء الآخر، حتى إن تم باعتدال، يطلق السلوك المتهور بشدة مفرطة، ويفسّر ذلك سبب الاستعداد السريع للمجرمين الذين تعرّضوا لإقصاء الآخر عدة سنوات، من دون ارتكابهم أعمال عنف، من أجل القتل مثل “الرجال العاديين”، ويفسر ذلك أيضاً لماذا يلجأ الناس الذين اعتادوا ثقافات العنف إلى القتل، لأسباب بسيطة وتافهة من وجهة نظرنا. إن تقبل المجتمع العنف وفكرة إقصاء الآخر هو الذي سهل التعديات المهلكة للقتلة.
“شبكات المعاني” التي تمثل نسيج كل المخلوقات البشرية هي شبكات اجتماعية ورمزية، تستمد قوتها على “تقييدنا” من حقيقة أنها جزء منا، هي ما نقول أو نفعل، والرموز التي نوقّرها،
“الأفعال المتقاربة
تسببها
أنماط ذهنية متداخلة” والأدوار التي نلعبها، وكلها تحدّد هويتنا باعتبارنا بشراً، فكما تحدّد أجسادنا وجودنا المادي، باعتبارنا كائنات حية مستقلة، قد توحد أحياناً بالتعاطف أو المحاكاة أو العناق الحاني أو الجنس كذلك، فإن معتقداتنا التي تحتل مشهدنا الإدراكي والمعرفي وطريقة إحساسنا بها تحدّدنا بصفتنا نظراء من الرأي والتفكير نفسها أو مختلفين، فتوحّدنا معاً أو تجعل كلاً منا منفرداً أو بمعزل عن الآخرين، وكلنا متحفز للدفاع عن نفسه في مجابهة التهديدات، سواء كان معنى النفس مادياً أو عملياً. لكن، بينما يكون التهديد المادي واضحاً للجميع، فإن التهديد بمعناه الرمزي موجه لنا ولكل من يعنينا أمرهم ونهتم بهم.
وبالطبع، لا يجوز أخلاقياً أن يفهم الإنسان على أنه تحرّكه المحفزات والدوافع، فذلك مرفوض أخلاقياً، وإن كانت حكومات كثيرة تود لو يفعل ذلك.
العربي الجديد